إن فتح المواد الأرشيفية الذي تم مؤخرا، يظهر بوضوح أن إسرائيل قد استخدمت أسلحة بيولوجية ضد السكان الفلسطينيين في عام 1948. وما تزال إسرائيل حتى يومنا هذا غير ملتزمة بالاتفاقيات المعترف بها دوليا بشأن استخدام مثل تلك الأسلحة. بينما يغض الإمبرياليون الأمريكيون الطرف عن كل هذا، لأنهم يمتلكون “أسلحة الدمار الشامل” الخاصة بهم.
كتب المؤرخ الفلسطيني، سلمان أبو ستة، مقالا مثيرا للاهتمام بعنوان: “انفضاح تاريخ إسرائيل المظلم”[1]، يتناول فصلا غير معروف من حرب 1948. يثبت هذا المقال أن النخبة الحاكمة في إسرائيل قد استخدمت الأسلحة البيولوجية حتى قبل إنشاء دولة إسرائيل، وذلك تحت أنظار الإمبرياليين البريطانيين خلال الأيام الأخيرة من الانتداب. وبالطبع فإن الطبقة السائدة الصهيونية تنفي ذلك. لكن إطلاق إسرائيل لأكثر من أربعة ملايين قنبلة متفجرة على السكان المدنيين، خلال الحرب الأخيرة في لبنان، كشف عن مدى همجية حكام دولة إسرائيل وما هم قادرون على اقترافه. في البداية تم إنكار القسوة اللاإنسانية التي ارتكبها الصهاينة في عام 1948 ضد السكان المدنيين، لكن المؤرخ الصهيوني، بيني موريس، اعترف لاحقا بصحتها، مما أعطى مصداقية لتلك الأبحاث. وفيما يلي ملخص لتلك المقالة.
تسميم إمدادات المياه في عكا
في أعقاب احتلال الصهاينة لحيفا، في 23 أبريل 1948، وتحت أنظار قوات الانتداب البريطاني، التي كانت تحت إشراف الجنرال ستوكويل، تعرضت عكا للهجوم. حاصر الصهاينة المدينة من الجهة البرية، وبدأوا يمطرون سكانها بوابل من قذائف الهاون ليل نهار. إلا أن عكا التي اشتهرت بأسوارها التاريخية، استطاعت أن تصمد أمام الحصار لبعض الوقت. كانت إمدادات المياه للمدينة تأتي من قرية كابري القريبة، على بعد حوالي 10 كيلومترات إلى الشمال، عبر قناة مائية. قام الصهاينة بحقن التيفوئيد في القناة عند نقطة وسيطة تمر عبر المستوطنات الصهيونية. [انظر الخريطة]
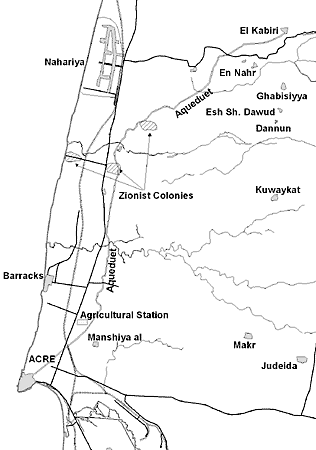
يمكن الآن سرد القصة بفضل ملفات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أصبحت متاحة بعد مرور 50 عاما على الحدث. حيث تصف سلسلة من التقارير، تحت الرقم المرجعي G59/1/GC, G3/82، والتي أرسلها مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دي ميورون، في الفترة من 06 ماي إلى حوالي 19 ماي 1948، ظروف سكان المدينة الذين أصيبوا بشكل مفاجئ بوباء التيفوئيد، والحالة الصحية التي عاشها سكان المدينة والجهود التي بذلت لمكافحتها.
والتقرير الأكثر أهمية هو محضر مؤتمر الطوارئ، الذي عقد في مستشفى الصليب الأحمر اللبناني في عكا، في 06 ماي، للتعامل مع وباء التيفوئيد. حضر اللقاء العميد بيفريدج، رئيس الخدمات الطبية البريطانية، والعقيد بونيه من الجيش البريطاني، والدكتور ماكلين من الخدمات الطبية، والسيد دي ميرون، مندوب اللجنة الدولية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في المدينة. ذكر المحضر أن هناك ما لا يقل عن 70 ضحية مدنية مؤكدة. في حين ربما لم يتم الإبلاغ عن الآخرين. وتقرر أن العدوى كانت “منقولة بالمياه”، وليس بسبب الازدحام أو الظروف غير الصحية كما ادعى الإسرائيليون. وتقرر أن تأتي إمدادات المياه البديلة من الآبار الارتوازية أو من المحطة الزراعية شمال عكا مباشرة [انظر الخريطة]، وليس من القناة. تم استخدام محلول الكلور المائي، وبدأ تلقيح السكان المدنيين، وتم التحكم في حركة السكان المدنيين (خشية أن يحمل اللاجئون المتجهون شمالا نحو لبنان وباء التيفوئيد معهم، كما كان يريد الصهاينة).
وذكر دي ميورون، في تقاريره الأخرى، وقوع 55 ضحية بين الجنود البريطانيين، الذين تم نقلهم إلى بورسعيد لتلقي العلاج. رتّب الجنرال ستوكويل سفر دي ميورون على متن طائرة عسكرية إلى القدس لإحضار الأدوية. لم يكن البريطانيون، الذين تركوا فلسطين في أيدي اليهود، يرغبون في وقوع حادث محرج آخر يؤخر رحيلهم.
وقال العميد بيفريدج لدي ميورون إن هذه كانت “المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في فلسطين”. وهذا يكذب الرواية الإسرائيلية، بما في ذلك رواية المؤرخ الإسرائيلي، بيني موريس، بأن الوباء كان بسبب “الظروف غير الصحية” للاجئين. ثم إذا كان الأمر كذلك، فكيف كان هناك عدد متساو تقريبا من الضحايا بين الجنود البريطانيين؟ ولماذا لم تتسبب مثل تلك الظروف في انتشار الأوبئة في التجمعات الأخرى للاجئين، والتي كانت تعيش في ظل ظروف أسوء بكثير، في يافا واللد والناصرة وغزة؟
أبدى مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دي ميرون، إعجابه الكبير بالجهود البطولية التي بذلها الأطباء العرب، الدكتور الدهان و الدكتور الأعرج، من مستشفى الصليب الأحمر اللبناني في عكا، والدكتور دباس والدكتورة بهائي من حيفا.
مدينة عكا، التي كانت منهكة بالوباء، أصبحت فريسة سهلة للصهاينة. فكثفوا قصفهم، وكانت شاحنات تحمل مكبرات الصوت تعلن مهددة: “استسلموا أو انتحروا. سندمركم حتى آخر رجل”.
هذه الحادثة التي بدأت بتسميم مياه عكا، وانتهت بسقوط المدينة وتهجير سكانها واحتلالها، تكررت في أماكن أخرى.
تسميم غزة
بعد أسبوعين، وبعد “نجاحهم” في عكا، ضرب الصهاينة مرة أخرى. هذه المرة في غزة، حيث تجمع مئات الآلاف من اللاجئين بعد احتلال قراهم في جنوب فلسطين. لكن النهاية كانت مختلفة.
تم إرسال البرقية التالية من قائد القوات المصرية في فلسطين إلى القيادة العامة بالقاهرة:
الساعة 15.20، 24 ماي [1948] ألقت قوات استخباراتنا القبض على يهوديين، ديفيد هورين وديفيد مزراحي، يتسكعان حول مواقع للجيش. وتم استجوابهما واعترفا أن الضابط موشيه أرسلهما لتسميم مياه الجيش [ومياه الشعب]”. كانا يحملان معهما قنينات مياه مقسمة من الوسط، الجزء العلوي به مياه صالحة للشرب، والجزء السفلي به سائل ملوث بالتيفود والدوسنتاريا، ومجهزة بفتحة خلفية يمكن من خلالها خروج السائل، واعترفا بأنهما أعضاء “فريق مكون من 20 فردا أرسلوا من رحوفوت لنفس الغرض. وقد كتب كلاهما اعترافهما باللغة العبرية ووقعا عليه. وقد اتخذنا الاحتياطات الطبية اللازمة.
الكوليرا في مصر وسوريا
كان صيف عام 1947 حارا بالنشاط الدبلوماسي. كانت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) مشغولة بجولة في فلسطين والبلدان العربية، من أجل اقتراح تقسيم فلسطين بحيث يتم منح اليهود المهاجرين الجدد إلى فلسطين، والذين كانوا تحت الانتداب البريطاني يسيطرون على 06% فقط من فلسطين، قطعة كبيرة من فلسطين (التي تبين فيما بعد أنها 54%) من أجل إقامة دولة أجنبية في وسط الأرض العربية.
والعرب، الذين كانوا ما يزالون تحت وصاية بريطانيا، كانوا يتناقشون حول كيفية مقاومة المخطط المدعوم من الغرب للاستيلاء على أراضيهم. كانت القوى التي يجب أن يحسب لها حساب هي البلدان المجاورة ذات الحدود المشتركة مع فلسطين. لبنان كان بلدا ضعيفا. وكان شرق الأردن ما يزال خاضعا لسيطرة البريطانيين بشكل مباشر، وكان الملك عبد الله تصالحيا مع اليهود. فلم يكن هناك سوى مصر، البلد العربي الأقوى، وسوريا، التي كانت قد تحررت للتو من براثن الانتداب الفرنسي. كانت سوريا مركز المقاومة العربية للاحتلال الأجنبي لفلسطين، حيث أنشئت مراكز تدريب في قطنا لإعداد المتطوعين العرب للدخول إلى فلسطين تحت شعار “جيش الإنقاذ العربي”. وهكذا فقد كانت مصر وسوريا أهم الأهداف.
في تقريره المكون من 220 صفحة، والذي يتم تحديثه باستمرار، بعنوان: الإرهاب البيولوجي والجرائم البيولوجية: الاستخدام غير المشروع للعوامل البيولوجية منذ عام 1900، بتاريخ فبراير 2001، يسرد الدكتور، سيث كاروس، من مركز أبحاث مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، جامعة الدفاع الوطني، واشنطن، ما يلي: عنوان فرعي، ص 87: القضية رقم 1947-01: الإرهابيون “الصهاينة” 1947-1948.
يشير في ذلك القسم إلى أن تفشي الكوليرا في سوريا ومصر حظي باهتمام واسع في الصحافة الدولية. نُشر أول تقرير عن الكوليرا في مصر في صحيفة التايمز اللندنية، في 26 شتنبر 1947، ص04. وبحلول الوقت الذي ظهرت فيه الحالات النهائية في يناير 1948، كان 10.262 شخصا قد ماتوا.
ويذكر أيضا أن تفشي المرض في سوريا كان أقل بكثير، حيث اقتصر على بلدتين، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب دمشق، أي قرب الحدود الفلسطينية. ظهر التقرير الأول في صحيفة نيويورك تايمز في 22 دجنبر 1947، الصفحة 05.
فرض الجيش السوري طوقا صحيا واقتصرت الخسائر البشرية على 44، بينهم 18 قتيلا. وبعد ذلك بفترة وجيزة، أوردت صحيفة أورينت، الناطقة بالفرنسية في بيروت، أنه تم اعتقال عدد من العملاء الصهاينة الذين استخدموا الكوليرا لتعطيل تعبئة جيش المتطوعين. مصيرهم غير معروف.
هذه الحوادث، بالإضافة إلى حادثة التسمم في غزة، كما يقول كاروس، تم وصفها في شكوى اللجنة العليا للأمم المتحدة واقتبس من التقرير قوله: “إن اليهود يخططون لاستخدام هذا السلاح اللاإنساني ضد العرب في الشرق الأوسط في حرب الإبادة التي يشنونها”.
ويضيف كاروس معلومات من مصادر أخرى حول التسمم في غزة. قال كاروس، صرحت راشيل كاتزمان، شقيقة هورين: “التقيت بأحد قادة [أخي] في محاضرة في القدس. وسألته عما إذا كان أخي قد حاول بالفعل تسميم الآبار. فأجاب: “كانت تلك هي الأسلحة التي كانت لدينا”، “وهذا ما كان”.
ويضيف كاروس أيضا مصدرا آخر حول تسميم عكا: يقول هذا المصدر: “تزعم هذه الرواية أيضا أن الإسرائيليين سمموا إمدادات المياه في بلدة عكا العربية، مما تسبب في تفش كبير للمرض في عكا وقرى عربية أخرى لمنع القرويين من العودة، ونقل عن المؤرخ العسكري أوري ميلستين كمصدر للخبر”[2].
كيف بدأ بن غوريون كل هذا؟
في الرابع من مارس 1948، كتب بن غوريون رسالة إلى إيهود أفرئيل، أحد عملاء الوكالة اليهودية في أوروبا، يأمره فيها بتجنيد علماء يهود من أوروبا الشرقية يمكنهم “إما زيادة قدرتنا على قتل أعداد كبيرة، أو قدرتنا على علاج أعداد كبيرة؛ كلاهما مهم”. هذا الاقتباس مقتطف من تصريح لأفنير كوهين، الذي استشهد بمؤلف في مركز أبحاث بن غوريون في سديه بوكر.
في الأربعينيات، جمع بن غوريون حوله إرنست ديفيد بيرجمان، وأبراهام ماركوس (ماريك) وكلينجبيرغ (من الجيش الأحمر) والأخوة أهرون وأفرايم كاتاشالسكي (كاتسير)، والذين كانوا جميعهم خبراء في علم الأحياء المجهرية (Microbiology).
لقد شكلوا نواة الفيلق العلمي في منظمة الهاغاناه أثناء الانتداب البريطاني. في ماي 1948، تم تعيين أفرايم كاتاشالسكي قائدا لتلك الوحدة الجديدة، التي تمت تسميتها HEMED. ونشأ خلاف بين حاييم وايزمان، الذي كان يرغب في إنشاء معهد علمي للعلوم “النظيفة”، بينما أصر بن غوريون على بناء مركز “قذر” للأسلحة البيولوجية. كلاهما حقق رغبته. تم بناء معهد وايزمان للبحث العلمي في رحوفوت. وتم تشكيل وحدة جديدة داخل HEMED، مخصصة للأسلحة البيولوجية وسميت هيمد بيت، كانت تابعة للجيش الإسرائيلي، وكان رئيسها ألكسندر كينان، عالم الأحياء المجهرية من كلية الطب في الجامعة العبرية في القدس.
وبعد إخلاء 530 بلدة وقرية فلسطينية، في النكبة عام 1948، أصبحت العديد من المباني والمنازل شاغرة، سكن فيها أكثر من نصف المهاجرين اليهود في الخمسينيات. فاختار رئيس الأركان، ييجال يادين، مقرا لوحدة تطوير الأسلحة البيولوجية الجديدة في قصر يقع داخل بستان برتقال كبير غرب نيس زيونا. هذه الوحدة، المعروفة باسم المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية (IIBR)، ما تزال موجودة حتى اليوم.
مطاردة الجناة
سارة ليبوفيتز دار، صحفية استقصائية مثابرة. تركت الصدمة التي تعرض لها والداها في موطنهما ليتوانيا بصمة لا تمحى عليها. لقد كانت تمقت الظلم، وتمقت على وجه الخصوص التعايش الوديع معه. قامت بالتحقيق في تسميم غزة وعكا وإسقاط الطائرة المدنية الليبية. حدد لها المؤرخ العسكري الإسرائيلي، أوري ميلشتاين، أسماء الضباط المسؤولين عن الجرائم البيولوجية.
وفي عام 1993، حاولت سارة إجراء مقابلة مع القائد المسؤول عن تسميم عكا. لكنه رفض الحديث عن الموضوع، وقال: “لماذا تبحثين عن المشاكل التي حدثت قبل 45 عاما؟ لا أعرف شيئا عن ذلك. ما الذي ستكسبينه من النشر؟”.
ومرة أخرى، أجرت سارة مقابلة مع الضابط المسؤول عن تسميم غزة. والذي، بدوره، رفض الرد، وقال: “لن تحصلي على إجابات على هذه الأسئلة. لا مني ولا من أي أحد آخر”. لكن سارة كانت مثابرة، وسألت العقيد شلومو غور، رئيس HEMED السابق، عما إذا كان على علم بالعمليات السرية التي حدثت عام 1948، فأجاب: “سمعنا عن وباء التيفوئيد في عكا وعن عمليات غزة. كانت هناك شائعات كثيرة، لكنني لا أعرف ما إذا كانت صحيحة أم لا”.
نشرت سارة النتائج التي توصلت إليها في صحيفة “حداشوت” تحت عنوان “الميكروبات في خدمة الدولة”، في 13 غشت 1993، الصفحات من 06 إلى 10. وقد اختتمت سارة، التي انتقلت الآن إلى هآرتس، المقال بالتعليق التالي: “إن ما تم القيام به آنذاك عن قناعة عميقة وحماس، أصبح الآن مخفيا بالعار”[3].
ليصير العالم أكثر أمانا لا بد من الاشتراكية
تظهر الحقائق الموثقة أعلاه أن الطبقة السائدة الصهيونية لم تكن لديها أية مخاوف في الماضي بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية ضد السكان المدنيين. لكن هذا لم يمنعها من توجيه أصابع الاتهام إلى نظام صدام حسين بنشر الذعر من التهديد الوشيك بإطلاق هذه الأسلحة. ومع ذلك، فقد كانت مسؤولة عن استخدام مثل هذه الأسلحة قبل فترة طويلة من أن يستخدمها صدام حسين ضد المدنيين العزل في بلده.
وهذا هو نفس نفاق الطبقة السائدة في الولايات المتحدة. إنهم يجوبون العالم ليخبروا البلدان ما إذا كان بإمكانهم امتلاك أسلحة نووية أم لا، مشيرين إلى مخاطر مثل تلك الأسلحة. لكنهم يتجاهلون بسهولة حقيقة أن الطبقة السائدة الوحيدة في التاريخ، على الإطلاق، حتى الآن، التي استخدمت هذه الأسلحة ضد المدنيين الأبرياء، هي الطبقة السائدة الأمريكية في عام 1945.
ليس صدفة أن إسرائيل قد وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية لكنها لم تصدق عليها حتى يومنا هذا. كما أنها لا تشارك في اتفاقية الأسلحة البيولوجية. كما أن إسرائيل لا تسمح بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، على عكس بقية بلدان العالم.
تنص المادة 147 من اتفاقية جنيف على أن “التسبب عمدا في معاناة شديدة [للمدنيين] أو في أذى خطير للجسم أو الصحة” يعد “انتهاكا جسيما”، يتطلب، وفقا للمادة 146، من جميع “الأطراف المتعاقدة” “البحث عن الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات الجسيمة أو أمروا بارتكابها”، ويجب عليهم أيضا “إحضار ذلك الشخص بغض النظر عن جنسيته أمام المحاكمة”.
إن سبب عدم التزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات المعترف بها دوليا أمر واضح. لا بد أن لديها مخزون من الأسلحة التي تعتبر بشكل عام “غير قانونية”، وبالتالي فإنها لا تريد التوقيع على “مذكرة اعتقال” خاصة بها، إذا جاز التعبير. كما أنها لا تريد أن تتدخل أي هيئة دولية في ما تعتبره “شؤونها الداخلية” في الأراضي الفلسطينية.
وكأن هذا كله ليس كافيا، فإن القوى الإمبريالية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تختار أيضا من يمكنه امتلاك الأسلحة النووية. من المعروف أن إسرائيل تمتلك القدرة النووية، لكن لم يتم فعل أي شيء لوقف ذلك. وكما هي العادة، فإن الأمر لا يعتمد على الأسلحة التي تمتلكها، بل على من هم أصدقاؤك. إذا كنت صديقا للإمبرياليين الأمريكيين، وتنفذ أوامرهم، فيمكنك الإفلات من العقاب. لكن إذا دخلت، لسبب ما، في صراع مصالح مع الإمبريالية، ولا سيما الإمبريالية الأمريكية، فإنك تخاطر بأن تتعرض للقصف والغزو. وهكذا فإن إسرائيل، والأنظمة الأخرى التي تمتلك الأسلحة النووية و”أسلحة الدمار الشامل” والأسلحة البيولوجية وما إلى ذلك، تترك لشأنها. لكن صربيا، ثم العراق، تتعرضان للقصف، وتتعرض البلدان الأخرى للترهيب.
كل هذا يوضح أن الأمر لا يتعلق نهائيا بالرغبة في جعل العالم مكانا أكثر أمانا للعيش فيه. كلا! إن الأمر يتعلق بالسيطرة على الأراضي ومصادر المواد الأولية ومناطق النفوذ. إن الخطر الحقيقي الذي يواجه شعوب هذا الكوكب ليس القوى الصغيرة والضعيفة نسبيا التي قد تدخل أحيانا في صراع مع المصالح الحيوية للإمبريالية. إن الخطر الحقيقي يأتي من القوى الإمبريالية الرئيسية، المستعدة لاقتراف أي فعل للدفاع عن مصالحها. إن محنة الشعب الفلسطيني، والمصير الرهيب الذي لقيه الشعب العراقي، الخ، هي شهادة كافية على ذلك.
إن أي شخص يريد عالما يتحول فيه تسميم إمدادات المياه بالتيفوئيد، أو إلقاء قنابل ذرية ضخمة، إلى ماض همجي مظلم وبعيد، يجب أن يفهم أن هذا لا يمكن أن يصبح حقيقة إلا إذا تم القضاء على المجتمع الطبقي الذي نعيش فيه. لن يصبح العالم مكانا آمنا للعيش فيه حقا، إلا عندما ستكون لدى العمال العاديين في كل مكان سيطرة حقيقية، وتكون لديهم سلطة حقيقية بين أيديهم. ولهذا السبب فإن العمل الصبور والمضني من جانب الشيوعيين الحقيقيين في جميع البلدان لبناء قوة سياسية قادرة على قيادة الطبقة العاملة في كل مكان إلى حسم السلطة، ليس حلما كاذبا. إنه النشاط الحقيقي الوحيد الجدير بالاهتمام الذي يمكننا الانخراط فيه. إن العالم يمكن تغييره ويجب تغييره.
الهوامش:
[1] “Israel’s Dark History revealed”
[2] Wendy Barnaby, The Plague Makers: The Secret World of Biological Warfare, London, Vision Paperbacks, 1997, pp114-116.
[3] للحصول على المقال كاملا يمكنكم الذهاب إلى: http://www.informationclearinghouse.info/article1750.htm
فريد ويستون ويوسي شوارتز
4 يناير 2007
ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية


