أصبح “الحوار الوطني”، منذ أن أعلن عنه الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، هو حديث الساعة بالنسبة للمعارضة والمهتمين بالشأن السياسي بشكل عام، وسط ترقب وانفتاح لباب النقاش السياسي. الدولة دفعت بكرة لن تستطيع وقفها بدون ضجيج بسهولة.
التفاعل الكبير في الأوساط السياسية مع هذه الدعوة دليل على تعطش قطاع من الجماهير، وبشكل خاص الشباب، للجدل السياسي. كما تلقفت المعارضة اليسارية والديمقراطية الدعوة بموجة من الأوراق والنقاشات والاجتماعات واللقاءات التلفزيونية، التي يُسمح لشيوخ المعارضة الإصلاحية المرتعشين فقط بالظهور فيها. كل هذا يأتي بعد سنوات من التجريف المنظم للمجال السياسي ومحاولة نزع النقاش والجدل من المجتمع.
هذه المقالة هي محاولة لفهم أسباب تلك الدعوة واستشراف إمكانياتها ومآلاتها.
وقبل كل شيء يجب أن نقول، إننا لا نثق في النظام ولا في تلك الدعوة، التي ليست أكثر من مناورة يسعى بها النظام لتجاوز أزمته عن طريق خلق حالة من “الاصطفاف الوطني”، ولا نتشارك وجهة النظر الإصلاحية التي تعتقد وتقول أنه يمكن التأثير على النظام أو إصلاحه، لا يمكن دفع النظام إلى تقديم تنازلات جدية وحقيقية إلا بضغط النضال الجماهيري، هذه نقطة مهمة ويجب أن تكون واضحة.
وقمع النظام لانتخابات النقابات الأخيرة عن طريق التزوير والتهديدات بالاعتقال أو الفصل من العمل دليل على عدم نية النظام فتح المجال السياسي بشكل حقيقي، واستمرار قمع المعتقلين السياسيين والتضيق عليهم مثلما يحدث حالياً مع علاء عبد الفتاح وحسن مصطفى وأحمد سمير سنطاوي وغيرهم هو دليل على ذلك، ومنع أحمد طنطاوي -وغيره- من الظهور على القنوات المصرية بعد حديثه القوى عن الحوار السياسي دليل على أن النظام لا يريد حوارا جادا وإنما مسرحية هزلية ويريد أن يحول المعارضين إلى مهرجين ومصفقين في مؤتمراته.
لماذا الآن؟
يواجه النظام أزمة اقتصادية عميقة أدت إلى تدني مستويات دعمه إلى أدني مستوياتها منذ العام 2013، مع ازدياد تكلفة المعيشة بشكل مضطرد نتيجة زيادة كبيرة في معدل التضخم، وبالتالي زيادة الفقر والبؤس، ما دفع الجماهير لتتحدث بشكل علني عن الأزمة وتوجه نقضها للنظام. وهذه الأزمة سوف تستمر، خصوصاً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التى لا يبدو أنها سوف تنتهي في القريب العاجل، واشتداد الأزمة العالمية بشكل عام.
بشرعية سياسية تتداعى باستمرار، ومع انخفاض تأثير ورقة “محاربة الإرهاب”، وسط كل هذا لجأ النظام إلى ورقة “الحوار السياسي”. يريد النظام بهذه الورقة أن يحول انتباه الجماهير عن المشاكل الاقتصادية بانتظار الإصلاحات السياسية التي بدورها ستجلب إصلاحات اقتصادية في وقت ما. وفي هذا يحاول أن يستخدم المعارضة المدنية كمنفس للغضب الجماهيري بدعوي: “أن النظام يشعر بما أصاب الشعب، والدليل هو الحوار السياسي، ولينتظر الشعب نتائجه”، أى أنه يحاول أن ينزع النقاش البادئ في المجتمع في الشوارع وأماكن العمل والمواصلات العامة وتوجيهه إلى قاعات الاجتماعات. هذا بالإضافة لاستخدام ذلك الحوار لتحسين صورته خارجياً.
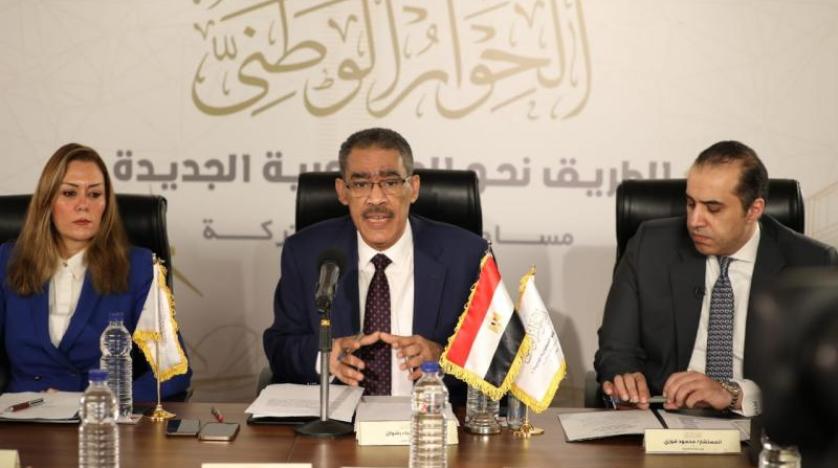
كان بالفعل ظهر منذ فترة تيار داخل الدولة يري في الإغلاق التام للمجال السياسي و إخراس كل الأصوات، حتى الخجولة منها، خطرا على الدولة، وسيدفع بالأحزاب والحركات السياسية إلى العمل تحت الأرض، بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام الجماهير -والشباب بشكل خاص- وهو ما قد يعني احتمالية انفجار غير متوقع في مرحلة ما، فيري هذا التيار أنه من الأفضل والأسلم للدولة السماح بهامش ما من السياسة يتم تفريغ شحنة الغضب الجماهيري من خلالها، ومن الواضح أن الفرصة أعطيت جزئياً لذلك التيار الآن، خصوصاً بعد استتباب سيطرة الدولة بشكل كامل على المجال السياسي حالياً.
وصل الديكتاتور لمستوى من الثقة بالنفس يجعله يظن أنه يمكن أن يطلق دعوة لحوار سياسي بدون أن يتحمل أى تبعات لذلك، وإن المعارضة ستأتي صاغرة فارحة بتلك الدعوة، تسمع وتطيع وتقبل بما يُقدم لها، والحقيقة أن أداء أغلبية قيادة تلك المعارضة الليبرالية والإصلاحية يتوافق مع ذلك التصور. تلك الثقة بالنفس تدفع بالديكتاتور الآن لارتكاب أول خطأ سياسي حقيقي له قد يجلب عليه تبعات لا يتمناها.
حول المعارضة المدعوة
تم توجيه دعوة الحوار الوطني بشكل أساسي إلى ما يسمى “الحركة المدنية”، وهي خليط من الأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية الإصلاحية المعارضة، وتم توجيه الدعوة بحضور حمدين صباحي المعارض الناصري الأبرز.

لا يبدو على القادة الاصلاحيين القدامى لتلك الأحزاب أنهم ينوون اتباع نهج مختلف عن الماضي، نفس الحديث الركيك القائم على المظلومية والتوسل لصاحب الأمر لكي يسمح لهم بالحديث والظهور، لدرجة أن بعضهم أعاد تذكير النظام بخدماتهم له، مطالبين بإعادة إحياء “تحالف 30 يونيو”، هذا الحلف الذين كانوا هم أنفسهم من ضحاياه بعد أن وصل الديكتاتور للحكم، وكأنهم لم يتعلموا شيئاً من التاريخ، أم لم يسمعوا إن من الغباء أن تقوم بنفس الخطوات وتنتظر نتائج مختلفة. هذا المستوى البائس غير مبشر إطلاقاً، وينذر بتكرار مأساة أخطاء الماضي، التي دفع هؤلاء القادة من مصداقيتهم الكثير بسببها.
لكن هناك رقم جديد في المعادلة، وهو جيل جديد من الكوادر والقيادات في الأحزاب اليسارية أكثر راديكالية من الشيوخ، وتنظر هذه الشريحة إلى تجربة “المعلمين” بعين النقد، وهذا ما يمكن أن يشكل فارقاً. لكن حتى الآن من الواضح أن كفة الشيوخ هي من تترجح، والإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في الأيام الأخيرة يرجح كفة الشيوخ المطالبين بالتعقل وافتراض حسن النية في النظام في مقابل جناح الشباب الأكثر راديكالية، ومن الأكيد أن هذه سياسة واعية من قبل النظام.
قيادة تلك الأحزاب لا تبدي الجدية الكافية في التعامل مع الوضع الحالي ولا تعمل على إشراك الجماهير في ما يحدث بشكل كامل، أنهم مازالوا يتعاملون مع أنفسهم بصفتهم المعلمين والجماهير هم التلاميذ. هذا النهج المعتاد للقيادة المتمثل في تقمص دور الحكماء انتج انفصال كبير عن الجماهير وهو ما يؤدي بهم دائماً لارتكاب أخطاء فادحة، وهو نتيجة حتمية لنهجهم الإصلاحي الذي يجعلهم يعتقدون أنه يمكن التأثير على النظام بالحكمة والموعظة الحسنة وإمكانية إصلاحه بدلاً من التوجه للجماهير والاعتماد عليها.
حتى الآن لم تعلن قيادة تلك الأحزاب عن تفاصيل الاجتماعات التي تجريها مع الدولة الآن ولا تعلم الجماهير عن محتواها شيئاً. إن كانت تلك الأحزاب جدية حقاً في تمثيلها للجماهير والمعارضة الحقيقية فلتعمل على نبذ ذلك التقليد القذر الخاص باتفاقيات الغرف المغلقة، التى يعلم الجماهير محتواها بحكم الأمر الواقع.
التجربة السيئة المليئة بالأخطاء الفادحة لشيوخ تلك الأحزاب الاصلاحية في سنوات الثورة مازالت عالقة في الأذهان، وهو ما يجب على الشباب التعلم منه والعمل على عدم تكرارها. والحقيقة أن على الشباب المتطلع للتغيير بشكل حقيقي القطع مع تلك القيادة ونهجها الإصلاحي، لكي لا ينتهي بهم الحال بمثل ما انتهى إليه شيوخهم.
أى قدر من التذيل للنظام -حتى ولو ضئيل- والتوسل له والانفصال عن الجماهير، سيؤدي بتلك الأحزاب لارتكاب أكبر أخطائها منذ ما بعد الثورة، وهو ما سوف يحولهم لأداة في يد النظام يمرر من خلالهم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية شديدة الهمجية، وسوف يتخلص منهم مجدداً عندما ينتهي دورهم، ولنا في “تحالف 30 يونيو” المشئوم عبرة وعظة.
تبعات الدعوة
الأكيد أن هذا الحوار سوف يخصم من رصيد النظام، سواءً تم أم لم يتم. إن تراجع النظام عن إجراء الحوار نتيجة عدم احتماله للجدل السياسي والنقاش الجدي، أو حوله لمؤتمر صوري، فسوف يؤكد مجدداً على طبيعته الديكتاتورية، وهي الحقيقة البادية للعيان، لكنه حينها سوف يضرب أيضاً كل دعايته حول الفترة الاستثنائية الماضية التي لجأ فيها لقمع الجميع لحماية المجتمع من الإرهاب وأنه الآن حان وقت “الجمهورية الجديدة”، وما إلى ذلك من الدعاوى التي يحاول استخدامها الآن.
وإن تم هذا الحوار، فسوف يخلق هامش -حتى ولو مؤقت- لما تسمى ب”المعارضة المدنية”، نتيجة عرض وجهات النظر في الحوار، والذي سوف يتسرب إلى العلن حتى إن لم يرد النظام، وهو ما سيؤدي لتقويض شرعية النظام أكثر وبشكل أسرع. لكن النظام لن يسمح بأن يصل لتلك النقطة بسهولة، وهو ما قد يؤدي لموجة أخرى من القمع العنيف لإخراس الجميع نتيجة “تبجح” المعارضة الاصلاحية في الحديث أكثر مما تسمح لهم الديكتاتورية العسكرية.
الأسابيع والشهور القادمة سوف تبين إلى أي سيناريو سوف نذهب جميعاً، لكن من الواضح أن النظام دخل في مرحلة من التخبط، ومحاولته استخدام المعارضة لاحتواء الأزمة هي أشبه بالسحر الذي من الممكن أن ينقلب على الساحر، حتى ولو على المدى البعيد. والأكيد أيضاً أن كل هذا لن يؤثر على سيرورة الصراع الطبقي الآخذة في ازدياد، ولن يحل الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، ولن يشفع للديكتاتور ونظامه أى مقدار من الجلسات مع المعارضة في أعين الجماهير التي كفرت بالسياسة الرسمية والتي ترى حياتها تزداد صعوبة يوماً بعد يوم وترى حاضرها ومستقبلها يسرق منها.
لا ثقة في النظام العسكري!
من أجل التوجه للجماهير!
الحرية للمعتقلين السياسيين!
تسقط الديكتاتورية العسكرية الحاكمة!
تسقط حكومات رأس المال!
لا حل سوى انتصار الثورة الاشتراكية بقيادة حكومة عمالية!
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية


