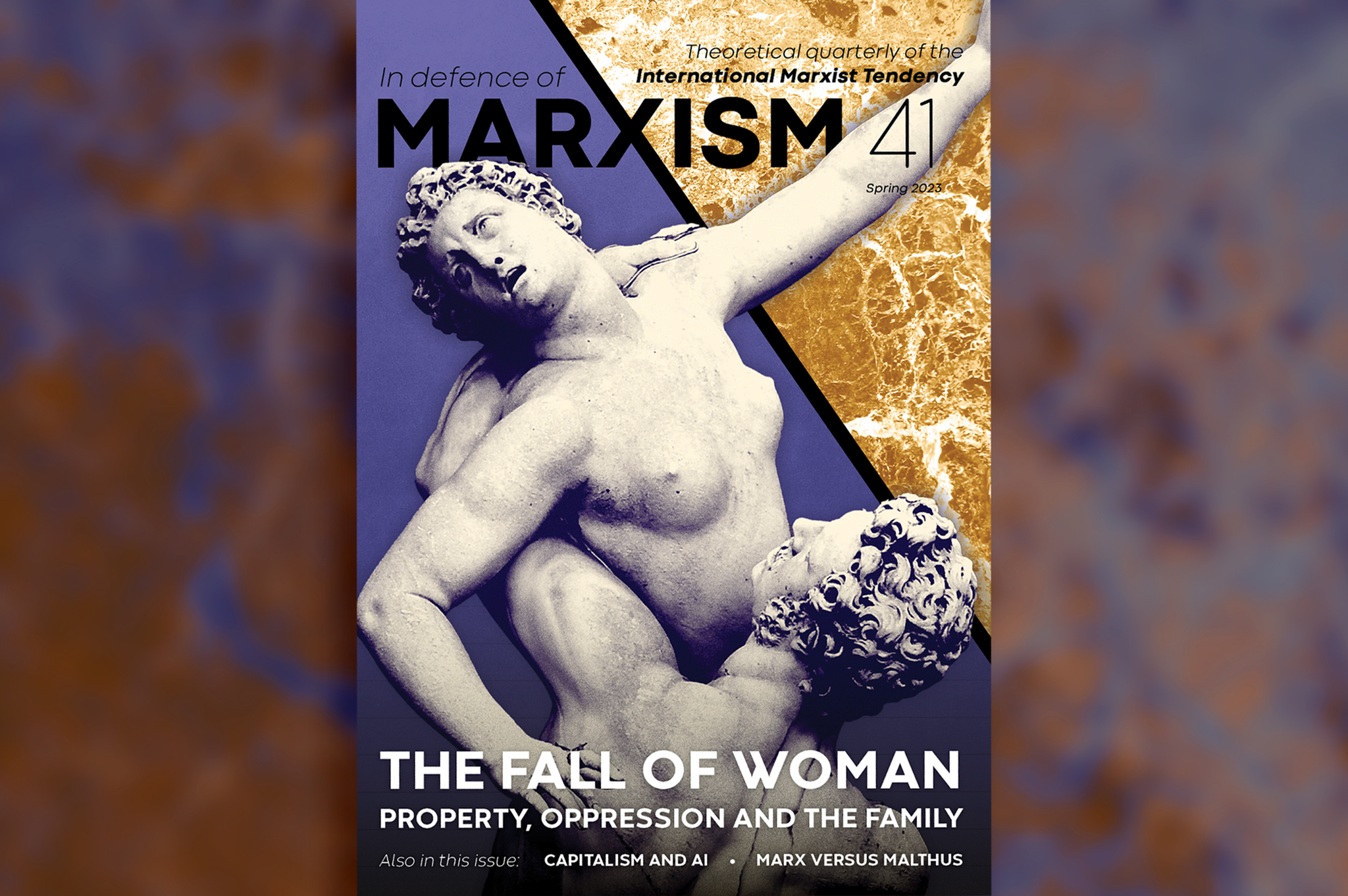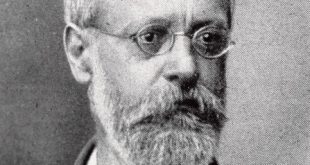تلقينا عددا كبيرا من الرسائل الإلكترونية من قراءنا يستفسرون فيها عن موقف الماركسيين من الدين، ليس فقط فيما يتعلق بالماركسية والمسيحية، بل أيضا بالإسلام. وقد تلقينا، على سبيل المثال، عدة رسائل من أشخاص متعاطفين يدعمون لاهوت التحرير في الفلبين. كما أننا على تواصل مع مجموعات تصف نفسها بأنها ماركسية إسلامية. من الواضح أن هذا السؤال مثير للاهتمام ويحمل أهمية كبيرة، ويستحق تناولا جادا. وكخطوة أولية في هذا المسار، ننشر مقالا بقلم “آلان وودز”، يستند في الواقع إلى ردوده عن مثل هذه الرسائل.

ما هو هدف الماركسيين
إن الهدف الأساسي للماركسيين هو النضال من أجل التغيير الاشتراكي للمجتمع على المستويين الوطني والأممي. نحن نؤمن بأن النظام الرأسمالي قد استنفذ منذ زمن بعيد ضرورته التاريخية، وتحول إلى نظام وحشي قمعي ظالم وغير إنساني. إن القضاء على الاستغلال وإقامة نظام عالمي اشتراكي متناغم، يستند إلى خطة إنتاج عقلانية تُدار ديمقراطيا، سيكون الخطوة الأولى نحو خلق مجتمع جديد وأرقى، يتعامل فيه الرجال والنساء مع بعضهم البعض كبشر.
نعتقد أن من واجب أي شخص إنساني أن يدعم النضال ضد هذا النظام الذي يتسبب في المعاناة الهائلة والأمراض والاضطهاد والموت لملايين الناس حول العالم. ونحن نرحب بكل حفاوة بمشاركة كل شخص تقدمي في هذا النضال، بغض النظر عن جنسيته أو لون بشرته أو معتقداته الدينية. كما نرحب بفرصة فتح حوار بين الماركسيين والمسيحيين والمسلمين وغيرهم من المجموعات.
ومع ذلك فإنه لكي يكون النضال فعالا، من الضروري وضع برنامج جاد وسياسة جادة ومنظورا واضحا لضمان النجاح. ونحن نعتقد أن الماركسية (الاشتراكية العلمية) هي وحدها التي توفر هذا المنظور.
مسألة الدين معقدة ويمكن تناولها من عدة زوايا مختلفة: تاريخية، فلسفية، سياسية، وغيرها. بدأت الماركسية باعتبارها فلسفة تُعرف بالمادية الديالكتيكية. ويمكن ايجاد شرح جيد جدا لهذه الفلسفة في أعمال مثل “ضد دوهرنغ” و”لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الألمانية” لإنجلز. كما يقدم كتاب “العقل في ثورة” (Reason in Revolt)، الذي يتناول الفلسفة الماركسية والعلم الحديث، عرضا شاملا وحديثا لنفس الأفكار. هذه هي نقطة الانطلاق لتوضيح الموقف الفلسفي للماركسية تجاه الدين.
الفلسفة المادية والعلم
يعتمد الماركسيون على أسس الفلسفة المادية والتي تنفي وجود أي كيان خارق للطبيعة أو أي شيء خارج أو “فوق” الطبيعة. وفي الواقع، لا توجد حاجة لمثل هذه التفسيرات للحياة أو الكون، خاصة في يومنا هذا. فالطبيعة تقدم تفسيراتها الخاصة وبوفرة.
لقد أثبت العلم أن البشر قد تطوروا، مثلهم مثل جميع الأنواع الأخرى، على مدار ملايين السنين، وأن الحياة نفسها قد نشأت من المادة غير العضوية. لا يمكن وجود دماغ دون جهاز عصبي مركزي، ولا يمكن وجود جهاز عصبي مركزي دون جسم مادي يتكون من الدم والعظام والعضلات، وما إلى ذلك. والجسد بدوره يجب أن يتغذى على الغذاء المستمد من بيئة مادية. وقد قدمت أحدث الاكتشافات في علم الوراثة، لا سيما في مشروع دراسة الجينوم البشري، أدلة قاطعة تؤيد الموقف المادي.
إن كشف التاريخ الطويل والمعقد للجينوم، الذي ظل مخفيا لفترة طويلة، قد أثار نقاشات حول طبيعة الإنسان وسيرورة الخلق. ومن المدهش أنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تتحدى حركة من يسمون بـ”الخلقويين” (Creationist ) في الولايات المتحدة أفكار داروين، حيث يريدون تعليم الأطفال في المدارس الأمريكية أن الله خلق العالم في ستة أيام، وأن الرجل خُلق من تراب، وأن المرأة الأولى خُلقت من أحد أضلاعه.
الاكتشافات الحديثة قضت نهائيا على هراء “الخلقوية”، فقد دحضت بشكل كامل فكرة أن كل نوع خُلق بشكل منفصل، وأن الإنسان، بروحه الخالدة، قد خُلق خصيصا لتمجيد الرب. وقد تمت البرهنة بوضوح الآن على أن البشر ليسوا مخلوقات فريدة. تبين نتائج دراسة الجينوم البشري بشكل قاطع أننا نتشارك جيناتنا مع كائنات أخرى، وأن الجينات القديمة ساهمت في تشكيلنا كما نحن الآن. إن البشر يتشاركون جيناتهم مع أنواع أخرى تعود لأزمنة بعيدة. والواقع هو أن جزءا من هذا الإرث الجيني المشترك يمكن إرجاعه إلى كائنات بدائية مثل البكتيريا. وفي كثير من الحالات، نجد أن البشر يمتلكون نفس الجينات الموجودة في الفئران، والقطط، والكلاب، وحتى ذباب الفاكهة. وقد اكتشف العلماء فعلا حوالي 200 جين يتشاركها البشر مع البكتيريا. بهذه الطريقة، تم إثبات التطور بشكل قاطع، وبذلك لا حاجة لأي تدخل إلهي.
حياة بعد الموت؟
لماذا، إذن، ما تزال الأديان تسيطر على عقول الملايين من الناس على الرغم من كل هذا التطور العلمي؟ إن الأديان تقدم للرجال والنساء عزاء يتمثل في وجود حياة بعد الموت. الفلسفة المادية تنفي إمكانية ذلك. فالعقل والأفكار والنفس، كلها نتاج للمادة المنظمة بطريقة معينة. تنشأ الحياة العضوية من المادة غير العضوية في مرحلة ما، وبالمثل، تتطور الأشكال البسيطة للحياة -مثل البكتيريا والكائنات وحيدة الخلية، إلخ- إلى أشكال أكثر تعقيدا تشمل العمود الفقري والجهاز العصبي المركزي والدماغ.
إن الرغبة في الخلود قديمة وتعود على الأقل إلى فجر الحضارة، وربما أقدم من ذلك. هناك شيء في كياننا يرفض فكرة أن “أنا” يجب أن أتوقف عن الوجود يوما ما. وفي الحقيقة إن التخلي إلى الأبد عن هذا العالم الرائع المليء بأشعة الشمس والزهور، وهبات النسيم التي تداعب وجهي وصوت خرير المياه، ورفقة أحبائي، والغرق في عالم لا نهائي من العدم، هو أمر يصعب تقبله أو حتى استيعابه. لذلك فقد سعى البشر منذ فجر التاريخ إلى تواصل وهمي مع عالم روحي غير مادي حيث يُعتقد أن جزءا من “الأنا” سيظل موجودا. وقد كانت هذه بالفعل إحدى أقوى رسائل المسيحية وأكثرها تأثيرا واستمرارية: “يمكنني أن أحيا بعد الموت”.
المشكلة تكمن في أن الحياة التي يعيشها معظم الرجال والنساء في المجتمع الحالي شاقة جدا وغير محتملة، أو أنها على الأقل خالية من المعنى، لدرجة أن فكرة الحياة بعد الموت تبدو وكأنها السبيل الوحيد لمنحها معنى. سنعود لاحقا إلى هذا السؤال المهم جدا. لكن دعونا، في الوقت الحالي، نحلل المعنى الدقيق لفكرة الحياة بعد الموت. والتي بمجرد إخضاعها لتحليل جدي، سرعان ما تتحول إلى غبار.
تم فهم هذه المشكلة منذ زمن بعيد، من طرف العديد من الفلاسفة من بينهم الفيلسوف الأفلاطوني المحدث (Neo-Platonist)، بلوتينوس، الذي قال عن الخلود: “لا يمكن التعبير عنه، لأنك إذا وصفت أي شيء منه، تجعله شيئا محددا”. تظهر نفس الفكرة في الكتابات الهندية عن الروح: “الذات توصف بعبارة: لا، لا (نيتي، نيتي)[1]. فهي غير قابلة للإدراك، لأنه لا يمكن فهمها”[2]. وهكذا فإن الروح بالنسبة للفلاسفة واللاهوتيين هي مثل “ليل حيث تبدو كل الأبقار سوداء”، كما قال “هيغل”. ومع ذلك، فإنه في الحياة اليومية، يسهب أناس ليس لديهم أي تعليم في الحديث بثقة عن الروح والحياة بعد الموت. ويتخيلونها تشبه الاستيقاظ من النوم، فيلتم شملهم بسعادة مع أحباءهم الذين طالما افتقدوهم، ويعيشون في سعادة أبدية.
من المفترض أن الروح غير مادية. لكن ما هي الحياة بدون المادة؟ إن تدمير الجسد المادي يعني نهاية حياة الكائن. صحيح أن تريليونات الذرات الفردية التي تشكل أجسادنا لا تختفي، وإنما تعود إلى الظهور في تركيبات مختلفة. من هذا المنظور، نحن جميعا خالدون، لأن المادة لا يمكن أن تُخلق أو تُدمّر. ومع ذلك يصر الروحانيون على أنهم يسمعون أصواتا رغم غياب أي كائن مادي. والإجابة على ذلك بسيطة جدا: إذا كان هناك صوت، فلا بد من وجود أوتار صوتية، وإلا فإننا لا نعرف ما هو الصوت! ومهما حاولت فإنك لن تتمكن من فصل أي من مظاهر نشاط حياتنا البشرية عن الجسد المادي.
الفكرة الشائعة عن “الحياة بعد الموت” هي إلى حد كبير امتداد للحياة التي نعيشها على الأرض (لأننا لا نعرف أي حياة أخرى). إذ يقال إنه بعد أن تتخلص الروح من الجسد، “تستيقظ” في أرض جميلة حيث نتحد بطريقة سحرية مع أحبائنا، لنعيش حياة من السعادة الأبدية التي لا مكان فيها للمرض أو الشيخوخة. ويكفي أن نطرح المسألة بشكل ملموس لكي نكتشف استحالة ذلك. إذا تأملنا في جميع الأمور التي تجعل الحياة تستحق العيش: تناول طعام جيد، شرب نبيذ فاخر (أو، بالنسبة للإنجليز، كوب شاي ثقيل)، الغناء، الرقص، العناق، ممارسة الجنس، إلخ، سنرى بوضوح أن كل هذه الأنشطة مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بالجسد وخصائصه المادية. وحتى الأنشطة الأكثر فكرية مثل الحديث والقراءة والكتابة والتفكير، مرتبطة بدورها بأعضائنا الجسدية. وينطبق نفس الشيء على التنفس، أو أي من الأنشطة الأخرى التي، في مجموعها، نطلق عليها الحياة.
في الواقع، سيكون أي وجود يخلو من الألم والمعاناة أمرا لا يطاق بالنسبة للبشر. وعالم يكون فيه كل شيء أبيض سيشبه، في الحقيقة، عالما يكون فيه كل شيء أسود. فمن الناحية الطبية البحتة، للألم وظيفة هامة؛ فهو ليس مجرد شر، بل هو تحذير يصدر من الجسم بأن الأمور ليست على ما يرام. إن الألم جزء من الوضع البشري. ليس هذا فقط، فالألم واللذة مرتبطان بشكل ديالكتيكي؛ فبدون وجود الألم، لا يمكن أن توجد لذة. وكما قال دون كيشوت لسانشو بانزا فإن: “أفضل توابل الطعام هو الجوع”. وبالمثل، فنحن نستمتع بالراحة بشكل أكبر بعد فترة من الجهد الشديد.
وبنفس الطريقة، فإن الموت هو جزء لا يتجزأ من الحياة. لا يمكن تصور الحياة دون الموت. نحن نبدأ بالموت منذ لحظة ولادتنا، لأن الحياة البشرية والنمو والتطور تتمثل في الواقع في موت تريليونات الخلايا واستبدالها بتريليونات أخرى جديدة. فبدون الموت، لا يمكن أن تكون هناك حياة ولا نمو ولا تغيير ولا تطور. وبالتالي فإن محاولة استبعاد الموت من الحياة -كما لو أنه من الممكن فصلهما- تؤدي إلى حالة من الاستقرار المطلق والجمود والتوازن الثابت. لكن هذا مجرد اسم آخر للموت، لأن الحياة لا يمكن أن تستمر بدون التغيير والحركة.
لكن ما هو الضرر في الإيمان بحياة أخرى؟ قد يبدو للوهلة الأولى أنه لا يوجد ضرر كبير. ومع ذلك، أليس من الخطأ أن نُضلل الرجال والنساء وندفعهم لبناء حياتهم على أساس وهم؟ فبقدر ما نتخلى عن الأوهام ونرى العالم على حقيقته، ونفهم أنفسنا كما نحن في الواقع، بقدر ما نستطيع أن نكتسب المعرفة الضرورية لتغيير العالم وتغيير أنفسنا.
ما نحن عليه كأفراد مرتبط بشكل وثيق بأجسادنا المادية، وليس له أي وجود مستقل أو بشكل منفصل علنها. نحن نولد ونعيش ونموت، مثل جميع الكائنات الحية الأخرى في الكون. على كل جيل أن يعيش حياته، ثم يفسح المجال للأجيال الجديدة التي لها أن تحل محلنا. إن الطموح إلى الخلود والحق المتخيل في العيش إلى الأبد، هو في جوهره طموح أناني وغير واقعي. وبدلا من إضاعة الوقت في السعي وراء “عالم آخر” غير موجود، من الضروري أن نسعى لجعل هذا العالم مكانا صالحا للعيش فيه. لأنه بالنسبة للغالبية العظمى من الرجال والنساء الذين يولدون في هذا العالم، السؤال الحقيقي ليس هو ما إذا كانت هناك حياة بعد الموت، بل هل هناك أصلا حياة قبل الموت؟
إن المعرفة بأن هذه الحياة عابرة، وأننا وأحباءنا لن نكون هنا دائما، هي معرفة بدلا من أن تكون سببا في اليأس، يجب أن تلهمنا بحب عميق للحياة، ورغبة حارقة في جعلها حياة أفضل للجميع. نحن نعلم أن كل زهرة تولد لتذبل، وبمعنى ما فإن هذا الذبول يضفي عليها جمالا مأساويا. لكننا نعلم أيضا أن الطبيعة تزهر مجددا في كل ربيع، وأن الدورة الأبدية للولادة والموت، التي تشكل جوهر كل شيء حي، هي ما يمنح الحياة طابعها الممزوج بالحلاوة والمرارة. إن التراجيديا والكوميديا، الضحك والدموع، هي ما يجعل الحياة تلك الفسيفساء الغنية بالمشاعر الإنسانية. هذا هو مصيرنا الذي لا مفر منه باعتبارنا بشرا. لأننا بشر، ولسنا آلهة، ويجب أن نتقبل وضعنا البشري. تتميز الآلهة عنا لكوننا فانون. لكننا لدينا ميزة عظيمة عليهم، وهي أننا نوجد حقا من لحم ودم، بينما هم مجرد خيالات بلا جسد من صنع الخيال.
خلاصة تشاؤمية؟
المادية باعتبارها فلسفة لها تاريخ طويل ومشرّف. لقد كان الفلاسفة الأيونيون الإغريق الأوائل جميعهم ماديين. ووفقا لأفلاطون فقد وُجّهت تهمة الإلحاد إلى أناكساغوراس، الذي يعتبر أحد أبرز هؤلاء الفلاسفة ومعلم بركليس. أما بروتاغوراس (حوالي 415 ق.م)، فقد قال بتلك السخرية المألوفة عند السوفسطائيين: “فيما يتعلق بالآلهة، لم أتمكن من الوصول إلى معرفة وجودهم أو عدم وجودهم، أو إلى معرفة أشكالهم. فالعديد من الأمور تعيق الوصول إلى هذه المعرفة، سواء غموض الموضوع أو قصر عمر الإنسان”[3]. أما معاصره دياغوراس، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، فعندما أشار أحدهم إلى الألواح النذرية الموجودة في معبد، والتي كان قد وضعها هناك ناجون من غرق سفينة تعبيرا عن امتنانهم، رد قائلا: “أما الذين غرقوا فلم يضعوا ألواحا”.
هل الفهم المادي يعبر عن رؤية تشاؤمية أو عدمية للحياة؟ على العكس تماما. إن الشرط الأول لحياة ثرية ومُرضية على الأرض هو تبني رؤية صحيحة للأشياء. ومن بين أسمى وأرحب الفلسفات التي طُرحت على الإطلاق هي فلسفة إبيقور، ذلك العبقري الذي اكتشف مع ديموقريطيس ولوكيبيس أن العالم مكوّن من ذرات. إبيقور (341-270 ق.م)، الذي شوهت الكنيسة سمعته لقرون، سعى لتحرير البشرية من عذاب الخوف، وخاصة الخوف من الموت. كانت رؤيته للحياة مبهجة ومتفائلة. ويقال إنه قال في يوم وفاته: “إنه يوم جيد للموت”.
الرواقيون، الذين بشروا بفكرة الأخوة العالمية حيث يكون الجميع أعضاء في كومنولث عظيم، اعتقدوا أن الكون لا يمكن تدميره، وأن أرواح البشر جميعا تبقى بعد الموت، ولكن ليس كأفراد. ولأن كل ما يحدث لنا هو جزء من مسار الطبيعة وتركيبتها، فلا ينبغي الخوف من الموت. وقد كان أحد الرواقيين أول من قال إن: “كل الرجال أحرار”.
وقد مارست الرواقية تأثيرا كبيرا على المسيحية من خلال كتابات إبيكتتوس وماركوس أوريليوس. ومع ذلك فإن الرواقيين لم يؤمنوا حقا بوجود إله على الإطلاق (استخدموا كلمة ثيوس للإشارة إلى مفهوم مختلف تماما عن الإله المسيحي)، وأكدوا أن الرجل الحكيم مساوي لـ زيوس. هدفهم لم يكن الذهاب إلى السماء، بل عيش حياة جيدة، والتي أطلقوا عليها اسم أباثيا (Apatheia)، والتي تعني السيطرة على العواطف وليس اللامبالاة.
في الواقع، يبدو أن معظم شعوب العصور القديمة كانوا لا يُبدون اهتماما كبيرا بالسؤال عما سيحدث لهم بعد الموت. كانت “الحياة” بعد الموت لدى الإغريق مكانا غير جذاب على الإطلاق، عالما رماديا كئيبا مليئا بأرواح هائمة ثرثارة. أما المصريون، فقد كانت لديهم رؤية أكثر جاذبية للعالم الآخر، حيث يوجد الطعام والنبيذ، والموسيقى، وفتيات يرقصن عاريات، ويتم تلبية جميع احتياجات المرء بواسطة جيش من العبيد. لكن بالنسبة للمصريين، كان العالم الآخر حكرا على الطبقة السائدة، حيث تُظهر مقابرهم الضخمة نفس مظاهر الثروة الفاخرة التي استمتعوا بها في حياتهم.
في الواقع، في الصين وفي كل المجتمعات الطبقية المبكرة الأخرى، كان تصور الحياة بعد الموت محصورا في الطبقة الأرستقراطية: الزعماء، والملوك، والمحاربون. كانت الحياة بعد الموت مجرد امتياز آخر للنخبة الحاكمة، أو بالأحرى استمرارا للامتيازات التي تمتعوا بها في حياتهم، والتي هي امتيازات استُثني منها العامة بصرامة.
مع ظهور المسيحية، أصبحت الجنة متاحة للجميع، لكن بثمن. وهذا الثمن يتمثل، إلى هذا الحد أو ذاك، في التضحية بالحياة في هذا العالم في انتظار أشياء أفضل في المستقبل. صحيح أن الأغنياء في ذلك العالم مُهددون بعقاب رهيب على خطاياهم، وهو الشيء الذي ربما أقلق البعض. ولكن، بشكل عام، نظرت الطبقة السائدة بلامبالاة مدهشة إلى احتمال الجحيم المستقبلي، مفضلة الاستمتاع الهادئ بثرواتها وملذات الحياة، وترك المستقبل ليهتم بنفسه. أما بالنسبة للفقراء، فإن القبول السلبي بعالم مليء بالألم والمعاناة في “وادي الدموع” هذا، كان ثمن الوعد بالسعادة المستقبلية وراء القبر. وقد قاد هذا الوعد ملايين الرجال والنساء إلى النسيان، بعد أن استنزفوا أنفسهم في حياة من العمل المضني والمعاناة الجسدية والعقلية المستمرة.
قد يبدو هذا الأمر بالنسبة لبعض الناس عادلا. لكنه يبدو بالنسبة لنا أقرب إلى الخداع الصريح والسرقة. “إذا حرمت عامة الناس من هذا الأمل، فماذا سيبقى لهم؟” هكذا يجادل السفسطائي المترَف. والإجابة: ستبقى لهم الحقيقة، وكما يقول الإنجيل فإن الحقيقة ستجعلنا أحرارا. فطالما بقيت أعين الرجال والنساء متجهة نحو السماء، فإنهم لن يتمكنوا من تركيز انتباههم على المشكلات الحقيقية التي تعذبهم، وعلى أعدائهم الحقيقيين. سيستبدلون إمكانية تحقيق السعادة الحقيقية وتحقيق إمكانياتهم الإنسانية، بوهم حياة غير موجودة بعد الموت. وبذلك يكونون قد ضحوا بأنفسهم باعتبارهم كائنات بشرية، تماما كما كان ضحايا الأديان الدموية القديمة يقدمون كقرابين. فيتم تدمير الحياة الحقيقية أجل وهم.
إن حب الحياة، الذي يمثل السمة المميزة الحقيقية للمادية الفلسفية، يجب أن ينطوي على رغبة ملتهبة في تغيير العالم الذي نعيش فيه، وتحسين حياة البشر أجمعين. وفي حين تدعونا الأديان إلى أن نرفع أعيننا نحو السماء، تعلمنا الماركسية أن نناضل من أجل حياة أفضل على هذه الأرض. الماركسيون يؤمنون بأنه يجب على الرجال والنساء أن يناضلوا من أجل تغيير حياتهم وخلق مجتمع إنساني حقيقي يمكن الجنس البشري من أن يسمو إلى مكانته الحقيقية. نحن نؤمن بأن البشر لديهم حياة واحدة فقط، ويجب أن يكرسوا أنفسهم لجعل هذه الحياة جميلة ومكتملة.
يمكننا القول، إذا أردت، إننا نناضل من أجل جنة في هذه الحياة، لأننا نعلم أنه لا توجد حياة أخرى. وكلما عشنا وناضلنا من أجل عالم يستحق العيش فيه، فإننا نحضر لمستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا. ورغم أن حياة كل فرد لها حدودها الزمنية، فإن الجنس البشري يستمر، ويمكن لمساهمتنا الفردية في النضال من أجل قضية الإنسانية أن تبقى حية بعد رحيلنا. يمكننا تحقيق الخلود، ليس بإنكار قوانين الطبيعة، بل في ذاكرة الأجيال القادمة – وهو الخلود الوحيد الذي يحق للبشر أن يطمحوا إليه.
هناك اختلاف فلسفي عميق بين الماركسية وبين كل أشكال الدين. لكن هل يعني ذلك أننا لا نستطيع الاتفاق على النضال والعمل معا من أجل عالم أفضل؟ كلا بالطبع. لكل شخص الحق الكامل في أن يتبنى ما يشاء من الآراء حول المصير الذي ينتظرنا بعد أن “نسلم الروح”. لكن هذا الاختلاف في الرأي -مهما كان مهما من وجهة نظر فلسفية- يجب ألا يمنعنا، بأي شكل من الأشكال، من الاتحاد في النضال ضد الاضطهاد والظلم في هذا العالم. كل ما يتطلبه الأمر هو الاتفاق حول البرنامج الأساسي للتغيير الاشتراكي للمجتمع والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك. أما الأمور الأخرى فسيكون لدينا متسع من الوقت لمناقشتها لاحقا!
عالم الدين هو عالم غامض، صورة مشوهة للواقع. لكن هذه الفكرة، مثلها مثل كل الأفكار، لها جذورها في العالم الحقيقي. وعلاوة على ذلك، فهي تعبير عن تناقضات المجتمع الطبقي. هذا الأمر واضح جدا في أقدم الديانات.
الإله البابلي مردوخ أعلن نيته خلق الإنسان لخدمة الآلهة، من أجل “تحريرهم”، أي لأداء المهام الدنيوية المرتبطة بطقوس المعبد وتوفير الطعام للآلهة. هنا نجد انعكاسا في الدين لواقع المجتمع الطبقي، حيث ينقسم البشر إلى طبقتين: الآلهة التي لا يمكن المساس بها في الأعالي (الطبقة السائدة)، و”الحطابون والسقاءون”[4] (الطبقة الكادحة). الغرض من ذلك كان توفير تبرير أيديولوجي (ديني) لاستعباد الأغلبية من قبل الأقلية. وكان هذا واقعا حقيقيا في كل المجتمعات القديمة (والحديثة): الكهنة كانوا معفيين من الحاجة إلى العمل، وتمتعوا بامتيازات حقيقية بوصفهم الممثلين الماديين للإله على الأرض.
عند الحديث عن أساطير الخلق البابلية (التي اشتُق منها سفر التكوين الأول)، يلاحظ س. هـ. هوك[5]:
“لقد رأينا بالفعل أن أسطورة لاهار وأشنان انتهت بخلق الإنسان لخدمة الآلهة. وتصف أسطورة أخرى […] الطريقة التي خُلق بها الإنسان. وعلى الرغم من أن الأسطورة السومرية تختلف كثيرا عن الرواية الواردة في الملحمة البابلية للخلق، فإن كلا الروايتين تتفقان حول الهدف من خلق الإنسان، وهو خدمة الآلهة، من خلال حرث الأرض وتحرير الآلهة من الحاجة إلى العمل لكسب رزقها”[6].
الدين بمعناه الدقيق (على عكس السحر، والطوطمية[7]، والأرواحية[8] (Animism)التي ميزت المجتمعات السابقة الخالية من الطبقات) ينشأ من انقسام المجتمع إلى طبقات متعارضة، ويعبر عن التناقضات التي لا يمكن حلها والتي تنبع من هذا الانقسام. في تلك المراحل المبكرة، بقيت هناك ذكرى باهتة لزمن مضى كان فيه الجميع متساوين. وهذه الذكرى تظهر في الأساطير على شكل فكرة “العصر الذهبي”، وتظهر في الإنجيل على شكل “جنة عدن”. تعبر هذه الأفكار عن شعور بالفقدان وتطلع إلى عالم مفقود من النعيم. يسعى الدين إلى التغلب على هذا التناقض، وتخفيف وطأته من خلال التصالح مع المعاناة والاستغلال عبر تصويرها على أنها إرادة إلهية، أو أنها نتيجة لعصيان الإنسان لأوامر الله، أو كلا الأمرين. الرسالة واضحة: “اخضع! أطع! ضحِّ! وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام”. في الواقع، إن هذا الفصل العنيف للإنسانية عن نفسها -هذا الاغتراب للجنس البشري- لا يمكن التغلب عليه إلا بالقضاء على المجتمع الطبقي وإعادة تأسيس الروابط الإنسانية الحقيقية بين الناس.
إن العلاقة النفسية بين البشر والآلهة التي يخلقونها لأنفسهم تخبرنا بالكثير عن الحالة الحقيقية للجنس البشري. ليس سرا أن آلهة أي مجتمع هي ليست سوى انعكاس لذلك المجتمع، ونمط إنتاجه، وعلاقاته الاجتماعية، وأخلاقياته، وتحيزاته. وكما أوضحنا في كتابReason in Revolt، فإنه لم يكن الله هو الذي خلق الإنسان على صورته، بل على العكس، الرجال والنساء هم من خلقوا الآلهة على صورتهم وشبههم. قال لودفيغ فيورباخ إنه لو كان للطيور دين، لكان إلهها يمتلك أجنحة. وأوضح أن: “الدين هو حلم تظهر فيه تصوراتنا ومشاعرنا على هيئة كيانات منفصلة، كائنات تبدو وكأنها خارج ذاتنا. العقل الديني لا يفرق بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، فهو ليست لديه شكوك؛ بل يمتلك قدرة، ليست على إدراك أشياء تختلف عن ذاته، وإنما على رؤية تصوراته الخاصة وكأنها موجودة خارجه ككائنات مستقلة”.
وقد فهم ذلك بالفعل مفكرون مثل زينوفانيس الكولوفوني (565-470 ق.م تقريبا)، الذي كتب:
“لقد نسب هوميروس وهيسيود إلى الآلهة كل فعل مخزٍ وغير شريف بين البشر: السرقة، والزنا، وخداع بعضهم البعض… الإثيوبيون يصورون آلهتهم سوداء وبأنوف مفلطحة، والتراقيون يصورونها زرقاء العينين وحمراء الشعر… ولو استطاعت الحيوانات الرسم وصنع الأشياء مثل البشر، لكانت الخيول والثيران أيضا قد صورت الآلهة على صورتها”.
لكن هذه الآلهة ليست مجرد نسخا مطابقة للواقع، بل هي رؤية للواقع من خلال عدسات الدين: عالم غريب، غامض، مقلوب رأسا على عقب، حيث كل شيء يبدو معكوسا. الآلهة تمثل كل ما يرغب الإنسان في أن يكونه لكنه عاجز عن ذلك. إنها تمتلك كل السمات التي يتطلع البشر لامتلاكها لكنهم يفشلون حتما في الوصول إليها. وبهذا المعنى فإن الدين يمثل تطلعا إلى المستحيل. لكن هذا الشعور الديني يحتوي أيضا على عنصر آخر: تطلع حارق لعالم أفضل وحياة أفضل. عندما يصرخ الفلاح الجائع المضطهد مناديا إلهه، فإنه يصرخ طلبا للعدالة، وبالتالي ضد الظلم والقسوة واللاإنسانية في هذا العالم.
هذا الإيمان بالمساواة والاتحاد بين المؤمنين يظهر أحيانا في شكل شيوعية بدائية، كما كان الحال مع المسيحيين الأوائل، الذين تحدثنا عنهم سابقا. والحركات الجماهيرية التي أثارتها هذه المعتقدات في المراحل الأولى لكل من المسيحية والإسلام هزت العالم. لكن وفي غياب التطور الضروري لوسائل الإنتاج، كان على البشرية أن تستمر في الكدح والمعاناة لألفي عام أخرى في ظل العبودية الطبقية. الحلم بالمساواة والأخوة تحطم. وخلف المالك الإقطاعي -ولاحقا الرأسمالي- وقف ليس فقط الملك الأرضي بجنوده وشرطته وسجانيه، بل أيضا الشرطة والسجانون الروحيون. وكانت أي مقاومة للوضع الراهن تُعاقب ليس فقط بالنار والسيف، بل وأيضا بالحرمان الديني والتهديد بالعذاب الأبدي. وإذ ييأس الإنسان من إمكانية تحقيق العدالة في العالم الواقعي، فإنه يستسلم لفكرة أن العدالة قد تكون موجودة، على الجانب الآخر من القبر.
نتحدث هنا عن الرجال، لأن الغالبية العظمى من التاريخ المكتوب شهدت هيمنة الرجال على المجتمع، حيث تم تقليص دور النساء ليصبحن “إماء العبيد”. وبالتالي، كان على الرجل أن يكون خادما لسيده، وملكه، وإلهه، بينما على المرأة أن تكون خادمة لزوجها، ربها وسيدها. بالنسبة للعديد من النساء، كان العزاء الديني هو السبيل الوحيد للتخفيف من المعاناة العميقة الناجمة عن استعبادهن. وهذا ما يفسر سبب ارتباط النساء بالدين في العديد من المجتمعات. إذ انه بدون ذلك العزاء، كانت حياتهن ستصبح غير محتملة نهائيا. إنه أشبه بمخدر يخدر الحواس ويجعلها غير قادرة على الشعور بالألم. لكنه لا يزيل سبب الألم أو يحسن حال النساء. بل على العكس. على الرغم من أن المسيحية في بداياتها قدمت أملا جديدا للنساء، وكانت توصف بازدراء من قبل أعدائها الرومان بأنها “دين العبيد والنساء”، فإنها في الممارسة العملية تتميز بعدائية شديدة تجاه النساء. تقول المسيحية إن الخطيئة الأصلية للإنسان قد تسببت بها امرأة، هي حواء.
تم قمع العلاقات الطبيعية بين الرجال والنساء ولُعنت باعتبارها خطيئة مميتة. وصف القديس أوغسطين الفعل الجنسي بأنه “كتلة من الهلاك”. المكان المناسب للمرأة هو أن تعاني في خدمة الرجل، وهو وضع تمثله بشكل مؤثر صورة العذراء الحزينة. لا يمكن توقع أي سعادة على هذه الأرض.
أجيال من تعاليم الدين عبر التاريخ وضعت ختمها على المصير البائس للنساء. وما ينطبق على المسيحية ينطبق بنفس القدر، أو ربما بشكل أكبر، على الديانات الأخرى. هناك صلاة يهودية قديمة تقول: “مبارك أنت أيها الرب، الذي لم تخلقني امرأة”. وفي بعض البلدان المسلمة، اتخذ اضطهاد النساء شكلا متطرفا، كما هو الحال في إيران، وبدرجة أسوأ في أفغانستان. وفي الهند، كانت التقاليد الهندوسية على مدى قرون تفرض على الأرامل أن يُحرقن مع أزواجهن على محارقهم الجنائزية. ومن هنا فإن تحرر النساء من عبوديتهن القديمة يتناقض مباشرة مع الدين.
يظهر في معظم الأديان الكبرى، مثل المسيحية، والإسلام، والبوذية، والسيخية -على الأقل في بداياتها- عنصر من النقد للعالم ومظالمه، مقترنا بحلم بعالم أفضل، عالم يخلو من الفقر والغنى، ومن المضطهِدين والمضطهَدين، حيث يصبح جميع البشر إخوة وأخوات. في كل من الكنائس المسيحية والمساجد الإسلامية، يستمر الحفاظ على وهم “الاتحاد” أو “الأخوة” بين جميع المؤمنين، وأن الجميع “متساوون أمام الله”، وما إلى ذلك. لكن، في اليوم التالي، يعود المسيحي أو المسلم الثري إلى استغلال العمال من أبناء دينه، ونهبهم، وإهانتهم، وخداعهم، تماما كما كان يفعل دائما. وعندما تتم الإشارة إلى هذا التناقض الصارخ بين النظرية والممارسة في الدين، يهزون رؤوسهم بحزن ويتمتمون بشأن عدم كمال البشر في هذا العالم المليء بالخطيئة. لكن هذا المبرر لا يُقدم أي عزاء حقيقي للعامل.
أصول المسيحية
لقد تغير دور الدين في المجتمع مرارا عبر مئات وآلاف السنين، ومن المهم أن نفهم أصول الأديان الكبرى وتطورها التاريخي. في بداياتها، كانت كل من المسيحية والإسلام حركات ثورية للفقراء والمضطهدين. لنأخذ المسيحية كمثال. قبل حوالي 2000 عام، نظم المسيحيون الأوائل حركة جماهيرية ضمت أفقر وأشد الفئات المظلومة في المجتمع. لم يكن من قبيل الصدفة أن اتهم الرومان المسيحيين بأنهم “حركة من العبيد والنساء”. وكما كتب إنجلز فإن: “تاريخ المسيحية المبكرة يحتوي على نقاط تشابه بارزة مع حركة الطبقة العاملة الحديثة… فكلاهما تعرضا للاضطهاد والمطاردة، وأتباعهما كانوا موضع احتقار وخضعوا لقوانين استثنائية؛ الأوائل باعتبارهم أعداء للجنس البشري، والأواخر باعتبارهم أعداء للدولة والدين والأسرة والنظام الاجتماعي. ورغم كل أشكال الاضطهاد، بل وحتى بدافع منه، تقدما إلى الأمام بانتصار”[9].
إن الشيوعية التي تبناها المسيحيون الأوائل تتضح بجلاء عند قراءة سفر أعمال الرسل. فقد كان المسيح نفسه يعيش بين الفقراء والمحرومين، وكان كثيرا ما يهاجم الأغنياء. ولم يكن من قبيل المصادفة أن أول ما فعله عند دخوله أورشليم هو طرد الصيارفة من الهيكل. وقال أيضا: “إن مرور جمل من ثقب إبرة، أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله” (لوقا 18:24). لقد وقف المسيحيون الأوائل إلى جانب الفقراء ودافعوا عنهم ضد الأغنياء وأصحاب النفوذ.
وفي رسالة يعقوب نقرأ “هلم الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. غناكم قد تهرأ، وثيابكم قد أكلها العث. ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار قد كنزتم في الأيام الأخيرة. هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم، المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض ، وتنعمتم وربيتم قلوبكم، كما في يوم الذبح. حكمتم على البار. قتلتموه. لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب”.
هذا الصوت هو صوت الصراع الطبقي دون مواربة أو استثناءات. ويوجد العديد من العبارات المشابهة في الكتاب المقدس.
وقد تجلت الشيوعية التي تبناها المسيحيون الأوائل من خلال حقيقة أن جميع الثروات كانت تُدار بشكل جماعي داخل مجتمعاتهم. كان على أي شخص يرغب في الانضمام إليهم أن يتخلى أولا عن جميع ممتلكاته الدنيوية. في أعمال الرسل نقرأ:
“وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والأخوية [كوينونيا بمعنى الشيوعية] وكسر الخبز والصلوات. وكان جميع المؤمنين معا، وكان لهم كل شيء مشترك. وكانوا يبيعون أملاكهم وأمتعتهم ويوزعونها على الجميع بحسب احتياج كل واحد”[10].
ونقرأ أيضا:
“وكان جمهور الذين آمنوا قلبا واحدا ونفسا واحدة، ولم يقل أحد إن شيئا مما يملكه هو له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. ولم يكن فيهم أحد محتاجا؛ لأن كل الذين كانوا يملكون حقولا أو بيوتا كانوا يبيعونها، ويضعون أثمانها عند أقدام الرسل، ويوزعون على كل واحد بحسب حاجته”[11].
بالطبع، كانت تلك الشيوعية تحمل طابعا بدائيا وساذجا. وهذا لا يقلل من شأن هؤلاء الرجال والنساء في ذلك الزمن، الذين أظهروا شجاعة فائقة ولم يخشوا التضحية بحياتهم في نضالهم ضد الدولة الرومانية الاستعبادية. لكن تحقيق الشيوعية الحقيقية، أي مجتمع بلا طبقات، كان مستحيلا في ذلك الوقت لأن الظروف المادية اللازمة لذلك لم تكن موجودة.
كان ماركس وإنجلز هما أول من أعطى الشيوعية طابعا علميا، حيث أوضحا أن تحرر الجماهير يعتمد على مستوى تطور القوى الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، العلم والتكنولوجيا)، وهو ما يخلق الظروف اللازمة لتقليل ساعات العمل وإتاحة الثقافة للجميع. هذا هو السبيل الوحيد لتغيير طريقة تفكير الناس وسلوكهم تجاه بعضهم البعض.
في زمن المسيحية المبكرة، لم تكن الظروف المادية متقدمة بما يكفي للسماح بتحقيق هذا التطور. وبالتالي فقد بقيت الشيوعية لدى المسيحيين الأوائل على مستوى بدائي، يتركز على تقاسم الاستهلاك (الطعام، الملابس، إلخ) بدلا من الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. وبسبب افتقارهم إلى الفهم العلمي لتطور المجتمع، وعلى الرغم من روحهم الثورية وشجاعتهم، لم يتمكن المسيحيون الأوائل من تحقيق مُثلهم العليا. كانت شيوعيتهم ذات طابع طوباوي وكان مصيرها الفشل.
المسيحية والشيوعية
في السنوات الأولى للكنيسة، استمر ممثلوها في التعبير عن الآراء الأصلية للحركة، والتي كانت شيوعية في جوهرها. كتب القديس إكليمندس: “ينبغي أن يكون استخدام جميع الأشياء الموجودة في هذا العالم مشتركا بين جميع البشر. فقط أكثر أشكال الظلم وضوحا يجعل شخصا يقول لآخر: “هذا يخصني، وذاك يخصك”. ومن هنا ينشأ الصراع بين البشر”.
هذا التعبير دقيق، حيث يشير بوضوح إلى أن أصل الصراع الطبقي (الصراع بين البشر) يكمن في وجود الملكية الخاصة. وبالتالي، فإن القضاء على الصراع بين البشر يفترض مسبقا إلغاء الملكية الخاصة. وقد عبر القديس باسيليوس الكبير عن فكرة مشابهة عندما قال:
“أي شيء تسميه ‘ملكك’؟ ما الشيء الذي يمكنك أن تدعي أنه ملكك؟ ممن حصلت عليه؟ أنت تتحدث وتتصرف كشخص ذهب مبكرا إلى المسرح واستولى بلا عائق على المقاعد المخصصة لعامة الناس، ثم يحاول منعهم من الدخول في الوقت المحدد ومنعهم من الجلوس، مطالبا باستخدام المكان بشكل خاص، وهو في الأصل مخصص للاستخدام العام. هكذا يتصرف الأغنياء”.
وكذلك قال القديس غريغوريوس:
“إذا أراد شخص أن يجعل نفسه سيدا لكل الثروات، ليحوزها ويقصي إخوته، حتى إلى الجيل الثالث أو الرابع، فإن مثل هذا الشخص ليس أخا بل طاغية غير إنساني، إنه بربري قاس، أو بالأحرى وحش مفترس، فمه دائما مفتوح لالتهام غذاء الآخرين”.
وكتب القديس أمبروز:
“الطبيعة توفر ثرواتها لجميع البشر بشكل مشترك. لقد خلق الله كل الأشياء بلطف لكي تتمتع بها جميع الكائنات الحية بشكل مشترك، ولكي تصبح الأرض ملكية عامة للجميع. إن الطبيعة نفسها هي التي أنشأت حق الجماعة، بينما الاغتصاب الظالم هو الذي أوجد حق الملكية الخاصة”.
وقال القديس غريغوريوس الكبير:
“الأرض التي وُلدوا منها هي ملك للجميع، وبالتالي فإن الثمار التي تنتجها الأرض تعود للجميع دون تمييز”. وأضاف القديس يوحنا الذهبي الفم: “الرجل الغني هو لص”.
هذه النصوص تكفي لإظهار الجذور الثورية للمسيحية في مرحلتها الأولى. كان المسيحيون الأوائل مستعدين لتحمل أشد أشكال التعذيب في سبيل الدفاع عن إيمانهم، حيث تحدوا الدولة والطبقة السائدة، وواجهوا الموت في الساحات. وقد كان السبب وراء ذلك الاضطهاد الوحشي هو أن تلك الحركة، التي تمثل الفقراء والمحرومين، كانت تشكل تهديدا للنظام القائم. ومع ذلك، لم تنجح أي من تلك الأساليب في سحق الحركة، بل استمدت قوتها من دماء شهدائها.
ومع ذلك، فإنه نظرا لغياب الأساس المادي اللازم لإقامة مجتمع بلا طبقات، تغير كل شيء تدريجيا إلى نقيضه. ففي ظل الظروف السائدة، خضعت قيادة الكنيسة، بدءا من الأساقفة الذين كانوا عمليا بمثابة أمناء الخزينة، لضغوط الطبقة السائدة والدولة، وابتعدت تدريجيا عن المعتقدات الشيوعية الأصلية للحركة. والطبقة السائدة التي أدركت استحالة هزيمة المسيحيين بالقمع، غيّرت تكتيكاتها. الطريقة التي تم بها إفساد الشرائح العليا للكنيسة من قبل الإمبراطور قسطنطين تتضح في المقطع التالي من المؤرخ الكنسي يوسابيوس، الذي يصف مجمع نيقية عام 325 م، والذي ترأسه الإمبراطور بنفسه، والذي تم وصفه بعبارة “كأنه رسول من الله”.
وعلى حد تعبير يوسابيوس فإنه:
“كانت ظروف الوليمة رائعة إلى حد لا يمكن وصفه. أحاطت فرق من الحرس الشخصي وجنود آخرين بمدخل القصر حاملين سيوفهم المسلولة، وفي وسطهم تقدم رجال الله بلا خوف إلى أعماق الغرف الإمبراطورية. كان البعض من رفاق الإمبراطور على المائدة، وآخرون استلقوا على الأرائك المرتبة على كلا الجانبين. قد يتصور المرء أن هذا المشهد يعكس ملكوت المسيح، وكأنه حلم أكثر منه واقع”[12].
هذه الأساليب مألوفة جدا للاشتراكيين والنقابيين اليوم. إنها نفس الأساليب التي يتم من خلالها إخضاع قادة النقابات العمالية والحركات العمالية لتأثير الأفكار البرجوازية، حيث يتم إفسادهم واستيعابهم داخل النظام. تتم دعوة قادة الحركة إلى عشاء فاخر وحفلات حيث يختلطون مع الأغنياء والمشاهير. ومنذ مجمع نيقية، أصبحت الكنيسة الحليف الأشد دعما للثروة، والامتيازات، والقمع.
كانت المكاسب التي حققتها الإمبراطورية من ذلك التنازل جلية. فقد كان المسيحيون الأوائل يرفضون الاعتراف بالدولة أو الخدمة في الجيش. أما بعد التنازل، فقد انعكس الوضع تماما. أصبحت الكنيسة واحدة من الدعائم الأساسية للدولة، وقامت باضطهاد شرس لكل من تجرأ على التشكيك في عقائدها الجديدة. وعندما رفض آريوس من الإسكندرية قانون الإيمان النيقي، تعرض أتباعه (الأريوسيون) للذبح. فقد تم قتل أكثر من 3.000 مسيحي على يد مسيحيين آخرين، وهو عدد يفوق عدد من قُتلوا خلال ثلاثة قرون من الاضطهاد الروماني. وهكذا، تحولت كنيسة الفقراء والمضطهَدين إلى الأداة الرئيسية لاستعبادهم.
كيف تغفر الخطايا… وتجني المال
على مدى فترة طويلة، تم استيعاب الكنيسة المسيحية، من خلال شريحتها العليا، في الدولة. وطوال تاريخها اللاحق، استغلت الكنيسة ضعف البشر وخوفهم من الموت لاستعباد عقولهم، وفي تلك السيرورة، حصلت على قوة وثروات هائلة، في تناقض صارخ مع تعاليم الثائر الجليلي الفقير الذي تزعم التحدث باسمه. ومن كونها حركة ثورية للفقراء والمضطهَدين، تحولت إلى حصن للرجعية وصوتٍ للأغنياء وأصحاب النفوذ، وهو واقع مستمر حتى يومنا هذا.
يمثل تاريخ الكنيسة نفيا كاملا ومطلقا لأفكارها ومعتقداتها وتقاليدها الأولى. وقد كُتبت مجلدات عديدة حول تاريخ البابوية خلال العصور الوسطى وعصر النهضة، وهو تاريخ مليء بالفضائح والجرائم التي لا مثيل لها. نكتفي هنا بتقديم مثال واحد يلخص الوضع الحقيقي ويظهر الهوة العميقة بين الواقع والأساطير المضللة. في عام 1517، أصدر البابا ليو العاشر قائمة Taxa Camerae، التي سمحت ببيع صكوك الغفران، حيث يمكن للمرء أن يضمن خلاص روحه مقابل مبلغ مالي. ولم تكن هناك جريمة شنيعة لا يمكن غفرانها بهذه الطريقة البسيطة. ومن بين 35 بندا في القائمة، نجد ما يلي:
- الكاهن الذي يرتكب خطيئة جسدية، سواء مع راهبات، أو قريباته، أو بناته (كذا!)، أو مع أية امرأة أخرى، يُغفر له ذنبه بدفع 67 جنيها و12 شلنا.
- إذا ارتكب الكاهن، إضافة إلى خطيئة الزنا، خطايا ضد الطبيعة أو البهيمية، فيجب أن يدفع 219 جنيها و15 شلنا للحصول على الغفران. أما إذا كانت الخطايا ضد الأولاد أو الحيوانات فقط، دون النساء، فيدفع 131 جنيها و15 شلنا فقط.
- الكاهن الذي يفض بكارة فتاة يدفع 2 جنيه و8 شلنات.
- الراهبة التي ترغب في الحصول على منصب رئيسة دير، بعد أن أقامت علاقات جنسية مع رجل أو أكثر، سواء داخل الدير أو خارجه، تدفع 131 جنيها و15 شلنا.
- المرأة الزانية التي تسعى للحصول على الغفران لتجنب الملاحقة القانونية والاستمرار في علاقاتها غير المشروعة تدفع 87 جنيها و3 شلنات. وبالمثل، يدفع الزوج نفس المبلغ إذا ارتكب سفاح القربى مع أطفاله، مع دفع مبلغ إضافي لتخليص الضمير بقيمة 6 جنيهات.
- الغفران وضمان عدم الملاحقة القانونية عن جرائم مثل الاغتصاب أو السرقة أو الحرق العمد يُكلف الجاني 131 جنيها و7 شلنات.
- الغفران عن القتل البسيط لشخص عادي يُحدد بـ15 جنيها و3 بنسات.
- إذا تسبب القاتل في وفاة شخصين أو أكثر في نفس اليوم، يدفع كما لو أنه قتل شخصا واحدا فقط.
- الزوج الذي يسيء معاملة زوجته يدفع 3 جنيهات و4 شلنات. إذا قتلها، يدفع 17 جنيها و15 شلنا. وإذا قتلها ليتزوج أخرى، يُضاف إلى المبلغ 32 جنيها و9 شلنات. أما من ساعده في الجريمة، فيدفع 2 جنيه لكل شخص.
- من يغرق طفله يدفع 17 جنيها و15 شلنا (أي أكثر بقليل من قتل شخص غريب)، وإذا اتفق الأب والأم معا على قتل الطفل، يدفعان 27 جنيها وشلن واحد للحصول على الغفران.
الإجهاض أيضا كان يُغفر بسهولة:
- الأم التي تجهض طفلها، والزوج الذي يشارك في الجريمة، يدفع كل منهما 17 جنيها و15 شلنا. أما من يُسهل الإجهاض لطفل ليس طفله، فيدفع جنيها أقل.
- القتل المتعمد للأخ أو الأخت، أو الأم أو الأب، يتطلب دفع 17 جنيها و5 شلنات.
ومع ذلك، إذا قُتل أسقف أو أحد كبار رجال الكنيسة من الفئات العليا في التسلسل الهرمي، فإن المبلغ الغرامة ترتفع بشكل كبير إلى 131 جنيها و14 شلنا عن الجريمة الأولى، ويُخفض إلى النصف عن الجرائم التالية (15). علاوة على ذلك، إذا كان القاتل “قد قتل العديد من الكهنة في مناسبات مختلفة”، فإنه يدفع 137 جنيها و6 شلنات عن القتل الأول، ونصف هذا المبلغ عن كل جريمة لاحقة”.
لكن جريمة الهرطقة -أي تبني أفكار تخالف تعاليم الكنيسة الرسمية- كانت أكثر خطورة من القتل أو الاغتصاب أو قتل الأطفال. فحتى إذا تاب الهرطيق وتراجع عن أفكاره، فإنه يظل ملزما بدفع مبلغ 269 جنيها. أما ابن الهرطيق الذي تم إعدامه بالحرق أو الشنق، أو بأي وسيلة أخرى، فلا يمكن إعادة تأهيله إلا بدفع مبلغ 218 جنيها و16 شلنا و9 بنسات.
تستمر القائمة لتشمل جرائم مثل الاحتيال، التهريب، عدم سداد الديون، تناول اللحوم في الأيام المقدسة، وأبناء الكهنة غير الشرعيين الذين يرغبون في الانضمام إلى السلك الكهنوتي، بل وحتى الخصيان الذين يرغبون في أن يصبحوا كهنة، والذين، وفقا للبند 33، كان يتوجب عليهم دفع مبلغ لا يقل عن 310 جنيهات و16 شلنا.
وعلى الرغم من هذه القائمة المضحكة من العار، فإن المؤرخين الكاثوليكيين يصفون البابا ليون العاشر بأنه بطل “الفترة الأكثر بريقا وربما الأكثر خطورة في تاريخ البابوية”[13].
الدين والثورة
لقد وقفت الكنيسة، في جميع البلدان وعبر القرون، إلى جانب المضطهِدين ضد المضطهَدين. فقد تعاون ملاك الأراضي الإنجليز بشكل وثيق مع وعاظ الكنيسة الرسمية (البروتستانتية). وفي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، كان الكهنة خداما أذلاء لملاك الأراضي، ثم لاحقا للرأسماليين. ومع ذلك، فإن التناقضات الطبقية في المجتمع وجدت غالبا تعبيرا لها في شكل ديني، وهو أمر لا ينبغي أن يفاجئ أي شخص ملم بالمادية التاريخية.
كتب تروتسكي حول هذا الموضوع:
“إن الأفكار الدينية، كما هو الحال مع أي أفكار أخرى، تنشأ من تربة الظروف المادية للحياة، وقبل كل شيء من تربة التناقضات الطبقية، لكنها لا تتلاشى إلا تدريجيا، ثم تظل قائمة بفعل قوة المحافظة لفترة أطول من الحاجة التي أوجدتها، ولا تختفي تماما إلا بعد تأثيرات الهزات الاجتماعية العميقة والأزمات”[14].
في فترات مختلفة، لعبت الأديان والكنائس والطوائف المختلفة أدوارا مختلفة، وعكست في آخر المطاف مصالح طبقية مختلفة، بل ومتعارضة. كانت البدايات الأولى للتمرد العظيم ضد الإقطاعية هي التحديات التي وُجِّهت إلى سلطة الكنيسة الكاثوليكية، والتي وجدت صدى واسعا بين الجماهير. يشير مؤرخ كاثوليكي إلى أن “روحا ثورية من الكراهية للكنيسة ورجال الدين سيطرت على الجماهير في مناطق مختلفة من ألمانيا… وأصبح الهتاف “الموت للكهنة!”، الذي كان يُهمس به سرا منذ زمن طويل، هو شعار اليوم”[15].
كانت الانتفاضات المبكرة، مثل حركة اللولارد في إنجلترا والهسّيين في ألمانيا، تمهيدا لإصلاحات لوثر[16]. وقد حملت كل هذه الحركات نزعة شيوعية استرجعت تقاليد الكنيسة المبكرة، لكنها قُمعت بوحشية في كل مرة. خلال ثورة الفلاحين الإنجليز عام 1381، يذكر المؤرخ فرويسارت نشاط حركة من “الكهنة المتشردين” المعارضين، بقيادة جون بول[17]، الذي طرح أفكارا شيوعية في شكل ديني مستخدما شعاره الشهير: “عندما حرث آدم وغزلت حواء، من كان السيد آنذاك؟”.
خلال مرحلة صعود البرجوازية، عكست الديانة البروتستانتية ثورة البرجوازية الناشئة ضد الإقطاع المحتضر. وبذلك قد لعبت بلا شك دورا تقدميا. انقسمت البروتستانتية منذ ظهورها في القرن السادس عشر. وفي خضم تلك الأوقات المضطربة، ظهرت سلسلة كاملة من الطوائف الجديدة، تمثل أفكار وتطلعات الطبقات والفئات المختلفة: المعمدانيون، والمينونايت، والبوهيميون، والكونغريغاشيون، والمشيخيون، والوحدويون. شكل الجناح اليساري اتجاها شيوعيا واضحا، كما هو الحال مع توماس مونتزر والمعمدانيون في ألمانيا. لقد انفصل مونتزر، وهو لوثري سابق، عن لوثر ودعا الفلاحين إلى الانتفاضة. أما لوثر، وعلى الرغم من الأهمية الثورية لأنشطته، فقد كان معاديا بشدة للحركة الثورية للفلاحين الألمان الذين حفزتهم تعاليمه على التحرك. وحث الأرستقراطيين بلغة عنيفة على سحق الحركة. وقد تم ذلك. ذبح الأمراء الأكثر مسيحية ما يقرب من 100 ألف فلاح. في ساكسونيا وحدها، قتل خمسة آلاف رجل بحد السيف. ولم ينج منهم سوى 300 وذلك فقط بعد أن وافقت نساؤهم على تحطيم رأسي كاهنين متهمين بإثارة التمرد. ثم تعرض مونتزر نفسه للتعذيب حتى الموت وقطع رأسه.
أنشطة محاكم التفتيش المقدسة -والتي كانت بمثابة الغيستابو للإصلاح المضاد- معروفة جيدا إلى درجة لا تستدعي تعليقا مطولا. ففي الأراضي المنخفضة التي كانت خاضعة للاحتلال الإسباني، كان امتلاك المرء للكتاب المقدس في منزله يعتبر جريمة كبرى تستوجب الإعدام. وكان يتم إحراق الهراطقة المدانين أحياء، لكن إذا اعترفوا وتابوا، فقد كانت محاكم التفتيش تظهر “رحمتها” تجاههم: إذ كان الرجال يُقطع رأسهم، بينما كانت النساء تُدفن وهن على قيد الحياة.
لكن ما هو أقل شهرة هو أن البروتستانت أنفسهم مارسوا القمع بحق المعارضين. فقد كان كالفن، الذي حكم جنيف بنظام دكتاتوري ثيوقراطي، مسؤولا عن إحراق مايكل سيرفيتوس [18] حيا عندما كان على وشك اكتشاف الدورة الدموية. توسّل سيرفيتوس طلبا للرحمة، ليس لإنقاذ حياته، بل لكي يُعدم بقطع رأسه بدلا من الحرق. لكن تم رفض طلبه، وظل يتعذب على النار لمدة نصف ساعة.
الثورتان الإنجليزية والفرنسية
في الثورة الإنجليزية، خلال القرن السابع عشر، كان الجناح الأكثر ثورية، الذي عبر عن تطلعات الطبقات الدنيا في المجتمع، من حرفيين وعمال، أي البروليتاريا الناشئة، قد وجد تعبيره في شكل ديني. كان الجناح اليساري للحركة منظما في سلسلة من الطوائف البروتستانتية الراديكالية والديمقراطية مثل رجال المملكة الخامسة، الرانترز[19]، والمعمدانيين.
في السياق التاريخي المعطى، كانت لتلك الحركات طبيعة تقدمية وثورية. لقد عبرت عن البدايات الأولى المضطربة للوعي الطبقي لطبقة لم تكن قد تشكلت بالكامل بعد. وبعد عودة الملكية، ظهرت تلك النزعات الشعبية الراديكالية مجددا في شكل أكثر خفوتا تحت مسمى المعارضين الدينيين. تعرض هؤلاء للاضطهاد من قبل الملكية، بدعم حماسي من الكنيسة الرسمية (الأنجليكانية)، مما دفع العديد منهم للهجرة إلى أمريكا، حيث تحولت طاقاتهم الثورية إلى عملية استكشاف القارة الجديدة. ومع مرور الزمن، فقدت تلك الجماعات جذورها الثورية بالكامل. بعضهم، مثل الكويكرز[20]، احتفظوا ببعض بقايا أفكارهم القديمة، ولكن بشكل باهت للغاية لا يتعارض مع السعي الناجح وراء المصالح التجارية. لكنهم في الغالب، تحولوا إلى معقل للردة الرجعية والدفاع الشرس عن القضايا اليمينية. في أمريكا اللاتينية، وبمفارقة غريبة، تحولت الطوائف الإنجيلية إلى رأس الحربة للرجعية ومدافعين عن الديكتاتوريات العسكرية، بينما مال بعض رجال الدين الكاثوليك، على الأقل في صفوفهم الدنيا، إلى الوقوف بجانب الفقراء والمضطهدين.
بحلول الثورة الفرنسية، بعد أكثر من قرن، كان وعي الجماهير قد تطور إلى حد أن الدين لم يعد يلعب أي دور في تفكيرهم. كان الارتباط الوثيق بين الكنيسة والدولة الاستبدادية واضحا للجميع. في الفترة التي سبقت اقتحام الباستيل، كان الفلاسفة الماديون مثل ديدرو وهولباخ [21] قد قاموا بعمل شامل في هدم الحصن الروحي للدين.
اجتثت الثورة الفرنسية الكنيسة من جذورها. كان نظام اليعاقبة ملحدا بشكل رسمي، رغم أن روبسبير[22] حاول تغطية ذلك بمفهوم “الكائن الأسمى”، وهو ما لم يُقنع أحدا سوى روبسبير نفسه. ورغم أن الفرنسيين كانوا يُعتبرون كاثوليكيين متحمسين، فإن الدين اختفى تقريبا بعد الثورة، باستثناء المناطق الأكثر تخلفا ورجعية، مثل فاندي. في الواقع، كان معظم الناس يكرهون الكهنة، معتبرين إياهم عملاء للطبقة السائدة. فقط في أواخر القرن التاسع عشر، خاصة بعد كومونة باريس، حين شعرت البرجوازية الفرنسية بالصدمة، بدأت في تشجيع إحياء ديني رجعي، مستخدمة “المعجزات” الملفقة في لورد [23] لذلك الغرض.
في الثورة الروسية، كان الأمر أكثر وضوحا. دخلت الطبقة العاملة الروسية إلى ساحة التاريخ لأول مرة في يناير 1905 بقيادة كاهن، وكان العمال يحملون الأيقونات الدينية، لكن كل ذلك تلاشى بسرعة بعد مجزرة التاسع من يناير، حين أمر القيصر “الأكثر مسيحية” قواته بإطلاق النار على الناس العزل الذين جاؤوا لتقديم التماس إليه. بعد ذلك لم يعد للدين أي دور في الحركة التي نظمها وقادها الماركسيون.
وبعد انتصار ثورة أكتوبر، انهار تأثير الكنيسة بسرعة وبشكل كامل، حتى أكثر مما حدث في فرنسا. كتب تروتسكي:
“لم تتجاوز الكنيسة الأرثوذكسية الميثولوجيا الفلاحية البدائية، بل تحولت مع الوقت إلى جهاز تابع للنظام القيصري. كان الكاهن يسير جنبا إلى جنب مع الشرطي، وأي معارضة دينية كانت تُقمع. لهذا السبب، كانت جذور الكنيسة الأرثوذكسية ضعيفة في وعي الشعب، خاصة في المراكز الصناعية. وعندما تخلص العامل الروسي من الجهاز الكنسي البيروقراطي، تخلص معه تماما من التفكير الديني”[24].
من المفارقات المدمّرة أن الستالينية أرجعت وعي المجتمع إلى الوراء، بحيث أنه فور انهيار الاتحاد السوفياتي، عادت كل القاذورات القديمة: القومية، معاداة السامية، الفاشية، الملكية، ومع هذا “المجد” القيصري، عاد الدين والخرافة، التي انتشرت مثل الطاعون في الجسد الروسي المريض والمنهار، كاشفة الحقيقة القاسية لـ”السوق الحرة”، وأن البرجوازية الروسية لا تقدم شيئا سوى الانحدار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
الكنيسة والاشتراكية
مثّل صعود الحركة العمالية الحديثة في العقد الأخير من القرن التاسع عشر والفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى تحديا للمؤسسة الدينية. وقفت الكنائس، دون استثناء، إلى جانب المستغِلين وضد الاشتراكية والحركة العمالية. ولتجنب انتشار الأفكار الاشتراكية بين صفوف الطبقة العاملة، اتخذت الكنيسة الكاثوليكية تدابير لتقسيم الحركة العمالية، حيث أنشأت نقابات عمالية كاثوليكية، ومنظمات نسائية وشبابية منفصلة لمنافسة الاشتراكية الديمقراطية. في الواقع، استنسخت الكنيسة أساليب التنظيم من الاشتراكية الديمقراطية.
كانت الكنيسة، التي طالما كانت في خدمة الأثرياء وأصحاب النفوذ، تنظر إلى الاشتراكية والحركة العمالية بارتياب وعداء واضحين. وقد عبر البابا ليون الثالث عشر عن معارضة الفاتيكان للاشتراكية في رسالته البابوية حول العمل، حيث كتب:
“يسعى الاشتراكيون، من خلال استغلال حسد الفقراء تجاه الأغنياء، إلى تدمير الملكية الخاصة، ويؤكدون أن الملكية الشخصية يجب أن تصبح ملكا مشتركا للجميع. إنهم بلا شك غير عادلين، لأنهم يسلبون المالك الشرعي… إذا أجّر شخص قوته أو اجتهاده لشخص آخر، فإنه يفعل ذلك ليحصل في المقابل على وسائل العيش، بقصد اكتساب حق حقيقي، ليس فقط في أجره، بل أيضا في حرية التصرف فيه. فإذا استثمر ذلك الأجر في الأرض، فهو أجره في شكل آخر…
“إن جوهر الملكية يكمن بالتحديد في هذه القدرة على التصرف بها، سواء كانت أرضا أو ممتلكات أخرى. إن الاشتراكيين يعتدون على حرية كل عامل مأجور، لأنهم يسلبونه حرية التصرف بأجره. لكل إنسان، وفقا لقانون الطبيعة، الحق في امتلاك ممتلكاته الخاصة…
“ويجب أن يكون من حقه امتلاك الأشياء، ليس فقط لاستخدامها الفوري، وليس فقط الأشياء التي تفنى عند استخدامها، بل تلك التي تمتلك قيمة دائمة ومستقرة.
… “الإنسان سابق على الدولة، وحقوقه الطبيعية تسبق أي حق للدولة… عندما يبذل الإنسان جهده الذهني وقوته البدنية لاستخراج خيرات الطبيعة، إنه بذلك يجعل لنفسه ملكية في تلك الرقعة من الأرض التي يحرثها، تلك الرقعة التي يضع عليها بصمة شخصيته. ولا يمكن إلا أن يكون من العدل أن تكون تلك الرقعة ملكا له، بمنأى عن أي تدخل خارجي”…
كما كتب أيضا:
“الديمقراطية المسيحية، بحكم كونها مسيحية، يجب أن تستند إلى مبادئ الإيمان الإلهي في سعيها لتحسين أوضاع الجماهير… ومن ثم، فإن العدالة مقدسة في نظر الديمقراطية المسيحية. ويجب أن تحافظ على أن الحق في اكتساب وامتلاك الملكية لا يمكن الطعن فيه، كما يجب أن تحمي الفوارق والتدرجات المختلفة، التي تعد ضرورية في أي مجتمع منظم بشكل جيد. من الواضح، إذن، أنه لا يوجد قاسم مشترك بين الديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية المسيحية. فهما يختلفان بقدر اختلاف مذهب الاشتراكية عن كنيسة المسيح”.
كما علق جيمس كونولي، الماركسي الأيرلندي والشهيد الثوري العظيم، الذي ما تزال مجادلاته مع الكنيسة الكاثوليكية تُعتبر من البيانات الكلاسيكية للاشتراكية:
“لو أن أحد الفتيان في المدارس الوطنية لم يستطع التفكير بمنطق أكثر مما ورد، لبقي في مقعد الفشل طوال أيام دراسته. تخيل كاهنا يدافع عن الإقطاع، كما يفعل الأب كين والبابا، قائلا: “الرجل الذي حرث الحقل خلال الشتاء والربيع له الحق في امتلاك المحصول الذي جناه”، متصورا أنه بذلك يطرح حجة ضد الاشتراكية! إن الاشتراكيين لا يسعون إلى التدخل في حق أي إنسان في الاحتفاظ بما كسبه؛ لكنهم يؤكدون بشدة أن هذا الرجل، سواء كان فلاحا أو عاملا، يجب ألا يُجبر على التخلي عن الجزء الأكبر، أو أي جزء، مما كسبه لصالح طبقة خاملة لا تزرع ولا تغزل، بل استولت على ممتلكات الأمة من خلال القوة الوحشية، والنهب، والاحتيال”[25].
في 21 شتنبر 1958، كتب البابا بيوس الثاني عشر: “إن تعدد الطبقات يتوافق تماما مع مشيئة الخالق”. وهذا يعني أن الكنيسة تعتبر المجتمع الطبقي نظاما ثابتا، أزليا، ومن أصل إلهي. قارن ذلك بما قاله القديس كليمنت (كما ورد سابقا):
“إن استخدام جميع الأشياء الموجودة في هذا العالم يجب أن يكون مشتركا بين جميع البشر. إن الظلم الأكثر وضوحا هو أن يقول أحدهم للآخر: “هذا لي، وذاك لك”، وهكذا ينشأ النزاع بين الناس”. موقف بيوس الثاني عشر يتوافق تماما مع كلمات الترتيلة الإنجليكانية القديمة كل الأشياء مشرقة وجميلة (All Things Bright and Beautiful)، التي تتضمن السطور الشهيرة:
“الرجل الغني في قصره، الفقير عند بابه:
لقد خلق [الله] العالي والوضيع، ونظّم مكانتهم”.
هذا هو الموقف النموذجي للكنيسة على مدى قرون: الدفاع العلني عن الوضع القائم وتقسيم المجتمع إلى طبقات.
لاحقا، ومع نمو الحركة العمالية والتقدم الحتمي نحو الاشتراكية، اضطرت الكنيسة الكاثوليكية إلى تعديل موقفها. كان البابا يوحنا الثالث والعشرون -الأكثر ذكاء بين بابوات القرن العشرين- قد تبنى موقفا أكثر تقدمية. لكن في ظل البابا الحالي[26]، تم التراجع عن ذلك التوجه بشكل حاد.
الكنيسة اليوم
“ألا تنقض كل دقيقة من حياتك العملية نظريتك؟ هل تعتبر اللجوء إلى المحاكم خطأ عندما تتعرض للخداع؟ لكن الرسول يكتب أن ذلك خطأ. هل تقدم خدك الأيمن عندما تتلقى ضربة على خدك الأيسر، أم أنك ترفع دعوى قضائية بتهمة الاعتداء؟ ومع ذلك، فإن الإنجيل ينهى عن ذلك […] أليست معظم القضايا في المحاكم وغالبية القانون المدني تدور حول الملكية؟ لكنك قد قيل لك إن كنزك ليس من هذا العالم“[27].
تعتمد أنشطة الكنيسة في المجتمع الحديث على تناقضات ونفاق صارخ، كما أشار ماركس في المقطع المذكور أعلاه. ليست للتقاليد الثورية للمسيحية المبكرة أية علاقة بالوضع الحالي. فمنذ القرن الرابع الميلادي، عندما تم الاستيلاء على الحركة المسيحية من قبل الدولة وتحويلها إلى أداة للقمع، أصبحت الكنيسة المسيحية في صف الأغنياء وأصحاب السلطة ضد الفقراء. اليوم، الكنائس الكبرى هي مؤسسات ثرية للغاية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشركات الكبرى، بالإضافة إلى المبالغ الهائلة التي تحصل عليها من الدولة، سواء في البلدان الإسلامية أو المسيحية.
في إسبانيا، وحتى وقت قريب، كانت الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب ثروتها الهائلة من الأراضي والمباني والحسابات المصرفية، تتلقى دعما منتظما من الدولة عبر الضرائب التي يدفعها جميع المواطنين، سواء كانوا متدينين أم لا، دون استشارة الشعب الإسباني بشأن تلك الغرامة. وينطبق الشيء نفسه على بلدان أخرى حيث أبرمت الكنيسة صفقات مع الدولة تمنحها موقعا متميزا ومربحا. بغض النظر عن الموقف الشخصي تجاه الدين، فإن هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا للديمقراطية. وعلى الرغم من أنه بات الآن بإمكان دافعي الضرائب الإسبان اختيار التبرع للكنيسة من عدمه، فإن الحقيقة هي أن الكنيسة ما تزال تتمتع بموقع متميز يتيح لها الوصول إلى الأموال العامة.
في العصور الوسطى، اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية الربا (إقراض المال بالفائدة) خطيئة مميتة، ولكن اليوم يمتلك الفاتيكان بنكا كبيرا ويتمتع بثروة وسلطة هائلتين. أما الكنيسة الأنجليكانية، فبالإضافة إلى استثماراتها التجارية المتعددة، تعد واحدة من أكبر ملاك الأراضي في بريطانيا. ويمكن بسهولة إثبات أن هذا الوضع موجود في كل مكان. كما أن هذا الظاهرة ليست مقصورة على الديانة المسيحية وحدها، فالقرآن أيضا حرم الربا، ومع ذلك فإنه في جميع البلدان الإسلامية المزعومة، توجد بنوك ضخمة مملوكة لمسلمين. صحيح أنهم يلجؤون إلى وسائل مختلفة لإخفاء الأمر، لكن الفائدة تُستخلص من الناس بنفس الطريقة.
من الناحية السياسية، كانت الكنائس دائما تدعم الرجعية. ففي الثلاثينيات من القرن الماضي، بارك الأساقفة الكاثوليك جيوش فرانكو في حملتها لسحق العمال والفلاحين الإسبان. وكانت الصحافة الفاشية الإسبانية تنشر بانتظام صورا لرجال الدين وهم يؤدون التحية الفاشية. كما دعم البابا بيوس الثاني عشر هتلر وموسوليني. والتزم الصمت تجاه الملايين الذين أُبيدوا في معسكرات الموت النازية، ورغم أن الفاتيكان كان من المفترض أن يكون محايدا رسميا خلال الحرب العالمية الثانية، فإن تعاطفه مع النازيين موثق جيدا. كتب جي لوي:
’’منذ بداية حكم هتلر حتى نهايته، لم يتوقف الأساقفة عن حث المؤمنين على قبول حكومته باعتبارها السلطة الشرعية التي يجب طاعتها […]. وبعد محاولة الاغتيال الفاشلة ضد هتلر بميونيخ، في 08 نوفمبر 1939، أرسل الكاردينال بيرترام، باسم الأساقفة الألمان، والكاردينال فولهابر، نيابة عن أساقفة بافاريا، برقيات تهنئة إلى هتلر. كما تحدثت الصحافة الكاثوليكية في جميع أنحاء ألمانيا، استجابة لتعليمات من غرفة الصحافة النازية، عن التدخل العجائبي للعناية الإلهية التي حمت الفوهرر”[28].
وكتب سول فريدلاندر:
“تُظهر الوثائق الألمانية اتفاقا واضحا بشأن نقطتين مهمتين: فمن جهة، يبدو أن الحبر الأعظم كان لديه ميل واضح تجاه ألمانيا، وهو ميل لم يتراجع رغم طبيعة النظام النازي، ولم يتبرأ منه حتى عام 1944. ومن جهة أخرى، كان بيوس الثاني عشر يخشى بلشفة أوروبا أكثر من أي شيء آخر، ويبدو أنه كان يأمل أن تصبح ألمانيا الهتلرية، في حال تصالحت مع الحلفاء الغربيين، الحصن الأساسي الذي يصد أي تقدم للاتحاد السوفياتي نحو الغرب”[29].
في تاريخ الأفكار، لعبت الكنيسة دائما دورا رجعيا. تم إجبار غاليليو غاليلي[30] على التراجع عن أفكاره تحت تهديد التعذيب من قبل محاكم التفتيش المقدسة. كما تم حرق جيوردانو برونو[31] حيا. وتعرض تشارلز داروين لملاحقة لا هوادة فيها من قبل المؤسسة الدينية في إنجلترا، لمجرد أنه تجرأ على تحدي الاعتقاد السائد بأن الله خلق العالم في ستة أيام.
وحتى اليوم ما زالت نظرية التطور تتعرض للهجوم من قبل اليمين الديني في الولايات المتحدة، الذي يسعى إلى تدريس سفر التكوين في المدارس الأمريكية بدلا من نظرية التطور. اليمين الديني في الولايات المتحدة حركة ممولة بشكل جيد، ويدعو إلى قضايا رجعية. قبل سنوات قليلة، تعهد رجل الأعمال النفطي، نيلسون بانكر هانت، من تكساس بتقديم أكثر من 10 ملايين دولار لحملة تمويل بقيمة مليار دولار لصالح منظمة “الحرم الجامعي الصليبي من أجل المسيح”. كما أن “مؤسسة الحرية المسيحية”، وهي مجموعة ضغط تعليمية، تمول من قبل جي هوارد بيو، مؤسس شركة “صن أويل”، ورجال أعمال آخرين يدعمون نظام السوق الحرة. هناك العديد من الأمثلة الأخرى التي توضح العلاقة الوثيقة بين اليمين الديني وبين كبار رجال الأعمال. هؤلاء الأثرياء لا يستثمرون مثل تلك الأموال بلا مقابل، فالدين هنا يستخدم بشكل صريح كأداة رجعية.
حركة الخلقوية في الولايات المتحدة تضم ملايين الأشخاص، وهي -بشكل مذهل- يقودها علماء، من بينهم بعض المتخصصين في علم الوراثة. هذا تعبير واضح عن العواقب الفكرية لانحطاط الرأسمالية. إنه مثال صارخ على التناقض الديالكتيكي الناجم عن تخلف الوعي البشري. ففي أكثر بلدان العالم تقدما من الناحية التكنولوجية، تغرق عقول ملايين الرجال والنساء في البربرية. مستوى وعيهم لا يكاد يكون أعلى من ذلك الذي كان لدى البشر عندما كانوا يضحون بأسرى الحرب للآلهة، ويسجدون أمام الأصنام المنحوتة، ويحرقون النساء بتهمة السحر. إذا نجحت هذه الحركة، كما قال أحد العلماء مؤخرا، فسنعود إلى العصور المظلمة.
في مجال التشريعات الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء، لعبت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية دائما دورا رجعيا. ما تزال ترفض منح المرأة حق التحكم في جسدها، وتنكر حقها في الطلاق، ووسائل منع الحمل، والإجهاض. البابا الحالي، كارول فويتيلا[32]، يعبر عن موقفه بوضوح في هذا الشأن. معارضة الكنيسة المستمرة لوسائل منع الحمل الاصطناعية تعتبر كارثية بشكل خاص فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ومع ذلك فقد أظهر استطلاع رأي أجراه معهد غالوب عام 1999 للكاثوليك الأمريكيين أن %80 من عامة الكاثوليك و50٪ من الكهنة يؤيدون وسائل منع الحمل الاصطناعية، بينما وجد استطلاع أجرته جامعة ماريلاند أن ثلثي الكاثوليك يعتقدون أنه في حالة تعارض ضميرهم مع تعاليم البابا، فعليهم اتباع ضميرهم. ويمكن الإشارة إلى أرقام مماثلة في بلدان متقدمة أخرى.
في المجال السياسي، يُعرف البابا الحالي بمواقفه الرجعية الصريحة وعدائه للماركسية والاشتراكية. وقد تمت مساعدته للوصول إلى السلطة من قبل أوبوس داي[33]، تلك المنظمة الكاثوليكية السرية سيئة السمعة، التي تمتد أذرعها إلى كل زاوية من زوايا الحياة السياسية في إيطاليا، وإسبانيا، وبلدان أخرى.
لينين والدين
أشار إنجلز في مقدمته لكتاب “الحرب الأهلية في فرنسا” إلى أن “الدين، من منظور الدولة، هو شأن خاص تماما”. وتعليقا على ذلك، كتب لينين في عام 1905:
“يجب على الدولة ألا تتدخل في الدين، كما يجب ألا تكون الجمعيات الدينية مرتبطة بالدولة. يجب أن يكون لكل فرد الحرية في اعتناق أي دين يشاء، أو في عدم اعتناق أي دين، أي أن يكون ملحدا، كما هو حال كل اشتراكي عادة”[34].
لكن فيما يتعلق بالحزب، فقد أشار لينين أيضا إلى أن إنجلز أوصى الحزب الثوري بخوض معركة ضد الدين:
“حزب البروليتاريا يطالب الدولة باعتبار الدين شأنا خاصا، لكنه لا يعتبر مسألة مكافحة أفيون الشعب -مكافحة الخرافات الدينية، إلخ- شأنا خاصا. لقد شوه الانتهازيون المسألة لدرجة أنهم يوهمون الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه يعتبر الدين شأنا خاصا”[35].
وأضاف:
“إن جذور الدين الحديث متغلغلة بعمق في أرض القهر الاجتماعي الذي تعانيه الجماهير العاملة، وفي شعورها الظاهري بانعدام الأمل أمام القوى العمياء للرأسمالية […] لا يمكن لأي قدر من القراءة، مهما كانت تنويرية، أن يمحو الدين من وعي الجماهير، إلا عندما تتعلم الجماهير نفسها النضال ضد الوقائع الاجتماعية التي تولد الدين، في شكل موحد، منظم، واع ومنضبط، أي حتى تتعلم النضال ضد سلطة الرأسمالية بجميع أشكالها“[36].
ومع ذلك، يجب على الماركسيين بذل كل ما في وسعهم لإشراك جميع العمال في النضال ضد الرأسمالية، بما في ذلك العمال المتدينون. يجب ألا نقيم حواجز بيننا وبين هؤلاء العمال، بل علينا أن نشجعهم على المشاركة الفعالة في النضال الطبقي.
وكما رأينا سابقا ففي عام 1905، دخلت الطبقة العاملة الروسية ساحة التاريخ تحت قيادة كاهن، وهم يحملون الأيقونات الدينية في أيديهم ويرفعون التماسا إلى القيصر. كانوا لا يثقون بالثوريين، وأحيانا كانوا يعتدون عليهم بالضرب. لكن كل ذلك تغير خلال 24 ساعة فقط بعد مجزرة التاسع من يناير، حيث جاء العمال أنفسهم إلى الثوريين في تلك الليلة مطالبين بالسلاح. وهكذا يمكن للوعي أن يتغير بسرعة هائلة في خضم الأحداث!
وعلى سبيل المثال، فإن الأب غابون، الذي نظم المظاهرة السلمية ورفع الالتماس للقيصر، وكان يعمل لصالح الشرطة القيصرية، تعرض هو نفسه لتحول مفاجئ بعد الأحد الدامي. حيث بدأ يدعو إلى الإطاحة الثورية بالقيصر، بل واقترب من البلاشفة في مرحلة ما. لم يقم لينين بإقصائه، بل حاول كسبه إلى الثورة، رغم أنه ظل متدينا.
ظهر موقف لينين المرن أيضا في موقفه من الإضرابات. فقد حذر من اتخاذ موقف عصبوي تجاه العمال المتدينين الذين يشاركون في الإضرابات، قائلا:
“إن التبشير بالإلحاد في مثل هذا الوقت [أي أثناء الإضراب] وفي مثل هذه الظروف، لن يؤدي إلا إلى خدمة مصالح الكنيسة والقساوسة، الذين لا يريدون شيئا أكثر من تقسيم العمال المشاركين في الحركة الإضرابية وفقا لمعتقداتهم الدينية”[37].
هذا هو جوهر المسألة. نحن نناضل من أجل وحدة التنظيمات العمالية، بغض النظر عن أي اختلافات دينية أو قومية أو لغوية أو اثنية. مهمتنا هي توحيد جميع المضطهَدين والمستغَلين في جيش واحد ضد البرجوازية.
لم يطالب الماركسيون قط بجعل الإلحاد شرطا للانضمام إلى الحزب، فقد كان ذلك دائما سمة مميزة للمنظمات اللاسلطوية. في كثير من الأحيان، يقترب عامل ما يزال متدينا من الحركة، مقتنعا ببرنامجها العام ومستعدا للنضال من أجل الاشتراكية، لكنه غير راغب في التخلي عن دينه. فكيف يجب أن يكون موقفنا منه؟
بالتأكيد ليس إبعاده. فهذا العامل لا ينضم إلى الحركة بهدف التبشير بالدين، بل للنضال ضد الرأسمالية. ومن المحتمل أنه مع مرور الوقت، سيدرك التناقض بين قناعاته الدينية والسياسية، ويتخلى تدريجيا عن الدين. لكن هذه مسألة حساسة، ولا ينبغي التعامل معها بحدة. وكما أوضح لينين، فإن الماركسيين “يعارضون تماما أي إهانة للمعتقدات الدينية لهؤلاء العمال”[38].
لكن الموقف يختلف تماما إذا كان الأمر يتعلق بمثقف من الطبقة الوسطى يسعى لإدخال مفاهيم مشوشة إلى أيديولوجية الحركة. هذا ما حدث عندما كان لينين يكتب عن الدين، حيث حاول بعض البلاشفة اليساريين الطفوليين، مثل بوغدانوف ولوناتشارسكي، إدخال مفاهيم فلسفية صوفية إلى الماركسية. وهنا، كان على لينين أن يخوض نضالا فكريا حازما ضد ذلك التيار، وكان ذلك ضروريا للحفاظ على وضوح أيديولوجية الحزب.
مستقبل الدين
ما هو مستقبل الدين؟ سيكون هناك، بالطبع، اختلاف عميق في الرأي بين الماركسيين والمسيحيين وأتباع الديانات الأخرى حول هذا السؤال. من الطبيعي أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل كما لو كان يُنظر إليه عبر كرة بلورية، لكن يمكن قول ما يلي: على الرغم من أن الماركسية، من وجهة نظر فلسفية، غير متوافقة مع الدين، فمن البديهي أننا نعارض أي فكرة لحظر الدين أو قمعه. نحن ندافع عن الحرية الكاملة للفرد في اعتناق أي معتقد ديني أو عدم اعتناق أي دين على الإطلاق.
ما نقوله هو أنه يجب أن يكون هناك فصل جذري بين الكنيسة والدولة. يجب ألا يتم دعم الكنائس بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الضرائب، ولا ينبغي تدريس الدين في المدارس الحكومية. إذا كان الناس يريدون الدين، فيجب أن يمولوا كنائسهم حصريا من خلال تبرعات المؤمنين، وأن ينشروا عقائدهم في وقتهم الخاص. تنطبق هذه الملاحظات الأساسية أيضا على الإسلام أو أي دين آخر.
بالنسبة لنا، سيستمر النقاش حول الدين، لكنه لا يجب أن يُستخدم لحجب المشكلة الأساسية في عصرنا. مهمتنا الأولى والرئيسية هي أن نتحد في النضال مع جميع الذين يسعون إلى إنهاء ديكتاتورية رأس المال التي تُبقي الجنس البشري في حالة عبودية. ستسمح الاشتراكية بالتطور الحر للبشر دون قيود الحاجة المادية.
لقد تم استخدام الدين المنظم على مدى قرون، من قبل المستغِلين لخداع الجماهير واستعبادهم. وكانت هناك ثورات على فترات متقطعة ضد هذا الوضع. فمنذ العصور الوسطى وحتى يومنا هذا، ارتفعت أصوات تحتج على تبعية الكنيسة للأثرياء وأصحاب النفوذ. وهو ما نراه حتى في وقتنا الحاضر. إن معاناة العمال والفلاحين، واستعباد البشرية تحت الاستبداد الفظيع لرأس المال، تثير غضب شرائح واسعة من الناس، وكثير منهم ليسوا على دراية بالفلسفة الماركسية، لكنهم مستعدون للنضال ضد الظلم والاستغلال. ويوجد من بين هؤلاء العديد من المسيحيين الصادقين وحتى الفئات الدنيا من رجال الدين، الذين يشهدون يوميا على معاناة الجماهير.
لاهوت التحرير هو تعبير عن الغليان الثوري في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية. فقد شعر رجال الدين المنتمون إلى الشرائح الدنيا بصدمة عميقة من معاناة الفقراء والمضطهَدين، مما دفعهم للانضمام إلى النضال من أجل حياة أفضل.
في حين أن القيادات العليا للكنيسة، التي أقامت على مدى مئات السنين علاقاتٍ وثيقة مع ملاك الأراضي الأثرياء والمصرفيين والرأسماليين، يتقاوم هذا التوجه الجديد أو تتغاضى عنه على مضض. وهكذا فقد تغلغل الصراع الطبقي إلى صفوف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية نفسها.
وبالمثل فقد بدأت الأفكار الماركسية تلقى صدى لها بين المسلمين أيضا، حيث بدأت الجماهير المضطهَدة في الشرق الأوسط وإيران وإندونيسيا بالتحرك لتحسين أوضاعها والبحث عن برنامج نضالي للإطاحة بمستغِليها.
إن المطلوب هو الإطاحة بالرأسمالية والإقطاعية والإمبريالية، إذ لا يمكن تحقيق أي تقدم دون ذلك. والبرنامج الوحيد الذي يمكنه أن يضمن انتصار هذا النضال هو برنامج الماركسية الثورية. إن التعاون المثمر بين الماركسيين وبين المسيحيين (وكذلك المسلمين والهندوس والبوذيين واليهود وأتباع الديانات الأخرى) في النضال من أجل تغيير المجتمع ليس ممكنا فحسب، بل ضروري أيضا، رغم الاختلافات الفلسفية التي تفصل بيننا. فالمسيحيون النزيهون يشعرون باستياء عميق من الاضطهاد الرهيب الذي تعانيه الغالبية العظمى من البشر. قال كاميلو توريس، وهو كاهن كولومبي سابق، ذات مرة: “لقد خلعت الثوب الكهنوتي لكي أصبح كاهنا حقيقيا. من واجب كل كاثوليكي أن يكون ثوريا؛ ومن واجب كل ثوري أن ينجز الثورة. الكاثوليكي الذي لا يكون ثوريا يعيش في خطيئة مميتة”.
هؤلاء هم الخلفاء الحقيقيون لأولئك الثوريين المسيحيين الأوائل الذين دافعوا عن قضية فقراء الأرض، والخطاة، والمضطهَدين، ولم يخشوا التضحية بحياتهم في سبيل النضال ضد الاضطهاد. إنهم الشهداء المعاصرون، الذين يجب أن تُحفظ ذكراهم باحترام من قبل كل من يقدر قضية الحرية والعدالة. بين عامي 1968 و1978، تم اعتقال وتعذيب وقتل أكثر من850 كاهنا وراهبة وأسقفا في أمريكا اللاتينية. وقبل مقتله، قال اليسوعي السلفادوري روتيليو غراندي[39]: “في الوقت الحاضر، من الخطير […] وهو في الواقع من غير القانوني تقريبا، أن يكون المرء مسيحيا حقيقيا في أمريكا اللاتينية”. والتأكيد هنا على كلمة “حقيقي”.
حياة بديلة؟
على الرغم من أن المؤسسة الدينية فقدت الكثير من نفوذها في السنوات الأخيرة، فإن الأفكار الدينية عادت للظهور في أشكال متنوعة من الطوائف والحركات، التي يروج بعضها لـ”أسلوب حياة بديل”. يعكس هذا، إلى حد ما، تنامي شعور بعض الشباب بعدم الرضا عن النظام الرأسمالي، بما في ذلك منظوره القاسي والمجرد من الروح للحياة، وتسليعه لكل جوانب الوجود، وماديته الفجة، وجشعه الذي لا يعرف حدودا، واستغلاله المدمر للبيئة. قد يكون هذا الرفض خطوة أولى نحو الوعي، لكن هنا تبدأ المشكلة: لا يكفي مجرد رفض الرأسمالية، بل يجب اتخاذ خطوات فعلية للقضاء عليها.
القاسم المشترك بين جميع هذه الحركات “البديلة” – مثل حركة العصر الجديد [40](New Ageism) هو أنها تعتمد على مفهوم فردي بحت للخلاص. لكنه لا يوجد مخرج حقيقي على هذا الطريق. وفي نهاية المطاف، فإن مؤيدي هذا “البديل” لا يقدمون بديلا حقيقيا على الإطلاق. فالرأسمالية قادرة تماما على التعايش مع قلة من الأفراد الذين يختارون “الانسحاب” من المجتمع، لأن ذلك لا يشكل أي تهديد لها، إذ يظل أصحاب السلطة مسيطرين على الحياة الاجتماعية كما كانوا من قبل.
حتى أولئك الذين يعلنون عن “انسحابهم” من المجتمع سيكتشفون في الواقع أنهم لا يستطيعون الانسحاب حقا. فهم مجبرون على استخدام المال، وشراء ضروريات الحياة من المتاجر، وتعبئة شاحناتهم القديمة في محطات الوقود الحديثة، حيث يشترون منتجاتهم من شركات النفط الكبرى التي تنهب البيئة وتلوثها، ويتعرضون للتنقل القسري من منطقة إلى أخرى على يد الشرطة، تماما مثل بقيتنا.
إن الاعتقاد بأنه يمكن للمرء الانفصال عن المجتمع وتجاهل السياسة ليس سوى وهم. حاول فقط أن تجرب ذلك! وستجد أن السياسة ستأتي في يوم من الأيام إلى باب منزلك وتقرع الجرس (إن لم تحطم الباب أصلا).
إن السعي لإيجاد حل فردي هو، في جوهره، موقف رجعي، لأن الطريقة الوحيدة للنضال ضد الرأسمالية والدولة البرجوازية هي توحيد الطبقة العاملة وتنظيمها في حركة ثورية. إن الانسحاب من هذا النضال يعني، بشكل أو بآخر، وضع نفسك تحت رحمة رأس المال والمساهمة في استمرار النظام القائم.
وللتغطية على هذا العجز، يدعي أنصار حركة العصر الجديد (New Ageism) أنهم يتمسكون بقيم روحية خاصة، والتي -بحسب تصورهم- تميزهم عن “البشر العاديين” وتضعهم في اتصال مباشر مع أمور خارقة للطبيعة تتجاوز كل فهم. وهكذا، يشعرون بأنهم متفوقون على بقية البشرية التي لا تملك حق الوصول إلى تلك “الأسرار العظيمة”.
في الواقع، هذه الأفكار ليست أرقى من تفكير البشر العاديين، بل أدنى منه بكثير. إن القانون الأول لمن يسعى إلى تغيير المجتمع هو أن يفهمه ويعيش فيه. ومحاولة الابتعاد عن المجتمع لا تؤدي إلا إلى العجز التام أمام الواقع القائم، والتخلي نهائيا، وبلا أمل، وبلا رجعة، عن أية فرصة لتغييره. لا يوجد بديل حقيقي على هذا الطريق، بل مجرد استمرار لنفس الوضع – إلى الأبد.
الدين وأزمة الرأسمالية
الدين هو ما يسميه الماركسيون وعيا زائفا، لأنه يوجه فهمنا بعيدا عن العالم ونحو آخرة لا يمكننا أن نعرف عنها شيئا، ولا جدوى من طرح الأسئلة حولها. ينطلق كل تاريخ العلم من افتراضين أساسيين: أ) العالم موجود خارج ذواتنا، و ب) يمكننا فهم هذا العالم، وحتى إن كانت هناك أشياء لا نفهمها حاليا، فنحن على الأقل قادرون على فهمها في المستقبل. إن وضع حد لا يمكن للمعرفة الإنسانية أن تتجاوزه هو فتح الباب لكل أشكال التصوف والخرافة. ومع ذلك، فعلى مدى أكثر من 2000 عام، كان البشر يكافحون لاكتساب المعرفة عن أنفسهم وعن العالم الذي يعيشون فيه. وخلال كل ذلك الوقت، كان الدين عدو التقدم العلمي، وليس ذلك مصادفة. فبقدر ما مكننا تقدم الفكر العلمي من فهم الأشياء التي كانت تعتبر في الماضي “ألغازا”، تراجع الدين وأصبح الآن يخوض معركة يائسة لحماية نفسه.
في صراع العلم ضد الدين -أي صراع الفكر العقلاني ضد اللاعقلانية- تقف الماركسية بقوة إلى جانب العلم. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. الغرض الكامل من اكتساب المعرفة العقلانية عن العالم هو تغييره. المعنى العميق لكل التاريخ البشري خلال المائة ألف سنة الماضية -وأكثر- هو كفاح مستمر للبشرية للفوز في معركتها مع الطبيعة، للتحكم في مصيرها، وبالتالي لتصبح حرة. تعود جذور الدين إلى الماضي البعيد، عندما كان البشر يكافحون لتحرير أنفسهم من العالم الحيواني الذي أتوا منه. ولإيجاد معنى للظواهر الطبيعية التي كانت خارجة عن سيطرتهم، لجأ البشر إلى الأرواحية (Animism) وهي أقدم أشكال الدين. وقد مثلت هذه في زمنها خطوة إلى الأمام للوعي البشري. كان ينبغي التخلي عن تلك المرحلة الطفولية من الوعي منذ زمن بعيد، لكن العقل البشري محافظ إلى حد بعيد ويستمر في التمسك بمفاهيم وأحكام مسبقة فقدت منذ زمن طويل أي سبب لوجودها.
في المجتمع الطبقي، تبدو عبارة “أحب جارك” فارغة من المضمون. اقتصاد السوق، مع أخلاقياته المصاحبة التي تتلخص في مبدأ “البقاء للأقوى” و”أنا وبعدي الطوفان”، تجعل من تلك العبارة اقتراحا صعبا، بل ومستحيلا. ومن أجل تغيير سلوك الرجال والنساء ونفسيتهم، يجب أولا تغيير الطريقة التي يعيشون بها. على حد تعبير ماركس: “الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد الوعي”. تهيمن على العالم بأسره حفنة من الاحتكارات الضخمة التي تنهب الكرة الأرضية، وتدمر الكوكب، وتخرب البيئة، وتحكم على ملايين لا حصر لهم بحياة من البؤس والمعاناة التي لا تطاق.
إن السيدات والسادة الذين يجلسون في مجالس إدارة تلك الشركات متعددة الجنسيات هم في الغالب من المسيحيين الممارسين، مع عدد أقل من اليهود والمسلمين والهندوس وأتباع الديانات الأخرى. ومع ذلك فإن الدين الحقيقي للرأسمالية ليس أيا من تلك الأديان، بل هو عبادة “مامون”[41]، إله الثروة. تقلب الرأسمالية العلاقات الإنسانية رأسا على عقب، حيث أصبحت الأمور مشوهة لدرجة أننا نشير إلى رجل على أنه “تبلغ قيمته مليون دولار”، كما لو كنا نتحدث عن سلعة تجارية. تشير التلفزيونات إلى سوق الأوراق المالية، والسوق، والدولار والجنيه وكأنها كائنات حية (“الجنيه كان أفضل قليلا اليوم”). هذه هي ماهية الاغتراب: إذ تُرى الأشياء الميتة (رأس المال) على أنها حية، وتُعتبر الكائنات الحية (البشر، العمال) ميتة، تافهة، بلا معنى.
يمتلك التطور البشري خطا هابطا كما له خط صعود. غلاف الثقافة والحضارة الحديثة التي بُنيت على مدار آلاف السنين ما يزال رقيقا جدا. تكمن تحته كل عناصر البربرية. إذا شك أي شخص في ذلك، فليدرس تاريخ ألمانيا النازية، أو الأحداث الأخيرة في البلقان. لقد وقفت البرجوازية، في فترة صعودها، على أرض العقلانية – نعم، وحتى الإلحاد أيضا. أما الآن، في فترة انحطاط الرأسمالية، تظهر النزعات اللاعقلانية في كل مكان، حتى في أكثر البلدان تقدما و”تحضرا”. إذا لم تنجح الطبقة العاملة في تغيير المجتمع، فإن كل مكتسبات الماضي ستكون مهددة، ولن يكون هناك ضمان لمستقبل الحضارة الإنسانية نفسها.
الدمار الذي ألحقته الرأسمالية بالعالم بأسره أفرز عددا لا يحصى من المسوخ. وفي مرحلة احتضارها، ولدت أيضا نزعات دينية وصوفية من أكثر الأشكال رجعية. يمكن رؤية الدور الرجعي للدين اليوم في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى أيرلندا الشمالية. نرى من كل جانب الوحش القبيح للأصولية: ليس فقط الأصولية الإسلامية، بل أيضا الأصولية المسيحية واليهودية والهندوسية. تتحول رسالة الحب الأخوي والأمل إلى نيران من اليأس والكراهية والمذابح المتبادلة. وعلى هذا الطريق، لا يلوح في الأفق سوى البربرية وانقراض الثقافة والحضارة الإنسانية.
سبب هذه الأهوال ليس الدين في حد ذاته، كما يدعي المراقبون السطحيون، بل جرائم الرأسمالية والإمبريالية، التي تدمر بلدانا ومجتمعات بأكملها، وتمزق نسيج المجتمع والأسرة دون أن تضع أي بديل مكانه. وبسبب خوف الناس من المستقبل ويأسهم من الحاضر، يبحثون عن العزاء في “حقائق أبدية” مزعومة لماض لم يوجد قط. إن صعود ما يسمى بالأصولية الدينية ليس إلا تعبيرا ملموسا عن مأزق المجتمع الرأسمالي، الذي يدفع الناس إلى اليأس والجنون. لكن، وكما نشهد في إيران وأفغانستان، فإن وعود “الجنة الدينية على الأرض” ليست سوى حلم فارغ ينتهي بكابوس.
لا يمكن للدين أن يفسر أيا من الأحداث التي يشهدها العالم اليوم. فدوره ليس في الحقيقة التفسير، بل مواساة الجماهير بالأحلام، ومسح جراحها ببلسم الوعود الزائفة. غير أن الإنسان يستيقظ دائما من الحلم، وسرعان ما يتلاشى تأثير حتى أحلى بلسم، ليترك ألما أشد من ذي قبل. الدين هو وعي زائف، في حين أن ما نحتاجه هو وعي حقيقي: رؤية علمية للكون ولمكاننا فيه. والشرط الأساسي لنيل حريتنا باعتبارنا كائنات بشرية هو القطيعة الجذرية مع الأحلام، والاستعداد لرؤية العالم كما هو، ورؤية أنفسنا على حقيقتنا: باعتبارنا رجالا ونساء فانون، يسعون إلى حياة تليق بالبشر على هذه الأرض.
بشرية مغتربة عن ذاتها
منذ الأزل، تربى الرجال (والنساء بدرجة أكبر) على روح الخنوع. تم تعليمنا أننا ضعفاء وعاجزون، وأنه مهما فعلنا فلن يتغير أي شيء، فـ”الإنسان يفكر والله يدبر”. الفكرة السائدة كانت القدرية، وأنه لا يمكن فعل شيء حيال المشكلات الكبرى التي تواجهنا. هذا القبول القدري والخنوع للواقع القائم نزعة متأصلة في كل الأديان. يُنصح المسيحي إذا صُفع على خده أن يدير خده الآخر، وكلمة الإسلام تعني “الاستسلام”، أما أنبياء العهد القديم فيؤكدون أن “كل شيء باطل”. ومن هذا الإحساس بالعجز، نشأت الحاجة إلى كائن أعلى يملك ما نفتقر إليه: الإنسان فان، الله خالد؛ الإنسان ضعيف، الله قوي؛ الإنسان جاهل بأسرار الكون، الله كلي المعرفة.
الإيمان بأن البشر يجب أن يتطلعوا إلى السماء طلبا للخلاص يؤدي أيضا إلى الإيمان بالمعجزات، ولا يقتصر هذا على غير المتعلمين. توجد الذهنية الخرافية ذاتها لدى خبراء التوقعات الاقتصادية وتجار البورصة الذين يكررون على مستوى أعلى ذهنية المقامر الذي يحمل قدم أرنب في يد ويلقي النرد باليد الأخرى. في الكتاب المقدس، أُطعم الجائع، وأبصر الأعمى، ومشى الأعرج، وكل ذلك من خلال تدخل المعجزات الإلهية. أما اليوم، فلا نحتاج إلى تدخل عناصر خارقة لتحقيق مثل تلك المعجزات، إذ تتيح إنجازات العلم والتكنولوجيا الحديثة تحقيق ذلك بالفعل. ما يمنع تعميم هذه الفوائد على كل رجل وامرأة وطفل على هذا الكوكب هو القيود المصطنعة الناتجة عن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والنظام القائم على الربح.
يعتقد الماركسيون أنه بقدر ما يتمكن الرجال والنساء من التحكم في حياتهم وتطوير ذواتهم باعتبارهم كائنات بشرية حرة، سيتلاشى الاهتمام بالدين -أي البحث عن العزاء في حياة أخرى بعد الموت- بشكل طبيعي من تلقاء نفسه. وبالطبع، سيعارض المؤمنون هذا التوقع، والوقت وحده سيحكم من هو على حق. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للخلافات حول مثل هذه الأمور أن تمنع جميع المسيحيين والهندوس واليهود والمسلمين النزيهين الذين يرغبون في المشاركة في النضال ضد الظلم من توحيد جهودهم مع الماركسيين في الكفاح من أجل عالم جديد وأفضل.
من أجل الجنة على هذه الأرض!
“لو قُدر لي أن أبدأ من جديد، لكنت […] حاولت تجنب ارتكاب هذا الخطأ أو ذاك، لكن المسار الرئيسي لحياتي سيبقى دون تغيير. سأموت ثوريا بروليتاريا، وماركسيا، ماديا ديالكتيكيا، وبالتالي ملحدا لا يلين. إيماني بالمستقبل الشيوعي للبشرية ليس أقل حماسة، بل هو اليوم أشد صلابة مما كان عليه في أيام شبابي. هذا الإيمان بالإنسان ومستقبله يمنحني حتى الآن قوة مقاومة لا تستطيع أية ديانة أن تمنحها“[42].
في كتابه “الميتافيزيقا”، قدم أرسطو فكرة عميقة حين قال إن الإنسان يبدأ في التفلسف عندما تُلبى احتياجاته المعيشية. عبر القضاء على التبعية المهينة للرجال والنساء تجاه الأشياء المادية، ستقيم الاشتراكية الأساس لتغيير جذري في طريقة تفكيرنا وسلوكنا. ويتوقع تروتسكي ما قد يحدث في مجتمع لا طبقي قائلا:
“في ظل الاشتراكية، سيكون التضامن أساس المجتمع. كل المشاعر التي نتردد نحن الثوريين اليوم في تسميتها -بسبب ما ألحقه بها المنافقون والسوقيون من ابتذال- مثل الصداقة الحقيقية وحب الجار والتعاطف، ستكون بمثابة أوتار قوية لعزف موسيقى الاشتراكية”[43].
سلاسل الاضطهاد الطبقي ليست مادية فقط، بل نفسية وروحية أيضا. لذا فحتى بعد زوال الرأسمالية، سيستغرق التحرر من الجراح النفسية والأخلاقية لذلك الاستعباد وقتا. من تشربوا روح العبودية طوال حياتهم لن يتحرروا ذهنيا ونفسيا فورا من الأحكام القديمة. لكن بمجرد أن تتهيأ الظروف الاجتماعية والمادية لعلاقات إنسانية حقيقية، سيتغير السلوك والتفكير وفقا لذلك. وعندها، لن تكون هناك حاجة للبوليس، سواء البوليس الماديين أو الروحيين.
أكد السفسطائيون الإغريق أن “الإنسان مقياس كل شيء”. هذه المقولة ستصبح حقيقة في مجتمع لا طبقي. عندما يسيطر البشر بوعي كامل على حياتهم ومصيرهم، فلن يكون هناك مكان لما هو خارق للطبيعة. وبدلا من التطلع إلى حياة وهمية بعد الموت، سيركز الناس كل طاقاتهم على جعل هذه الحياة جميلة ومُرضية. هذا هو الجوهر الحقيقي للاشتراكية: تحويل ما كان دائما موجودا كإمكانية كامنة إلى واقع فعلي.
في ذلك الشكل الأرقى من المجتمع الإنساني، سيرتقي الرجال والنساء إلى عظمتهم الحقيقية، ويطهرون العالم من الفقر والكراهية والظلم، ويعيدون لكوكبنا مجده الطبيعي، وتصبح الأنهار والبحار والشلالات نقية من جديد، وتحظى كل تنوعات الحياة الرائعة بالحماية والرعاية. ستُهدم المدن المزدحمة المكتظة ويُعاد بناؤها برعاية فنية وإبداعية تليق بالبشر وبيئتهم. ستُستكشف أعماق المحيطات وتبوح بآخر أسرارها. وأخيرا، ستمتد أيدينا إلى السماء، ليس للصلاة، بل عبر سفن فضاء تحمل البشرية إلى أطراف مجرتنا وربما إلى ما بعدها. عندما يتمتع الرجال والنساء بتلك الآفاق اللامحدودة للتقدم البشري، التي يمكننا تحقيقها بجهودنا ومواردنا وحدها، دون مساعدة أي أرواح، أي مكان سيتبقى عندها للجوء إلى الدين؟ سيتخلى الناس عن المعتقدات القديمة بقدر ما يكتشفون أنهم لم يعودوا بحاجة إليها.
يمكن العثور في الكتاب المقدس على كلمات بالغة الحكمة، كما في رسالة كورنثوس: “لما كنت طفلا، كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفهم، وكطفل كنت أفكر. ولما صرت رجلا، أبطلت ما للطفل”. ينطبق الأمر ذاته على تطور نوعنا البشري. عندما ستحقق البشرية أخيرا قدرها وتتمكن من الوقوف على قدميها والعيش حياة مكتملة، لن تعود بحاجة إلى عكاز الدين، أو إلى كائن خارق للطبيعة تصلي له، أو إلى عزاء زائف بحياة أخرى غير هذه. وعندما يحين ذلك الوقت، ستتخلى الإنسانية عن الدين بنفس السهولة التي يتخلى بها البالغون عن قصص الخيال التي أحبوها كثيرا في طفولتهم، لكنها فقدت منذ زمن فائدتها.
آلان وودز
13 يوليو/تموز 2005
ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:
الهوامش:
[1] نيتي نيتي (नेति नेति) هي عبارة من الفلسفة الهندية القديمة، تأتي من نصوص الأوبنشاد الفيدية، وتعني “ليس هذا، ليس هذا”. تُستخدم للتعبير عن أن الذات الإلهية أو الروح (أتمن) لا يمكن تعريفها أو إدراكها من خلال الصفات المادية أو الحسية. فهي تشير إلى أن الروح تتجاوز أي توصيف أو تعريف محدود، وكلما حاول الفرد تحديد طبيعة الذات، يجب أن يُنكر الوصف بالقول “نيتي نيتي” ليدل على أن الروح لا يمكن فهمها بالعقل أو الحواس (إضافة المترجم).
[2] A.C. Bouquet, Comparative Religion, p. 162
[3] A.C. Bouquet, Comparative Religion, pp. 105-106.
[4] ’’الحطّابون وسقاة الماء’’: مأخوذ من تعبير ورد في الكتاب المقدس (يشوع 9:21)، ويشير إلى أولئك الذين يقومون بالأعمال الشاقة والخدمية كقطع الحطب وجلب الماء، رمزيا يمثل الطبقة العاملة التي تؤدي المهام القاسية في خدمة الطبقة السائدة (إضافة المترجم).
[5] س. هـ. هوك (S. H. Hooke): عالم لاهوت ودراسات شرقية بريطاني، اشتهر بأبحاثه في الأديان القديمة، خاصة أساطير الشرق الأوسط وعلاقتها بالنصوص التوراتية. (إضافة المترجم).
[6] S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology, p. 29.
[7] الطوطمية :(Totemism) اعتقاد قديم يقوم على وجود علاقة رمزية أو روحية بين جماعة بشرية وطوطم، وهو عادة كائن طبيعي مثل حيوان أو نبات يُعتبر رمزا مقدسا يمثل الجماعة ويوفر لها الحماية (إضافة المترجم).
[8] الأنيميزم :(Animism) اعتقاد بأن الكائنات والأشياء في الطبيعة، مثل الأشجار، الأنهار، الجبال، وحتى الظواهر الطبيعية، تمتلك أرواحا أو قوى روحية تؤثر في حياة البشر (إضافة المترجم).
[9] Marx and Engels, On Religion, p. 281.
[10] Acts, 2:42
[11] Acts, 4:32
[12] T. Ware, The Orthodox Church, p.27.
[13] P. Rodriguez, (1997). Mentiras fundamentales de la Iglesia catolica. Barcelona: Ediciones B., Anexo, pp. 397-400.
[14] Trotsky, Brailsford and Marxism, On Britain, vol. 2, p. 167.
[15] W. Manchester, A World Lit only by Flame, p. 161.
[16] اللولارد في إنجلترا :كانت حركة دينية إصلاحية في القرن الرابع عشر بقيادة جون ويكليف، الذي انتقد فساد الكنيسة الكاثوليكية ودعا إلى العودة إلى تعاليم الكتاب المقدس. دعم اللولارد مبادئ مثل ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية ورفض سلطة الكنيسة المركزية. تعرّض أتباعهم للقمع الشديد، لكن أفكارهم مهدت الطريق للإصلاح البروتستانتي في إنجلترا (إضافة المترجم).
الهسّيون في ألمانيا: كانوا أتباع جان هس، وهو مصلح ديني بوهيمي في القرن الخامس عشر دعا إلى إصلاح الكنيسة وانتقد فساد رجال الدين. بعد إعدامه عام 1415، قاد أتباعه ثورات ضد الكنيسة والإمبراطورية الرومانية المقدسة، عُرفت بـ’’حروب الهسّيين’’ (1419-1434). نجحوا في تحقيق بعض الإصلاحات الدينية والسياسية، وكان لهم تأثير كبير على الحركات البروتستانتية اللاحقة (إضافة المترجم).
[17] جون بول :كاهن إنجليزي وراديكالي ديني في القرن الرابع عشر، لعب دورا رئيسيا في ثورة الفلاحين الإنجليز عام 1381. دعا إلى المساواة الاجتماعية وانتقد الإقطاع، مستخدما شعارات مثل “عندما حرث آدم وغزلت حواء، من كان السيد آنذاك؟””. بعد فشل الثورة، أُعدم شنقا وتقطيعا، لكنه ظل رمزا للمقاومة ضد الظلم الاجتماعي (إضافة المترجم).
[18] مايكل سيرفيتوس (1511-1553): طبيب ولاهوتي إسباني، رفض عقيدة الثالوث وكان على وشك اكتشاف الدورة الدموية الصغرى. أُعدم حرقا في جنيف بأمر جون كالفن بتهمة الهرطقة. (إضافة المترجم).
[19] رجال المملكة الخامسة: طائفة بروتستانتية نشأت في إنجلترا القرن 17، آمنت بقرب عودة المسيح لإقامة حكم ديني وسعت لإسقاط كرومويل، لكن حركتها سُحقت. الرانترز: جماعة دينية راديكالية خلال الحرب الأهلية الإنجليزية، رفضت الكنيسة والقوانين الأخلاقية التقليدية، ودعت إلى الحرية المطلقة، لكن تم قمعها بسرعة. (إضافة المترجم)
[20] الكويكرز : طائفة بروتستانتية نشأت في إنجلترا في القرن السابع عشر، تؤمن بـالتجربة الروحية المباشرة دون وساطة رجال الدين، وتتبنى السلمية والمساواة. لعبوا دورا بارزا في إلغاء العبودية، حقوق المرأة، وحركات السلام، وأسّسوا مستعمرة بنسلفانيا في أمريكا. (إضافة المترجم)
[21] ديدرو (Denis Diderot) (1713-1784): فيلسوف وكاتب فرنسي، أحد رواد التنوير، ومحرر الموسوعة الفرنسية التي نشرت الأفكار العقلانية والمادية. انتقد السلطة الدينية وساهم في نشر الفكر الحر. (إضافة المترجم)
هولباخ (Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach) (1723-1789): فيلسوف ومفكر مادي فرنسي من عصر التنوير، اشتهر بكتاباته الإلحادية والمادية، مثل “نظام الطبيعة”، حيث أنكر وجود إله واعتبر الدين عائقًا أمام التقدم البشري. (إضافة المترجم)
[22] روبسبير (Maximilien Robespierre) (1758-1794) واليعاقبة (Jacobins): روبسبير كان قائدًا بارزًا في الثورة الفرنسية وزعيم نادي اليعاقبة، وهو فصيل سياسي جمهوري راديكالي. خلال عهد الإرهاب (1793-1794)، حكم اليعاقبة فرنسا بقبضة حديدية، حيث أعدموا آلاف المعارضين باسم الفضيلة والثورة. انتهى حكم روبسبير بإعدامه بالمقصلة عام 1794، مما أنهى سيطرة اليعاقبة على السلطة. (إضافة المترجم)
[23] المعجزات في لورد: إشارة إلى المعجزات المزعومة التي قيل إنها حدثت في مدينة لورد الفرنسية منذ عام 1858، حيث زعمت فتاة تدعى برناديت سوبيروس أنها رأت العذراء مريم. وقد استخدمت الكنيسة تلك الروايات لتعزيز الإيمان الديني، خاصة بعد الثورة الفرنسية وكومونة باريس، في محاولة لإحياء التأثير الديني في المجتمع. (إضافة المترجم)
[24] Ibid., p. 164.
[25] J. Connolly, Selected Writings, pp. 78-79.
[26] حين كُتب النص في أوائل عام 2005، كان البابا يوحنا بولس الثاني هو بابا الفاتيكان، لكنه تُوفي في 2 أبريل 2005، وخلفه البابا بنديكتوس السادس عشر، الذي تولى المنصب في 19أبريل 2005. (إضافة المترجم)
[27] Marx and Engels, On Religion, p. 35.
[28] G. Lewy, The Catholic Church and Nazi Germany, NY, 1965, p.310-311.
[29] Saul Friedhandler, Pius XII and the Third Reich, A Documentation, NY, 1958, p. 236
[30] غاليليو غاليلي (1564-1642): عالم فلك وفيزياء إيطالي، اشتهر بدعمه لنظرية مركزية الشمس التي وضعها كوبرنيكوس. أجبرته الكنيسة الكاثوليكية على التراجع عن آرائه العلمية تحت تهديد محاكم التفتيش. (إضافة المترجم)
[31] جيوردانو برونو (1548-1600): فيلسوف وعالم إيطالي، تبنى أفكارًا ثورية حول الكون اللانهائي، مما جعله يتصادم مع تعاليم الكنيسة. اعتُبر مهرطقا وحُكم عليه بالإعدام حرقا بتهمة التجديف والهرطقة. (إضافة المترجم)
[32] هو نفسه البابا يوحنا بولس الثاني.
[33] Opus Dei هي منظمة كاثوليكية محافظة تأسست عام 1928 في إسبانيا، وتركز على نشر القيم المسيحية من خلال النخب الفكرية والسياسية والاقتصادية، وكان لها تأثير سياسي كبير، خاصة في إسبانيا خلال حكم فرانكو، حيث دعمت النظام وشاركت في الحكومة، كما منحها البابا يوحنا بولس الثاني مكانة قانونية خاصة عام 1982، مما زاد من الشكوك حول علاقتها به. (إضافة المترجم)
[34] Lenin, On Religion, p. 8.
[35] Ibid., p. 18
[36] Ibid., pp. 14-15.
[37] Ibid., p. 16.
[38] Ibid., p. 17.
[39] روتيليو غراندي (1928-1977): كاهن يسوعي من السلفادور ومدافع عن حقوق الفقراء، كان من رواد لاهوت التحرير. اغتيل عام 1977 بسبب نشاطه في تنظيم الفلاحين ومناهضة القمع، ويُعتبر شهيدا للنضال الاجتماعي في أمريكا اللاتينية. (إضافة المترجم)
[40] حركة العصر الجديد (New Age): تيار روحاني حديث يجمع بين الفلسفات الشرقية والغربية، يركز على التنمية الذاتية، الطاقة الروحية، والتأمل، دون عقيدة موحدة. (إضافة المترجم)
[41] مامون: هو إله الثروة في المعتقدات المسيحية، ويرمز إلى الجشع المفرط وحب المال. ذُكر في العهد الجديد (إنجيل متى 6:24) كممثل للمال والثراء المادي، حيث لا يمكن للإنسان أن يخدم الله والمال (مامون) في الوقت نفسه. (إضافة المترجم)
[42] L. Trotsky, Stalin, NY 1967, p. 54.
[43] Trotsky, Literature and Revolution, p.60.
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية