كتب آلان وودز هذا النص افتتاحية للعدد 41 لمجلة الدفاع عن الماركسية (متاح للشراء الآن!). تناقش افتتاحية آلان وودز اغتراب البشر في ظل المجتمع الطبقي، وهو الموضوع الذي يربط جميع المقالات المنشورة في هذا العدد، والتي تشمل مقالة عن أصول اضطهاد المرأة؛ وتأثير وتداعيات الذكاء الاصطناعي في ظل الرأسمالية؛ والطبيعة الرجعية للنظرية المالثوسية ومظاهرها الحديثة، مثل فكرة ما يسمى بالاكتظاظ السكاني؛ ورسالة من أحد محررينا، يعلق فيها على رواية جيمس جويس (Dubliners).
لدى تصفحي للمقالات الواردة في هذا العدد، أذهلني أنها جميعها مرتبطة ببعضها من خلال عنصر واحد مشترك، ألا وهو موضوع الاغتراب. وبما أننا لم نخصص مساحة كافية لهذا الموضوع في الإصدارات السابقة، فقد قررت أن أجعله محور هذه الافتتاحية.
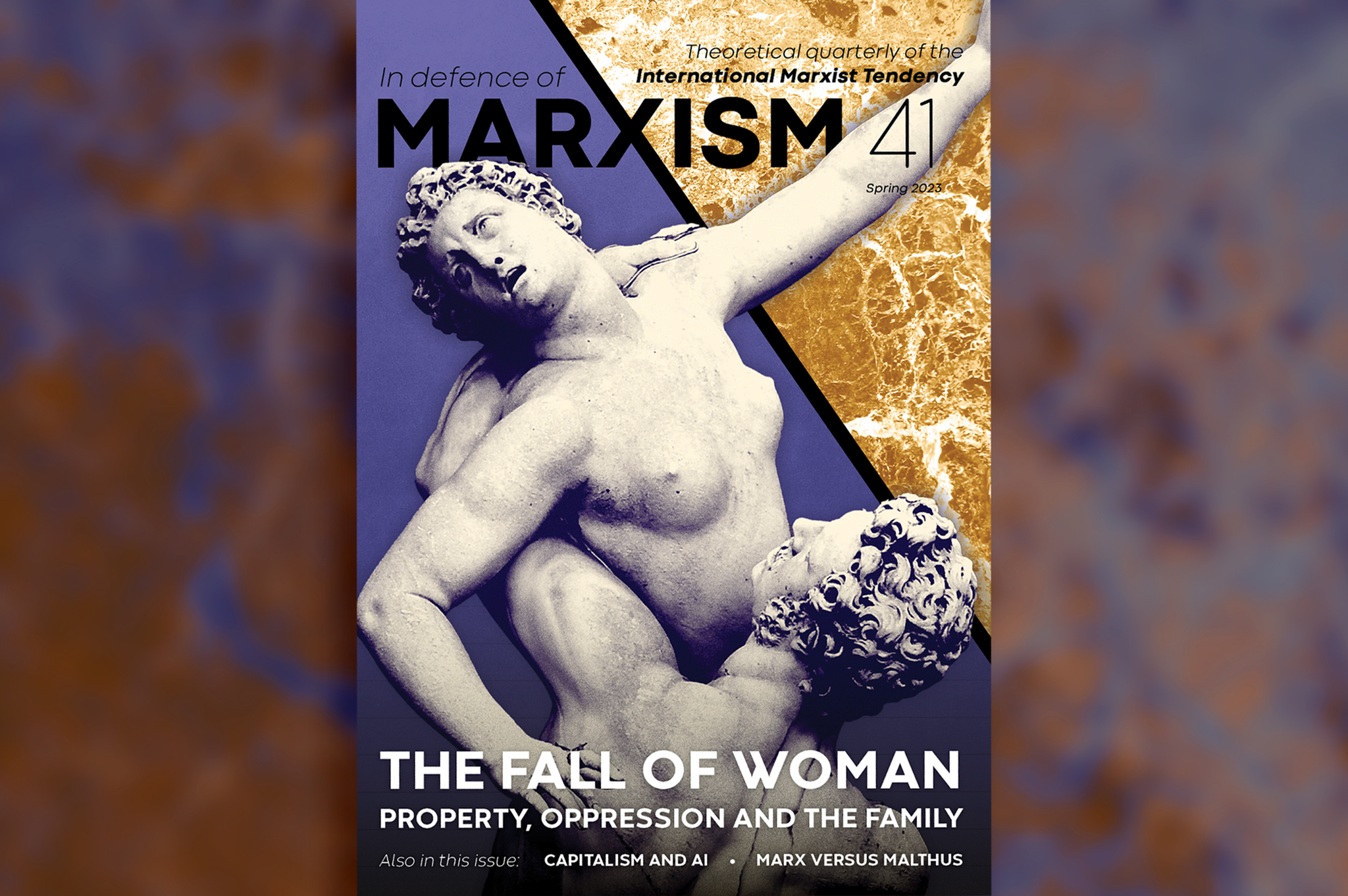
قالت الراحلة مارغريت تاتشر ذات مرة إنه: “لا وجود لشيء يسمى مجتمع”. بيد أن أرسطو قال: إن الإنسان حيوان سياسي، وكان يقصد أن: الإنسان حيوان اجتماعي.
كما أن الفيلسوف الوجودي، جان بول سارتر، قال: “الجحيم هو الآخرون” (L’enfer, c’est les autres). قد تروق لك هذه الفكرة في حال ما إذا كان جارك المزعج يقيم حفلة في الثالثة فجرا. لكن إذا كان الجحيم هو الآخرون، فعلينا أيضا أن نضيف أن الجنة هي أيضا الآخرون، لأننا نشكل كياناتنا من خلالنا ومن خلال الآخرين، ولا يمكننا أن نتواجد كأفراد منعزلين.
هيغل، الذي كان فيلسوفا جادا، على عكس سارتر، أشار إلى أن ثراء شخصية المرء نتاج لثراء علاقاته.
إن حياتنا الشخصية، وأفكارنا، وهواياتنا، والأشياء التي نحبها أو نكرهها –باختصار الأسس النفسية للحياة نفسها- جميعها محددة بتفاعلاتنا الاجتماعية، أي بالضبط من خلال الآخرين. لو أن شخصا تم نفيه إلى جزيرة مهجورة أو احتُجز لسنوات عديدة في سجن انفرادي، فسوف يجد حتما أن قدرته على التفكير والتواصل قد لحق بها ضررا جسيما.
هذه الحقيقة البديهية لها جذورها في تاريخ البشرية بأكمله منذ أقدم العصور. مفتاح كل التطور البشري (بما في ذلك الفكر واللغة) هو النشاط الاجتماعي، وهذا له جذوره في العمل الجماعي.
تَنْزَع الرأسمالية إلى عزل وتذرير وفرض الاغتراب على الناس، الذين يتم تلقينهم أن ينظروا إلى أنفسهم باعتبارهم “أفرادا” وحسب. لكن وعلى الرغم من تأصل هذا المفهوم بشدة، فإنه ليس له أي أساس سواء في العلم أو في التاريخ.
الطبيعة البشرية
في سياق محاولتهم دحض حجج الماركسيين، كثيرا ما يزعم المدافعون عن الوضع الراهن بأن فكرة المجتمع المتساوي تتعارض مع الطبيعة البشرية، التي يدعون أنها تميل بشكل فطري إلى الأنانية.
هذا الادعاء ليس ساذجا وحسب، بل ويفتقر إلى أي أساس علمي أيضا. يقدم لنا مقال الرفيق فريد ويستون في هذا العدد مادة غنية تثبت بشكل كامل خطأ ذلك الادعاء. نحن الآن نعرف كيف تطور الوعي البشري من الناحية التطورية.
وفقاً لأحدث الاكتشافات، فإن نوعنا، الإنسان العاقل (Homo sapiens)، يبلغ عمره على الأقل 300.000 سنة. عاش الرجال والنساء خلال الجزء الأكبر من هذه المدة في مجتمعات القنص والالتقاط حيث لم تكن توجد ملكية خاصة تتجاوز الممتلكات الشخصية، وكانت تلك الحالة تعتبر طبيعية تماما.
وجد الأنثروبولوجيون الذين درسوا وعاشوا مع بعض المجموعات المعتمدة على القنص والالتقاط، القليلة المتبقية في العالم، أنها تتسم بالمساواة إلى حد كبير. ومثلهم مثل أسلافنا الأوائل الكثير منهم لا يختزنون الطعام، بل يستهلكونه بعد الحصول عليه مباشرة. ولا يراكمون الممتلكات، بل يتقاسمون الموارد، وليس لديهم هيكل سلطة هرمي.
وهذا بطبيعة الحال يخلق نفسية لا يشعر الناس فيها بالحاجة أو الرغبة في التنافس ضد بعضهم البعض أو اضطهاد بعضهم البعض -على الأقل داخل مجتمعاتهم المحلية. و الواقع، إن أي مظهر من مظاهر هذه الميول غير الطبيعية سيواجه بأشد الاستنكار.

قام الأنثروبولوجي الشهير، ريتشارد لي، بدراسة مستفيضة لشعب الـكونغ (Kung) الذي كان يعيش في ذلك الوقت في مجموعات صغيرة من القناصين وملتقطي الثمار في الطرف الغربي لصحراء كالاهاري. وفي تعليقه على النتائج التي توصل إليها، يكتب ريتشارد لي:
“في نفس السياق الذي تأتي فيه أخلاقيات المشاركة، تأتي درجة مفاجئة من المساواة. ليس لدى شعب الـكونغ رؤساء ولا زعماء”.
وعندما سُئلوا عما إذا كان لديهم زعيم قبيلة، أعربوا عن دهشتهم وأجابوا: “بالطبع لدينا زعماء قبيلة”، “في الواقع، نحن جميعا زعماء؛ كل واحد منا هو زعيم نفسه!”. ومن الواضح أنهم اعتبروا السؤال مزحة كبيرة.
يتطلب هذا التركيز على المساواة أن تتم مراعاة بعض الطقوس عندما يعود القناص الناجح إلى المعسكر. الهدف من تلك الطقوس هو التقليل من أهمية الحدث لتثبيط الغرور والغطرسة: “السلوك الصحيح للقناص الناجح”، كما يوضح لي، “هو التواضع والبساطة”.
وصف رجل من الـكونغ، يُدعى غاوغو، الأمر بهذه الطريقة: “لنقل أن رجلا قد ذهب للقنص. يجب عليه ألا يعود إلى المنزل ويعلن متفاخرا: “لقد قتلت فريسة كبيرة في الأدغال!”. يجب عليه أولا أن يجلس في صمت حتى آتي أنا أو شخص آخر إلى موقده ونسأله: “على ماذا حصلت اليوم؟”، فيرد بهدوء: “آه، أنا لست جيدا في القنص. لم أحصل على شيء بالمطلق… ربما مجرد فريسة صغيرة”. ثم أبتسم في سري لأنني آنذاك أعرف أنه قتل شيئا كبيرا. كلما كان الحيوان أكبر، كلما تم التقليل من شأنه أكثر”.
نحن لسنا مثاليين، وليست لدينا نظرة عاطفية أو مثالية عن حياة أسلافنا الأوائل. ومع ذلك، كم هو نبيل ومؤثر بشكل عميق ذلك السلوك المتواضع لذلك القناص الشاب في حضور من يكبروه سنا، بالمقارنة مع الأنانية المقززة و التفاخر الجامح في عصرنا “المتحضر”.
الاغتراب والدين
كانت هناك، بالطبع، جوانب أخرى أكثر سلبية للمجتمعات المبكرة. فقد هيمن على حياة أسلافنا الأوائل عالم مخيف حيث تحولت قوى الطبيعة، التي لم يكن ممكنا فهمها بعد، إلى أرواح غير مرئية. وبالتالي كان من الضروري ممارسة الطقوس وتقديم التضحيات لإرضائها وتجنب الأذى منها.
بهذه الطريقة، خضع الرجال والنساء لأول مرة لقوى غير مرئية خارجة عن سيطرتهم، وأثناء هذه السيرورة، أعطوها أشكالا بشرية أو شبه بشرية. كان الدين هو الشكل الأول للاغتراب.
عالم الدين هو عالم مغلّف بالأساطير، انطباع مشوه عن الواقع. لكن، وكما هو الحال مع جميع الأفكار، فإن لتلك التصورات جذورها في العالم الواقعي. وعلاوة على ذلك، فهي تعبير عن تناقضات المجتمع نفسه. وهذه الحقيقة واضحة جدا في أقدم الديانات.
في هذا العالم الخيالي الغريب، تنقلب جميع العلاقات رأسا على عقب. حيث يصنع الإنسان صنما بيديه ثم يسجد أمامه. يصبح الفاعل مفعولا والعكس صحيح.
الملكية الخاصة
بالنسبة لعقول مجتمعات القنص والالتقاط لم تكن فكرة الملكية الخاصة للأرض مفهومة أو متصورة. كان يُنظر للأراضي على أنها هبة مقدسة من الطبيعة، يجب أن تكون مشتركة بين الجميع. لكن مع حلول الملكية الخاصة، أصبح المجتمع مقسما إلى أغنياء وفقراء، بين من يملك ومن لا يملك.
في كتابه “الأنواع البشرية”، يقارن أنتوني بورنيت بين السلوك المناطقي عند الحيوانات وبين الامتلاك عند البشر. يقول عن الحيوانات:
“يتم الحفاظ على المناطق من خلال إشارات محددة مشتركة بين كل نوع. كل بالغ، أو مجموعة من كل نوع، يمتلكون منطقة خاصة.
بينما لا يُظهر الإنسان مثل هذا الاتساق، إذ حتى داخل المجتمع الواحد، قد تكون هناك مساحات واسعة مملوكة لشخص واحد، بينما لا يمتلك الآخرون شيئا”.
ويختتم قائلا: “الإنسان، في الحقيقة، ليست لديه ‘غريزة حيازة الملكية’ مثلما ليست لديه ‘غريزة للسرقة'”.
جاء التغيير الكبير مع ما أسماه غوردون تشايلد ثورة العصر الحجري الحديث: الانتقال من نمط العيش القائم على القنص والالتقاط إلى الزراعة المستقرة، والتي أنتجت في النهاية الملكية الخاصة للأراضي والحيوانات والموارد الأخرى.
لم يكن ذلك التحول نتيجة حتمية لميل فطري نحو الأنانية، بل كان انقلابا عنيفا في حياة الناس ووعيهم. ولأول مرة في تاريخهم، بدأت روح الأنانية والتنافس تظهر على أنقاض العلاقات والأخلاق الشيوعية القديمة. هنا تكمن الجذور الحقيقية للاغتراب.
ما هو الاغتراب؟
أوضح مؤسسا الاشتراكية العلمية أن الاغتراب هو التعبير عن التناقضات الحقيقية الموجودة في المجتمع والتي نشأت في مرحلة محددة من تطوره التاريخي. عندما يصبح العمل البشري -الذي اختُزل في حد ذاته إلى عمل مجرد وأصبح موضع تأليه كالمال- حكراً على أقلية، صار يقدم نفسه كشيء غريب، كقوة فوق المجتمع.
في مخطوطاته الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، يرسم ماركس مقارنة بين الاغتراب الديني واغتراب العامل عن عمله الخاص، قائلا:
“كلما زاد ما يضعه الإنسان في الله، كلما قل ما يحتفظ به في نفسه. يضع العامل حياته في المنتَج؛ ولكن الآن لم تعد حياته تعود إليه بل إلى المنتَج. وعليه فإنه كلما زادت هذه الأنشطة، كلما افتقر العامل للمنتجات. وبغض النظر عن ماهية منتَج عمله، فإنه لا يمثله. لذلك، كلما زاد حجم هذا المنتج، كلما قل وجوده الشخصي”.
الملكية الخاصة هي المصدر الحقيقي للاغتراب الاجتماعي. ولكن في ظل الرأسمالية يكتسب الاغتراب تعبيره الأكثر اكتمالا وحسما. والرأسمالية تختلف نوعيا عن أنماط الاستغلال السابقة.
في جميع المجتمعات الطبقية السابقة كانت استغلال العمل موجودا، لكنه كان واضحاً، ملموسا، غير متنكر. ففي المجتمع العبودي، كان العبد يُختزل إلى مجرد شيء ( أداة ناطقة[1]).
في ظل الإقطاع، كان على القن أن يسلم نسبة معينة من ناتج عمله للسيد. لذا فقد كان الاستغلال واضحا للجميع. لكن في الرأسمالية، يتم الاستغلال بشكل مُقنَّع. فالعامل حر من الناحية الرسمية و’يبيع’ ‘طوعا’ قدرته على العمل مقابل أجر. إنه ليس مستعبدا من الناحية الرسمية أو مملوكا لصاحب العمل. ولكن في الواقع، يصبح العمال مستعبدين للطبقة الرأسمالية ككل.
وهكذا فإن النفاق يكمن في صميم النظام برمته، حيث تُقلب جميع العلاقات الاجتماعية وتُحوَّل إلى نقيضها. فالمال، وهو شيء خامل، لا حياة فيه، يكتسب كل صفات الكائن الحي. وخلال الأزمة المالية، يعطوننا إخبارات يومية حول الحالة الصحية للجنيه الإسترليني (” لقد تعافى الجنيه قليلا اليوم…”)، كما لو كان المرء يتحدث عن شخص محبوب للغاية يرقد مريضا في سرير المستشفى.
ومن ناحية أخرى، يُشار إلى إنسان ما على أنه “يساوي مليار دولار”، وبذلك يُختزل إلى مرتبة سلعة جامدة بلا حياة. عند هذه النقطة، يبلغ الاغتراب أكثر أشكاله بشاعة ولاإنسانية، ويصبح العمل -النشاط الحياتي للفرد- حادثا عرضيا، شيئا خارجيا عنه: وسيلة لتحقيق غاية، وليس غاية في حد ذاته.
إله رأس المال
إله المجتمع الرأسمالي هو مامون (Mammon)[2]، وعبادته تتمحور حول الأشياء والعلاقات بينها، بدلا من الأشخاص. هذا الكائن القوي، الذي يراقب كل شيء له معابده، والتي تعرف بالبورصات، وله كهنته الكبار ممن يمارسون طقوسهم وتعاويذهم السحرية. ويتمتع بقوى خفية كإله غير مرئي يسود على المجتمع ويخترق كل مسامه.

لكن الناس يجهلون هذه العلاقة. فهي محاطة بالغموض، وكما هو الحال في جميع الأديان الأخرى، لا يكشف هذا الإله القاسي عن وجهه الحقيقي أبدا، بل يتجلى في أشكال كثيرة ومزيفة. هذا الإله العظيم، الذي يجب على الجميع الركوع أمامه، قادر على اجتراح معجزات تتجاوز معجزات الكتاب المقدس، كما يفسر ماركس إذ يقول:
“خِصال المال تصبح خِصالي أنا -صاحب المال- فهي قواي الجوهرية. وهكذا فإن ما أكون عليه وما أستطيع فعله لا يتحدد مطلقا بذاتي. فقد أكون قبيحا، لكن بإمكاني شراء أجمل النساء. لذلك فإني لست قبيحا، لأن تأثير القبح -وقوته المنفّرة- يقضي عليهما المال”.
“قد أكون، وفقا لخصائصي الفردية، كسيحا، لكن المال يمنحني أربعة وعشرين قدما. ولذلك فأنا لست كسيحا. أنا سيء، وغير نزيه، وعديم الضمير، وغبي؛ لكن المال مبجل، ومن تم يبجل صاحبه. المال هو الخير الأسمى، ولذلك فإن صاحبه خير. وعلاوة على ذلك فإن المال يوفر علي مشكلة عدم النزاهة، ولذلك يُفترض أنني نزيه”.
“أنا أبله، ولكن المال هو العقل الحقيقي لكل الأشياء، فكيف إذن يمكن أن يكون صاحبه بلا عقل؟ وعلاوة على ذلك فإنه يستطيع شراء الأذكياء، وعليه هل يمكن أن يكون من يملك السيطرة على الأذكياء ليس أكثر ذكاء منهم؟ وأنا، الذي بفضل المال أصبحت قادرا على الحصول على كل ما يهفو إليه الفؤاد، ألست إذن أمتلك كل القدرات البشرية؟ أفلا يحول مالي، إذن، كل نواقصي إلى نقيضها؟”.
الحل الوحيد
في مجتمع يكون فيه استخراج فائض القيمة هو الدافع الوحيد للحياة الاقتصادية، يُرفع الجشع إلى مرتبة أسمى الفضائل. وأخلاقياته تحكمها أخلاق الغابة، حيث يلتهم القوي الضعيف، بينما الضعيف يهلك. ثقافة الجشع والأنانية تُولد اللامبالاة تجاه المعاناة الإنسانية.
المعاملة غير الإنسانية للنساء وكبار السن والأطفال العاجزين كانت ستُعتبر أمرا لا يمكن تصوره في المجتمعات التي توصف الآن بـأنها ‘همجية’. لكن هذه الفظائع أصبحت طبيعية لدرجة أنها تُنسب بشكل روتيني إلى ‘طبيعة الإنسان’.
هذا افتراء شنيع على الجنس البشري.
إنها ليست الطبيعة البشرية، بل نظام وحشي، غير إنساني، يُعيق الرجال والنساء جسدياً وعقليا وروحيا، يُشوههم ويُحرفهم عن شكلهم الأصلي، يحفز على المنافسة والانقسام من أجل إدامة ديكتاتورية أقلية صغيرة فاحشة الثراء من الطفيليين .
إن المنظور البورجوازي أناني بطبيعته. لكن بالنسبة للطبقة العاملة الأمور مختلفة تماما. فالعمال ملزمون على التعاون في العمل الجماعي، على خط الإنتاج، حيث نمط الإنتاج اجتماعي وليس فرديا.
وبالتالي فإن وعي العامل يكون جماعيا بشكل طبيعي. كما أن أسلحة نضال الطبقة العاملة هي جماعية بطبيعتها: الإضراب، والإضراب العام، والاجتماعات العامة والمظاهرات الجماهيرية. إذن فالفردانية هي السمة المميزة لكاسر الإضراب الذي يضع مصالحه الأنانية فوق مصالح زملائه في العمل.
ولهذا السبب تشيد الصحافة الرأسمالية دائما بـ’شجاعة’ من يكسر الإضراب، مدعية أنه يدافع عن ‘حرية الفرد’. لكنه من وجهة نظر باقي أفراد طبقته، من يكسر الإضراب يمثل أحقر مستويات الحياة الحيوانية.
إن استمرار هذا النظام الهرم والمتهالك يشكل التهديد الأكثر خطورة على مستقبل الحضارة البشرية، وربما على مستقبل الجنس البشري نفسه.
لكن النظام الرأسمالي ليست لديه الرغبة في الموت. إنه يتمسك بالحياة بشدة ويقاوم كل الجهود الرامية للإطاحة به، مستخدما مزيجا من العنف والمكر. و بدلا من الاعتراف بأنه محكوم عليه بالفناء، فهو مستعد لسحب الجنس البشري بأكمله إلى الهاوية معه.
على الماركسيين واجب تقديم بديل شامل لأساليب التفكير القديمة التي عفا عليها الزمن. وفي وجه الأيديولوجية الفاسدة للبرجوازية ترفع الماركسية بحزم راية فلسفة جديدة: فلسفة الثورة.
وإلى جانب منظور عالمي ثوري جديد، نحن بحاجة إلى أخلاق جديدة: أخلاق بروليتارية. والوصية الأولى المكتوبة على راية هذه الأخلاق الطبقية الثورية هي: الأخلاقي والتقدمي هو ما يسهم في تعزيز الوعي الطبقي للبروليتاريا؛ أما الرجعي و غير أخلاقي فهو ما يسهم في تخلف ذلك الوعي أو تثبيطه .
وانطلاقا من هذا المنظور، تؤدي كل النظريات الزائفة التي يتبناها مناصرو ما يُعرف بـ’ما بعد الحداثة’، دورا مضادا للثورة بشكل تام. إنهم يسعون جاهدين لإرباك العمال وتفرقتهم من خلال ‘سياسيات الهوية’، التي تعمل على تفتيت الطبقة العاملة والقضاء على وعيها الطبقي.
لقد أوضح لينين أن النضال ضد الطبقة السائدة لا يمكن أن يقتصر على المصانع والشوارع والبرلمان والمجالس المحلية فقط. بل يجب علينا أيضا أن نخوض المعركة في الميدان الأيديولوجي، حيث لا يقل تأثير البرجوازية ضررا وخطرا كونه مخفيا تحت ستار الحياد الزائف والموضوعية الشكلية.
لقد استنفذ النظام الرأسمالي أي دور تقدمي قد يكون لعبه في الماضي. لقد تجاوز منذ زمن طويل مبررات وجوده، ويجد نفسه الآن في حالة متقدمة من الشيخوخة والتدهور. إنه، في الواقع، فاسد لدرجة أنه بدأت تنبعث منه رائحة العفن.
ومع ذلك، فإنه وعلى عكس ما يدعي البعض بأنه لا وجود لشيء اسمه التقدم، وأن كل نظام اجتماعي لا يقل جودة (أو سوءا) عن أي نظام آخر، فإن تاريخ 10.000 عام لم يمر عبثا. فمن خلال تطوير القوى الإنتاجية، تم وضع الأساس المادي لإقامة الشيوعية الحقيقية، والتي لا تعتمد على الندرة الشاملة بل على الوفرة الفائقة.
وحدها الشيوعية التي يمكن أن توفر الشروط لعالم يقوم على علاقات إنسانية حقيقية، ومساواة حقيقية بين الرجال والنساء. وستكون قفزة عملاقة للبشرية من عالم الضرورة إلى عالم الحرية.
الهوامش:
[1] instrumentum vocale
[2] مامون: -Mammon- المال/ الثروة والجشع لتحقيق الثروة، حسب العهد القديم. المترجم
آلان وودز
03 مارس/آذار 2023
ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:
Alienation and society – Alan Woods’ editorial for IDoM 41: out now!
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية



تعليق واحد
تعقيبات: ملخص لفلسفة كارل ماركس