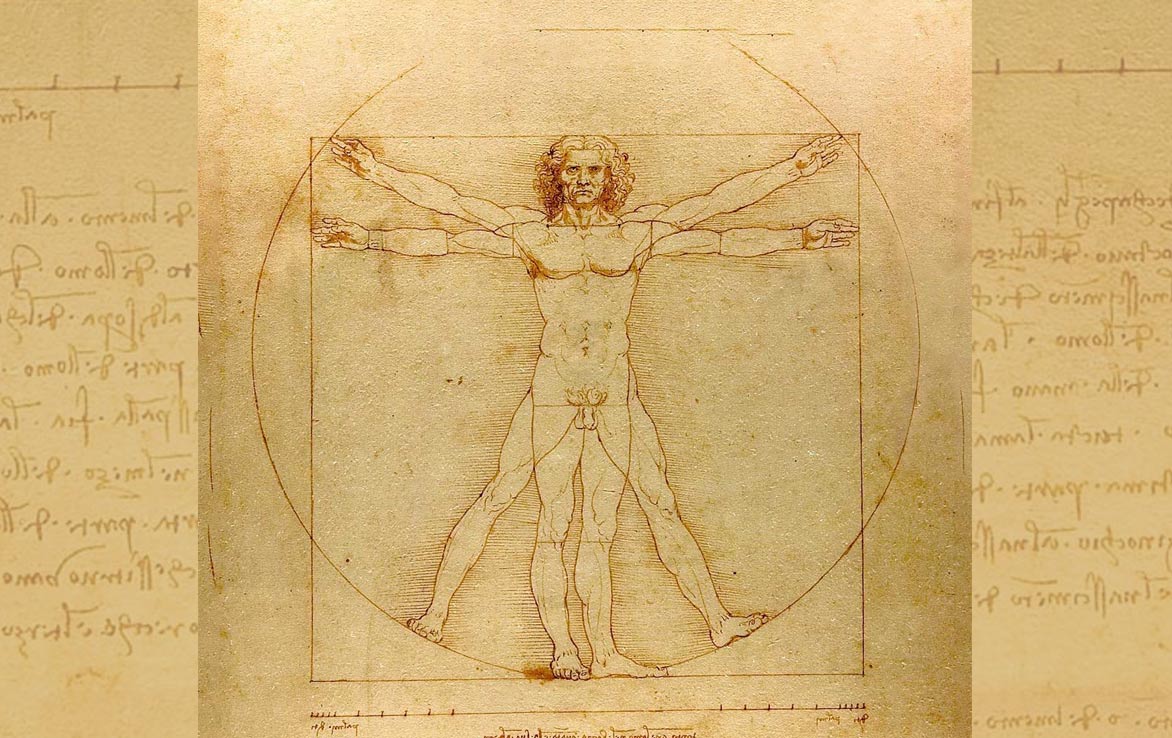في مثل هذا اليوم سنة 1926، الثالث من فبراير/شباط، ألقى ليون تروتسكي محاضرة بعنوان “حول الثقافة”، في نادي الساحة الحمراء في موسكو. ثم قام بجمع هذه المحاضرة مع خطابات أخرى ألقاها في المقالة الآتية، التي نُشرت لأول مرة في كراسنايا نوف، في وقت لاحق من ذلك العام. ونعيد نشر هذه المقالة، بعد نشر الترجمة العربية لها لأول مرة في العدد 46 من مجلة “الدفاع عن الماركسية”.
في هذه المقالة الرائعة والعميقة، يشرح تروتسكي العلاقة بين تطور التكنولوجيا وتطور الثقافة البشرية. ثم يمضي في دراسة دور الثقافة في بناء الاشتراكية، ويشير إلى الطريق إلى الأمام للاتحاد السوفياتي، الذي كان يحاول وضع أسس الاشتراكية في ظروف العزلة والتخلف.

I- التكنولوجيا والثقافة
دعونا نتذكر، أولا وقبل كل شيء، أن الثقافة (Culture) كانت تعني ذات يوم حقلا محروثا مزروعا، في مقابل الغابات البكر والأراضي البكر. كانت الثقافة على النقيض مع الطبيعة، أي أن ما تم تحقيقه من خلال الجهود البشرية كان يتناقض مع هدايا الطبيعة. وما يزال هذا التناقض يحتفظ بقوته حتى يومنا هذا.
الثقافة هي كل ما تم ابتكاره وبنائه واستيعابه وتحقيقه من قبل الإنسان عبر تاريخه بالكامل، في تناقض مع ما تقدمه الطبيعة، بما في ذلك التاريخ الطبيعي للإنسان نفسه باعتباره نوعا حيوانيا. والعلم الذي يدرس الإنسان باعتباره نتاجا لتطور الحيوان يسمى الأنثروبولوجيا. لكن ومنذ اللحظة التي انفصل فيها الإنسان عن مملكة الحيوان، -وقد حدث هذا تقريبا عندما أخذ بين يديه لأول مرة أدوات بدائية مثل الحجارة أو العصي وسلح بها أعضاء جسمه-، منذ ذلك الوقت بدأ خلق وتراكم الثقافة، أي كل أنواع المعرفة والمهارة في الصراع مع الطبيعة من أجل التحكم فيها.
عندما نتحدث عن الثقافة التي تراكمت لدى الأجيال السابقة، نعتمد بشكل مقصود على المقتنيات المادية التي اكتسبتها في شكل أدوات وآلات وأبنية وآثار، وما إلى ذلك. فهل هذه ثقافة؟ لا شك أنها ثقافة أو رواسبها المادية: ثقافة مادية. إنها تخلق -على أسس الطبيعة- الإطار الأساسي لحياتنا ووجودنا اليومي وإبداعنا. لكن الجزء الأكثر قيمة من الثقافة يتألف من رواسبها في وعي الإنسان نفسه، أي أفكارنا وعاداتنا ومهاراتنا وقدراتنا المكتسبة التي نمت من كل الثقافة المادية السابقة، والتي تستمر في إعادة بنائها بينما هي تستند إليها. إذن أيها الرفاق: تنشأ الثقافة من صراع الإنسان مع الطبيعة من أجل البقاء وتحسين ظروف المعيشة وزيادة قوته. ولكن على هذا الأساس تنمو الطبقات أيضا. ففي سيرورة التكيف مع الطبيعة، وفي الصراع مع قواها المعادية، يتطور المجتمع البشري إلى تنظيم طبقي معقد. إن البنية الطبقية للمجتمع هي التي تحدد بشكل حاسم محتوى وشكل التاريخ البشري، أي علاقاته المادية وانعكاساتها الإيديولوجية. وبقولنا هذا، فإننا نقول أيضا إن الثقافة التاريخية لها طابع طبقي.
لقد أنتج المجتمع العبودي ثقافته وأنتج المجتمع الإقطاعي ثقافته وكذلك أنتج المجتمع البرجوازي ثقافته: ففي مراحل مختلفة توجد ثقافات مختلفة، مع العديد من الأشكال الانتقالية. المجتمع التاريخي هو مجتمع تنظيم استغلال الإنسان للإنسان. والثقافة تخدم التنظيم الطبقي للمجتمع. المجتمع المبني على الاستغلال يولد ثقافة استغلالية. لكن هل يعني هذا أننا ضد كل أنواع الثقافة الموروثة من الماضي؟
إننا نقف فعلا أمام تناقض عميق: فكل ما تم كسبه وابتكاره وبنائه من خلال جهود الإنسان ويساعد في تطوير قدرات الإنسان هو ثقافة. لكن وبما أننا نتعامل مع الإنسان الاجتماعي وليس الفرد؛ وبما أن الثقافة ظاهرة اجتماعية تاريخية بطبيعتها؛ وبما أن المجتمع التاريخي كان وما يزال مجتمعا طبقيا، فإن الثقافة تتكشف كأداة أساسية للاضطهاد الطبقي. قال ماركس: «إن الأفكار السائدة في عصر معين هي أفكار الطبقة السائدة في ذلك العصر». وهذا القول ينطبق أيضا على الثقافة ككل. ومع ذلك فإننا نقول للطبقة العاملة: يجب عليك أن تتملكي كل ثقافة الماضي، وإلا فلن تتمكني من بناء الاشتراكية. كيف يمكن فهم هذا؟
لقد تعثر كثيرون في هذا التناقض، وهم يتعثرون في كثير من الأحيان لأنهم يتعاملون مع مفهوم المجتمع الطبقي بشكل سطحي وشبه مثالي، متناسين أنه في الأساس تنظيم للإنتاج. لقد تطور كل مجتمع طبقي وفقا لوسائل محددة للصراع ضد الطبيعة، وقد تغيرت هذه الوسائل تبعا لتطور التكنولوجيا. لكن ما هو الأكثر جوهرية، هل التنظيم الطبقي للمجتمع أم قواه المنتجة؟ لا شك أنها قوى الإنتاج. لأنه على أساس هذه القوى، وعلى أساس مستوى معين من تطورها، تتطور الطبقات وتعيد تشكيل نفسها. وفي قوى الإنتاج تتجلى المهارة الاقتصادية المادية للإنسان، وقدرته التاريخية على تأمين وجوده. تنمو الطبقات على هذا الأساس الديناميكي، وعلاقاتها المتبادلة هي التي تحدد طابع الثقافة.

ومن هنا، وفيما يتصل بالتكنولوجيا قبل كل شيء، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا: هل هي مجرد أداة للاضطهاد الطبقي؟ يكفي أن نطرح مثل هذا السؤال حتى نتمكن من الإجابة على الفور: كلا! التكنولوجيا هي مكسب أساسي للبشرية؛ ورغم أنها كانت حتى الآن بمثابة أداة للاستغلال، فإنها في الوقت نفسه تشكل الشرط الأساسي لتحرر المستغَلين. فالآلة تخنق العبد المأجور. ولكن العبد المأجور لا يمكن أن يتحرر إلا من خلال الآلة. وهنا يكمن جذر المسألة بأكمله.
إذا لم ننس أن القوة الدافعة للسيرورة التاريخية هي نمو قوى الانتاج، التي تحرر الإنسان من قوى الطبيعة، فسنفهم أنه يتعين على البروليتاريا أن تتملك كل تراكم المعرفة والمهارة، التي طورها البشر خلال مسار تاريخهم، من أجل رفع نفسها من خلال بناء الحياة على أساس مبادئ التضامن.
“هل الثقافة هي التي تقود التكنولوجيا، أم أن التكنولوجيا هي التي تقود الثقافة؟”، هذا هو السؤال الذي تطرحه إحدى المذكرات الموضوعة أمامي. هذه هي الطريقة الخاطئة لطرح السؤال. لا يمكن أن نضع التكنولوجيا في مواجهة الثقافة، لأنها المحرك الرئيسي للثقافة. فبدون التكنولوجيا لا توجد ثقافة. إن نمو التكنولوجيا يدفع الثقافة إلى الأمام. لكن العلم والثقافة عموما، واللذان ينهضان على أساس التكنولوجيا، يعطيان دفعة قوية لنمو التكنولوجيا. يوجد هنا تفاعل ديالكتيكي.
أيها الرفاق، إذا كنتم بحاجة إلى مثال بسيط، لكنه معبر، عن التناقض الكامن في التكنولوجيا نفسها، فلن تجدوا مثالا أفضل من السكك الحديدية. إذا فحصتم قطارات الركاب الأوروبية، فسترون فيها عربات “درجات مختلفة”. وتذكرنا هذه الدرجات بالطبقات الموجودة في المجتمع الرأسمالي. فالدرجة الأولى مخصصة للنخبة المتميزة، والثانية للبرجوازية المتوسطة، والثالثة للبرجوازية الصغيرة، والرابعة للبروليتاريا، والتي كانت تسمى سابقا، لسبب وجيه، بالهيئة الرابعة. إن السكك الحديدية، في حد ذاتها، تشكل إنجازا ثقافيا وتكنولوجيا هائلا للبشرية، والذي غيّر خلال قرن واحد وجه الأرض إلى حد كبير. لكن البنية الطبقية للمجتمع تؤثر حتى على بنية وسائل النقل. ما زالت السكك الحديدية السوفياتية بعيدة كل البعد عن المساواة. وهذا ليس فقط لأنها ما زالت تستخدم عربات موروثة عن الماضي، بل وأيضا لأن السياسة الاقتصادية الجديدة لا تعمل إلا على تحضير الشروط للمساواة، لكنها لا تخلقها.
قبل ظهور السكك الحديدية، كانت الحضارة مكدسة على طول شواطئ البحار وضفاف الأنهار الكبيرة. وقد عملت السكك الحديدية على إدخال قارات بأكملها إلى الثقافة الرأسمالية. إن أحد الأسباب الأساسية، إن لم يكن الأكثر جوهرية، لتخلف القرية الروسية وإهمالها هو الافتقار إلى السكك الحديدية والطرق السريعة والطرق المعبدة. وفي هذا الصدد، تظل غالبية قرانا في ظروف ما قبل الرأسمالية. يجب علينا أن نتغلب على ما يشكل حليفنا العظيم وفي نفس الوقت عدونا الأعظم: المساحة الشاسعة. إن الاقتصاد الاشتراكي هو اقتصاد مخطط. وتفترض الخطة، قبل كل شيء، الاتصال. ووسائل النقل هي أهم وسيلة اتصال. إن كل خط سكة حديدية جديد هو طريق إلى الثقافة، وهو في ظروفنا يشكل طريقا إلى الاشتراكية. ومرة أخرى، ومع تطور تكنولوجيا وسائل النقل وازدهار البلاد، سوف يتغير أيضا المظهر الاجتماعي للسكك الحديدية: سوف يختفي الانقسام إلى “درجات”، وسوف يسافر الجميع في عربات مريحة… هذا إذا كان الناس بحلول ذلك الوقت ما يزالون يركبون العربات، بدلا من تفضيل السفر بالطائرات التي ستكون متاحة للجميع.
دعونا نأخذ مثالا آخر: أدوات العسكرة ووسائل التدمير. في هذا المجال تتجلى الطبيعة الطبقية للمجتمع في أشكال واضحة ومثيرة للاشمئزاز بشكل خاص. كل جهاز مدمر، سواء كان متفجرا أو مادة سامة، يكون اكتشافه في حد ذاته إنجازا علميا أو تكنولوجيا قيما. يمكن أيضا استخدام المتفجرات أو المواد السامة لأغراض إبداعية، وليس فقط مدمرة، وهي تفتح إمكانيات جديدة في مجال الاكتشافات والاختراعات.
لا يمكن للبروليتاريا الاستيلاء على سلطة الدولة إلا من خلال تحطيم جهاز الحكم الطبقي القديم. لقد قمنا بهذا العمل بشكل أكثر حزما من أي وقت مضى في التاريخ. لكننا في سياق بناءنا لجهاز جديد اكتشفنا أننا مجبرون على استخدام عناصر من الجهاز القديم بدرجة معينة وإلى حد ما. إن بناء جهاز الدولة الاشتراكي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل السياسي والاقتصادي والثقافي بشكل عام.
لا ينبغي لنا أن نحطم التكنولوجيا. فالبروليتاريا تستولي على المصانع التي جهزتها البرجوازية، وهي تفعل ذلك بالشكل الذي وجدتها عليه إبان الانقلاب الثوري. ما تزال المعدات القديمة تخدمنا حتى يومنا هذا. ويكشف هذا الظرف بوضوح وبشكل مباشر حقيقة أننا لا نتخلى عن ذلك “الميراث”. كيف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ ففي نهاية المطاف، لقد تم إنجاز الثورة على وجه التحديد من أجل الاستيلاء على هذا “الميراث”. لكن التكنولوجيا القديمة، بالشكل الذي اخذناها به، غير مناسبة تماما للاشتراكية. إنها تمثل الفوضى المتبلورة للاقتصاد الرأسمالي. إن المنافسة بين مختلف المؤسسات، والسعي إلى تحقيق الأرباح، والتطور اللامتكافئ للفروع المنفصلة، وتخلف المناطق المختلفة، والطبيعة الصغيرة للزراعة، وإهدار الموارد البشرية، كل هذا وجد في التكنولوجيا تعبيره في الحديد والنحاس. لكن وفي حين يمكن تحطيم جهاز الاضطهاد الطبقي بضربة ثورية، فإن الجهاز الإنتاجي للفوضى الرأسمالية لا يمكن إعادة بنائه إلا تدريجيا. إن استكمال فترة الاستعادة، على أساس المعدات القديمة، لا يقودنا إلا إلى عتبة هذه المهمة العظيمة. يجب أن نكملها مهما كلف الأمر.
II- ميراث الثقافة الروحية
إن الثقافة الروحية متناقضة هي أيضا، مثلها مثل الثقافة المادية. وكما أننا لا نستخرج من ترسانات ومخازن الثقافة المادية الأقواس والسهام، ولا الأدوات الحجرية أو أدوات العصر البرونزي، بل نأخذ أفضل الأدوات الممكنة من أحدث التقنيات، فيتعين علينا أن نتعامل مع الثقافة الروحية بنفس الطريقة.

كان الدين هو العنصر الرئيسي في ثقافة المجتمع القديم. وكان أهم أشكال المعرفة والوحدة الإنسانيتين؛ لكن هذا الشكل كان يعبر في المقام الأول عن ضعف الإنسان أمام الطبيعة وعجزه داخل المجتمع. نحن نعمل على كنس الدين وكل بدائله بشكل كامل.
أما الموقف من الفلسفة فهو مختلف. فمن الفلسفة التي خلقها المجتمع الطبقي لابد أن نستوعب عنصرين لا يقدران بثمن: المادية والديالكتيك. فمن خلال التركيب العضوي للمادية والديالكتيك على وجه التحديد ولد منهج ماركس ونشأ نظامه. وهذا المنهج هو ما يشكل الأساس الذي قامت عليه اللينينية.
وإذا انتقلنا إلى العلم بالمعنى الحقيقي للكلمة، فسوف يتضح لنا بشكل كامل هنا أننا أمام مخزون هائل من المعرفة والمهارة تراكم لدى البشرية طيلة مسار حياتها الطويل. صحيح أنه يمكن للمرء أن يشير هنا إلى أن العلم، الذي يهدف إلى إدراك الواقع، يشوبه الكثير من الغش الطبقي المغرض. وهذا صحيح تماما! فإذا كانت السكك الحديدية نفسها تظهر علامات تدل على امتياز البعض وفقر الآخرين، فإن الأمر نفسه ينطبق على العلم، الذي تتسم مادته بقدر أعظم من المرونة مقارنة بالمعدن والخشب اللذين يستخدمان في بناء عربات السكك الحديدية. إلا أنه يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن الإبداع العلمي يتغذى في الأساس على الحاجة إلى فهم الطبيعة، من أجل السيطرة على قواها. ورغم أن المصالح الطبقية أدخلت وما تزال تدخل ميولا زائفة حتى في العلوم الطبيعية، فإن هذا الغش مقيد بالحدود التي يبدأ بعدها في عرقلة التقدم التكنولوجي بشكل مباشر. وإذا فحصنا العلوم الطبيعية من الألف إلى الياء، من عالم تراكم الحقائق الأولية إلى أعلى التعميمات وأكثرها تعقيدا، فسوف نرى أن البحث العلمي كلما كان أكثر تجريبية، كلما كان أقرب إلى مادته وإلى الحقائق، وكلما كانت النتائج التي يقدمها أكثر وضوحا. وكلما اتسع مجال التعميمات، كلما اقتربت العلوم الطبيعية من مشاكل الفلسفة، وكلما أصبحت أكثر عرضة لتأثير القناعات الطبقية.
تصير الأمور أكثر تعقيدا وأكثر سوءا عندما يتعلق الأمر بالعلوم الاجتماعية، أو ما يسمى بـ“العلوم الإنسانية”. حتى هنا نجد، بالطبع، أن الرغبة في معرفة الواقع هي الدافع الجوهري. وبفضل هذا، بالمناسبة، ظهرت مدرسة رائعة من الاقتصاديين البرجوازيين الكلاسيكيين. لكن المصلحة الطبقية، التي نشعر بها في العلوم الاجتماعية بشكل أكثر مباشرة وإلزامية مما هو الحال في العلوم الطبيعية، سرعان ما أوقفت تطور الفكر الاقتصادي في المجتمع البرجوازي. ومع ذلك، فإننا نحن الشيوعيون مسلحون في هذا المجال بشكل أفضل من أي مجال آخر. فعلى أساس العلم البرجوازي وانتقاده، تمكن المنظرون الاشتراكيون، الذين أيقظهم الصراع الطبقي للبروليتاريا، من أن يبتكروا في أعمال ماركس وإنجلز المنهج القوي للمادية التاريخية وتطبيقه الذي لا مثيل له في [كتاب] رأس المال. لكن هذا لا يعني بالطبع أننا محصنون ضد تأثير الأفكار البرجوازية في مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع ككل. كلا، ففي كل خطوة تتسرب إلى ممارساتنا اليومية الميول الأكاديمية والشعبوية ضيقة الأفق الأكثر فظاظة من “مخازن المعرفة” القديمة، بحثا عن الغذاء لنفسها في العلاقات الغامضة والمتناقضة التي تميز الفترة الانتقالية. إلا أنه حتى في هذا المجال لدينا المعايير الماركسية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تم التحقق منها وإثراؤها في أعمال لينين. وكلما تحررنا من قيود تجربة اليوم، كلما استوعبنا على نطاق أوسع التطور الاقتصادي العالمي ككل، وفصلنا بين اتجاهاته الأساسية والتغيرات الظرفية، كلما كان انتصارنا على الاقتصاديين وعلماء الاجتماع المبتذلين أكثر حسما.
في حقول القانون والأخلاق والإيديولوجية بشكل عام، وضع العلم البرجوازي أكثر سوءا، إن كان هذا ممكنا، مما هو عليه في مجال الاقتصاد. لا يمكن للمرء أن يجد لؤلؤة صغيرة من المعرفة الحقيقية في هذه المجالات إلا بعد البحث في أطنان من أكوام القمامة التي ينشرها هؤلاء الأساتذة.
إن الديالكتيك والمادية يشكلان العناصر الأساسية للإدراك الماركسي للعالم. لكن هذا لا يعني، بأي حال من الأحوال، أنه يمكن تطبيقهما في أي مجال من مجالات المعرفة مثل مفتاح صالح لكل شيء. لا يمكن فرض الديالكتيك على الحقائق، بل يجب أن يُستمد هو من الحقائق، ومن طبيعتها وتطورها. إن العمل المضني على مادة لا حدود لها هو وحده الذي أعطى ماركس القدرة على بناء النظام الديالكتيكي للاقتصاد على مفهوم القيمة باعتبارها عملا متحققا. إن أعمال ماركس التاريخية، وحتى مقالاته الصحفية، مبنية بنفس الطريقة. لا يمكن للمرء أن يطبق المادية الديالكتيكية على مجالات المعرفة الجديدة إلا بعد تملكها من الداخل. لا يمكن تنظيف العلم البرجوازي إلا من خلال تملك العلم البرجوازي. لن تحقق شيئا هنا بمجرد النقد الجامح أو الأوامر. إن الاستيعاب والتطبيق يسيران جنبا إلى جنب مع النقد. نحن لدينا المنهج، لكن هناك ما يكفي من العمل ليدوم أجيالا.
إن النقد الماركسي للعلم لا ينبغي أن يكون يقظا فحسب، بل وحذرا أيضا، وإلا فإنه قد ينحدر إلى مستوى التملق المطلق أو الفاموسوفية (Famusovism)[1]. فلنأخذ علم النفس كمثال. إن علم المنعكسات (Reflexology) عند بافلوف يتبع تماما خطوط المادية الديالكتيكية. فهو يدمر إلى الأبد الجدار الذي كان يفصل بين علم وظائف الأعضاء (Physiology ) وعلم النفس (Psychology). إن أبسط رد فعل هو رد فعل فسيولوجي، ونظام من الانعكاسات يمنحنا “الوعي”. إن تراكم الكم الفسيولوجي يعطينا طفرة نوعية “سيكولوجية” جديدة. إن منهج مدرسة بافلوف تجريبي ومضن. والتعميمات تكتسب خطوة بخطوة: من لعاب الكلب إلى الأشعار، أي إلى آلياته النفسية (لكن ليس محتواه الاجتماعي). وبطبيعة الحال، فإن المسارات المؤدية إلى الشعر لم تُكتشف بعد.
مدرسة المحلل النفسي الفييني، فرويد، تتبنى نهجا مختلفا في التعامل مع المشكلة. فهي تفترض مسبقا أن القوة الدافعة وراء السيرورات النفسية الأكثر تعقيدا وسموا هي الحاجة الفسيولوجية. إن التحليل النفسي بهذا المعنى العام مادي، إذا ما تجاهلنا مسألة ما إذا كان التحليل النفسي يركز على العنصر الجنسي على حساب العناصر الأخرى، لأن هذا بالفعل نقاش يدور في إطار المادية. لكن المحلل النفسي لا يتناول مسألة الوعي بطريقة تجريبية، انطلاقا من الظواهر الدنيا إلى الظواهر العليا، أو من ردود الفعل البسيطة إلى الظواهر المعقدة؛ بل يحاول أن يخطو كل هذه الخطوات الوسيطة بقفزة واحدة، من فوق إلى أسفل، من الأساطير الدينية، أو القصائد الغنائية، أو الأحلام، مباشرة إلى الأساس الفسيولوجي للنفسية.
يقول المثاليون إن النفس مستقلة، وأن “النفس” هي بئر لا قاع له. ويرى كل من بافلوف وفرويد أن علم وظائف الأعضاء هو قاع “النفس”. لكن بافلوف، مثل الغواص، ينزل إلى القاع ويستكشف البئر بشق الأنفس من الأسفل إلى الأعلى. بينما فرويد يقف على الجانب الآخر من البئر، ويحاول بنظرة ثاقبة أن يلتقط أو يخمن أسرار القاع من خلال أعماق المياه المتغيرة والعكرة. إن طريقة بافلوف هي التجربة، أما طريقة فرويد فهي التخمين، وأحيانا الخيال.
إن محاولة إعلان أن التحليل النفسي “غير متوافق” مع الماركسية والتخلي عن الفرويدية بكل بساطة هي محاولة مبتذلة للغاية، أو بعبارة أكثر دقة، محاولة تبسيطية. لكننا لسنا ملزمين، في أي حال من الأحوال، بتبني الفرويدية. إنها فرضية عملية يمكنها أن تقدم، وهي تقدم بلا شك، استنتاجات وتخمينات تسير على خطى علم النفس المادي. ومع مرور الوقت، سيؤدي المسار التجريبي إلى التحقق منها. لكننا لا نمتلك لا الأساس ولا الحق في فرض حظر على المسار الآخر، والذي، حتى وإن كان أقل موثوقية، ما يزال يحاول توقع الاستنتاجات التي سيتوصل إليها المسار التجريبي لكن ببطء أكبر[2].
أردت من خلال هذه الأمثلة أن أظهر ولو جزئيا مدى تنوع تراثنا العلمي ومدى تعقيد الطرق التي يمكن للبروليتاريا أن تبدأ بها في تملكها. فإذا لم تكن الأمور في البناء الاقتصادي تُحَل بمرسوم، وكان لزاما علينا أن “نتعلم التجارة”، فإن الأوامر في العلم لن تسفر إلا عن الأذى والإحراج. يتعين علينا هنا أن “نتعلم كيف نتعلم”.

إن الفن هو أحد الأشكال التي يجد الإنسان من خلالها بوصلته في العالم؛ وبهذا المعنى فإن ميراث الفن لا يختلف عن ميراث العلم والتكنولوجيا، ولا يقل عنه تناقضا. لكن وعلى النقيض من العلم، فإن الفن هو شكل من أشكال إدراك العالم ليس كنظام من القوانين، بل كمجموعة من الصور، وفي الوقت نفسه كوسيلة لإلهام مشاعر وأمزجة معينة. لقد جعل فن القرون الماضية الإنسان أكثر تعقيدا ومرونة، ورفع نفسيته إلى مستوى أعلى وأغنى عقله بطرق عديدة. وهذا الإثراء يشكل مكسبا لا يقدر بثمن للثقافة. وبالتالي فإن إتقان الفن القديم يشكل شرطا ضروريا ليس فقط لخلق فن جديد، بل وأيضا لبناء مجتمع جديد، لأن الشيوعية تحتاج إلى أناس يتمتعون بنفسية متطورة للغاية. لكن هل الفن القديم قادر على إثرائنا بالإدراك الفني للعالم؟ أجل، إنه قادر على ذلك. ولهذا السبب بالذات فهو قادر على تغذية مشاعرنا وتنميتها. وإذا ما تخلينا عن الفن القديم بلا تمييز، فسوف نصبح على الفور أكثر فقرا في الروح.
صرنا اليوم نلاحظ هنا وهناك وجود ميل بيننا إلى الترويج لفكرة مفادها أن الفن لا يهدف إلا إلى إلهام بعض الأمزجة، وليس إلى إدراك الواقع. ومن هنا تأتي الخلاصة: أي نوع من المشاعر يمكن أن نصاب بعدواها بفعل فن النبلاء أو البرجوازيين؟ هذا خطأ جوهري. إن أهمية الفن كوسيلة للمعرفة -بالنسبة للجماهير الشعبية على وجه الخصوص- لا تقل عن أهميته “الحسية”. ليست القصائد البطولية وحدها التي تمنحنا المعرفة من خلال الصور، بل وحتى الحكايات الخرافية والأغاني والأمثال والأناشيد الشعبية؛ إنها تنير لنا الماضي وتعمم خبراتنا وتوسع آفاقنا، وهي قادرة في هذا السياق فقط على إلهام “مشاعر” معينة. ينطبق هذا على كل الأدب بشكل عام، وليس فقط على الملحمة، بل وعلى القصيدة الغنائية أيضا. وينطبق على الرسم والنحت أيضا. والاستثناء الوحيد، بمعنى ما، هو الموسيقى، التي يكون تأثيرها قويا، لكنه أحادي الجانب. حتى الموسيقى تستند، بطبيعة الحال، إلى معرفة خاصة بالطبيعة، وصوتها وإيقاعاتها. لكن المعرفة هنا مخفية إلى حد كبير، ونتائج إلهام الطبيعة منعكسة إلى حد كبير من خلال أعصاب الإنسان، بحيث تعمل الموسيقى كـ “إلهام” ذاتي محض. وكثيرا ما بُذِلت محاولات لتقريب جميع أشكال الفن من الموسيقى باعتبارها فن “العدوى”، وكانت تلك المحاولات تعني دائما تقليص دور العقل في الفن لصالح نزعة شهوانية مجردة؛ وبهذا المعنى كانت تلك المحاولات رجعية وما تزال كذلك… والأسوء من كل هذا بالطبع هي الأعمال “الفنية” التي لا تمنحنا إدراكا من خلال الصور ولا “عدوى” فنية، بل إنها تروج لأغرب الادعاءات. ونحن ننشر عددا لا يستهان به من هذه الأعمال، التي من المؤسف أنها لا تقتصر على دفاتر طلاب الفن، بل تنشر بآلاف النسخ…
إن الثقافة ظاهرة اجتماعية. ولهذا السبب بالذات، فإن اللغة، باعتبارها أداة للتواصل بين الناس، هي أداتها الأكثر أهمية. وثقافة اللغة نفسها هي الشرط الأكثر أهمية لنمو جميع مجالات الثقافة، خاصة العلوم والفنون. وكما تظل التكنولوجيا غير راضية عن أدوات القياس القديمة وتبتكر أدوات جديدة: الميكرومتر، والفولتميتر، وما إلى ذلك، بهدف تحقيق دقة أكبر على نحو متزايد، فكذلك في عالم اللغة، فلامتلاك القدرة على اختيار الكلمات المناسبة وتركيبها بالطريقة المناسبة، نحتاج إلى عمل شاق ومستمر ومنهجي لتحقيق أقصى قدر من الدقة والوضوح والصحة. إن أساس هذا العمل لابد وأن يكون مكافحة الأمية أو شبه الأمية أو تخفيض مستوى الأمية. والمرحلة التالية في هذا العمل هي إتقان الأدب الروسي الكلاسيكي.
أجل، لقد كانت الثقافة الأداة الرئيسية للاضطهاد الطبقي. لكن الثقافة، وحدها، قادرة على أن تصبح أداة للتحرر الاشتراكي.
III- تناقضاتنا الثقافية
المدينة والريف
إن ما يميز موقفنا هو أننا -عند مفترق الطرق بين الغرب الرأسمالي والشرق المستعمر الفلاحي- أول من نفذ ثورة اشتراكية. فقد تأسس نظام دكتاتورية البروليتاريا أولا في بلد له ميراث هائل من التخلف والهمجية، حتى أن قرونا كاملة من التاريخ تفصل بين بدوي سيبيري وبين بروليتاري من موسكو أو لينينغراد. إن أشكالنا الاجتماعية أشكال انتقالية إلى الاشتراكية، وبالتالي فهي أعلى بما لا يقاس من الأشكال الرأسمالية. وبهذا المعنى فإننا محقون في اعتبار أنفسنا البلد الأكثر تقدما في العالم. لكن تكنولوجيتنا، التي تشكل أساس الثقافة المادية أو أي ثقافة أخرى، متخلفة إلى حد غير عادي مقارنة بالبلدان الرأسمالية المتقدمة. وهنا يكمن التناقض الأساسي في واقعنا الحالي. وتتلخص المهمة التاريخية التي تنبع من هذا التناقض في رفع التكنولوجيا إلى مستوى الشكل الاجتماعي. فإذا لم نتمكن من القيام بذلك، فإن بنيتنا الاجتماعية سوف تهبط حتما إلى مستوى تخلفنا التكنولوجي. أجل، من أجل فهم الأهمية الكاملة للتقدم التكنولوجي بالنسبة لنا، يجب أن نقول لأنفسنا بصراحة: إذا لم نتمكن من استكمال الشكل السوفياتي لبنيتنا بالتكنولوجيا الإنتاجية المطلوبة، فإننا سنستبعد إمكانية الانتقال إلى الاشتراكية وسنعود إلى الرأسمالية، وإلى أي نوع؟ إلى رأسمالية شبه اقطاعية وشبه مستعمرة. إن النضال من أجل التكنولوجيا بالنسبة لنا هو نضال من أجل الاشتراكية، والذي يرتبط به، بشكل لا ينفصم، مستقبل ثقافتنا بالكامل.
هذا مثال جديد ومعبر للغاية عن تناقضاتنا الثقافية: قبل بضعة أيام ظهرت ملاحظة في صحفنا مفادها أن مكتبتنا العامة في لينينغراد احتلت المرتبة الأولى فيما يتعلق بعدد المجلدات: فهي تحتوي الآن على 4.250.000 كتاب! أول إحساس لدينا هو شعور مشروع بالفخر السوفياتي: مكتبتنا هي الأولى في العالم! ما الذي يعود له الفضل في هذا الإنجاز؟ يعود الفضل في ذلك لحقيقة أننا صادرنا المكتبات الخاصة. فمن خلال تأميم الملكية الخاصة، أنشأنا أغنى مؤسسة ثقافية، وهي متاحة للجميع. هذه الحقيقة البسيطة توضح بلا جدال المزايا العظيمة للبنية السوفياتية. ولكن في الوقت نفسه، يتجلى تخلفنا الثقافي في حقيقة مفادها أن نسبة الأمية في بلدنا أكبر من أي بلد أوروبي آخر. مكتبتنا هي الأولى في العالم، ولكن حتى الآن، أقلية من سكاننا تقرأ الكتب. وهذا هو الحال في كل المجالات تقريبا. الصناعة المؤممة مع المشاريع العملاقة، ولكنها بعيدة كل البعد عن الجودة، مثل مشروع دنيبروستروي وقناة فولغا دون، وما إلى ذلك، لكن ومع ذلك ما يزال الفلاحون يدرسون محاصيلهم بوسائل متخلفة. إن تشريعاتنا الأسرية مشبعة بروح اشتراكية، لكن الضرب ما يزال يلعب دورا لا يستهان به في الحياة الأسرية. تنبع هذه التناقضات وغيرها من كامل بنية ثقافتنا، التي تقع عند مفترق الطرق بين الغرب والشرق.

إن أساس تخلفنا هو الهيمنة الوحشية للقرية على المدينة، والفلاحة على الصناعة؛ وعلاوة على ذلك نحن نشهد الآن العودة إلى سيطرة الأدوات ووسائل الإنتاج الأكثر تخلفا على القرية. وعندما نتحدث عن القنانة التاريخية فإننا نعني في المقام الأول العلاقات بين الطبقات الاجتماعية، وتبعية الفلاحين لملاك الأراضي والمسؤولين القيصريين. ولكن القنانة، أيها الرفاق، لها أساس أعمق: تبعية الإنسان للأرض، واعتماد الفلاح الكامل على العناصر الطبيعية. هل قرأتم غليب أوسبنسكي؟ أخشى أن الجيل الأصغر سنا لا يقرأه. ولابد أن نعيد نشر أعماله، أو على الأقل أفضل أعماله، فقد كتب بعض الأعمال الرائعة. كان أوسبنسكي شعبويا. وكان برنامجه السياسي طوباويا تماما. لكن أوسبنسكي -مؤرخ القرية- ليس فنانا بارعا فحسب، بل إنه أيضا واقعي رائع. فقد كان قادرا على فهم الحياة اليومية للفلاح ونفسيته باعتبارها ظواهر مشتقة تنمو على قاعدة اقتصادية وتحددها هذه القاعدة بالكامل. لقد كان قادرا على فهم القاعدة الاقتصادية للقرية باعتبارها اعتماد الفلاح المستعبد في عملية العمل على الأرض، وبشكل عام على قوى الطبيعة. يجب عليكم بالتأكيد قراءة كتابه “قوة الأرض”. مع أوسبنسكي، يحل الحدس الفني محل المنهج الماركسي، وبناء على نتائجه، يمكن أن نقول إنه يضاهي المنهج الماركسي في كثير من النواحي. ولهذا السبب على وجه التحديد، كان أوسبنسكي الفنان دائما محاصرا في معركة مميتة مع أوسبنسكي الشعبوي. حتى الآن ما يزال علينا أن نتعلم من الفنان إذا أردنا أن نفهم بقايا القنانة القوية في حياة الفلاحين، وخاصة في العلاقات الأسرية، والتي غالبا ما تمتد إلى حياة المدينة: يكفي أن نستمع بعناية إلى الملاحظات المختلفة للمناقشة الجارية الآن بشأن مشاكل التشريع الزوجي!
في كل أنحاء العالم، جعلت الرأسمالية التناقض بين الصناعة والفلاحة، وبين المدينة والريف، تناقضا متوترا للغاية. وفي بلادنا، وبسبب تأخر تطورنا التاريخي، نجد إن هذا التناقض يحمل طابعا وحشيا تماما. ومهما بدا الأمر غريبا، فقد حاولت صناعتنا بالفعل أن تضاهي الأمثلة الأوروبية والأمريكية، في وقت كان فيه ريفنا يتراجع إلى أعماق القرن السابع عشر وحتى إلى قرون أبعد. حتى في أمريكا، من الواضح أن الرأسمالية عاجزة عن رفع الفلاحة إلى مستوى الصناعة. وهذه المهمة تنتقل بالكامل إلى الاشتراكية. وفي ظل ظروفنا، مع الهيمنة الهائلة للقرية على المدينة، يشكل تصنيع الفلاحة الجزء الأكثر أهمية في البناء الاشتراكي.
نفهم بتصنيع الفلاحة سيرورتين لا بد من الجمع بينهما إذا أردنا أن نمحو بشكل نهائي وحاسم الحدود بين المدينة والريف. دعونا نتناول هذه المسألة الحاسمة بمزيد من التفصيل.
إن تصنيع الفلاحة يتلخص، من ناحية، في فصل سلسلة كاملة من الفروع، التي تشارك في المعالجة الأولية للموارد الصناعية والمواد الغذائية الخام، عن الاقتصاد المنزلي القروي. ذلك أن كل الصناعات، بشكل عام، جاءت من الريف، عن طريق الحرف اليدوية والإنتاج البدائي، عبر فصل فروع مختلفة عن النظام المغلق للاقتصاد المنزلي، من خلال التخصص، وخلق التدريب اللازم والتكنولوجيا، وصولا إلى الإنتاج الآلي. وسوف يتعين على صناعتنا السوفياتية أن تتبع هذا المسار إلى حد كبير، أي أنها لابد أن تتبع مسار تأميم سلسلة كاملة من العمليات الإنتاجية التي تقف بين الاقتصاد القروي، بالمعنى الحقيقي للكلمة، وبين الصناعة. ويوضح مثال الولايات المتحدة أن هناك إمكانيات غير محدودة تنتظرنا.
لكن ما قلناه لم يستنفد المسألة. إن التغلب على التناقضات بين الفلاحة والصناعة يتطلب تصنيع زراعة المحاصيل الحقلية، وتربية الحيوانات، والبستنة، وما إلى ذلك. وهذا يعني أن حتى هذه الفروع من النشاط الإنتاجي يجب أن تستند إلى التكنولوجيا العلمية: الاستخدام الواسع للآلات في التركيبة الصحيحة، والجرارات والكهرباء، والتسميد، وتناوب المحاصيل المناسب، والاختبارات المعملية والتجريبية للأساليب والنتائج، والتنظيم الصحيح لعملية الإنتاج بأكملها مع الاستخدام الأكثر عقلانية لقوة العمل، إلخ. وبطبيعة الحال فإنه حتى الزراعة الحقلية المنظمة للغاية ستختلف في بعض النواحي عن بناء الآلات. لكن حتى في الصناعة، تختلف الفروع عن بعضها البعض بشكل عميق. إذا كان من المبرر لنا اليوم مقارنة الفلاحة بالصناعة ككل، فهذا لأن الفلاحة تُدار على نطاق صغير وبوسائل بدائية، مع اعتماد المنتج بشكل أعمى على ظروف الطبيعة وظروف وجود متخلفة للغاية للفلاح. لا يكفي تشريك الفروع المنفصلة من اقتصاد القرية اليوم، مثل صناعة الزبدة، وصناعة الجبن، وإنتاج النشا أو الشراب، إلخ. بل يتعين علينا تشريك الفلاحة ذاتها، أي انتزاعها من حالتها الحالية من التفتت واستبدال عملية الحفر البائسة في التربة التي تتم اليوم بـ“مصانع” الحبوب والجاودار المنظمة علميا، و“مصانع معالجة” الأبقار والأغنام، وما إلى ذلك. وقد اتضح أن هذا ممكن، جزئيا من خلال التجربة الرأسمالية التي نراها بالفعل، وخاصة في التجربة الفلاحية في الدنمارك، حيث تم إخضاع الدجاج للتخطيط والتوحيد القياسي؛ فهو يضع البيض وفقا لجدول زمني، وبكميات هائلة، وبنفس الحجم واللون.
إن تصنيع الفلاحة يعني القضاء على التناقض الأساسي الموجود اليوم بين الريف والمدينة، وبالتالي بين الفلاح والعامل: عندما يتعلق الأمر بدورهما في اقتصاد الأمة، أو مستويات معيشتهما، أو مستواهما الثقافي، فيجب أن يقتربا من بعضهما البعض إلى درجة تختفي معها الحدود بينهما. فعندما يصير المجتمع الذي تشكل فيه الزراعة الآلية للحقول جزءا متساويا من الاقتصاد المخطط، وحيث تتبنى المدينة مزايا الريف (المساحات المفتوحة، والخضرة)، وحيث تثري القرية نفسها بمزايا المدينة (الطرق المعبدة، والإضاءة الكهربائية، وإمدادات المياه بالأنابيب، ونظام الصرف الصحي)، أي عندما يختفي التناقض بين المدينة والريف، سيتحول الفلاح والعامل إلى مشاركين متساويين في القيمة والحقوق في عملية إنتاج موحدة: مثل هذا المجتمع سيكون مجتمعا اشتراكيا حقيقيا.
إن الطريق إلى ذلك المجتمع طويل وصعب. وتشكل محطات الطاقة الكهربائية القوية أهم المعالم على طول الطريق. فهي ستجلب إلى القرية الضوء والقوة التحويلية: قوة الكهرباء في مواجهة قوة التربة!
قبل فترة ليست بالبعيدة افتتحنا محطة شاتورا لتوليد الطاقة، وهي واحدة من أفضل محطاتنا، وقد بنيت على مستنقع من الخث. تبلغ المسافة من موسكو إلى شاتورا أكثر بقليل من مائة كيلومتر، حتى يبدو أنهما يستطيعان أن يصافحا بعضهما البعض. لكن ما أعظم الفارق في الظروف! فموسكو هي عاصمة الأممية الشيوعية، لكنك إذا مشيت بضع عشرات من الكيلومترات فسوف تجد الأدغال والثلوج وأشجار التنوب، والمستنقعات المتجمدة، والحيوانات البرية. وقرى مكونة من أكواخ خشبية تغفو تحت الثلوج. وفي بعض الأحيان يمكن رؤية آثار الذئاب من نافذة عربة القطار. وفي المكان الذي تقف فيه محطة شاتورا الآن، عندما بدأ بناؤها قبل بضع سنوات، كان من الممكن أن نجد الأيائل. الآن يغطي المسافة بين موسكو وشاتورا بناء متطور من الصواري المعدنية التي تدعم كابلات كهربائية بتيار يبلغ 115 ألف فولت. وتحت تلك الصواري تربي الثعالب والذئاب صغارها. هذا هو حال ثقافتنا بأكملها، فهي تتكون من أكثر التناقضات تطرفا، من أعلى إنجازات التكنولوجيا والفكر من ناحية، ومن التايغا البدائية من ناحية أخرى.
تعيش شاتورا على الخث وكأنها مرعى. والواقع أن كل المعجزات التي خلقتها الخيالات الطفولية للدين، وحتى الخيال الإبداعي للشعر، تتضاءل أمام هذه الحقيقة البسيطة: فالآلات التي تشغل حيزا ضئيلا تلتهم المستنقع القديم، وتحوله إلى طاقة غير مرئية، وتعيده عبر كابلات رفيعة إلى نفس الصناعة التي خلقت تلك الآلات وأقامتها.
شاتورا شيء جميل. فقد صنعه بناة موهوبون ومخلصون لعملهم. وجماله ليس مصطنعا ولا مفروضا، بل إنه ينبع من خصائص ومتطلبات التكنولوجيا ذاتها. والمعيار الأعلى، بل الوحيد، للتكنولوجيا هو الجدوى. ومعيار الجدوى هو قدرتها على الاقتصاد. وهذا يفترض أعظم التوافق بين الكل وأجزائه، بين الوسائل والغايات. والمعيار الاقتصادي والتكنولوجي يتوافق تماما مع المعيار الجمالي. ويمكننا أن نقول، وهذا ليس مفارقة: إن شاتورا شيء جميل لأن كيلووات-ساعة التي تنتجها أرخص من كيلووات-ساعة من محطات أخرى مبنية في ظروف مماثلة.
تقع شاتورا على مستنقع. ولدينا العديد من المستنقعات في الاتحاد السوفياتي، أكثر بكثير مما لدينا من محطات الطاقة. ولدينا كذلك العديد من أشكال الوقود التي تنتظر التحول إلى طاقة ميكانيكية. في الجنوب، يتدفق نهر الدنيبر عبر أغنى منطقة صناعية، وتضيع القوى الجبارة لتياره هباء؛ إنه يمر على طول المنحدرات التي يبلغ عمرها قرونا، وينتظر منا التحكم في تياراته من خلال بناء سد، وإجباره على الإضاءة، وتشغيل وإثراء مدننا ومصانعنا وحقولنا. وهذا ما سنفعله!
في الولايات المتحدة الأمريكية، يتلقى كل فرد 500 كيلووات-ساعة من الطاقة سنويا؛ أما عندنا فالرقم هو 20 كيلووات-ساعة فقط، أي أقل بخمس وعشرين مرة. وبشكل عام، لدينا قوة دفع ميكانيكية للفرد أقل بخمسين مرة مما هو عليه الحال في الولايات المتحدة. النظام السوفياتي المجهز بالتكنولوجيا الأمريكية: تلك هي الاشتراكية. نظامنا الاجتماعي من شأنه أن يضع التكنولوجيا الأمريكية في إطار استخدام أكثر عقلانية بما لا يقاس. ولكن بعد ذلك ستحول التكنولوجيا الأمريكية بنيتنا الاجتماعية وتحررها من ميراث التخلف والبدائية والهمجية. إن الجمع بين البنية الاجتماعية السوفياتية وبين التكنولوجيا الأمريكية سيعزز تكنولوجيا جديدة وثقافة جديدة: تكنولوجيا وثقافة للجميع، دون مفضلين أو منبوذين.
مبدأ “الناقل” في الاقتصاد الاشتراكي
إن مبدأ الاقتصاد الاشتراكي هو التناغم، أي الاستمرارية القائمة على التنسيق الداخلي. ومن الناحية التكنولوجية، يجد هذا المبدأ أعلى تعبير له في الناقل. فما هو الناقل؟ إنه حزام يتحرك باستمرار يحمل إلى العامل، أو يأخذ منه، أي شيء تتطلبه وتيرة عمله. ومن المعروف الآن على نطاق واسع كيف تستخدم شركة فورد مجموعة من الناقلات كوسيلة للنقل الداخلي: النقل والتوريد. لكن الناقل هو شيء أكثر من ذلك: إنه وسيلة لتنظيم عملية الإنتاج ذاتها، بقدر ما يضطر العامل إلى تنسيق تحركاته مع حركة حزام لا نهاية له. تستخدم الرأسمالية هذا من أجل استغلال العامل بشكل أعلى وأكثر شمولا. لكن مثل هذا الاستخدام مرتبط بالرأسمالية، وليس بالناقل بحد ذاته. إلى أين يتجه تطور أساليب تنظيم العمل: في اتجاه دفع الأجر بالقطعة أم في اتجاه الناقل؟ كل شيء يشير إلى أنه يسير في اتجاه الناقل. إن الدفع مقابل العمل بالقطعة، مثله مثل أي شكل آخر من أشكال السيطرة الفردية على العامل، هو سمة من سمات الرأسمالية في العصور الأولى من تطورها. يضمن هذا الأسلوب دفع العمل الفسيولوجي للعامل الفرد إلى أقصاه، لكنه لا يضمن تنسيق الجهود بين العمال المختلفين. وكلا المشكلتين يحلهما الناقل بشكل أوتوماتيكي. ولابد أن يسعى التنظيم الاشتراكي للاقتصاد إلى خفض العبء الفسيولوجي للعمال الأفراد بما يتوافق مع نمو القوة التكنولوجية، مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على تنسيق جهود العمال المختلفين. وهنا، على وجه التحديد، تكمن أهمية الناقل الاشتراكي، على النقيض من الناقل الرأسمالي. وبصورة أكثر تحديدا، فإن النقطة الرئيسية هنا هي تنظيم حركة الحزام بالنظر إلى عدد معين من ساعات العمل للعمال، أو على العكس من ذلك، تنظيم وقت العمال بالنظر إلى سرعة الحزام.

في ظل النظام الرأسمالي يتم استعمال الناقل في إطار مشروع واحد، باعتباره وسيلة للنقل الداخلي. لكن مبدأ الناقل بحد ذاته أوسع بكثير. فكل مشروع منفصل يتلقى من الخارج المواد الخام والوقود والمواد المساعدة وقوة العمل التكميلية. العلاقات بين المشاريع المنفصلة، حتى الأكثر ضخامة من بينها، تنظمها قوانين السوق، على الرغم من أنه من الصحيح أن تلك القوانين مقيدة في كثير من الحالات بأنواع مختلفة من الاتفاقات طويلة الأجل. لكن كل مصنع على حدة، وحتى المجتمع ككل، مهتم بحقيقة أن المواد الخام يتم توريدها في الوقت المحدد، وبأن لا تبقى في المستودعات أو تتسبب في توقف الإنتاج، أي أنها تخضع لمبدأ الناقل، بما يتوافق تماما مع إيقاع الإنتاج. وفي هذا السياق لا داعي لأن نتخيل الناقل دائما على شكل حزام متحرك لا نهاية له. يمكن لأشكاله أن تكون متنوعة بلا حدود. إن السكك الحديدية، إذا كانت تعمل وفقا للخطة، أي من دون الانقطاعات في نقل البضائع، ومن دون تراكم موسمي للأحمال، أو باختصار من دون عناصر الفوضى الرأسمالية -وفي ظل الاشتراكية سوف تعمل السكك الحديدية على هذا النحو بالضبط- تشكل ناقلا جبارا يضمن إمداد المصانع في الوقت المناسب بالمواد الخام والوقود والمواد والبشر. وينطبق الشيء نفسه على السفن البخارية والشاحنات وما إلى ذلك. سوف تصبح كافة أشكال الاتصال عناصر نقل للنظام الداخلي للإنتاج من وجهة نظر الاقتصاد المخطط ككل. وتشكل خطوط أنابيب النفط نوعا من الناقلات للمواد السائلة. وكلما اتسع نطاق شبكة خطوط أنابيب النفط، كلما قل احتياجنا إلى الخزانات، وقل حجم النفط الذي يتحول إلى رأس مال ميت.
نظام الناقلات لا يفترض، بأي حال من الأحوال، تكدس الشركات في مكان واحد. بل على العكس من ذلك، تسمح التكنولوجيا الحديثة بتشتيتها، ليس بطبيعة الحال بطريقة فوضوية وعشوائية، بل مع مراعاة المكان الأكثر ملاءمة (Standort) لكل مصنع على حدة. إن إمكانية انتشار المؤسسات الصناعية على نطاق واسع، والتي من دونها يستحيل إذابة المدينة في القرية، والقرية في المدينة، مضمونة إلى حد كبير بالطاقة الكهربائية كقوة دافعة. والكابلات المعدنية هي الناقل الأكثر تطورا للطاقة، مما يجعل من الممكن تقسيم القوة الدافعة إلى أصغر الوحدات، وتشغيلها أو إيقافها بمجرد الضغط على زر. وبهذه الخصائص على وجه التحديد، يدخل “ناقل” الطاقة في صدام عدائي شديد مع قيود الملكية الخاصة. وفي تطورها الحالي، تُعَد الكهرباء القطاع الأكثر “اشتراكية” في التكنولوجيا. لذا ليس من المستغرب أن يكون هذا القطاع هو القطاع الأكثر تقدما.
ومن هذا المنظور، تشكل ناقلات المياه للزراعة -للري أو التصريف السليم- هي الأنظمة العملاقة الضرورية لاستصلاح الأراضي. وكلما نجحت قطاعات الكيمياء وصنع الآلات والكهرباء في تحرير زراعة الأراضي من تأثير العناصر الطبيعية، وبالتالي ضمان أعلى مستوى من التخطيط، كلما اندمج “اقتصاد القرية” اليوم بشكل أكثر اكتمالا في نظام الناقل الاشتراكي الذي ينظم وينسق كل الإنتاج، بدءا من باطن الأرض (استخراج الفحم والمعادن) والتربة (حراثة وزرع الحقول).
وبناء على أساس خبرته في مجال الناقل، يحاول العجوز فورد بناء شيء من الفلسفة الاجتماعية. وفي هذه المحاولة نرى مزيجا غريبا للغاية من الإنتاج والخبرة الإدارية على نطاق واسع للغاية، مع ضيق أفق لا يطاق لرجل متعجرف راضٍ عن نفسه، رجل أصبح مليونيرا لكنه بقي مجرد برجوازي صغير يمتلك الكثير من المال. يقول فورد: «إذا كنت تريد تحقيق الثروة لنفسك والرفاهية لمواطنيك، فتصرف كما أتصرف أنا». لقد طالب كانط بأن يتصرف كل إنسان على النحو الذي يجعل سلوكه معيارا للآخرين. وهكذا فإن فورد بالمعنى الفلسفي يعتبر كانطيا. لكن “المعيار” العملي لعمال فورد، البالغ عددهم مائتي ألف عامل، ليس سلوك فورد، بل حركة ناقله الآلي: فهو يحدد إيقاع حياتهم، وحركة أيديهم وأقدامهم وأفكارهم. وبالتالي فإنه من أجل “رفاهية المواطنين”، لابد من فصل الفوردية عن فورد؛ لابد من تأميمها وتنقيتها. وهذا ما سوف تفعله الاشتراكية.
“لكن ماذا عن رتابة العمل، الذي أفقده الناقل شخصيته وروحه؟”، يسأل أحد الحاضرين. هذا السؤال ليس جديا. لأنه إذا فكرت فيه حتى النهاية وناقشته، فسوف تجد أنه موجه في المقام الأول ضد تقسيم العمل وضد الآلات بشكل عام. هذا طريق رجعي. لم يكن هناك أي شيء مشترك بين الاشتراكية وبين نزعة العداء للآلات، ولن يكون بينهما أي شيء مشترك. المهمة الأساسية والأكثر أهمية هي القضاء على الخصاص. من الضروري أن يعطي العمل البشري أكبر قدر ممكن من المنتجات. الخبز والأحذية والملابس والصحف، ويجب أن يتم إنتاج كل ما هو ضروري بكميات وافرة بحيث لا يخشى أحد أن يفتقر إليها. يجب أن نقضي على الخصاص، ومعه الجشع. يجب أن نحقق الرخاء، والراحة، ومعهما متعة الحياة للجميع. لا يمكن تحقيق إنتاجية عالية للعمل بدون المكننة والأتمتة، والتي يمثل الناقل تعبيرهما النهائي. سيتم تعويض رتابة العمل من خلال تقصير مدته وسهولته المتزايدة. سوف تكون للمجتمع دوما فروع صناعية تتطلب الإبداع الفردي؛ وهذا هو المكان الذي سوف يتوجه إليه أولئك الذين يجدون في الإنتاج متعتهم. ونحن نتحدث بطبيعة الحال عن أبسط أشكال الإنتاج في فروعه الأكثر أهمية، إلى أن تطيح الثورات الكيميائية والطاقة الجديدة في التكنولوجيا بأشكال المكننة الحالية. لكننا سوف نترك للمستقبل أن يقلق بشأن هذا الأمر. إن السفر في قارب تجديف يتطلب قدرا عظيما من الإبداع الشخصي، أما السفر على متن سفينة بخارية فهو “أكثر رتابة”، لكنه أكثر راحة وموثوقية. فضلا عن ذلك فإنك لن تتمكن حقا من عبور المحيط في قارب تجديف. ولابد لنا أن نعبر محيطا من الاحتياجات البشرية.
يعلم الجميع أن الاحتياجات المادية محدودة إلى حد كبير مقارنة بالاحتياجات الروحية. إن الإشباع المفرط للاحتياجات المادية يؤدي بسرعة إلى الشبع. أما الاحتياجات الروحية فلا تعرف حدودا. لكن ولكي تزدهر الاحتياجات الروحية، فإن الإشباع الكامل للاحتياجات المادية أمر ضروري. لا يمكننا، بطبيعة الحال، ولا ينبغي لنا، تأجيل النضال من أجل رفع المستوى الروحي للجماهير إلى أن يتم القضاء نهائيا على البطالة أو التشرد أو الفقر. كل ما يمكن القيام به، يجب القيام به. لكن من المؤسف والمثير للازدراء أن نعتقد أننا قادرون على خلق ثقافة جديدة حقيقية قبل أن نضمن الرخاء والوفرة والرفاه للجماهير الشعبية. إننا قادرون على أن نتحقق، وسوف نتحقق، من تقدمنا بقدر ما يتجلى في الحياة اليومية للعمال والفلاحين.
الثورة الثقافية
أعتقد أنه بات الآن واضحا للجميع أن خلق ثقافة جديدة ليست مهمة مستقلة تتم بمعزل عن عملنا الاقتصادي والبناء الاجتماعي أو الثقافي ككل. هل التجارة جزء من “الثقافة البروليتارية”؟ من وجهة نظر مجردة، لابد وأن نجيب على هذا السؤال بالنفي. لكن وجهة النظر المجردة لن تفي بالغرض هنا. ففي العصر الانتقالي، وعلاوة على ذلك في المرحلة الأولية التي نتواجد فيها، تتخذ المنتجات -وستظل تفعل ذلك لفترة طويلة- الشكل الاجتماعي للسلعة. لكن لابد من التعامل مع السلعة على النحو اللائق، أي لابد أن نتمكن من بيعها وشرائها. فبدون هذا لن ننتقل أبدا من المرحلة الأولية إلى المرحلة التالية. لقد قال لينين إننا لابد أن نتعلم التجارة، وأوصى بأن نتعلم من الأمثلة الثقافية الأوروبية. إن ثقافة التجارة، كما نعلم الآن جيدا، تشكل أحد أهم مكونات ثقافة الفترة الانتقالية. ولا أدري ما إذا كنا نستطيع أن نطلق على ثقافة التجارة المرتبطة بالدولة العمالية والتعاون اسم “الثقافة البروليتارية”. لكن لا جدال في أن هذه الثورة الثقافية تشكل خطوة نحو الثقافة الاشتراكية.
وعندما تحدث لينين عن الثورة الثقافية، رأى أن محتواها الأساسي هو رفع المستوى الثقافي للجماهير. إن النظام المتري هو نتاج العلم البرجوازي. لكن تعليم مائة مليون فلاح هذا النظام البسيط من المقاييس يعني إنجاز مهمة ثورية وثقافية عظيمة. ومن المستحيل تقريبا أن نحقق هذه المهمة بدون الجرار وبدون الطاقة الكهربائية. إن أساس الثقافة هو التكنولوجيا. والأداة الحاسمة للثورة الثقافية لابد وأن تكون الثورة في التكنولوجيا.
فيما يتعلق بالرأسمالية، نقول إن تطور القوى المنتجة مقيد بسبب الأشكال الاجتماعية للدولة البرجوازية والملكية البرجوازية. وبعد أن قمنا بالثورة البروليتارية، نقول إن تطور الأشكال الاجتماعية مقيد بسبب تخلف القوى المنتجة، أي التكنولوجيا. والحلقة الكبرى في السلسلة، التي إذا أمسكنا بها سيمكننا أن ننتج الثورة الثقافية، هي حلقة التصنيع، لكنها ليست حلقة الأدب أو الفلسفة بأي حال من الأحوال. إنني آمل ألا يُفهَم هذا الكلام على أنه موقف سيء النية أو غير محترم تجاه الفلسفة والشعر. فبدون تعميم الفكر وبدون الفن ستكون الحياة البشرية فقيرة ومقفرة. لكن هذه هي الحياة الآن إلى حد كبير بالنسبة لملايين البشر. ولابد أن تتألف الثورة الثقافية من توفير الإمكانية التي تمكنهم من الوصول إلى الثقافة حقا، وليس فقط بقاياها. إلا أن هذا مستحيل دون خلق أعظم الشروط المادية. ولهذا السبب فإن الآلة التي تنتج القنينات الزجاجية آليا تشكل بالنسبة لنا في الوقت الحاضر عاملا من الدرجة الأولى في الثورة الثقافية، في حين أن القصيدة البطولية ليست سوى عامل من الدرجة العاشرة.
لقد قال ماركس ذات يوم إن الفلاسفة قد فسروا العالم بشكل كاف، وأن المهمة الآن هي قلبه رأسا على عقب. لم يكن في هذه الكلمات أي نقص في الاحترام تجاه الفلسفة. فقد كان ماركس نفسه واحدا من أقوى الفلاسفة على مر العصور. لقد كانت كلماته تعني ببساطة أن المزيد من تطوير الفلسفة، والثقافة ككل، سواء المادية أو الروحية، يتطلب ثورة في العلاقات الاجتماعية. ولهذا السبب اتجه ماركس من الفلسفة إلى الثورة البروليتارية ، وذلك ليس ضد الفلسفة، بل لصالحها. وبنفس المعنى، يمكننا أن نقول الآن: إنه لأمر جيد أن يغني الشعراء عن الثورة والبروليتاريا؛ لكن الأمر سيكون أفضل عندما يغني توربين قوي. لدينا العديد من الأغاني ذات القيمة المتوسطة التي تظل ملكا للحلقات الصغيرة، في حين لدينا عدد قليل جدا من التوربينات. لا أريد أن أقول بهذا إن القصائد المتوسطة تعوق ظهور التوربينات. كلا، لا يمكن أن نجزم بمثل هذا. لكن التوجيه الصحيح للرأي العام، أي فهم الارتباط الحقيقي بين الظواهر -الأسباب والحيثيات- ضروري تماما. علينا أن نفهم الثورة الثقافية ليس بطريقة مثالية سطحية ولا بروح الحلقات الصغيرة. نحن نتحدث عن تغيير ظروف الحياة، وأساليب العمل والعادات اليومية لشعب عظيم، ولمجموعة واسعة من الشعوب. فقط نظام قوي من الجرارات يسمح لأول مرة في التاريخ للفلاح بأن يقف منتصبا؛ ووحدها آلة نفخ الزجاج التي تنتج مئات الآلاف من القنينات الزجاجية وتحرر رئتي نافخي الزجاج؛ ووحدها توربينات بقوة عشرات ومئات الآلاف من الأحصنة؛ وكذلك طائرات في متناول الجميع؛ هذه الأشياء مجتمعة هي وحدها التي ستضمن الثورة الثقافية، ليس للأقلية بل للجميع. إن هذا النوع من الثورة الثقافية وحده هو الذي يستحق هذا الاسم. وعلى أساسه فقط ستبدأ فلسفة جديدة وفن جديد في الازدهار.
قال ماركس: «إن الأفكار السائدة في عصر ما هي أفكار الطبقة السائدة في ذلك العصر». وهذا صحيح أيضا فيما يتعلق بالبروليتاريا، لكن بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تنطبق بها على الطبقات الأخرى. فبعد استيلاء البرجوازية على السلطة، حاولت إدامة تلك السلطة. وكانت ثقافتها بأكملها موجهة لخدمة هذا الغرض. لكن البروليتاريا بعد استيلاءها على السلطة لابد وأن تسعى جاهدة إلى تقصير فترة حكمها قدر الإمكان، من خلال الاقتراب من المجتمع الاشتراكي الخالي من الطبقات.
ثقافة الأخلاق
ممارسة التجارة بطريقة مثقفة تعني، من بين أمور أخرى، عدم الخداع، أي قطع الصلة مع تقاليدنا التجارية الوطنية القائمة على: “إذا لم تخدع فلن تبيع”. إن الكذب والخداع ليسا مجرد عيب شخصي، بل إنهما وظيفة (أو فعل) من وظائف النظام الاجتماعي. الكذب وسيلة للصراع، وبالتالي فهو ينبع من تناقض المصالح. والتناقضات الأكثر أساسية تنبع من العلاقات الطبقية. يمكننا، بالطبع، أن نقول إن الخداع أقدم من المجتمع الطبقي. حتى الحيوانات تظهر “المكر” والخداع في صراعها من أجل البقاء. وقد لعب الخداع -المكر العسكري- دورا لا يستهان به في حياة القبائل البدائية. كان ذلك الخداع ينبع بشكل أو بآخر من الصراع الحيواني من أجل البقاء. لكن منذ اللحظة التي ظهر فيها المجتمع “المتحضر”، أي المجتمع الطبقي، أصبح الكذب أكثر تعقيدا بشكل رهيب، وتحول إلى وظيفة اجتماعية، وانقسم على أسس طبقية وأصبح أيضا جزءا من “ثقافة” الإنسان. لكن هذا هو الجزء من الثقافة الذي لن تقبله الاشتراكية. ستكون العلاقات في المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي، أي في أعلى مراحل تطور المجتمع الاشتراكي، شفافة تماما ولن تتطلب مثل تلك الأساليب المساعدة مثل الخداع والكذب والتزوير والتزييف والخيانة والغدر.
لكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تلك المرحلة. ما يزال هناك في علاقاتنا وأخلاقنا الكثير من الأكاذيب التي تتجذر في كل من نظام القنانة والنظام البرجوازي. والدين هو أعلى تعبير عن أيديولوجية القنانة. كانت العلاقات في المجتمع الإقطاعي الملكي مبنية على التقاليد العمياء، وارتقت إلى مستوى الأسطورة الدينية. والأسطورة هي التفسير الخيالي الزائف للظواهر الطبيعية والمؤسسات الاجتماعية في ترابطها. ولكن ليست الجماهير المخدوعة، أي المضطهَدة، هي وحدها التي كانت تؤمن بالأسطورة، بل وأيضا أولئك الذين تم الخداع باسمهم -أي الحكام- كانوا يؤمنون بها في أغلب الأحيان ويعتمدون عليها بضمير مرتاح. إن الأيديولوجية الزائفة موضوعيا، والتي تقوم على الخرافات، لا تعني بالضرورة كذبا ذاتيا. فقط إلى الحد الذي تصبح فيه العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيدا، أي إلى الحد الذي يتطور فيه النظام الاجتماعي البرجوازي، والذي تدخل الأسطورة الدينية في تناقض متزايد معه، يصبح الدين مصدرا لمكر متزايد وخداع أكثر اتقانا.
إن الأيديولوجية البرجوازية المتطورة أيديولوجية عقلانية وموجهة ضد الأساطير. لقد حاولت البرجوازية الراديكالية الاستغناء عن الدين وبناء دولة تقوم على العقل وليس التقاليد. وكان التعبير عن ذلك هو الديمقراطية بمبادئها المتمثلة في الحرية والمساواة والإخاء. لكن الاقتصاد الرأسمالي خلق تناقضا وحشيا بين الواقع اليومي وبين المبادئ الديمقراطية. فكان لابد من شكل من أشكال الكذب من الدرجة الأعلى لرأب ذلك التناقض. ولا يوجد مكان يكذب فيه الناس سياسيا أكثر من الديمقراطيات البرجوازية. وهذا لم يعد “كذبا” موضوعيا في الأساطير، بل خداعا منظما واعيا للشعب باستخدام أساليب مركبة ذات تعقيد غير عادي. إن تكنولوجيا الكذب لا تقل تطورا عن تكنولوجيا الكهرباء. والواقع أن الديمقراطيات الأكثر “تطورا”، فرنسا والولايات المتحدة، هي التي تمتلك الصحافة الأكثر خداعا.
ولكن في الوقت نفسه -وهذا ما يجب علينا أن نعترف به علنا- فإنهم في فرنسا يتاجرون بأمانة أكبر منا، وهم في كل الأحوال يولون اهتماما أكبر بما لا يقاس بالمشتري. إن البرجوازية، بعد أن بلغت مستوى معينا من الرفاهية، تتخلى عن أساليب الاحتيال التي مارستها خلال مرحلة التراكم الأولي، ليس انطلاقا من أي اعتبارات أخلاقية مجردة، بل لأسباب مادية: فالخداع التافه والتزوير والجشع يفسد سمعة المؤسسة ويهدد مستقبلها. إن مبادئ التجارة “الصادقة”، التي تنبع من مصالح التجارة ذاتها عند مستوى معين من تطورها، تدخل في الأخلاق، وتتحول إلى قواعد “أخلاقية” وتخضع لسيطرة الرأي العام. صحيح أن الحرب الإمبريالية أدخلت في هذا المجال أيضا تغييرات هائلة، وأعادت أوروبا إلى الوراء. لكن جهود “الاستقرار” التي بذلتها الرأسمالية بعد الحرب تغلبت على أقبح أشكال الخبث في التجارة. وعلى أية حال، إذا نظرنا إلى تجارتنا السوفياتية ككل، أي من المصنع إلى المستهلك في القرية البعيدة، فلابد وأن نقول إننا نتاجر بطريقة أقل ثقافة بكثير من البلدان الرأسمالية المتقدمة. وهذا ينبع من فقرنا، ومن نقص السلع، ومن تخلفنا الاقتصادي والثقافي.
إن نظام الدكتاتورية البروليتارية معاد بشكل لا يقبل المساومة للأساطير الزائفة موضوعيا الموروثة عن العصور الوسطى وللخداع الواعي للديمقراطية الرأسمالية. إن النظام الثوري مهتم بشكل حيوي بكشف العلاقات الاجتماعية بدلا من إخفائها. وهذا يعني أنه مهتم بالصدق السياسي، وبقول ما هو موجود. لكن يجب ألا ننسى أن نظام الدكتاتورية الثورية هو نظام انتقالي، وبالتالي فهو نظام متناقض. إن وجود أعداء أقوياء يجبرنا على استخدام المكر العسكري، والمكر لا ينفصل عن الكذب. إن حاجتنا الوحيدة هي ألا يؤدي المكر المستخدم في النضال ضد أعدائنا إلى تضليل شعبنا، أي الجماهير الكادحة وحزبها. وهذا مطلب أساسي للسياسة الثورية يمكن رؤيته في جميع أعمال لينين.
لكن وبينما تخلق دولتنا الجديدة وأشكالنا الاجتماعية الجديدة إمكانية وضرورة درجة أكبر من الصدق لم يتم تحقيقها من قبل بين الحكام والمحكومين، فإنه لا يمكننا أن نقول نفس الشيء عن علاقاتنا في الحياة اليومية المشتركة؛ إننا نعيش في عالم اليوم، حيث يفرض تخلفنا الاقتصادي والثقافي -وبصورة عامة ما ورثناه من الماضي- ضغوطا هائلة. إننا نعيش حياة أفضل كثيرا مما كنا عليه في عام 1920. ولكن النقص في أكثر الحاجيات الضرورية في الحياة ما يزال يترك آثاره على حياتنا وعلى أخلاقنا، وسوف يستمر في ترك آثاره لسنوات عديدة قادمة. ومن هنا تنبع التناقضات الكبيرة والصغيرة، والتفاوتات الكبيرة والصغيرة، والصراع المرتبط بالتناقضات، والمكر والأكاذيب والخداع المرتبط بالصراع. وهنا أيضا لا يوجد سوى مخرج واحد: رفع مستوى تكنولوجيتنا، سواء في الإنتاج أو في التجارة. ولابد أن يساهم التوجه الصحيح على هذا النحو في حد ذاته في تحسين “أخلاقنا”. والتفاعل بين التكنولوجيا الصاعدة والأخلاق من شأنه أن يدفعنا على طول الطريق إلى بناء صرح اجتماعي من المتعاونين المتحضرين، أي إلى ثقافة اشتراكية.
ترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسي
هوامش:
[1] فاموسوف هو الشخصية الرئيسية في مسرحية غريبويدوف “نقمة الذكاء” (1824). وهو بيروقراطي وصولي رفيع المستوى في موسكو، يتودد بشكل خاص إلى رؤسائه، بينما يتصرف بغطرسة مع مرؤوسيه. وباعتباره محافظا متشددا، فإنه لا يخشى شيئا أكثر من الإبداع و“الفكر الحر”. وقد استخدم لينين هذه الإشارة في فقرة مثيرة للاهتمام: «إن الفاموسوفيين من أعضاء حزبنا ليسوا ضد لعب دور المقاتلين الشرسين الحازمين من أجل الماركسية، لكن عندما يتعلق الأمر بالمحسوبية الفئوية، تجدهم ليسوا ضد التمويه على أخطر التراجعات عن الماركسية!».
(V. I. Lenin, “From the Editors,” PSS, vol. 17, p.185) [Ashukin & Ashukina, Krylatye slova, M., 1986, p.657].
[2] إن تطوير فرويدية مزعومة تقوم على الإفراط في الانغماس في الشهوة الجنسية أو التهتك، ليست له بطبيعة الحال أية علاقة بهذه المسألة. إن مثل هذا التلاعب بالألفاظ لا علاقة له بالعلم، ولا يمثل سوى عقليات منحطة: حيث ينتقل مركز الثقل من المخ إلى النخاع الشوكي… (ليون تروتسكي).
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية