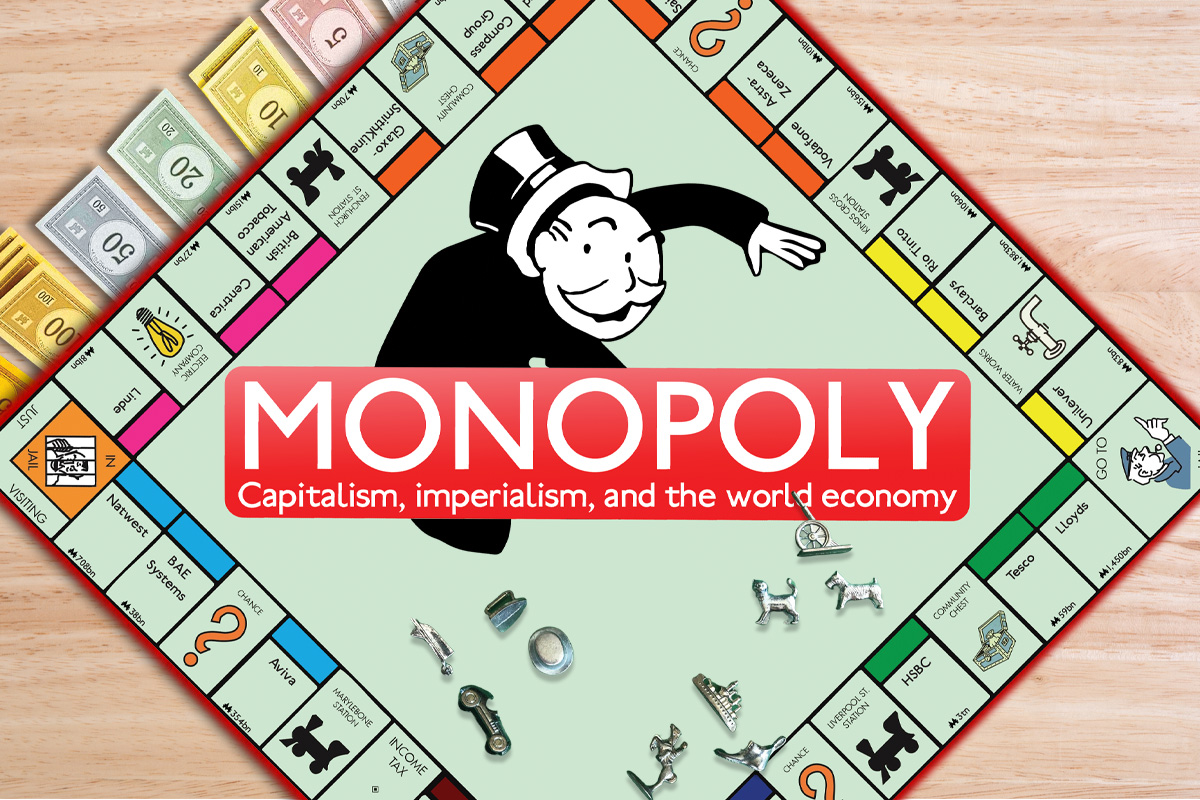انتهت سنة 2016 بحادثتين مأساويتين ودمويين إضافيتين: اغتيال السفير الروسي في اسطنبول والقتل الوحشي لأناس في برلين كانوا يستمتعون بسلام بالاستعدادات لعيد الميلاد. وقد تم ربط هذه الأحداث بالمستنقع الدموي في منطقة الشرق الأوسط وبسوريا تحديدا.
شكل سقوط حلب منعطفا حاسما في الوضع. روسيا، التي كان من المفترض أنه قد تم عزلها وإخضاعها من طرف “المجتمع الدولي” (إقرأ: واشنطن)، تسيطر الآن على سوريا وتقرر ما يحدث هناك. لقد دعت لمؤتمر للسلام في كازاخستان لم تستدع إليه لا الأميركيين ولا الأوروبيين، أعقبه اتفاق لوقف اطلاق النار بشروط أملتها روسيا.
لقد عبرت هذه التطورات عن نفس الظاهرة، وإن بطرق مختلفة، وهي أن النظام العالمي القديم قد مات وفي مكانه نواجه مستقبلا من عدم الاستقرار والصراعات، والتي لا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجتها. وبالتالي فإن عام 2016 مثل نقطة تحول في التاريخ. لقد كانت سنة تميزت بالأزمة والاضطراب على نطاق عالمي.
قبل خمس وعشرين سنة، عندما سقط الاتحاد السوفياتي، كان المدافعون عن الرأسمالية مبتهجين. لقد تحدثوا عن موت الاشتراكية والشيوعية وحتى نهاية التاريخ. وعدونا بمستقبل من السلام والازدهار بفضل انتصار اقتصاد السوق الحرة والديمقراطية.
لقد انتصرت الليبرالية وبذلك وجد التاريخ تعبيره النهائي في الرأسمالية. هذا هو المعنى الجوهري لعبارة فرانسيس فوكوياما السيئة الذكر. ولكن الآن ها هي عجلة التاريخ قد دارت دورة كاملة. اليوم لم يبق حجر على حجر في تلك التنبؤات الواثقة لمنظري الرأسمالية. لقد عاد التاريخ لينتقم.
فجأة ظهر أن العالم يعاني من ظواهر غريبة وغير مسبوقة تتحدى جميع محاولات الخبراء السياسيين لشرحها. يوم 23 يونيو صوت الشعب البريطاني في استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتوقعه أحد، وتسبب في موجات صدمة على نطاق عالمي. لكن ذلك لم يكن شيئا بالمقارنة مع التسونامي الناجمة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي لم يكن أحد يتوقع نتيجتها، بمن في ذلك الرجل الذي فاز بها.
بعد ساعات قليلة على انتخاب دونالد ترامب، امتلأت شوارع المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالمتظاهرين. تلك الأحداث تأكيد مطلق لحالة عدم الاستقرار التي يعاني منها العالم بأسره. فبين عشية وضحاها اختفت الثوابت القديمة. هناك سخط عام في المجتمع وشعور بعدم اليقين على نطاق واسع، يشغل بال الطبقة الحاكمة ومنظريها بقلق عميق.
يشتكي المدافعون عن الليبرالية الرأسمالية بمرارة من صعود سياسيين مثل دونالد ترامب الذي يمثل نقيض ما يعرف باسم “القيم الليبرالية.” بالنسبة لمثل هؤلاء الناس بدا عام 2016 وكأنه كابوس. يأملون أنهم سيستيقظون ويجدون أن كل ذلك كان مجرد حلم، أن يوم أمس سيعود وأن غدا سيكون يوما أفضل. لكن لن تكون هناك صحوة ولا غد بالنسبة لليبرالية البرجوازية.
يتكلم المعلقون السياسيون بخوف عن صعود شيء يسمونه “الشعبوية”، والتي هي كلمة فضفاضة بقدر ما هي بدون معنى. إن استخدام مثل هذه المصطلحات الغامضة يعني فقط أن أولئك الذين يستخدمونها ليست لديهم أي فكرة عما يتحدثون عنه. ليست الشعبوية، من الجانب الاشتقاقي المحض، إلا مجرد ترجمة لاتينية للكلمة اليونانية Demagogy (ديماغوجيا). ويتم استخدام هذا المصطلح بنفس الطريقة التي يقوم بها رسام سيء بتغطية جدار بطبقة سميكة من الطلاء لإخفاء أخطائه. فهو مصطلح يستخدم لوصف طائفة واسعة من الظواهر السياسية حتى أصبح خاليا تماما من أي مضمون حقيقي.
فقادة حزب بوديموس وغيرت فيلدرز وياروسلاف كاتشينسكي وإيفو موراليس ورودريغو ديتيرت وهوغو شافيز وجيريمي كوربين ومارين لوبان، جميعهم ملطخون بنفس الفرشاة الشعبوية. ويكفي أن نقارن المحتوى الحقيقي لهذه الحركات، التي لا تختلف عن بعضها البعض فحسب، بل هي معادية لبعضها جذريا، لكي نفهم العقم المطلق لهذه اللغة. إن هدفها ليس التوضيح بل التشويش، أو بعبارة أصح إخفاء تيهان المحللين السياسيين البرجوازيين الأغبياء.
موت الليبرالية
في افتتاحيتها، لعدد يوم 24 دجنبر 2016، أنشدت صحيفة الإيكونوميست ترنيمة الثناء على الليبرالية العزيزة على قلبها. يقال لنا فيه إن الليبراليين يؤمنون بـ «الاقتصادات المفتوحة والمجتمعات المفتوحة، حيث يتم تشجيع التبادل الحر للسلع ورأس المال وتواصل الناس والأفكار، وحيث تتم حماية الحريات العامة، بحكم القانون، من سوء المعاملة من طرف الدولة». تستحق هذه الكلمات الجميلة حقا أن تلحن.
لكن بعد ذلك يخلص المقال بحزن إلى أن 2016 «كانت سنة من النكسات. ليس فقط بسبب البريكست (Brexit) وانتخاب دونالد ترامب، ولكن أيضا بسبب مأساة سوريا، التي تُركت وحدها لمعاناتها، والدعم الواسع النطاق في المجر وبولندا وغيرهما “للديمقراطيات غير الليبرالية”. وبينما أصبحت العولمة مجرد وهم، فإن النزعات القومية وحتى السلطوية ازدهرت. في تركيا أعقبت الانقلاب الفاشل حملة انتقامية وحشية (واسعة النطاق). وفي الفلبين اختار الناخبون الرئيس الذي لم يعمل فقط على نشر فرق الموت، بل وتفاخر بالضغط على الزناد. في حين تصر كل من روسيا، التي اخترقت الديمقراطية الغربية، والصين، التي قامت في الأسبوع الماضي بالتهكم من الولايات المتحدة عن طريق الاستيلاء على واحدة من غواصاتها، على أن الليبرالية مجرد غطاء للتوسع الغربي».
انتهت ترنيمة الثناء الجميلة على القيم الليبرالية والغربية بنغمة حزينة. حيث اختتمت الإيكونوميست بمرارة: «في مواجهة مع هذا فقد الكثير من الليبراليين (من أنصار السوق الحرة) أعصابهم. وقد كتب بعضهم المرثيات عن النظام الليبرالي وأصدروا تحذيرات من المخاطر التي تواجه الديمقراطية. بينما يرى آخرون أنه بإجراء تعديل بسيط لقانون الهجرة أو رسوم جمركية إضافية، ستعود الحياة ببساطة إلى وضعها الطبيعي».
لكن الحياة لن “تعود ببساطة إلى وضعها الطبيعي”، أو بعبارة أصح سوف ندخل مرحلة جديدة مما يسميه الاقتصاديون بأنه “الوضع الطبيعي الجديد”: مرحلة من الاقتطاعات التي لا نهاية لها والتقشف وانخفاض مستويات المعيشة. ونحن في الواقع نعيش في هذا الوضع الطبيعي الجديد منذ مدة. وهو الوضع الذي تترتب عنه عواقب وخيمة جدا.
لقد خلقت الأزمة العالمية للرأسمالية ظروفا تختلف تماما عن الظروف التي كانت سائدة (على الأقل بالنسبة لعدد قليل من البلدان الغنية) خلال الأربعة عقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. شهدت تلك الفترة أكبر تطور لقوى الإنتاج شهدته الرأسمالية منذ الثورة الصناعية. كانت تلك هي التربة التي مكنت الكثير من مزاعم “القيم الليبرالية” من أن تزدهر. وقد وفر الازدهار الاقتصادي للرأسماليين أرباحا كافية لتقديم تنازلات للطبقة العاملة.
كان ذلك هو العصر الذهبي للإصلاحية. لكن المرحلة الحالية ليست عصر الإصلاحات، بل عصر تدمير الإصلاحات. ليس هذا نتيجة لدوافع أيديولوجية، كما يتصور بعض الإصلاحيين الحمقى، بل النتيجة الحتمية لأزمة النظام الرأسمالي الذي وصل إلى أقصى حدوده. وكل السيرورة التي حدثت على مدى الستة عقود الماضية تسير الآن في الاتجاه المعاكس.
بدلا من الإصلاحات وارتفاع مستويات المعيشة تواجه الطبقة العاملة في كل مكان الاقتطاعات والتقشف والبطالة والفقر. يقع تدهور ظروف العمل والأجور والحقوق والمعاشات على كاهل أفقر وأضعف فئات المجتمع وتتآكل فكرة المساواة للنساء بسبب السعي الوحشي لزيادة الربحية ويتم حرمان جيل كامل من الشباب من المستقبل. هذا هو جوهر المرحلة الحالية.
لحظة ماري أنطوانيت بالنسبة للنخبة
تجد الطبقة الحاكمة ومنظروها صعوبة في قبول حقيقة الوضع الحالي وهم عاجزون تماما عن رؤية العواقب السياسية التي تترتب عنه. يمكننا ملاحظة نفس العمى عند كل طبقة حاكمة تواجه خطر الانهيار لكنها ترفض أن تتقبل ذلك. وكما قال لينين بحق: لا يمكن للذي يقف على حافة الهاوية التفكير بعقل.
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالا مثيرا للاهتمام لوولفغانغ مونشو بعنوان: “لحظة ماري أنطوانيت بالنسبة للنخبة”. ويبدأ كما يلي:
«كان بالإمكان تجنب بعض الثورات لو أن الحرس القديم امتنعوا فقط عن القيام بالاستفزازات. لا يوجد أي دليل على صحة حادث “فليأكلوا الكعك”[1]، لكن هذا هو نوع الخطاب الذي كان يمكن لماري أنطوانيت أن تقوله، يبدو الحادث حقيقيا. كان من الصعب إقناع آل البوربون، مثلهم مثل مؤسساتهم المنفصلة عن الواقع.
صار لديهم الآن منافسون.
إن مؤسساتنا الديمقراطية الليبرالية العالمية تتصرف بنفس الطريقة. ففي الوقت الذي صوتت فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي وتم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتسير مارين لوبان نحو قصر الإليزيه، نستمر نحن – حراس النظام الليبرالي العالمي – في تعريض كل شيء للخطر».
المقارنة مع الثورة الفرنسية مفيدة للغاية. ففي كل مكان أعطت الطبقة الحاكمة و”خبراؤها” الدليل على انفصالهم الكلي عن الوضع الحقيقي في المجتمع. لقد افترضوا أن الوضع الذي نتج عن الازدهار الاقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب سيستمر إلى الأبد. وكأن اقتصاد السوق و”الديمقراطية” البرجوازية ثوابت العصر التي لا جدال فيها.
رضاهم عن النفس وغرورهم يشبه بالضبط سلوك ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا سيئة الحظ. ليس من المؤكد أنها قالت فعلا تلك العبارة الشهيرة، لكنها تعكس بدقة عقلية طبقة حاكمة منحطة لا تهتم لمعاناة الناس العاديين أو العواقب الحتمية التي تترتب عنها.
في النهاية فقدت ماري انطوانيت رأسها والآن ها هي الطبقة الحاكمة وممثلوها السياسيون يفقدون رؤوسهم بدورهم. يستمر مقال فاينانشال تايمز قائلا:
«لماذا يحدث هذا؟ يعتقد خبراء الاقتصاد الكلي أنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على تحدي سلطتهم. كان السياسيون الإيطاليون يمارسون ألاعيب السلطة منذ الأزل وكان عمل موظفي الاتحاد الأوروبي هو إيجاد سبل بارعة لإختطاف التشريعات والمعاهدات المعقدة سياسيا، وراء ظهر التشريعات الوطنية. وحتى مع زحف أمثال السيدة لوبان والسيد غريللو وغيرت فيلدرز اليميني المتطرف رئيس حزب الحرية الهولندي، نحو السلطة، ما زالت المؤسسات الرسمية تتصرف بنفس الطريقة. لو أن الأمر يتعلق بوصي على عرش آل البوربون، لكان في لحظة تفكير غير معهود من طرفه، قد تراجع إلى الوراء. لكن نظامنا الرأسمالي الليبرالي، مع مؤسساته المتنافسة، غير قادر دستوريا على القيام بذلك. إنه مبرمج على تعريض كل شيء للخطر.
إن المسار الصحيح للعمل سيكون هو التوقف عن إهانة الناخبين، والأهم هو حل مشاكل القطاع المالي الخارج عن السيطرة والتدفقات غير المتحكم فيها للناس ورأس المال والتفاوت في توزيع الدخل. في منطقة اليورو وجد القادة السياسيون أنه من المناسب تقديم حلول مرتجلة للأزمة المصرفية ومن ثم أزمة الديون السيادية – فقط ليجدوا أمامهم الديون اليونانية الضخمة والنظام المصرفي الإيطالي في ورطة خطيرة. وبعد ثماني سنوات ما يزال هناك مستثمرون يراهنون على انهيار منطقة اليورو كما نعرفها الآن».
في عام 1938 كتب تروتسكي أن الطبقة الحاكمة تتدحرج نحو الكارثة وأعينها مغمضة. والأسطر المذكورة أعلاه دليل واضح على هذه الحقيقة. ثم يصل السيد مونشو إلى الاستنتاج التالي:
«لكن هذا يحدث لنفس السبب مثلما كان الحال في فرنسا قبيل الثورة. فحراس الرأسمالية الغربية، مثلهم مثل آل البوربون قبلهم، لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا».
انهيار الوسط
إن الوعي البشري، وخلافا للأحكام المسبقة التي يتبناها الليبراليون، ليس تقدميا بل محافظ بشكل عميق. معظم الناس لا يحبون التغيير، إنهم يتمسكون بعناد بالأفكار القديمة والأحكام المسبقة والدين والأخلاق، لأنها مألوفة، والشيء المألوف هو دائما مريح أكثر من الشيء غير المألوف. فكرة التغيير مخيفة لأنها تعني المجهول. تتجذر هذه المخاوف عميقا في النفس البشرية، وكانت موجودة منذ القدم.
إلا أن التغيير ضروري لبقاء الجنس البشري مثلما هو ضروري لبقاء الفرد. إن غياب التغيير هو الموت. جسم الإنسان يتغير باستمرار منذ لحظة الولادة؛ جميع الخلايا تتحطم وتموت وتستبدل بخلايا جديدة. ويجب أن يختفي الطفل لكي يسمح للبالغ بأن يبرز.
ومع ذلك، ليس من الصعب أن نفهم كره الناس للتغيير. فالعادة والروتين والتقاليد، كل هذه الأشياء ضرورية للحفاظ على المعايير الاجتماعية التي تعزز عمل المجتمع. وعلى مدى فترة طويلة تصبح متأصلة، تكيف الأنشطة اليومية لملايين الرجال والنساء. وتصير مقبولة من الجميع، مثل احترام القوانين والأعراف وقواعد الحياة السياسية والمؤسسات القائمة، أو بعبارة واحدة: الوضع القائم.
يوجد شيء مماثل لهذا في العلم. في دراسته العميقة “بنية الثورات العلمية” يشرح توماس.س. كون، كيف أن كل مرحلة من مراحل تطور العلوم تستند إلى نموذج قائم يتم قبوله بشكل عام، يوفر الإطار اللازم للعمل العلمي. وطيلة فترة طويلة يقدم ذلك النموذج خدمة مفيدة. لكن في نهاية المطاف تظهر تناقضات صغيرة وتافهة، على ما يبدو، تؤدي في النهاية إلى سقوط النموذج القديم واستبداله بآخر جديد. يشكل هذا، وفقا لكون، جوهر الثورة العلمية.
تحدث نفس السيرورة الجدلية بالضبط في المجتمع. فالأفكار التي وجدت لفترة طويلة بحيث أنها تحولت إلى أحكام مسبقة، تدخل في نهاية المطاف في صراع مع الواقع القائم. عند هذه النقطة تبدأ في الحدوث ثورة في الوعي. يبدأ الناس في التشكيك فيما كان يبدو وكأنه لا يرقى إليه الشك. وتتحطم الأفكار التي كانت مريحة، لأنها كانت توفر اليقين، على صخرة الواقع الصعب. ولأول مرة يبدأ الناس في التخلص من أوهامهم المريحة القديمة ويبدأون في النظر إلى الواقع في وجهه.
إن السبب الحقيقي لمخاوف الطبقة الحاكمة هو انهيار الوسط السياسي. ما نشهده في بريطانيا والولايات المتحدة واسبانيا والعديد من البلدان الأخرى هو الاستقطاب الحاد والمتزايد بين اليمين واليسار في السياسة، والذي ليس بدوره سوى انعكاس لتزايد الاستقطاب بين الطبقات. وهذا بدوره انعكاس للأزمة التي هي الأعمق في تاريخ الرأسمالية.
على مدى القرن الأخير استند النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية على حزبين اثنين: الديمقراطيون والجمهوريون، واللذان يدافعان معا عن الحفاظ على الرأسمالية، وكلاهما يمثل مصالح البنوك والشركات التجارية الكبرى. عبر غور فيدال عن ذلك بشكل جيد عندما قال: «جمهوريتنا لديها حزب واحد، حزب الملكية الخاصة، بجناحين يمينيين».
كان هذا هو الأساس المتين لاستقرار واستمرارية ما يعتبره الأمريكيون “الديمقراطية”. ليست هذه الديمقراطية البرجوازية، في الواقع، سوى ورقة تين لإخفاء حقيقة دكتاتورية أصحاب الأبناك والرأسماليين. والآن يتعرض هذا الوضع المريح للتحديات والرجات حتى النخاع. ملايين الناس يستيقظون على تعفن المؤسسات السياسية الرسمية وحقيقة أنهم خدعو من قبل أولئك الذين يدعون تمثيلهم. هذا هو الشرط المسبق للثورة الاجتماعية.
أزمة الإصلاحية
نرى وضعا مماثلا في بريطانيا، حيث طيلة 100 سنة تناوب حزب العمال والمحافظون على السلطة، ووفرا نفس النوع من الاستقرار للطبقة الحاكمة. كان حزب العمال وحزب المحافظين يسيران من طرف فئة صلبة من الرجال والنساء المحترمين والذين يمكن الاعتماد عليهم لتسيير المجتمع في مصلحة البنوك والرأسماليين من مدينة لندن. لكن انتخاب جيريمي كوربين قلب الطاولة.
تخشى الطبقة الحاكمة من أن تدفق أعداد كبيرة من الأعضاء الجدد على حزب العمال قد يكسر قبضة اليمين على الحزب. وهذا ما يفسر حالة الذعر التي أصابت الطبقة الحاكمة والطبيعة الشرسة للحملة ضد كوربين.
أزمة الرأسمالية هي أيضا أزمة الإصلاحية. منظرو الرأسمال يشبهون آل البوربون، لكن القادة الإصلاحيين ليسو سوى تقليد رديء للأولين. إنهم صم عمي. لا يمتلك الإصلاحيون، بكل تنويعاتهم اليمينية واليسارية، أي فهم للوضع الحقيقي، وعلى الرغم من أنهم يمدحون أنفسهم بأنهم واقعيون كبار، فإنهم أسوء أنواع الطوباويين.
الإصلاحيون مثلهم مثل الليبراليين، رغم أنهم ليسو سوى انعكاس شاحب لهم، متلهفون لعودة الماضي الذي اختفى بدون رجعة. إنهم يشتكون بمرارة من ظلم الرأسمالية، دون أن يدركوا أن سياسات البرجوازية تمليها الضرورة الاقتصادية للرأسمالية نفسها.
من سخرية التاريخ أن الإصلاحيين قد تبنوا بالكامل اقتصاد السوق في نفس الوقت بالضبط الذي بدأ يتحطم أمام أعيننا. قبلوا بالرأسمالية كشيء معطى مرة وإلى الأبد، لا يمكن التشكيك فيها، وبالتأكيد لا يمكن إسقاطها. إن واقعية الإصلاحيين المزعومة هي واقعية رجل يحاول إقناع النمر أن يأكل العشب بدلا من اللحم البشري. لكن ذلك الواقعي الذي حاول أداء هذا العمل الفذ الجدير بالثناء لم ينجح، بطبيعة الحال، في إقناع النمر وانتهى به الأمر داخل بطنه.
ما لا يفهمه الإصلاحيون هو أنه إذا كنت تقبل بالرأسمالية فيجب عليك أن تقبل أيضا بقوانين الرأسمالية. وهذا يعني، في ظل الظروف الحالية، قبول الاقتطاعات والتقشف. ليس هناك من دليل على إفلاس الإصلاحية التام أوضح من حقيقة أنهم لم يعودوا يتحدثون عن الاشتراكية ولا يتحدثون عن الرأسمالية، وبدلا من ذلك يشتكون من شرور “النيو ليبرالية”، وهذا يعني أنهم لا يعترضون على الرأسمالية في حد ذاتها، بل فقط على شكل معين للرأسمالية. لكن ما يسمى بالنيوليبرالية مجرد كناية عن الرأسمالية في مرحلة الأزمة.
الإصلاحيون، الذين يتخيلون أنهم واقعيون كبار، يحلمون بالعودة إلى أوضاع الماضي في حين أن ذلك الماضي قد اختفى في غياهب التاريخ. إن المرحلة التي تنفتح الآن أمامنا ستكون مختلفة تماما. خلال العقود التي تلت عام 1945، تراجع الصراع الطبقي في البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى حد ما نتيجة للإصلاحات التي حققتها الطبقة العاملة بواسطة النضال.
لقد أوضح تروتسكي منذ زمن طويل أن الخيانة صفة ضمنية في الإصلاحية بجميع أنواعها. لم يكن يعني بهذا أن الإصلاحيين يخونون الطبقة العاملة بوعي. هناك العديد من الإصلاحيين الشرفاء، فضلا عن عدد لا بأس به من الوصوليين الفاسدين، لكن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة. إذا كنت تقبل بالنظام الرأسمالي – كما يفعل كل الإصلاحيين، سواء اليمينين أو اليساريين، يجب عليك بالتالي أن تطيع قوانين النظام الرأسمالي. وفي مرحلة الأزمة الرأسمالية هذا يعني حتمية الاقتطاعات والهجمات على مستويات المعيشة.
هذا هو الدرس الذي يجب تعلمه من تجربة تسيبراس وفاروفاكيس في اليونان. لقد وصلا إلى السلطة بدعم شعبي كبير على أساس برنامج مكافحة التقشف، لكن سرعان ما فهما على يد ميركل وشويبله أن ذلك لم يكن على جدول الأعمال، وفي نهاية المطاف استسلما وطبقا بخنوع برنامج التقشف الذي أملته برلين وبروكسل. وقد شاهدنا حالة مماثلة لذلك في فرنسا حيث حقق هولاند نصرا انتخابيا كبيرا واعدا بتطبيق برنامج مضاد للتقشف، ثم انقلب بدوره 180 درجة ونفذ سياسة اقتطاعات أعمق حتى من الحكومة اليمينية السابقة. وكانت النتيجة الحتمية هي صعود مارين لوبان والجبهة الوطنية.
الرأسمالية في طريق مسدود
في بلدان مثل الولايات المتحدة، كان في إمكان كل جيل منذ الحرب العالمية الثانية، أن يتطلع إلى مستوى معيشي أفضل من ذلك الذي تمتع به آباؤه. خلال عقود الازدهار الاقتصادي أصبح العمال معتادين على الانتصارات السهلة نسبيا. لم يكن القادة النقابيون مضطرين للنضال كثيرا للحصول على زيادات في الأجور. واعتبرت الإصلاحات هي القاعدة. كان اليوم أفضل من الأمس والغد سيكون أفضل من اليوم.
خلال فترة الازدهار الرأسمالي الطويلة، تراجع الوعي الطبقي للعمال إلى حد ما. وبدلا من سياسات اشتراكية حازمة وواضحة، تلوثت الحركة العمالية بالأفكار الغريبة عنها من خلال قناة البرجوازية الصغيرة التي دفعت العمال إلى الهامش وأخرست صوتهم بالخطب الحادة للراديكالية البرجوازية الصغيرة.
وتدريجيا صار ما يسمى بالاعتدال السياسي، مع فتات الأفكار نصف المطهوة التي انتشلت من مزبلة الليبرالية البرجوازية، يصبح مقبولا حتى في النقابات حيث التقطه القادة الإصلاحيون اليمينيون بلهفة كبديل عن السياسات الطبقية والأفكار الاشتراكية. وقد لعب الإصلاحيون اليساريون على وجه الخصوص دورا خبيثا في هذا الصدد. وسوف يتطلب الأمر ضربات مطرقة الأحداث لهدم هذه الأحكام المسبقة التي لها تأثير هدام على الوعي.
لكن أزمة الرأسمالية لا تسمح بمثل هذا الترف. اليوم سيواجه جيل من الشباب لأول مرة ظروفا أسوأ من الحياة التي عاشها آبائهم. وتدريجيا يتغلغل هذا الواقع الجديد في وعي الجماهير. هذا هو سبب تصاعد الاستياء الحاد الموجود في جميع البلدان، والذي صار يكتسي طابعا متفجرا. وهو ما يفسر الزلازل السياسية التي حدثت في بريطانيا واسبانيا واليونان وإيطاليا والولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى. إنها تنبيه إلى إعداد شروط تطورات ثورية.
صحيح أن الحركة في هذه المرحلة تتميز بارتباك هائل. كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، في الوقت الذي تحولت فيه تلك المنظمات والأحزاب، التي من المفترض فيها أن تقود الحركة لتغيير المجتمع، إلى عقبات هائلة في طريق الطبقة العاملة؟ الجماهير تبحث عن طريق للخروج من الأزمة، وتضع الأحزاب السياسية والقادة والبرامج على محك الاختبار وتلقي جانبا بلا رحمة بتلك التي تفشل في الاختبار. هناك تقلبات عنيفة على الجبهة الانتخابية، سواء إلى اليسار أو إلى اليمين. كل هذا مبشر بالتغيير الثوري.
في وقت لاحق سوف ينظر لفترة نصف قرن التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بكونها مجرد استثناء تاريخي. في جميع الاحتمالات لن تتكرر تلك السلسلة الخاصة من الظروف التي أنتجت ذلك الوضع. ما نواجهه الآن هو على وجه التحديد العودة إلى الرأسمالية العادية. سوف ينزع الوجه المبتسم لليبرالية والإصلاحية والديمقراطية جانبا ليكشف عن الوجه الوحيد الحقيقي للرأسمالية.
نحو أكتوبر جديد!
مرحلة جديدة تنفتح أمامنا، مرحلة من العواصف والضغوط ستكون أشبه بسنوات الثلاثينات وليس بفترة ما بعد 1945. سوف تنتزع جميع أوهام الماضي من وعي الجماهير بمبضع حاد. في مثل هكذا مرحلة سيكون على الطبقة العاملة أن تناضل بشراسة للدفاع عن مكتسبات الماضي، وفي مسار الصراع المرير سوف تصل إلى فهم الحاجة إلى برنامج ثوري جذري. إما أن تتم الإطاحة بالرأسمالية أو أن الإنسانية ستواجه مصيرا رهيبا. هذا هو البديل الوحيد، وأي مسار آخر هو مجرد كذب وخداع. لقد حان الوقت للنظر في وجهه الحقيقة.
على أساس الرأسمالية المريضة لا يمكن أن يكون هناك أي مخرج للمضي قدما أمام الطبقة العاملة والشباب. يسعى الليبراليون والإصلاحيون جاهدين لدعم الرأسمالية. أنهم يتذمرون من التهديد للديمقراطية، ويخفون حقيقة أن ما يسمى بالديمقراطية البرجوازية هي مجرد ورقة تين يختفي وراءها واقع ديكتاتورية المصارف والشركات التجارية الكبرى. سيحاولون جذب الطبقة العاملة إلى تحالفات “للدفاع عن الديمقراطية”، لكن ذلك مجرد مهزلة للنفاق.
القوة الوحيدة التي لها مصلحة حقيقية في الديمقراطية هي الطبقة العاملة نفسها. إن من يسمون بالبرجوازيين الليبراليين غير قادرين عن النضال ضد الردة الرجعية، التي تنبع مباشرة من النظام الرأسمالي الذي تقوم عليه ثرواتهم وامتيازاتهم. أوباما هو الذي مهد الطريق لانتصار ترامب، تماما مثلما أن هولاند هو الذي مهد الطريق لصعود لوبان.
في الواقع، النظام القديم يتحطم بالفعل أمام أعيننا. وأعراض تحلله واضحة للجميع. في كل مكان نرى الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي والاضطراب والحروب والدمار والفوضى. إنها صورة رهيبة، لكنها تنبع من حقيقة أن الرأسمالية قد دفعت بالبشرية إلى طريق مسدود.
ليست هذه هي المرة الأولى التي رأينا فيها مثل هذه الأشياء. يمكن أن نرى نفس الأعراض في مرحلة انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية ومرحلة اضمحلال المجتمع الإقطاعي. لم يكن من قبيل الصدفة أن الناس في تلك الأيام تصوروا أن نهاية العالم وشيكة. لكن ما كان على وشك الحدوث ليس نهاية العالم، بل فقط نهاية نظام اقتصادي اجتماعي محدد استنفد إمكاناته وأصبح عقبة هائلة في طريق التقدم الإنساني.
قال لينين ذات مرة إن الرأسمالية هي الرعب بلا نهاية. ونحن نرى الآن الحقيقة الحرفية لهذه المقولة. لكن جنبا إلى جنب مع الأهوال التي ينتجها نظام منحط ورجعي هناك جانب آخر لهذه الصورة. إن عصرنا هو عصر ولادة، وفترة انتقالية من مرحلة تاريخية إلى أخرى. تتميز مثل هذه الفترات دائما بالآلام، التي هي آلام مجتمع جديد يكافح من أجل أن يولد، في حين يكافح المجتمع القديم للحفاظ على بقاءه من خلال خنق الطفل في الرحم.
العالم القديم يحتضر وهو واقف على قدميه. وتشير إلى سقوطه أعراض واضحة. ينتشر التعفن في النظام القائم ومؤسساته تنهار. وقد استولى على المدافعين عن النظام القديم رعب غير محدد من شيء مجهول. كل هذه الأمور تدل على أن هناك شيئا آخر يقترب.
سيتم تسريع هذه الانهيار التدريجي بدخول الطبقة العاملة إلى مسرح التاريخ. وهؤلاء المشككون الذين شطبوا الطبقة العاملة من حساباتهم سيضطرون إلى بلع كلماتهم. حمم بركانية تتراكم تحت سطح المجتمع. وتتراكم التناقضات الى النقطة التي لا يمكن التحمل أكثر بعدها.
مهمتنا هي اختصار هذه السيرورة المؤلمة وضمان حدوث الولادة بأقل معاناة ممكنة. ومن أجل القيام بذلك لا بد من إنجاز مهمة إسقاط النظام الحالي الذي أصبح حاجزا رهيبا أمام تطور الجنس البشري وتهديدا لمستقبله.
كل أولئك الذين يحاولون الحفاظ على النظام القديم ورأب تصدعاته وإصلاحه وتزويده بالعكازات التي من شأنها أن تمكنه من العرج لبضع سنوات أو عقود أخرى، يلعبون أكثر الأدوار رجعية. إنهم يمنعون ولادة المجتمع الجديد، الذي وحده من يمكنه أن يقدم مستقبلا للبشرية، ويضع حدا لكابوس الرأسمالية الحالي.
العالم الجديد الذي يسعى جاهدا ليولد يسمى الاشتراكية. واجبنا أن نضمن أن تتم هذه الولادة في أقرب وقت ممكن وبأقل ما يمكن من الألم والمعاناة. إن الطريق لتحقيق هذه الغاية هي بناء تيار ماركسي عالمي قوي من الكوادر الثورية وبروابط قوية مع الطبقة العاملة.
قبل مائة سنة وقع حدث غير مجرى تاريخ العالم. ففي بلد إقطاعي شبه متخلف في طرف أوروبا، تحركت الطبقة العاملة لتغيير المجتمع. لا أحد توقع ذلك، بل على العكس من ذلك، بدا أن الظروف الموضوعية للثورة الاشتراكية في روسيا غير موجودة.
كانت أوروبا في قبضة حرب رهيبة. عمال بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا كانوا يذبحون بعضهم البعض باسم الإمبريالية. في ذلك السياق لا بد أن شعار “يا عمال العالم اتحدوا” بدا وكأنه تعبير عن السخرية المريرة. كانت روسيا نفسها تحت نير نظام استبدادي قوي يمتلك جيشا ضخما وقوات شرطة وشرطة سرية تمتد مخالبها إلى كل الأحزاب السياسية، بما في ذلك البلاشفة.
ورغم ذلك، ففي هذا الوضع، الذي بدا مستحيلا، تحرك عمال روسيا للاستيلاء على السلطة بأيديهم. أطاحوا القيصر وأنشأوا أجهزة السلطة الديمقراطية: السوفييتات. بعد تسعة أشهر فقط تمكن الحزب البلشفي، الذي كان في بداية الثورة مجرد قوة صغيرة لا يزيد أعضاؤه عن 8000 عضو، من الوصول إلى السلطة.
بعد مائة عام تواجه الماركسيين نفس المهمة التي واجهت لينين وتروتسكي في عام 1917. قواتنا صغيرة ومواردنا شحيحة، لكننا مسلحون بأقوى سلاح: سلاح الأفكار. قال ماركس إن الأفكار تصبح قوة مادية عندما تعانق الجماهير. لفترة طويلة كنا نصارع ضد تيار قوي، لكن تيار التاريخ صار الآن يتدفق بقوة في صالحنا.
إن الأفكار التي يستمع إليها اليوم أفراد قلائل، سوف تستقبل بلهفة من قبل الملايين خلال المرحلة التي تنفتح الآن. يمكن أن تقع أحداث عظيمة بسرعة كبيرة، وتغير الوضع برمته. وعي الطبقة العاملة يمكن أن يتغير في غضون أيام أو ساعات. مهمتنا هي إعداد الكوادر للأحداث الكبيرة التي تتحضر. رايتنا هي راية ثورة أكتوبر وأفكارنا هي أفكار لينين وتروتسكي. وهذا هو الضمان النهائي لنجاحنا.
آلان وودز
الخميس: 05 يناير 2017
هوامش:
[1] العبارة التي تقول الرواية إن ملكة فرنسا أثناء ثورة 1789، وزوجة الملك لويس 16، ماري أنطوانيت، قالتها عندما أخبروها بأن الشعب خرج إلى الشوارع يحتج على انعدام الخبز – المترجم –
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية