تتسبب أزمة الرأسمالية المتفاقمة حالة من الاضطراب السياسي الهائل في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، أدى تزايد عدد الحكومات “السلطوية” و”الشعبوية” إلى إثارة الكثير من النقاش حول صعود ما يُعرف بسياسات “الرجل القوي”. لكن ما الذي يعنيه هذا تحديدا؟ يدرس بن غلينيكي في هذه المقالة طبيعة الدولة الرأسمالية ومفهوم “البونابرتية” كما طوره ماركس، للإجابة عن هذا السؤال وتقديم منظور لتأثير الصراع الطبقي على السياسة اليوم.

من المواضيع الشائعة في أوساط المعلقين البرجوازيين اليوم صعود ما يسمى بـ”الزعيم القوي”. ويقال إن هناك “ركودا ديمقراطيا” في السنوات الأخيرة، يُنتج بشكل متزايد قادة سلطويين يهددون قيم الديمقراطية الليبرالية. وهذا مصدر قلق كبير للجناح “المسؤول” من الطبقة السائدة.
في العام الماضي، نشر جيديون راشمان، كاتب الشؤون الخارجية الرئيسي في فايننشال تايمز في بريطانيا، كتابا بعنوان: “عصر الرجل القوي: كيف تهدد عبادة القائد الديمقراطية في أنحاء العالم”، أطلق فيه تحذيرا بشأن التهديد المتزايد للديمقراطية الليبرالية.
في كتابه، يصنف راشمان عددا كبيرا من القادة ضمن فئة “الرجل القوي”، من بينهم: فلاديمير بوتين، رجب طيب أردوغان، شي جين بينغ، ناريندرا مودي، فيكتور أوربان، بوريس جونسون، دونالد ترامب، محمد بن سلمان آل سعود، بنيامين نتنياهو، جايير بولسونارو، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وآبي أحمد.
يركز تحليل راشمان على سرد الأمور التي يشترك فيها هؤلاء القادة السلطويون من الناحية الشكلية: القومية، كراهية “النخب”، عبادة الشخصية، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والنزعة نحو الفساد، من بين أمور أخرى. إلا أن ما يتجنبه هو تقديم أي تفسير للسيرورات الجوهرية التي تنتج هذه الأنظمة.
يقول راشمان، على سبيل المثال، إن نظام بوتين في روسيا قائم على الفساد والقومية. لكن هذا لا يفسر شيئا. الفساد والقومية موجودان، بدرجات متفاوتة، في جميع الأنظمة الرأسمالية وفي كل الأوقات. لكن مسألة لماذا وكيف أدى الفساد والقومية إلى إنتاج نظام بوتين في روسيا في لحظة تاريخية معينة، تبقى بلا إجابة.
وبدلا من ذلك، يقدم راشمان لمحات سطحية “للقادة الأقوياء” كأفراد معزولين، مما يحول السياسة إلى مجرد نتاج لخصائص الأفراد ونزواتهم. هذا لا يخفي فقط الفروقات المهمة بين الأنظمة، مثل نظام بوتين وما يسمى بالحكومات “الشعبوية” مثل حكومة دونالد ترامب؛ بل يجعلنا أيضا عاجزين تماما عن استخلاص أي استنتاجات للمستقبل إذا اتبعنا نهج راشمان.
ما يفتقر إليه راشمان هو تحليل الصراع الطبقي في كل مجتمع على حدة، وعلى النطاق العالمي. وأي محاولة لفهم الدولة وطبيعتها السياسية دون تقييم وتيرة وظروف الصراع الطبقي في لحظة معينة ستفضي إلى نتائج سطحية.
بينما قام كارل ماركس، من جهته، بدراسة تاريخ وتطور الصراع الطبقي، ومساره، والأشكال السياسية التي ينتجها.
كتب ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي: “إن تاريخ كل المجتمعات التي وجد حتى الآن هو تاريخ الصراعات الطبقية”[1]. إن الأنظمة السياسية التي ستشكل تاريخ المرحلة التي نعيشها الآن ليست نتاجا لمستشارين إعلاميين بارعين، ولا لرؤساء قدموا الرشاوى للأشخاص المناسبين. لا يمكن فهمها إلا باعتبارها نتاجا لمرحلة معينة من الصراع الطبقي.
في كتابه الثامن عشر من برومير لويس بونابرت، حلل ماركس صعود “رجل قوي” آخر إلى السلطة، هو نابليون الثالث، وما تزال الاستنتاجات النظرية التي توصل إليها تشكل أداة لا غنى عنها لفهم طبيعة الدولة، ومنظورات ما يسمى بـ”القادة الأقوياء” اليوم.
النظرية الماركسية للدولة
قبل أن نتمكن من فهم الطابع السياسي لنظام معين، سواء كان ديمقراطيا ليبراليا أم نظاما ديكتاتوريا، علينا أولا أن نفهم دور الدولة في المجتمع.
الدولة هي أداة لحكم الطبقة. فهي مملوكة وتدار من قبل الطبقة السائدة في أي مجتمع معين. والدول الحديثة، على سبيل المثال، مرتبطة بمصالح الرأسمالية بآلاف الخيوط.
هناك باب دوار يصل بين قطاع الأعمال وبين الحكومة، وهو ما يضمن انتقال الوزراء وكبار الموظفين بسهولة من مناصبهم كمنظمين حكوميين وبين الشركات التي يفترض بهم تنظيمها. ويملك لوبي الشركات الكبرى وصولا مباشرا دائما إلى الوزراء، مستخدمين أشكالا متنوعة من “الإقناع”، تشمل الرشاوى والتهديدات، لتشكيل السياسات الحكومية بما يتوافق مع مصالح البرجوازية. وتستخدم المحاكم، والسجون، والشرطة، والجيش للدفاع عن حقوق الملكية الخاصة للأثرياء، بينما تهمل حقوق الفقراء في السكن والغذاء، التي لا تنتزع إلا من خلال النضال الطبقي.
الوزراء، وكبار الموظفين، والقضاة، والجنرالات، ورؤساء الشرطة، وغيرهم من مسؤولي الدولة، ينحدرون عادة من شريحة اجتماعية ضيقة، تتم تربيتهم وتعليمهم بمنظور الطبقة الرأسمالية. ففي بريطانيا، 65% من كبار موظفي الدولة تلقوا تعليمهم في مدارس خاصة نخبوية وحصرية، وكذلك 65% من كبار القضاة، و70% من الجنرالات، و65% من كبار الوزراء في الحكومة.

هذه العلاقة بين الدولة وبين الطبقة السائدة ليست حكرا على الرأسمالية. لقد كانت الدولة، في الواقع، أداة لحكم الطبقة السائدة منذ أن ظهرت لأول مرة على مسرح التاريخ، قبل نحو 5000 سنة. فمنذ أن انقسم المجتمع إلى طبقات مستغِلة ومستغَلة، وُجدت الدولة لتنظيم الصراع بينهما، وهو صراع كان سيمزق المجتمع لولا وجودها.
كما يشرح إنجلز:
“[الدولة] هي اعتراف بأن هذا المجتمع قد تورط في تناقض لا يمكن حله، وانقسم إلى تناقضات لا يمكن التوفيق بينها، وهو عاجز عن تخليص نفسه منها. ولكن من أجل ألا تستهلك هذه التناقضات، أي الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتضاربة، نفسها والمجتمع في صراع عقيم، أصبح من الضروري وجود قوة، تبدو وكأنها تقف فوق المجتمع، لتخفيف حدة الصراع وإبقائه ضمن حدود ‘النظام'”[2].
إلا أن الدولة ليست حكما محايدا بين الطبقات المتصارعة، بل هي أداة في يد الطبقة السائدة في المجتمع، للحفاظ على موقعها السائد وعلاقات الملكية الخاصة بها. كما يوضح إنجلز:
“العنصر المركزي في المجتمع المتحضر هو الدولة، التي تكون، في جميع الفترات النموذجية، دون استثناء، دولة الطبقة السائدة، وتبقى في جميع الحالات، في جوهرها، آلة لإخضاع الطبقة المضطهَدة والمستغَلة”[3].
لهذا السبب، تملك السلطات الرسمية احتكارا قانونيا لاستخدام العنف من خلال الشرطة والجيش والسجون. ولهذا كتب ماركس وإنجلز:
“السلطة التنفيذية للدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للبرجوازية بأسرها”[4].
ولكي تحافظ على علاقات الملكية بنجاح في وجه الصراع الطبقي، وتبرير احتكارها للعنف، يجب على الدولة أن تظهر كما لو أنها تقف فوق المجتمع، ومنفصلة عنه إلى حد ما. لا بد لها أن تستخدم الهيبة والغموض لحجب دورها كأداة في يد الطبقة السائدة.
كان الملوك الإقطاعيون في أوروبا يزعمون أنهم يحكمون بالحق الإلهي، باختيار من الله وهداية منه. أما “الديمقراطيات” الحديثة فتتزين بلغة “الاقتراع”، و”حقوق الإنسان”، و”سيادة القانون”.
هذه الزينة “الديمقراطية” تؤدي وظيفة نافعة للرأسماليين. فهي، أولا، تمكن الطبقة الرأسمالية ككل من فرض سيطرتها على آليات الدولة، من خلال ممثليها المأجورين في البرلمان، ووسائل الإعلام، والقضاء، والجهاز البيروقراطي الهائل، والقوات المسلحة.
وقد أظهر قِصَر عمر حكومة تراس في بريطانيا، عام 2022، ذلك بوضوح. فقد أدت ردود فعل السوق على سياساتها، إلى جانب التصريحات اللاذعة من مؤسسات رأسمالية مثل صندوق النقد الدولي، إلى إجبارها على ترك المنصب خلال 44 يوما فقط. ويكفي أن نسأل ما إذا كان بإمكان ليز تراس أن تسجن منتقديها من الطبقة السائدة، حتى ندرك العلاقة الحقيقية بين الرأسماليين ورجال دولتهم.
وفوق ذلك، توفر “الديمقراطية” البرجوازية وهم الاختيار للناخبين، الذين يمكنهم التصويت لإدخال أفراد وأحزاب سياسية وإخراجها من السلطة، دون أن يشكل ذلك تهديدا للنظام الرأسمالي. وهذا يعزز الأسطورة القائلة إن الدولة محايدة وتقف فوق الطبقات المتصارعة في المجتمع.
لهذا السبب، إذا تساوت العوامل الأخرى، فإن الشكل الأكثر كفاءة للدولة في ظل الرأسمالية هو الجمهورية الديمقراطية. وكما يشرح لينين فإن:
“الجمهورية الديمقراطية هي أفضل غلاف سياسي ممكن للرأسمالية، ولذلك، ما إن تمتلك الرأسمالية هذا الغلاف الأفضل، حتى ترسخ سلطتها بقوة، إلى درجة أن لا تغيير في الأشخاص، أو المؤسسات، أو الأحزاب ضمن الجمهورية الديمقراطية البرجوازية يمكنه زعزعتها”[5].
إن احتكار العنف وتغريب الدولة عن المجتمع أمران حاسمان في فاعليتها كسلاح في يد الطبقة السائدة. لكن، في ظروف معينة، يمكن لهذين الأمرين أن يكتسبا حياة مستقلة. وكما يوضح إنجلز:
“لكن فترات استثنائية تحدث عندما تكون الطبقات المتصارعة متكافئة تقريبا في القوى، بحيث تكتسب سلطة الدولة، بوصفها وسيطا ظاهريا، استقلالا معينا، ولو مؤقتا، عن كلتا الطبقتين”[6].

ومثل تلميذ الساحر، قد تجد الطبقة السائدة نفسها وقد استحضرت قوى لم تعد قادرة على السيطرة عليها.
فعلى سبيل المثال، ففي عام 2000، أصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، وسرعان ما قام بسجن ونفي فلاديمير غوسينسكي، وهو قطب إعلامي ومالك بنك وعقارات، كانت قنواته الإعلامية تنتقد الرئيس.
ثم انتقل بوتين إلى استهداف ميخائيل خودوركوفسكي، قطب النفط وأغنى رجل في روسيا آنذاك، والخصم السياسي له. في عام 2003، أودع خودوركوفسكي السجن، وصودرت ثروته وأصوله.
وبدلا من أن يكون خادما للطبقة السائدة في روسيا، بدا بوتين كالسيد المتحكم فيها. هذه الظاهرة، التي ترفع فيها أجهزة الدولة نفسها فوق المجتمع ككل، ويترأسها “زعيم عظيم”، هي ما أطلق عليه ماركس اسم “البونابرتية”.
البونابرتية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تنقلب فيها الدولة، والتي يُفترض أنها خادمة للطبقة السائدة، على بعض من أسيادها السابقين. النموذج الأصلي لهذه الظاهرة كان نابليون بونابرت نفسه.
جاء نابليون إلى السلطة في أعقاب الثورة الفرنسية، وبشكل أدق، في فترة انحسارها. فمنذ عام 1789، كانت تحالفات البرجوازية، وجماهير باريس شبه البروليتارية، والفلاحين الفرنسيين قد أسقطت الملكية، ووزعت الأرض على الفلاحين، وبدأت في شن الحرب على أوروبا الإقطاعية، ممهدة الطريق أمام تطور الرأسمالية.
وقد أطلقت “لجنة السلامة العامة” في الثورة الفرنسية العنان لإرهاب اليعاقبة ضد القوى المضادة للثورة التي سعت إلى استعادة النظام الملكي. غير أن الجماهير الباريسية، وقد ألهمها النجاح، بدأت تذهب أبعد من ذلك. فأخذت شعار “الحرية، المساواة، الأخوة” بمعناه الحرفي وبدأت تتخذ إجراءات ضد الملكية الخاصة.
كانت تلك ذروة الثورة، لكنها كانت ذروة نفرت منها البرجوازية والفلاحين. وبما أنهم كانوا أكثر عددا من “رعاع” باريس، فقد بدأوا يدفعون البندول في الاتجاه المعاكس. أولا، تمت الإطاحة بروبسبيير ولجنة السلامة العامة، واستبدلوا بالديركتوار[7]، الذي أطلق “إرهابا أبيض” جديدا ضد أكثر العناصر ثورية، مطالبا بإعادة “النظام”، والمقصود بذلك النظام البرجوازي الجديد.
كانت البرجوازية قد دعت الجماهير إلى النضال في عام 1789، لكنها، بعد الإطاحة بالملكية، لم تتمكن من فرض سيطرة حاسمة على الوضع. وصل الصراع إلى طريق مسدود، وأصبحت القوة الغاشمة هي العامل الحاسم.
كانت البرجوازية المحاصرة بين مؤامرات الملكيين والانتفاضات، مثل الشوان[8] في الغرب، وتهديد عودة اليعاقبة في باريس، تتوق إلى “حكومة مستقرة” ونهاية “للفوضى” مرة واحدة وإلى الأبد.
كان نابليون، المنتصر حديثا في حملاته العسكرية والذي كان يحظى بولاء الجيش، المؤلف في معظمه من الفلاحين، هو المنقذ الذي كان كثيرون يبحثون عنه. دعا الأب سيييس، وهو عضو بارز في الديركتوار، وجوزيف فوشيه، وزير الشرطة، وتاليران، وزير الخارجية، نابليون لاستخدام الجيش للإطاحة بحكومتهم هم أنفسهم في 18 برومير، السنة الثامنة للجمهورية (9 نوفمبر 1799).
وبمجرد توليه السلطة، بدأ بونابرت يوازن بين الطبقات المتصارعة. وعد البرجوازية بالنظام ونهاية الشغب والاضطرابات الثورية. ووعد الجنود والجماهير بإنقاذ الثورة من المؤامرات الملكية. وفي الوقت نفسه، رفع نفسه وجهازه القسري فوق جميع طبقات المجتمع. رغم الديماغوجية التي كانت غالبا متناقضة ومتلطفة في محاولته إرضاء الجميع، دافع نابليون عن نظام الملكية الخاصة الذي أرسته الثورة البرجوازية.
لم يكن لديه خيار في ذلك، لأن قاعدته الداعمة كانت الفلاحين الذين شكلوا صفوف الجيش. لم يكن لديهم أي اهتمام بمطالب شبه البروليتاريين في باريس، وأرادوا الحفاظ على الملكية الخاصة للأرض التي منحتهم إياها الثورة ضد الملكية.

مع نمو الاقتصاد، استطاع نابليون إسكات الجماهير بينما كان يركز سلطته. أظهر ولاء شكليا للثورة، بينما كان يقضي على النظام السياسي الذي أنشأته. احتفظ فقط بالقاعدة الاقتصادية الجديدة للرأسمالية التي حلت محل الإقطاعية.
بعد ترسيخ موقعه، اعتمد على القوة الغاشمة. شيد شبكة من الجواسيس، وأعاد فتح سجون الملكيين، وفرض رقابة على الصحافة، وأعاد تأسيس الكنيسة، وانطلق في مغامرات عسكرية ونهب في الخارج. حكم بالسيف، وفي عام 1804 توج نفسه إمبراطورا. قدم كل ذلك كأمر واقع ثم جرى التصويت عليه كـ”استفتاء شعبي” دون حرية نقاش ودون طرح بدائل.
لم يشكل أي من ذلك تغييرا جوهريا في الطابع البرجوازي للنظام ما بعد الثورة. لم يتراجع عن المكاسب الأساسية للثورة، مثل إلغاء الملكية الإقطاعية وإعادة توزيع الأرض. ما غيره نابليون كان الطابع السياسي للنظام. أصبح ديكتاتورية بدلا من الديمقراطية، مع جهاز دولة ضخم تدفع تكاليفه البرجوازية والجماهير على حد سواء.
هذه هي البونابرتية النموذجية، التي عرفها تروتسكي بأنها “حكومة بيروقراطية بوليسية تُرفع فوق المجتمع وتحافظ على نفسها على أساس التوازن النسبي بين المعسكرين المتعارضين”[9]، متظاهرة بأنها “الوسيط النزيه” للأمة.
يحكم الزعيم القوي بعد ذلك بالقوة السافرة، مُخضعا الجميع لسلطته التنفيذية، دون تغيير الطابع الطبقي الأساسي للنظام. غالبا ما يتم استخدام العنف ضد أفراد من الطبقة السائدة أو أجزاء معينة منها، وكذلك ضد الجماهير، بينما يوازن النظام بين الطبقات.
حذا ابن أخ نابليون، لويس بونابرت، حذو عمه حرفيا تقريبا، عندما أطاح بالجمهورية الفرنسية الثانية بانقلاب عسكري عام 1851 وتوج نفسه إمبراطورا في العام التالي.
في كتاب “الثامن عشر من برومير لويس بونابرت”، شرح ماركس كيف أن البرجوازية، في كفاحها لقمع الجماهير بعد ثورة 1848، اضطرت إلى تفكيك جميع الأجهزة الديمقراطية للدولة لتجنب استيلاء “الحمر” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي عليها. وفي الوقت نفسه، منحت البرجوازية المزيد والمزيد من السلطة للجهاز التنفيذي للدولة، برئاسة الرئيس بونابرت، الذي انتهى به المطاف -على حد تعبير ماركس- “على أكتاف جنود ثملين اشتراهم بالويسكي والنقانق”[10].
هؤلاء الجنود الثملون قتلوا مئات العمال الذين احتجوا على انقلاب لويس بونابرت، واعتقلوا عشرات الآلاف، بينما تم فرض رقابة صارمة على الصحافة.
لم يكن العنف والقمع موجهين ضد العمال فقط، كما شرح ماركس: “يُقتَل البرجوازيون المتعصبون للنظام من على شرفات منازلهم على يد حشود من الجنود الثملين، وتدنس ملاذاتهم المنزلية، وتقصف بيوتهم للهو”.
لكن العنف ضد أفراد من البرجوازية، والنهب الذي نفذه رجال بونابرت، لم يشكل في أي وقت تهديدا للطبيعة البرجوازية الأساسية للمجتمع. فقد كانت علاقات الملكية الخاصة محفوظة دائما. لم يكن أفراد الطبقة البرجوازية محصنين بالضرورة من آثار حكم السيف، لكن البرجوازية باعتبارها طبقة، كانت سعيدة بتقبل تجاوزات لويس بونابرت إذا ما وفر لهم “النظام” ووضع حدا لفترة الاضطراب الثوري التي تلت عام [11]1848.
روسيا بوتين
لا يمكن اعتبار نظام نابليون ولا نظام ابن أخيه نموذجا مطلقا. فعندما يصف الماركسيون أنظمة بأنها “بونابرتية”، فإنهم يتحدثون عن التشابه مع نظام نابليون، لا عن نسخة مطابقة له.
هناك بعض أوجه الشبه، على سبيل المثال، بين نابليون بونابرت وفلاديمير بوتين، وإن كانت بعيدة عن أن تكون نسخة طبق الأصل. لقد كانت استعادة الرأسمالية في روسيا أوائل التسعينيات ضربة قاسية ضد الجماهير الروسية وقد أثارت موجة من التوحش الإجرامي من قبل البرجوازية الروسية الصاعدة. بيعت أصول الدولة، وتغلغل الفساد في جميع مفاصل المجتمع.
في عهد الرئيس بوريس يلتسين، بلغ انحطاط الطبقة الرأسمالية وبؤس العمال حدا أصبح فيه خطر انفجار السخط الجماهيري إلى السطح أمرا حقيقيا، كما حدث في عدة مناسبات. وردا على ذلك، اتخذ نظام يلتسين “الديمقراطي” إجراءات قمعية متزايدة، وصلت إلى حد قصف البرلمان الروسي سنة 1993 بينما كان النواب ما يزالون بداخله.
عادة ما كانت مثل هذه الأساليب تُعتبر أساليبا “استبدادية” من قبل المعلقين الليبراليين، لكن اللافت أن يلتسين في ذلك الوقت لقب، في الصحافة البرجوازية عموما، بالقائد الشجاع والمدافع عن الديمقراطية. والسبب بسيط: إذ لم يكن يمثل حكم السيف المفروض على جميع الطبقات، بل كان القمع الذي مارسه يلتسين سيفا بيد الأوليغارشية الرأسمالية، وإن في ظروف شديدة الاضطراب.

ومع استمرار الأزمة، لم يكن يلتسين وحده من أصبح مكروها، بل بات النظام الحاكم بأسره موضع رفض عارم من طرف الجماهير. بين عامي 1996 و1998، اجتاحت البلاد موجات من الإضرابات واحتلالات المصانع، عبرت عن مقاومة نضالية لعملية استعادة الرأسمالية. غير أن الإمكانات الهائلة لذلك الحراك ضاعت على يد من يسمون بالقادة الشيوعيين.
لم يؤد فشل العمال في إسقاط النظام إلى إنهاء الأزمة والاضطراب اللذين مزقا المجتمع الروسي. ففي ظل تلك الظروف البائسة، بدأ القانون والنظام في الانهيار، وأصبح اختطاف وقتل رجال الأعمال الأثرياء أمرًا شائعا. وقد بث ذلك الرعب في قلوب الطبقة الجديدة من الأوليغارشيين الرأسماليين، الذين راكموا ثرواتهم عبر نهب ممتلكات الدولة.
في ظل ذلك الوضع، برزت الحاجة إلى “رجل محايد، شخص يضمن حماية ممتلكات الأوليغارشيين دون أن يكون مرتبطا بشكل وثيق بالإمبريالية الأمريكية أو بالفساد المتفشي في أجهزة الدولة. كان فلاديمير بوتين، عميل الـKGB السابق والبيروقراطي المحنك، هو ذلك الرجل. لم يفرض نفسه على البلاد في البداية؛ بل اختاره أحد أجنحة الأوليغارشية، وتم تقديمه للجماهير على أنه قطيعة مع الماضي.
تولى بوتين السلطة في عام 1999، عارضا على الأوليغارشيين حماية ثرواتهم مقابل دعمهم له. وفي الوقت نفسه، وجه ضربات علنية لبعض الرأسماليين الروس متهما إياهم بالفساد، بينما كان يصور نفسه في أعين الجماهير على أنه “صديق الشعب”.
أدار بوتين توازنا بين الطبقات المتصارعة، وقدم وعودا وخطابات ديماغوجية للطرفين، بينما كان يعزز جهاز الدولة والأمن، رافعا إياه فوق المجتمع، ليفرض سلطته على جميع الطبقات دون استثناء.

بلغ الصراع الطبقي درجة من التوازن، نتج عن الإنهاك المتبادل بين الطبقات المتصارعة. كانت البرجوازية ضعيفة وعاجزة عن الحكم بشكل مباشر، فيما كانت الجماهير عاجزة عن انتزاع السلطة. لم يفض ذلك الوضع إلى نفس الحالة التي شهدتها فرنسا في عهد نابليون، لا من حيث الطريقة ولا من حيث الأسباب، لكن النتيجة النهائية، أي حالة الجمود بين الطبقات، كانت واحدة.
لا يمكن لمثل ذلك الوضع أن يستمر إلى الأبد. فلا بد من إيجاد مخرج من الأزمة، وعندما لا يمكن العثور عليه من خلال حكم طبقة بعينها، فإن من سيجد ذلك المخرج هو “الأجهزة الخاصة من الرجال المسلحين” التي تشكل الدولة، يتقدمها “القائد القوي”.
بعد فترة وجيزة من انتخابه في عام 2000، نشرت في صحيفة «كوميرسانت» الروسية وثيقة مسربة كانت بمثابة مخطط لتعزيز جهاز الدولة الروسية، بهدف تسهيل حكم بوتين. الوثيقة، المعنونة “المراجعة رقم ستة”، وضعت خططا لتوسيع دور جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ، وتقليص استقلالية وسائل الإعلام، والتلاعب بنتائج الانتخابات باستخدام أدوات المراقبة الحكومية والعملاء السريين. وقد شكل ذلك النمط الإطار العام لروسيا في عهد بوتين طوال العقدين الماضيين. فمعارضوه السياسيون تعرضوا للاعتقال، أو حتى للقتل. وقد زور الانتخابات، وداست سلطته على الدستور الروسي.
تم تعزيز جهاز الدولة بشكل كبير في عهد بوتين، بينما كان يوطد قبضته على الحكم. فالدولة تحمي الطبقة الرأسمالية الروسية، لكنها في الوقت ذاته لا تخضع لسيطرتها. وهذا ما يجعل نظام بوتين نظاما بونابرتيا.
ترامب، جونسون، وبولسونارو
لكن إذا أخذنا بعض الأنظمة الأخرى التي أشار إليها راتشمان، وسألنا ما إذا كان يمكن تطبيق نفس التشبيه مع نظام نابليون، فسنجد أن الجواب هو: كلا.
لم يصل دونالد ترامب، بوريس جونسون، وجاير بولسونارو إلى السلطة نتيجة حالة جمود منهك في الصراع الطبقي. فلم تكن الولايات المتحدة، أو بريطانيا، أو البرازيل، قد شهدت هزات في الصراع الطبقي كتلك التي شهدتها فرنسا في عام 1789، أو روسيا في أوائل التسعينيات مع استعادة الرأسمالية.
في الواقع، عند انتخابهم، كانت الطبقة العاملة في البلدان الثلاثة بالكاد تبدأ في الوقوف على قدميها، وتظهر قوتها، وتستعد لخوض الصراع.
ففي الولايات المتحدة مثلا، كانت حركة “حياة السود مهمة (BLM)”، التي انفجرت بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس، واحدة من أكبر الحركات الجماهيرية في تاريخ البلاد، وقد حدثت خلال رئاسة ترامب. بين 26 ماي و22 غشت 2020، وقعت أكثر من 7750 مظاهرة مرتبطة بالحركة في أكثر من 2240 موقعا في أنحاء البلاد. وقد دفعت قوة هذه الحركة مجلس مدينة مينيابوليس إلى التصويت لصالح تفكيك جهاز الشرطة بالكامل.
وبالمثل، في البرازيل، خرج ملايين العمال في إضراب يوم 14 يونيو 2019 احتجاجا على هجمات حكومة بولسونارو على نظام التقاعد والتعليم. وقد نظمت مظاهرات في 380 مدينة بأنحاء البلاد. أما محاولات بولسونارو لتنظيم مظاهرات مضادة، فلم تجمع أكثر من 20.000 شخص في المدن الكبرى.
لم تكن الصراعات الطبقية قد وصلت إلى طريق مسدود في تلك البلدان، بل كانت في بدايات تصاعدها. ولذلك فإن وضع ترامب أو جونسون أو بولسونارو في نفس خانة بوتين يعد تشخيصا خاطئا تماما للمرحلة التي تمر بها الصراعات الطبقية في جميع تلك البلدان.
صحيح أن ترامب، وجونسون، وبولسونارو كانوا، كأفراد، خارج السيطرة الكاملة لطبقاتهم السائدة. جميعهم قدموا خطابات ديماغوجية للجماهير، رغم كونهم في الوقت نفسه أعضاء في الطبقة السائدة. وقد ظهرت بعض ملامح المناورة بين الطبقات في خطاباتهم “المناهضة للمؤسسة الحاكمة”.
لكن الدوافع الفردية للقادة ليست سوى جزء صغير من المعادلة. حتى لو كان لدى ترامب، أو جونسون، أو بولسونارو، رغبة فعلية في أن يكونوا زعماء بونابرتيين، فإن ذلك لا يكفي لجعلهم كذلك. فالأمر يعتمد على توازن القوى الطبقية في المجتمع، وعلى المرحلة التي يمر بها الصراع الطبقي.
في الحالات الثلاث، ظل جهاز الدولة -ولا سيما الأجهزة المسلحة التي تشكل نواته- تحت السيطرة الراسخة للطبقة السائدة، لا في يد المغامرين غير الموثوقين في البيت الأبيض أو داوننغ ستريت أو قصر ألفورادا.
في عام 2019، علق بوريس جونسون عمل البرلمان البريطاني. لقد تجاوز الإجراءات الدستورية الديمقراطية في سبيل تمرير تشريعات بريكست، وهو قرار أبطلته لاحقا المحكمة العليا.
وبالمثل فقد ملأ بولسونارو حكومته بضباط الجيش، من ضمنهم جنرالات حاليون وقادة عسكريون آخرون. وقد هدد بأن الجيش سيجري عده الخاص للأصوات في انتخابات الرئاسة لعام 2022، بسبب ما زعم أنه تحيز في السلطة القضائية ومحاكم الانتخابات.
في المقابل قام ترامب بمضايقة صحفيين لا يحبهم، بل سحب تصاريحهم الصحفية، ودعا إلى إسقاط الدستور الأمريكي. وقد تم اتهامه هو أيضا بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات.
من الواضح أن هؤلاء الأشخاص ليسوا ديمقراطيين برجوازيين تقليديين. ينظر بولسونارو إلى الديكتاتورية العسكرية في البرازيل بعين الحنين، وترامب يعبر صراحة عن إعجابه بنظام بوتين البونابرتي. لكن رجلا واحدا لا يصنع نظاما.
فعلى الرغم من ازدرائهم بالمعايير الديمقراطية البرجوازية، فإن كلا من جونسون وترامب وبولسونارو حكموا ضمن تلك الحدود. ولا يمكن وصف أي من أنظمتهم بأنه حكم بالسيف.
عندما واجه لويس بونابرت احتمال خسارة رئاسة الجمهورية الفرنسية الثانية بالوسائل الدستورية، نظم انقلابا عسكريا، بعد أن ضمن ولاء كل من رئيس هيئة الأركان وغالبية صفوف الجيش. أما بولسونارو وترامب، فعندما واجها مشكلة مشابهة، فقد حرضا حشودا مسلحة من أنصارهما، حاولت بدورها اقتحام مباني الحكومة. لكن في كلا الحالتين، سرعان ما تعرضت تلك المحاولات للسحق على يد القوات المسلحة التابعة للدولة، التي ظلت خاضعة بثبات لسيطرة الطبقة السائدة.
أظهرت هشاشة ما يسمى بـ”محاولات الانقلاب” مدى ضعف قدرة ترامب وبولسونارو على الاعتماد على قوى العنف المنظم لدعمهما، بغض النظر عن مدى رغبتهما في ذلك. وفي مغامرة ترامب تحديدا، من المشكوك فيه أنه توقع أصلا أن تصل حشود مؤيديه إلى مبنى الكابيتول. ولم يكن “المتمردون” أنفسهم يتوقعون ذلك على الأرجح، بالنظر إلى الطريقة التي تجولوا بها بلا هدف في الأروقة، ينهبون آلات البيع ويلتقطون صورا شخصية.
أن تصف نظاما بأنه بونابرتي، يعني أن تصفه بأنه ديكتاتوري، بدرجات متفاوتة من الشدة. وهذا لا ينطبق بوضوح على أنظمة ترامب أو بولسونارو أو جونسون. لم تكن هناك أصلا إمكانية لأن يتمكن أي منهم من إقامة مثل ذلك النظام أثناء وجوده في الحكم. والسبب في ذلك هو بالضبط ما يفشل راتشمان في ملاحظته، أو يتعمد تجاهله: توازن القوى الطبقية في تلك البلدان.
آفاق البونابرتية اليوم

يقول جيديون راتشمان إننا نعيش في “عصر القائد القوي”، ويصور مشهدا كارثيا لبلدان تتساقط الواحدة تلو الأخرى فريسة لزعماء بونابرتيين يهددون بالقضاء على الديمقراطية الليبرالية إلى الأبد.
وهذا رأي يكرره الكثير ممن يوصفون بأنهم من اليسار. لكنه رأي غير دقيق على الإطلاق، وينم عن الكسل أن نلجأ ببساطة إلى وصف كل حكومة لا نرضى عنها بأنها “استبدادية” أو حتى “فاشية”. والأسوأ من ذلك أن هذا الكسل يفضي إلى تشاؤم مفرط، وهو سمة شائعة لدى من لا يدركون دور الطبقة العاملة أو قوتها. مثل هذا التشاؤم والسطحية لا يقدمان شيئا لفهمنا للأنظمة المختلفة، ومن دون هذا الفهم، لا أمل في الإطاحة بها.
في الواقع، السمة المميزة للعصر الحالي على المستوى العالمي هي سمة الثورة والثورة المضادة، المرافقة بصراع طبقي عاصف. ويزداد هذا الصراع حدة بفعل الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها النظام الرأسمالي. فقد قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2022، إن الحقبة السابقة من الاستقرار النسبي، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم، بدأت تفسح المجال لعصر يمكن فيه “أن ينحرف أي بلد عن مساره بسهولة أكبر، وبشكل متكرر”.
وأضافت، بشكل لافت:
“نحن نشهد تحولا جوهريا في الاقتصاد العالمي، من عالم يتسم بتوقع نسبي… إلى عالم يتسم بقدر أكبر من الهشاشة، وعدم يقين أوسع، وتقلب اقتصادي أشد، ومواجهات جيوسياسية، وكوارث طبيعية أكثر تواترا وتدميرا”[12].
إن عمق هذه الأزمة يتسبب في حالة من الاضطراب الهائل على كل مستويات المجتمع. تدخل الأنظمة الديمقراطية الليبرالية في حالة أزمة بسبب حالة الاستقطاب بين الجماهير، والانقسامات التي بدأت تظهر داخل الطبقة السائدة نفسها. هذه الظواهر، وليس “الاستبداد”، هي التي تفسر ظهور حكومات غير موثوقة وغير مستقرة مثل حكومتي جونسون وترامب. ما تظهره هذه الحالات ليس انحدار المجتمع الحتمي نحو حكم بونابرتي، بل ضعف الطبقة السائدة ونظامها.
وفي الوقت نفسه، تؤدي الأزمة إلى تصاعد حاد في الصراع الطبقي في جميع البلدان الواحد منها تلو الآخر. وفي العديد من البلدان حول العالم، لم تتعرض الطبقة العاملة للهزيمة، وهي مستعدة لخوض النضال.
حتى في البلدان التي تُحكم بأنظمة بونابرتية راسخة، مثل إيران مثلا، لا يتعلق الأمر بدكتاتوريين جدد فُرضوا على طبقة عاملة منهكة ومهزومة. بل إن النظام هناك نشأ نتيجة لهزيمة ثورة 1979، وهي الهزيمة التي تعافت منها الطبقة العاملة بوضوح. فالحراك الجماهيري الذي اندلع في أواخر عام 2022، إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، هز النظام الإيراني من جذوره. وكان هذا مجرد الزلزال الأخير في سلسلة من الهزات التي بدأت تتفجر بقوة متزايدة منذ عام 2018 تحت أقدام البونابرتيين الرجعيين الذين يحكمون البلاد.
في روسيا، تراجعت شعبية بوتين إلى درجة أن النظام توقف عن نشر استطلاعات التأييد، وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2015. وفي ظل هذه الظروف، كثف بوتين من إجراءاته القمعية، واستغل الحرب في أوكرانيا لحشد السكان حوله. هذه ليست علامات على نظام مستقر يحكم طبقة عاملة منهكة. بل على العكس، إنها مؤشرات على أن قاعدة النظام تتآكل بفعل تصاعد الاضطراب، مما ينذر بصراع طبقي أعظم في المستقبل القريب. أما تركيز السلطة في يد شي جين بينغ في الصين، فيعبر بدوره عن نفس حالة الاضطراب في أساسات نظام الحزب الشيوعي الصيني، الذي لم يعد واثقا من قدرته على الحكم بالأساليب التي استخدمها في الماضي. العقبة الرئيسية أمام الثورة في جميع البلدان ليست في السلطة الهائلة “للقادة الأقوياء”، بل في ضعف القيادة الطبقية للعمال وجبنها.
تحاول الطبقة السائدة في كل مكان تعزيز وسائل قمعها في مواجهة غضب الجماهير. وهذا يوضح أن كل الدول الرأسمالية، سواء كانت دكتاتورية أو ديمقراطية، لا بد لها من الدفاع عن النظام الرأسمالي، واليوم، صارت كل نظام في العالم أقل أمنا من سابقه. لكن في البلدان الرأسمالية المتقدمة على الأقل، تتوخى الطبقة السائدة حذرا شديدا من أي خطوة نحو الحكم بالسيف، لما قد يثيره ذلك من رد فعل هائل بين الجماهير العاملة. بل إن مثل هذا الخيار قد يجعل الثورة أكثر احتمالا وليس أقل احتمالا، وهذا ما يدركه أكثر ممثلي الطبقة الرأسمالية تعقلا.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يقودنا هذا المنظور إلى التراخي. ففي ظل أزمة رأسمالية عميقة من جهة، وغياب قيادة ثورية للطبقة العاملة من جهة أخرى، يمكن أن تظهر أنواع شتى من الظواهر. فإذا لم تستطع الطبقة السائدة أن ترسخ حكمها بفعل الأزمة، وإذا منعت الطبقة العاملة من الاستيلاء على السلطة وحل الأزمة بالوسائل الاشتراكية، فمن الممكن أن يبدأ الجهاز التنفيذي برفع نفسه فوق المجتمع على نحو بونابرتي.
حلل ليون تروتسكي الأنظمة التي نشأت في فرنسا وألمانيا بين الحربين، ووصفها بتلك الطريقة. فقد شرح أن حكومة دومرغ في فرنسا، التي وصلت إلى السلطة على رأس حكومة “وحدة وطنية” سنة 1934 وبدأت تحكم خارج نطاق سيطرة البرلمان، كانت حكومة بونابرتية. وكما قال:
“بفضل التوازن النسبي بين معسكر الثورة المضادة الذي يهاجم، ومعسكر الثورة الذي يدافع عن نفسه، وبفضل تحييدهما المتبادل المؤقت، ارتفع محور السلطة فوق الطبقات وفوق تمثيلها البرلماني”[13].
لكن بينما كان نظام نابليون يقوم على الإنهاك المتبادل للطبقات، فإن “التوازن النسبي” الذي ارتكزت عليه حكومة دومرغ كان مبنيا على توقع قيام ثورة في ظل أزمة رأسمالية عميقة. وفي الواقع، فإن العاصفة العاتية من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت ذلك النظام أغرقته خلال تسعة أشهر فقط، في خضم الإضرابات العامة وتهديدات الحرب الأهلية.
إن صعود أنظمة مستقرة، سواء من النمط الديمقراطي الليبرالي أو البونابرتي، ليس مطروحا. بل إن ما يتصاعد في كل مكان هو الاضطراب والأزمة.
لقد أشار مارتن وولف، كبير معلقي الاقتصاد في صحيفة فاينانشالتايمز البريطانية، إلى “ازدياد عدد ما تسميه قاعدة بيانات Polity IV بـ”الأنوقراطيات”، أي البلدان ذات الحكومات غير المتماسكة، غير المستقرة، وغير الفعالة”، مشيرا إلى أن عدد “الأنوقراطيات” ارتفع “من 21 في عام 1984، و39 في عام 1989، إلى 49 في عام 2016”[14].
ترتفع الأنظمة البونابرتية من خلال التوازن بين الطبقات المتنازعة عندما يكون هناك توازن في الصراع الطبقي. لكن أي توازن في الفترة القادمة من المرجح أن يكون هشا للغاية. وبقدر ما تفرز عواصف الصراع الطبقي أنظمة تظهر عليها سمات بونابرتية، فإن تلك الأنظمة ستكون على الأرجح هشة وقصيرة العمر. وكما قال تروتسكي:
“لا يمكن للبونابرتية أن تبلغ الاستقرار ما لم يقم معسكر الثورة ومعسكر الثورة المضادة بقياس قوتهما في خضم المعركة”[15].
يجب التأكيد أيضا على أنه في ثلاثينيات القرن العشرين، حتى البلدان الرأسمالية القوية مثل فرنسا وألمانيا كانت تضم فئات كبيرة من الفلاحين. أما اليوم فإن ميزان القوى الطبقي، في معظم أنحاء العالم، يميل بشكل أوضح لصالح الطبقة العاملة.
من حيث العدد، لم يوجد في تاريخ العالم عدد أكبر من العمال مما هو عليه اليوم، نتيجة تحول الفلاحين والبرجوازية الصغيرة إلى طبقة عاملة في العديد من البلدان. فبحسب البنك الدولي، على سبيل المثال، يعيش اليوم 56% من سكان العالم -أي 4.4 مليار نسمة- في المدن، والغالبية العظمى منهم من العمال. القاعدة الاجتماعية للرجعية والبونابرتية، التي قام عليها نظام نابليون على سبيل المثال، قد تآكلت.
أما في البلدان الرأسمالية المتقدمة، فقد اختفت طبقة الفلاحين بالكامل. وهذا سيجعل من الصعب حتى إنشاء نظام بونابرتي مضطرب نسبيا، مما يعني أننا نواجه فترة طويلة من الثورة والثورة المضادة، والتي ستكون لدى الطبقة العاملة خلالها عدة فرص لانتزاع السلطة.
كيف نناضل ضد البونابرتية

رغبة الكثير من العمال والشباب في النضال ضد كل مظاهر الاستبداد هي غريزة صحية. لكن السؤال الذي نحتاج إلى الإجابة عليه هو: كيف يمكن الدفاع عن الحقوق الديمقراطية وكسبها من قبل الطبقة العاملة؟
هناك ممن يطلق عليهم “يساريون” يتطلعون إلى التحالف مع الليبراليين البرجوازيين طلبا للحماية. فالليبراليون -مثل جيديون راتشمان- لا يحبون حكم السيف، أو هكذا يزعمون. إنهم يفضلون المؤسسات الديمقراطية الليبرالية بوصفها أنجع وسيلة لحماية الملكية الخاصة ومصالح الطبقة البرجوازية. وبناء على ذلك، تستنتج بعض التنظيمات والمعلقين من اليسار أنه ينبغي علينا تشكيل “جبهة موحدة” بأوسع شكل ممكن ضد “النزعات الاستبدادية”، أو حتى “الفاشية”، لدى أشخاص مثل ترامب بولسونارو وجونسون.
لكن الحقيقة أن حكم البرجوازية الليبرالية المباشر هو ما أفرز تلك الحكومات الشعبوية. الليبراليون هم من نفذوا سياسات التقشف، وهم من مرروا القوانين المناهضة للنقابات. ويظهر لنا التاريخ مرارا وتكرارا أنه، عندما تقترب لحظة الحسم، وحين تلوح إمكانية الإطاحة الثورية بالرأسمالية، يفضل الليبراليون البرجوازيون الرهان على دكتاتور محتمل يتعهد بالحفاظ على الرأسمالية، بدلا من تسليم السلطة للعمال. وعلى هذا الأساس فقد دعمت مجلة الإيكونوميست، المحبة للحرية، قيام دكتاتورية بينوشيه الشرسة في تشيلي، على سبيل المثال.
سبق لماركس أن شرح هذا بمنتهى الوضوح في الثامن عشر من برومير للويس بونابرت. فقد بين كيف أن الليبراليين البرجوازيين، في مواجهة موجة متصاعدة من نضال الطبقة العاملة، سلموا المزيد والمزيد من السلطة إلى لويس بونابرت، تحت شعار “استعادة النظام”.
وقد كتب، ملخصا نتيجة هذا المسار:
“وهكذا، صفقت البرجوازية الصناعية بانبطاح خنوع لانقلاب الثاني من دجنبر، ولتدمير البرلمان، ولسقوط حكمها هي نفسها، ولديكتاتورية بونابرت”[16].
ما تعلمنا إياه هذه النتيجة هو أنه لا يمكن مقاومة البونابرتية من خلال الديمقراطية الليبرالية.
المنهج الماركسي، حين يكون الصراع الطبقي في حالة توازن هش، هو الدفع نحو كسر ذلك التوازن لصالح الطبقة العاملة. عبر كسر حالة التوازن، نمنع البونابرتي من أن يتوازن بين الطبقات، ويرفع نفسه فوقها مستخدما قوة الدولة.
وهذا بالضبط ما حدث في روسيا بين فبراير وأكتوبر 1917. لقد حاول نظام كيرينسكي، الذي وصل إلى السلطة بعد ثورة فبراير التي أطاحت بالقيصر، أن يصبح نظاما بونابرتيا.
كانت الطبقة العاملة تتحرك، لكن في فبراير كان قادتها في السوفييتات ضعفاء وغير مستعدين لتسلم السلطة. وفي المقابل، كانت البرجوازية أضعف من أن تحافظ على سلطتها.
أطلق كيرينسكي الوعود للجميع، وناور بين الطبقات محاولا الاعتماد على الجيش. وبدلا من الانخراط في تلك المناورات، أو الاتكال على الليبراليين كما فعل المناشفة، طرح لينين وتروتسكي والبلاشفة خطّا مستقلا للطبقة العاملة، تلخص في الشعار: “كل السلطة للسوفييتات.
شرح لينين في ذلك الوقت:
“إن حكومة كيرينسكي هي، من دون شك، حكومة تتخذ الخطوات الأولى نحو البونابرتية”. وأضاف أنه سيكون “غباء برجوازيا صغيرا محضا أن نتعلق بأوهام دستورية”، مؤكدا بدلا من ذلك على ضرورة “البدء في نضال حقيقي وعنيد لإسقاط البونابرتية، نضال يخاض على نطاق سياسي واسع، ويرتكز على مصالح طبقية عميقة”[17].
لقد كان ذلك الخط المستقل، الطبقي، الواضح، هو ما رجح كفة التوازن الهش لصالح العمال، ومنع كيرينسكي، أو أي دكتاتور محتمل، من إقامة نظام بونابرتي.
لا يمكن النضال ضد البونابرتية من خلال التعاون الطبقي، بل فقط من خلال النضال المستقل للطبقة العاملة من أجل السلطة. إن الأحداث المروعة الجارية في السودان أثناء كتابة هذا المقال تمثل تحذيرا مهما في هذا الصدد[18].
وهذه دروس للعمال في كل مكان. ففي روسيا أو الصين مثلا، لا يجمع الماركسيين أي قاسم مشترك مع البرجوازيين الليبراليين الذين ينوحون على غياب الديمقراطية البرجوازية. كما لا نؤيد السياسات القائمة على التعاون الطبقي، والتي تدفعنا للانضواء خلف الليبراليين البرجوازيين.
نحن ندعو إلى يرتكز النضال ضد تلك الأنظمة على الوسائل الثورية وقوة الجماهير، بقيادة البروليتاريا. قد يتضمن هذا النضال، في ظل النظام البونابرتي، رفع مطالب وشعارات ديمقراطية، لكننا نؤكد أن هذه الحقوق لا يمكن انتزاعها إلا على يد الطبقة العاملة.
إن هذه السياسة الطبقية المستقلة للبروليتاريا هي المحور الذي يبنى عليه الحزب الثوري. ويعد تطوير هذه السياسة، وبناء أداة تنظيمية لها في شكل حزب ثوري، المسؤولية العليا للماركسيين. فبهذه الوسيلة وحدها يمكن أن يكون نضالنا ضد البونابرتية والرأسمالية والمجتمع الطبقي، نضالا ناجحا.
بن غلينيكي
12 أبريل/نيسان 2024
ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:
Demagogues and dictators: what is Bonapartism?
الهوامش:
[1] K Marx, F Engels, The Classics of Marxism, Vol. 1, Wellred Books, 2013, pg 3
[2] F Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, Wellred Books, 2020, pg 155-156
[3] ibid., pg 162
[4] The Classics of Marxism, Vol. 1, pg 5
[5] V I Lenin, The State and Revolution, Wellred Books, 2019, pg 14
[6] The Origin of the Family, Private Property and the State, pg 157-158
[7] الديركتوار (Le Directoire) هو اسم نظام الحكم الذي حكم فرنسا من عام 1795 إلى 1799، خلال المرحلة الأخيرة من الثورة الفرنسية، قبل صعود نابليون بونابرت إلى السلطة. الديركتوار كان هيئة تنفيذية تتكوّن من خمسة أعضاء (مديرين)، أُنشئت بموجب دستور سنة 1795 (دستور السنة الثالثة)، وكان الغرض منها تحقيق توازن بين السلطات ومنع عودة الحكم المطلق أو الاستبداد الثوري (مثل فترة اليعاقبة).
[8] الشوان (Les Chouans) هم جماعات مناهضة للثورة الفرنسية ظهرت في غرب فرنسا، خصوصًا في منطقة بريتاني (Bretagne) ، خلال تسعينيات القرن الثامن عشر. كانوا جزءًا من حركة ملكية ومناهضة للجمهورية، دعمت عودة الملكية ورفضت تغييرات الثورة، خصوصًا ما تعلق منها بإلغاء الامتيازات الكنسية والإقطاعية.
[9] L Trotsky, The Struggle Against Fascism in Germany, Pathfinder Press, 2019, pg 443-444
[10] K Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Wellred Books, 2022, pg 113
[11] ibid., pg 14
[12] K Georgieva, “Navigating A More Fragile World”, imf.org, October 6, 2022
[13] H Marcuse, One Dimensional Man, Routledge and Kegan Paul, 2002, pg 128
[14] The Struggle Against Fascism in Germany, pg 577
[15] ibid., pg 444
[16] The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, pg 105
[17] V I Lenin, Lenin Collected Works, Vol. 25, Progress Publishers, 1964, pg 220
[18] https://www.marxist.com/sudan-bloody-clash-erupts-within-counter-revolution.htm
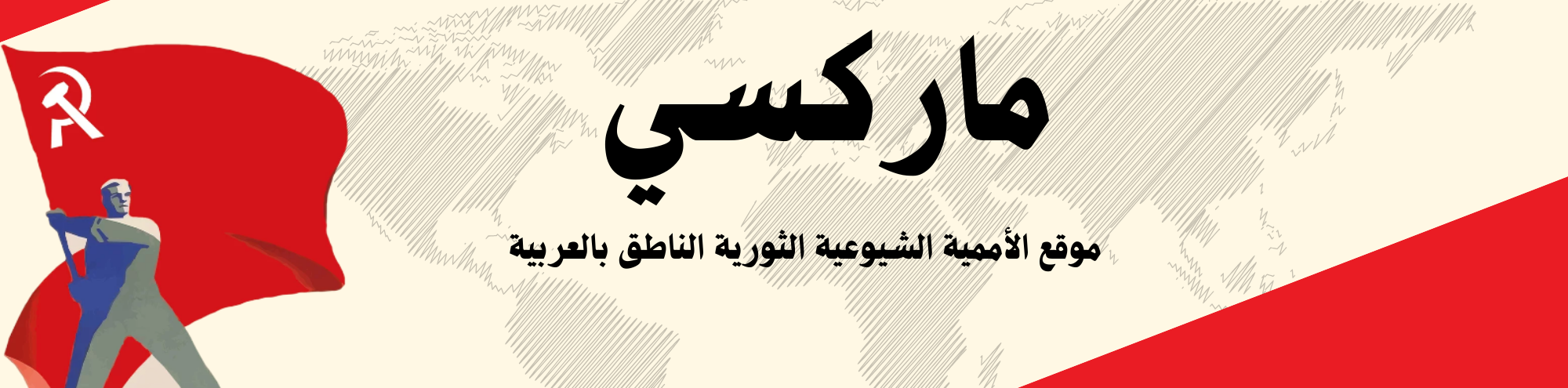 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية


