تمت المصادقة على هذه الوثيقة خلال المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأممي 2023. وفيها نقدم منظورنا وتحليلنا للاتجاهات الرئيسية التي تشكل السياسة العالمية والصراع الطبقي في هذه المرحلة الدرامية لاحتضار الرأسمالية.
نحن نعيش في مرحلة تحولات عظيمة في تاريخ العالم. تحولات فريدة من نوعها من عدة نواح. المنظرون الاستراتيجيون لرأس المال يدركون هذا جيدا. وكما هي العادة فإن الأكثر ذكاء من بينهم، يتوصلون إلى استنتاجات مماثلة لتلك التي توصل إليها الماركسيون، وإن مع بعض التأخير وبدون فهم حقيقي لطبيعة المشاكل التي يصفونها، ناهيك عن تقديم حلول.

وخير مثال على ذلك هو لاري سمرز، الاقتصادي الأمريكي الذي شغل منصب وزير الخزانة الأمريكي الحادي والسبعين من 1999 إلى 2000. والذي وصف حالة الاقتصاد العالمي على النحو التالي:
أستطيع أن أتذكر فترات سابقة ذات خطورة مشابهة أو أكبر لهذه التي يعيشها الاقتصاد العالمي، لكن لا يمكنني أن أتذكر فترات تزامنت فيها العديد من الجوانب المنفصلة وعدد من التيارات المتقاطعة كما هو عليه الحال الآن.
انظروا إلى ما يحدث في العالم: مسألة تضخم هائلة للغاية في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك بالتأكيد الكثير من بلدان العالم المتقدم؛ وسياسة تشدد نقدي كبير قيد التنفيذ؛ صدمة طاقة ضخمة، لا سيما في الاقتصاد الأوروبي، والتي هي في نفس الوقت صدمة حقيقية وصدمة تضخم؛ ثم القلق المتزايد بشأن صناعة القرار السياسي الصيني والأداء الاقتصادي الصيني، وكذلك القلق بشأن نواياها تجاه تايوان؛ ثم، بالطبع، الحرب التي ما تزال مستمرة في أوكرانيا.
-Financial Times, 6 October 2022
تصف هذه السطور بشكل واف الوضع الحالي الذي لم يتغير بشكل جوهري منذ كتابتها. ويمكن إعطاء المزيد والمزيد من الأمثلة. إنها تعكس بدقة الشعور العام بالتشاؤم واليأس الذي يسيطر على منظري رأس المال، الذين يمكنهم رؤية الكارثة الوشيكة، لكن ليست لديهم فكرة واضحة عن كيفية تجنبها.
في الواقع سيكون من العبث البحث عند الاقتصاديين البرجوازيين للحصول عن نوع من التفسير لهذا الوضع. لم يتمكنوا من توقع لا الركود ولا الازدهار. إنهم لم يفهموا الماضي، فلماذا عليهم أن يفهموا الحاضر وبالأحرى المستقبل؟
لا يمكن الوصول إلى فهم صحيح للأوضاع، في وقتنا الحالي، إلا من خلال منهج التفكير الديالكتيكي أي: منهج الماركسية. يمنحنا هذا أفضلية هائلة، مما يجعلنا نتميز عن كل التيارات الأخرى في المجتمع. وهو ما يجعلنا متفردين. إنه، في الواقع، الشيء الوحيد الذي يمنحنا الحق في أن نوجد باعتبارنا تيارا مستقلا ومتميزا داخل الحركة العمالية.
بخصوص نقاط الانعطاف
تمثل الأزمة العالمية الحالية بوضوح نقطة انعطاف في الوضع برمته. إلا أنه يمكن للمرء أن يقول إن عام 2008 كان بدوره نقطة انعطاف. وهذا صحيح تماما. ونفس الشيء عن عام 1973، الذي كان عام الركود العالمي الأول منذ الحرب العالمية الثانية.
هناك، في الواقع، العديد من الأوضاع التي يمكن وصفها بأنها نقاط انعطاف، ويمكن أن نتعرض لخطر تحويل هذه العبارة إلى شيء لا معنى له من خلال تكرارها بشكل طائش.
ومع ذلك فإن هذا المفهوم بعيد كل البعد عن أن يكون بلا معنى. إنه، على العكس، يحتوي على فكرة عميقة للغاية. إنه حقا طريقة للتعبير عن فكرة هيغل عن المسار العقدي للتطور (the nodal line of development)، حيث تصل سلسلة من التغيرات الصغيرة (الكمية) إلى نقطة حرجة، فيحدث تحول نوعي.
لكل نقطة انعطاف سمات مشتركة مع الماضي، لكن لها أيضا ميزاتها الخاصة. والمهمة الضرورية هي إبراز خصوصيات الوضع وشرح التغيرات الملموسة التي تنشأ عنه.
لقد فاجأت أزمة عام 2008 الاقتصاديين البرجوازيين اليائسين. ومن أجل منع حدوث انهيار على غرار عام 1929، أنفقت البرجوازية مبالغ كبيرة من المال العام لإنقاذ البنوك. لقد ضخوا مبالغ ضخمة في الاقتصاد. كانت إجراءات الذعر التي اتخذوها في ذلك الوقت ضرورية لإنقاذ النظام. إلا أنه كانت لها عواقب كارثية وغير متوقعة.
سياسة ما يسمى بالتيسير الكمي مكنت من إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية. لكن حقن النظام الاقتصادي بذلك الكم الهائل من رأس المال الوهمي أدى حتما إلى خلق سلسلة من الضغوط التضخمية.

لكن ذلك لم يتضح على الفور، وذلك نتيجة للانهيار العام في الطلب، بما في ذلك استهلاك الأسر، واستثمارات الشركات، والإنفاق الحكومي. أدى انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة إلى خنق الطلب، والذي لم يعد من الممكن تحفيزه بالاقتراض، لأن الناس كانوا بالفعل غارقين بشكل كبير في المديونية.
ومع ذلك فقد عبرت الضغوط التضخمية عن نفسها في طفرة سوق الإسكان وخاصة في موجة المضاربة الجامحة في أسواق الأوراق المالية، إلى جانب ظواهر مثل العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs)، وغير ذلك من الحيل المضارباتية.
حدود العولمة
لفهم الوضع الحالي من الضروري أن نستند على الأساسيات. علينا دائما أن نضع في اعتبارنا العائقين الرئيسيين اللذين يعرقلان التطور الكامل لقوى الإنتاج، أي: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، من جهة، والحدود الخانقة للدولة الوطنية، من جهة أخرى.
لكن النظام الرأسمالي هو كائن حي، يمكنه أن يطور آليات دفاعية معينة من أجل أن يديم وجوده. لقد شرح ماركس في المجلد الثالث من رأس المال الطرق التي يمكن للبرجوازية من خلالها محاربة ميل معدل الربح إلى الانخفاض. وإحدى الطرق الرئيسية هي تعزيز وتوسيع السوق من خلال زيادة التجارة العالمية.
أشار البيان الشيوعي، منذ أكثر من 150 عاما، إلى الهيمنة الساحقة للسوق العالمية. هذه الآن هي أهم ميزة في العصر الحديث.
كان ظهور العولمة تعبيرا عن حقيقة أن نمو قوى الإنتاج قد تجاوز الحدود الضيقة للدولة القومية. لقد ساعد الرأسماليين -جزئيا على الأقل- على تجاوز حدود السوق الوطنية لفترة من الزمن.
تلقى هذا الاتجاه دفعة قوية بفعل انهيار الاتحاد السوفياتي ودخول الصين إلى السوق الرأسمالية العالمية. كما أن بلدانا أخرى -ليس فقط بلدان أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي، بل أيضا الهند، التي كانت تتوازن بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة- انخرطت بدورها في هذا المسار.
هكذا، وبضربة واحدة، انخرط مئات الملايين من الناس في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وانفتحت أسواق ومجالات استثمار جديدة.
كان هذا (إلى جانب التوسع غير المسبوق في الاقتراض) أحد أقوى القوى المحركة التي دفعت الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة. كان للزيادة الهائلة في التجارة العالمية انعكاس على زيادة الناتج الإجمالي العالمي.
لكن العولمة لم تقض على تناقضات الرأسمالية، إذ لم تعمل سوى على إعادة إنتاجها على نطاق أوسع. ومن الواضح الآن أن هذا قد وصل إلى حدوده.
كان النمو السريع للإنتاج قائما على التوسع الأسرع في التجارة العالمية، أما الآن فمن الواضح أن العولمة قد بدأت تتباطأ. وبدأ كل شيء يسير فجأة في الاتجاه المعاكس. ما نواجهه اليوم هو عواقب ذلك التقهقر. فوفقا لمنظمة التجارة العالمية ستنمو التجارة العالمية، في عام 2023، بنسبة 1% فقط.
وبدلا من حرية حركة السلع والخدمات، نشهد الآن انحدارا سريعا نحو القومية الاقتصادية. وهذا تشابه مثير للقلق مع سنوات الثلاثينيات. لقد كان صعود الميول الحمائية، وزيادة التعريفات الجمركية، والتخفيضات التنافسية لقيمة العملة وسياسات تصدير الأزمة للآخرين، هي الأسباب الحقيقية للكساد العظيم. وليس من المستبعد على الإطلاق أن تتكرر حالة مماثلة.
تشوهات السوق
في ظل اقتصاد السوق الرأسمالي قوى السوق هي التي تقرر في آخر المطاف. سياسات الحكومات يمكنها أن تشوه وتؤخر قوى السوق، إلا أنه لا يمكنها أبدا أن تقضي عليها. والحقيقة هي أن الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة لم تتعاف قط من الأزمة الرأسمالية العالمية لسنة 2007-2009.
بقي استثمار الشركات الخاصة ضعيفا واستمر النمو الاقتصادي بطيئا. ومن ناحية أخرى كان التضخم منخفضا وحافظت البنوك المركزية على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل غير مسبوق، مما وسع قبضة رأس المال المالي على الحياة الاقتصادية. يوفر هذا المفتاح لفهم الأزمة الحالية.
عشية الجائحة، كان الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يملكون 15 تريليون دولار من الأصول المالية، مقابل 3,5 تريليون دولار في عام 2008. وقد أضافوا لذلك 06 تريليونات أخرى خلال الجائحة في محاولة للحفاظ على الاقتصاد طافيا.
جزء كبير من تلك المبالغ كان ديونَ الحكومات التي اشترتها البنوك المركزية للإبقاء على تكاليف الاقتراض الحكومي في أدنى مستوياتها. مستوى المديونية -الذي كان قد بلغ أصلا مستويات لا يمكن تحملُها- واصل الارتفاع بشكل كبير حيث اقترضت الحكومات مبالغ ضخمة لدفع ثمن تدابير مواجهة الأزمة.
هذا التحفيز الحكومي غير المسبوق (عمليات الإنقاذ)، إضافة إلى عمليات الإغلاق، أدى إلى إحداث انحراف مؤقت في أنماط طلب المستهلكين، وإثارة فوضى في سلاسل التوريد، بينما أذكى نيران التضخم. من المفترض أن تكون التداعيات التضخمية لكل ذلك مرئية للجميع. لكنهم تجاهلوها، على أساس أنه:
عندما يكون الجهل نعمة، فمن الحماقة أن تكون عاقلا.
ومثلما يصبح مدمن المخدرات أكثر اعتمادا على المواد التي توفر له إحساسا فوريا بالنشوة، فقد أصبحت الحكومات والشركات والأسر مدمنين على استمرار أسعار فائدة قريبة من الصفر.
لكن تلك التشوهات التي أحدثها تدخل الحكومات لا تؤدي إلا إلى تفاقم التناقضات، التي ستنفجر في النهاية بقوة وعنف مضاعفين.
هذا بالضبط هو ما نشهده في الوقت الحاضر. ففي محاولة يائسة، حاولت الحكومات حل أزمة 2008 أولا، ثم جائحة كوفيد، والآن أزمة الطاقة، من خلال إنفاق مبالغ ضخمة من أموال لم تكن تمتلكها، مما ساهم في الوضع الفوضوي الحالي في الاقتصاد العالمي.
عودة التضخم
هذا يدل على نهاية نظام مالي اعتاد على معدلات تضخم منخفضة وأسعار فائدة منخفضة. والآثار مأساوية ومؤلمة. وتماما مثل مدمن محروم من المخدرات التي يعتمد عليها، تجد الحكومات الآن نفسها فجأة مصدومة في مواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض.
لكن وبما أنه ليس لديهم أي فهم للنظرية الاقتصادية الحقيقية، فإن البرجوازيين ينظرون حولهم بيأس بحثا عمن يمكنهم أن يحملوه مسؤولية محنتهم، وقد وجدوا في فلاديمير بوتين كبش فداء مناسبا لهم. لكن الحرب في أوكرانيا لم تكن سبب الكارثة التضخمية، فهي لم تعمل سوى على صب المزيد من الوقود على النار.
من الناحية الديالكتيكية يصبح السبب نتيجة، وتصبح النتيجة بدورها سببا. وعلى الرغم من أن الحرب لم تكن السبب في حدوث الأزمة، فمن المؤكد أنها أدت إلى تفاقم مشكلة التضخم وتعطيل التجارة العالمية.
لكلاوزفيتز مقولة شهيرة مفادها أن الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى. لكن الإمبريالية الأمريكية أدخلت تعديلا طفيفا على ذلك التعريف الصحيح. لقد جعلت من التجارة حربا، وتعمل على معاقبة أي بلد لا ينصاع لإرادتها.

في تلك الأيام البعيدة عندما كانت بريطانيا تسيطر على بحار العالم، كانت الإمبريالية البريطانية تحل مشاكلها بإرسال بارجة حربية. أما الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، فتبعث رسالة من وزارة التجارة. ولذلك فإن التجارة، في ظل الظروف الحديثة، أصبحت مجرد استمرار للحرب بوسائل أخرى.
روسيا، التي هي واحدة من أكبر مصدري الوقود الأحفوري، طردت عمدا من أسواقها في الغرب بسبب العقوبات التي فرضتها الإمبريالية الأمريكية ووافق عليها الاتحاد الأوروبي. وقد أثار هذا على الفور أزمة طاقة، مما أدى إلى ارتفاع أكبر للأسعار.
وكما سنرى لاحقا، فإن العقوبات التي فرضتها الإمبريالية الأمريكية فشلت بشكل واضح في تحقيق هدفها، والذي هو شل اقتصاد روسيا وتقويض عملياتها العسكرية في أوكرانيا. لكنها أعطت منعطفا جديدا قويا للدوامة التضخمية في جميع أنحاء العالم. ومن المفارقات هو أن تلك الدوامة ضربت أيضا الولايات المتحدة بشدة، مما قلب جميع حسابات بايدن رأسا على عقب، بينما استمر بوتين يجني بهدوء الأرباح المتأتية من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
كل الطرق تؤدي إلى الخراب
تواجه البنوك المركزية معضلة حادة. لقد رفعوا أسعار الفائدة من أجل كبح الطلب وبالتالي خفض التضخم (كما يأملون). كانت تلك هي النظرية التي دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، مما أجبر معظم السلطات النقدية في العالم على فعل الشيء نفسه.
لا يمكن لمثل هذه التدابير، في حد ذاتها، أن توفر علاجا أكيدا لمرض التضخم المزمن، لكنها بالتأكيد ستجعل الركود أمرا حتميا. وهذا يعني إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وفقدان الوظائف والتخفيضات الوحشية في مستويات المعيشة.
هذه وصفة ملائمة لاشتداد الصراع الطبقي واندلاع صراع سياسي عنيف. أي أنها تعني القفز من الرمضاء إلى النار.
وعلاوة على ذلك فإنه بمجرد أن يدخل الاقتصاد في الانكماش، سيكون من الصعب وقف دوامة السبب والنتيجة التي ستنتهي بركود عميق، سيجدون صعوبة بالغة في الخروج منه.
وبالتالي سيواجه العالم بأسره فترة طويلة من الركود الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة، مع عواقب اجتماعية وسياسية متفجرة. وبعبارة أخرى فإنه في ظل النظام الرأسمالي، كل الطرق تؤدي إلى الخراب.
صب الزيت على النار
من المستحيل أن نحدد بدقة الوتيرة التي ستسير بها الأحداث. هناك عدد كبير جدا من العناصر العرضية في هذه المعادلة. إلا أن هناك أيضا عدد من الأشياء التي يمكننا قولها على وجه اليقين، ومن بينها على وجه الخصوص أن كل هذا سيؤثر حتما على الوعي.
هذا هو الحال قبل كل شيء مع أزمة غلاء المعيشة. والتي هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لكثير من الناس. وينطبق هذا بشكل خاص على أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. لكن هذه الآثار لا تقتصر بأي حال من الأحوال على البلدان المتخلفة. إذ يتم الشعور بها بشكل متزايد كذلك في البلدان الرأسمالية المتقدمة، في أوروبا وأمريكا الشمالية.
فجأة وجدت الجماهير في أوروبا، على وجه الخصوص، نفسها أمام كابوس حقيقي يتمثل في انهيار مستويات المعيشة: الأجور، التي كانت متدنية بالفعل عند مستويات منخفضة للغاية، يتم دفعها إلى مستويات جديدة ومنخفضة بشكل غير مسبوق بسبب التضخم الهائل. وقيمة المعاشات والمدخرات يتم تخفيضها بسرعة. كما تواجه الأسر معضلة مؤلمة تتمثل في الاختيار بين تدفئة منازلهم أو إطعام أطفالهم.
المسنون والمرضى وأكثر فئات المجتمع هشاشة، يتعرضون الآن لخطر مميت لأن الحكومات تخفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. وصارت الطبقة الوسطى، لأول مرة منذ عقود عديدة، تواجه الخراب.
تتجه الأعمال التجارية الصغيرة إلى الإفلاس بسبب مزيج سام من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والإيجارات وسداد أقساط الرهن العقاري. ومع استمرار الركود فإن إغلاق المصانع سيعني زيادة حادة في البطالة وتراجعا في الطلب، مما سيؤدي إلى مزيد من حالات الإفلاس.
إن الأزمة التي يواجهها الرأسماليون عميقة للغاية، والتناقضات أكبر من أن يتم حلها على أساس رأسمالي. لم يعد يمكنهم تكرار السياسات النقدية التي طبقوها خلال الفترة السابقة.
لقد استنفدوا كل ذخيرتهم في محاولتهم حل الأزمة الأخيرة. وعلاوة على ذلك فإن تلك التكتيكات مسؤولة عن خلق هذا الجبل الضخم من الديون الذي يخيم على العالم مثل خطر انهيار جبل جليدي.
سيضطرون الآن إلى الترنح من أزمة إلى أخرى، دون الأسلحة اللازمة لمواجهتها. سوف يتوجب سداد الديون، بشكل أو بآخر، عاجلا أم آجلا. وسيتم تقديم الفاتورة لمن هم أقل قدرة على الدفع.
لكن هذا بدوره يصب الزيت على نار الصراع الطبقي. فبعد فترة طويلة من تخفيض مستويات المعيشة، نفد صبر الجماهير من التقشف، وستثير محاولات فرض تدابير تقشف جديدة مقاومة شرسة.
كل هذا يقدم صورة مفزعة للطبقة السائدة. لقد بدأ بالفعل غليان واسع النطاق وتشكيك عام في النظام القائم. توجد إمكانية ليس فقط لرد فعل عمالي في كل مكان، بل أيضا لرد فعل هائل ضد السوق وضد النظام الرأسمالي وكل سياساته بين فئات واسعة من المجتمع.
الاقتصاد العالمي
لقد امتلأت صفحات الصحف المالية طيلة أشهر عديدة بأكثر التكهنات تشاؤما. يتنامى الشعور بأن النظام العالمي يقف على رأسه مع تحول العولمة إلى نقيضها وتصدع الاستقرار القديم بسبب الحرب في أوكرانيا والفوضى الناتجة عن ذلك في سوق الطاقة.

انعكست مخاوف واضعي استراتيجيات رأس المال في خطاب ألقته المديرة العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بجامعة جورج تاون، حيث حذرت من أن:
النظام القديم، الذي كان يتميز بالالتزام بالقواعد العالمية، وانخفاض معدلات الفائدة، وانخفاض التضخم، يفسح المجال لنظام يمكن فيه أن يخرج أي بلد عن مساره بسهولة أكبر وفي كثير من الأحيان.
إننا نشهد تحولا جوهريا في الاقتصاد العالمي، من عالم يتسم بإمكانية التوقع النسبي… إلى عالم أكثر هشاشة -حالة عدم يقين أكبر، وتقلبات اقتصادية أشد، ومواجهات جيوسياسية، وكوارث طبيعية أكثر تواترا وتدميرا.
وتقدم الأسواق المالية العالمية مؤشرا واضحا على عمق الأزمة. فوفقا لمجلة الإيكونوميست:
الاضطرابات في الأسواق هي من حجم لم يسبق له مثيل منذ جيل. التضخم العالمي صار من رقمين للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عاما. وبعد أن كان الاحتياطي الفيدرالي بطيئا في الاستجابة، بدأ الآن يقوم برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، بينما بقي الدولار في أقوى حالاته منذ عقدين، مما يتسبب في حدوث فوضى خارج أمريكا. إذا كانت لديك محفظة استثمارية أو معاش تقاعدي، فإن هذه السنة كانت مروعة. لقد تراجعت الأسهم العالمية، من حيث القيمة الدولارية، بنسبة 25%، وهي أسوء سنة منذ الثمانينيات على الأقل، والسندات الحكومية في طريقها إلى أسوء سنة لها منذ 1949. وإلى جانب حوالي 40 تريليون دولار من الخسائر، هناك شعور بالقلق البالغ من أن النظام العالمي ينقلب رأسا على عقب مع اقتراب العولمة من التراجع وتحطم نظام الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
هذا التوتر الذي تعرفه الأسواق هو مقياس دقيق لانهيار ثقة المستثمرين، الذين يرون غيوم العواصف تتجمع بسرعة في سماء الاقتصاد العالمي.
الارتفاع الجامح للدولار
جزء كبير من المشكلة يتمثل في الارتفاع المتواصل للدولار. لكنه عوض أن يكون تعبيرا عن الثقة في قوة الاقتصاد الأمريكي، فإنه مؤشر على مدى الذعر الذي يسيطر على الأسواق.
لقد ارتفعت العملة الأمريكية بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، لكن أيضا إلى امتناع المستثمرين عن المخاطرة. ينظر المستثمرون الخائفون حولهم بحثا عن ملاذ آمن لأموالهم وتخيلوا أنهم قد وجدوه في ‘الدولار العظيم’.
لكن ارتفاع الدولار هو بحد ذاته عامل في أزمة أسواق المال في العالم، حيث يسحق كل شيء آخر في أحضانه الحديدية. إن الآثار المالية للتضييق النقدي الذي فرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي تظهر في صورتها الأقسى والأكثر ضررا خارج أمريكا، كما أشارت إلى ذلك الفاينانشيال تايمز (12 أكتوبر 2022):
أيا كان الحال، فإن ضحايا الدولار القوي لديهم متهم واحد: الاحتياطي الفيدرالي.
إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في واقع الأمر، استمر حتى اللحظة الأخيرة، يتبنى موقفا متساهلا -بل ينبغي أن نقول ضعيفا- تجاه التضخم، الذي كان من المفترض، وفقا للمعايير المقبولة، أنه قد تمت هزيمته.
لكن عندما بدأ الضوء الأحمر في الوميض بعنف، استولت على الاحتياطي الفيدرالي فجأة حالة من الذعر، مما دفعه إلى أن يطبق زيادات متواصلة في سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا كان يشبه الضغط بقوة على فرامل السيارة.
زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تدفع بالاقتصاد الأمريكي نفسه إلى الركود. وقد كان هذا هو المقصود بالضبط. كل المؤشرات سلبية. أسعار المنازل آخذة في الانخفاض، والبنوك تسرح الموظفين، وأصدرت شركتا فيديكس وفورد، وهما شركتان رائدتان، تحذيرات بشأن الأرباح. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ معدل البطالة في الارتفاع.
إن الارتفاع الجامح في قيمة الدولار يصبح على الفور عاملا رئيسيا من عوامل زعزعة الاستقرار. يشعر المستثمرون الدوليون بالقلق من احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة إلى درجة أن يؤدي إلى انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود. سيؤدي ذلك إلى مفاقمة الركود الذي تواجهه بالفعل اقتصادات رئيسية أخرى وسوف يجر بقية العالم إلى أسفل.
لمخاوفهم ما يبررها. ففي جميع أنحاء العالم، أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة الواردات وكذلك تكلفة سداد الديون بالنسبة للحكومات والشركات والأسر التي أخذت قروضا مقومة بالدولار. تجد جميع البلدان الأخرى نفسها مضطرة للسير بخطى متوازنة مع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورفع أسعار الفائدة إلى المستويات التي يمليها.
اضطرت الحكومات في جميع أنحاء آسيا إلى رفع قيمة الفوائد وإنفاق احتياطياتها لمقاومة انخفاض قيمة عملاتها. وقد تدخلت كل من الهند وتايلاند وسنغافورة في الأسواق المالية لدعم عملاتها. ووفقا لبنك جي بي مورجان تشيس فقد انخفضت احتياطيات العملات في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، بأكثر من 200 مليار دولار في العام الماضي، وهو أسرع انخفاض منذ عقدين.
ولهذا تداعيات خطيرة، ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية أيضا. وقد ردت الصين بطرح عملتها كوسيلة بديلة للتجارة، لا سيما في مجال النفط.
ديون حكومية ضخمة
اقتصادات منطقة اليورو المثقلة بالديون دُفعت بلا رحمة إلى حافة الإفلاس. إنها تجد نفسها الآن في وضعٍ أسوء من ذلك الذي كان قائما أثناء أزمة الديون السيادية قبل عقد من الزمن.
وقد حذر جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن الفيدرالي الأمريكي يصدِّر الركود بنفس الطريقة التي فرضت بها أزمة اليورو بموجب إملاءات ألمانيا بعد عام 2008.
وأضاف أن: «الكثير من بلدان العالم صارت الآن مهددة بأن تصبح مثل اليونان».
في أوروبا، ازداد الوضع سوءا عندما صبت بريطانيا البنزين على النار بسياسة مالية متهورة، الأمر الذي أثار على الفور حالة من الذعر في الأسواق المالية.
تكشف الضرورة عن نفسها من خلال الصدفة. وقد كانت الأزمة في بريطانيا وإجراءات خفض الضرائب، التي اتخذتها إدارة تروس قصيرة العمر في أكتوبر 2022، بمثابة حافز، مما أدى إلى إصابة الأسواق المالية بالذعر، والذي كان من الممكن أن ينتشر بسهولة إلى النظام النقدي العالمي بأكمله.
قوبل هذا بمزيج من الغضب والشك والقلق من قبل أسواق المال العالمية. لقد ألقت ليز تروس، في الواقع، قنبلة يدوية على برميل من المتفجرات كان جاهزا للانفجار عند أدنى اهتزاز.
وقد شن صندوق النقد الدولي هجوما لاذعا على خطة المملكة المتحدة لتنفيذ 45 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية الممولة بالديون. ونجح في ذلك، حيث اضطرت حكومة تروس إلى التراجع بشكل مهين. تمت إقالة وزير الخزانة، كواسي كوارتنغ، وتم إيقاف العمل بميزانيته بالكامل. بعد ذلك بفترة وجيزة تم طرد تروس نفسها من منصبها واستقرت الأسواق مؤقتا. لكن الضرر كان قد حدث بالفعل.
المصداقية المالية بمجرد ما يتم فقدانها يصير من الصعب إلى حد ما استعادتها، وسمعة بريطانيا كقوة عالمية قد صارت الآن في الحضيض. المملكة المتحدة، التي كانت تتمتع في السابق بتصنيف ائتماني مثالي، تم تخفيض تصنيفها الآن وصارت تعتبر في نفس فئة إيطاليا المثقلة بالديون والمعرضة للأزمات.
لكن تلك كانت النتيجة الأقل أهمية لهذه القضية. فقد انتشرت الآثار إلى أبعد من الشواطئ البريطانية.
تشابهات مقلقة مع الثلاثينيات
كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوضح مؤشر على عواقب القومية الاقتصادية. وكان سلوك الحكومة البريطانية في هذه القضية بمثابة تحذير من العواقب الخطيرة لذلك.
أظهرت فترة رئاسة الوزراء القصيرة والمدمرة لليز تروس في بريطانيا أن اقتراض الكثير من المال في وقت التضخم وارتفاع معدلات الفائدة ليس خيارا جيدا. لكن ما هو البديل؟

لاري سمرز، الذي لاحظنا سابقا قلقه بشأن الوضع الحالي، صرح في الفاينانشيال تايمز أن:
الاضطراب الذي أحدثته أخطاء البريطانيين لن يقتصر على بريطانيا.
وهذا هو بيت القصيد. فقد تقلبت أسعار السندات في بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة وإيطاليا بعنف استجابةً لكل منعطف وتحول في القصة المعقدة القادمة من لندن.
لم يكن ذلك من قبيل الصدفة. فقد كان من الممكن لانهيار مالي في بريطانيا -التي، على الرغم من تراجع مكانتها، ما تزال واحدة من أهم المراكز المالية في العالم- أن يكون له نفس تأثير أزمة سنة 1931، لكن على نطاق أوسع بكثير.
إن الواقع الذي يتم نسيانه بشكل عام الآن هو أن الكساد العظيم في أوروبا اندلع بسبب انهيار بنك Creditanstalt في فيينا في ماي 1931، والذي أطلق تأثير الدومينو الذي انتشر بسرعة في جميع الأسواق المالية في أوروبا وخارجها.
كان ذلك هو الدافع وراء دوامة الانكماش الهائلة التي شهدتها أوروبا بين سنتي 1931 و1933. ويمكن للتاريخ أن يعيد نفسه بسهولة، خاصة وأن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر تداخلا وترابطا مما كان عليه في ذلك الوقت.
العامل الأوكراني
أصبحت الحرب في أوكرانيا الآن عاملا مهما في المنظورات العالمية. لكن من أجل الحصول على فكرة واضحة عن القضايا المطروحة وكيف يمكن أن تتطور، من الضروري تركيز انتباهنا على السيرورات الجوهرية، وعدم تشتيت انتباهنا بسبب حرب المعلومات الصاخبة، أو التقلبات الحتمية في ساحة المعركة.
لقد دأبت وسائل الإعلام الرئيسية على تكرار المزاعم حول هزيمة روسيا. لكن هذا لا يتوافق مع الحقائق المعروفة.
النقطة الأكثر أهمية هي أن هذه حرب بالوكالة بين روسيا والإمبريالية الأمريكية. روسيا لا تقاتل جيشا أوكرانيا بل جيش الناتو -أي جيش دولة ليست عضوا رسميا في ذلك التحالف، لكنه يتم تمويلها وتسليحها وتدريبها وتجهيزها من قبل الناتو- والذي يوفر لها أيضا الدعم اللوجستي والمعلومات الحيوية.
“السياسة بوسائل أخرى“
الحرب، كما سبقت الإشارة، ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى. وسوف تنتهي الحرب الحالية عندما تكون الغايات السياسية للاعبين الرئيسيين قد تحققت، أو عندما يصاب أحد الطرفين، أو كلاهما معا، بالإرهاق ويفقد الرغبة في مواصلة القتال.
ما هي تلك الأهداف؟ أهداف زيلينسكي الحربية ليست سرا. فهو يقول إنه لن يقبل بأقل من الطرد الكامل للجيش الروسي من جميع الأراضي الأوكرانية – بما في ذلك القرم.

وقد لقي هذا الموقف دعماً حماسيا من طرف الصقور في التحالف الغربي: البولونيون والسويديون وقادة دول البلطيق -الذين تحركهم مصالحهم الخاصة- وبالطبع هؤلاء الشوفينيون المتحجرون ودعاة الحرب في لندن، الذين يتوهمون أن بريطانيا، حتى في حالتها الحالية من الإفلاس الاقتصادي والسياسي والمعنوي، ما تزال قوة عالمية كبرى.
هؤلاء السيدات والسادة المجانين يواصلون دفع الأوكرانيين للذهاب بعيدا، أبعد مما يريده الأمريكيون. رغبتهم الأكثر حماسة هي أن يروا الجيش الأوكراني وهو يطرد الروس، ليس فقط من دونباس بل أيضا من شبه جزيرة القرم، مما يؤدي إلى الإطاحة ببوتين والهزيمة الكاملة والتفكيك الكامل لفدرالية روسيا (على الرغم من أنهم في غالب الأحيان لا يتحدثون عن هذا علنا).
لكن وعلى الرغم من أنهم يتسببون في الكثير من الضجيج، فإنه لا يوجد شخص جاد يولي أدنى اهتمام لصراخ هؤلاء السياسيين في لندن ووارسو وفيلنيوس. فباعتبارهم قادة لدول من الدرجة الثانية تفتقر إلى أي وزن حقيقي في موازين السياسة الدولية، يبقون مجرد ممثلين من الدرجة الثانية ولا يمكنهم أبدا لعب أكثر من دور داعم ثانوي في هذه الدراما الضخمة.
إن الولايات المتحدة هي التي تدفع الفواتير وهي من تقرر كل ما يحدث. والمنظرون الأكثر رصانة للإمبريالية الأمريكية يعرفون أن كل هذا الهذيان مجرد كلام فارغ. يمكن لدول امبريالية صغرى أن تلعب، في ظل ظروف معينة، دورا ما في الأحداث الجارية، لكن واشنطن هي التي تقرر في آخر المطاف.
وعلى الرغم من التبجح المعد للاستهلاك الاعلامي، فقد أدرك الاستراتيجيون العسكريون الجادون أنه من المستحيل على أوكرانيا هزيمة روسيا. الجنرال مارك ميلي هو الرئيس العشرون لهيئة الأركان المشتركة، وهو أعلى ضابط عسكري في الولايات المتحدة. لذلك يجب أن تؤخذ آراؤه على محمل الجد عندما يقول:
إن احتمال حدوث نصر عسكري أوكراني يؤدي إلى طرد الروس من جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك القرم، في أي وقت قريب، ليس احتمالا عاليا من وجهة النظر العسكرية.
إن أهم نقطة يجب فهمها هي أن أهداف الحرب بالنسبة لواشنطن لا تتطابق مع أهداف الحكام في كييف، الذين سلموا منذ زمن بعيد ما يسمى بسيادتهم الوطنية إلى أسيادهم على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والذين لم يعد في مقدورهم أن يقرروا في أي شيء بأنفسهم.
إن هدف الإمبريالية الأمريكية من الحرب ليس -ولم يكن أبدا- هو الدفاع ولو عن شبر واحد من الأراضي الأوكرانية أو مساعدة الأوكرانيين على كسب الحرب، أو أي شيء مشابه.
إن هدفهم الحقيقي بسيط للغاية: إضعاف روسيا عسكريا واقتصاديا. استنزافها حتى آخر قطرة وإلحاق الأذى بها؛ قتل جنودها وتدمير اقتصادها حتى لا يعود في إمكانها أن تقاوم بعد الآن الهيمنة الأمريكية على أوروبا والعالم.
وقد كان هذا هو الهدف الذي دفعهم إلى إقحام الأوكرانيين في صراع غير ضروري على الإطلاق مع روسيا بشأن عضوية الناتو. وبعد أن أشعلوا هذا الصراع، جلسوا، على بعد مسافة آمنة تبلغ عدة آلاف من الأميال، يتابعون مشهد الطرفين وهما يتناحران.
وبغض النظر عن كل التباكي العلني فإن هؤلاء المنافقين الإمبرياليين لا يبالون نهائيا بمعاناة الشعب الأوكراني، الذي يعتبرونه مجرد بيادق على رقعة الشطرنج المحلية في صراعهم مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى يومنا هذا، لم يتم قبول أوكرانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو الناتو، وهو الشيء الذي كان من المفترض أن يكون النقطة المركزية في القضية برمتها. وذلك ليس من قبيل الصدفة.
الصراع الحالي يناسب مصالح أمريكا من نواح كثيرة. إنه يخدم هدفهم المتمثل في دق إسفين بين أوروبا وروسيا، وبالتالي جر أوروبا أكثر تحت سيطرتهم. وقد حققت لهم الحرب بالفعل بعض النتائج في هذا الصدد. لقد تم كسر التشابك الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة، وهو الشيء الذي ضرب بشدة أقوى اقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي أي: ألمانيا. وأصبحت تجارة الغاز الطبيعي عبر بحر البلطيق غير قابلة للاستمرار ماديا بفعل التفجير المتعمد لخطوط أنابيب نورد ستريم. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يسمح للولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي، وخاصة الصناعة الألمانية. والأمريكيون لديهم رفاهية توريط أعدائهم في حرب لا يشارك فيها أي جندي أمريكي (على الأقل من الناحية النظرية)، وكل القتال والموت يتكبده الآخرون.
لو كانت أوكرانيا عضوا في الناتو، لكان ذلك سيعني أنه على القوات الأمريكية أن تشارك في حرب أوروبية، لتقاتل الجيش الروسي. وفي الوقت نفسه فإن بلدان الاتحاد الأوروبي الرئيسية ليست لديها لا المصلحة ولا الإمكانية لقبول أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وهو ما يعني انهيار التوازن الاقتصادي والسياسي الهش للغاية أصلا لنسيج الاتحاد الأوروبي. كلا، من الأفضل ترك الأشياء كما هي.
عندما يشتكي زيلينسكي من أن حلفائه الغربيين لا يرسلون له الأسلحة التي يحتاجها لكسب الحرب، فهو ليس مخطئا. فالأمريكيون يكتفون بأن يرسلوا له ما يكفي من الأسلحة لمواصلة الحرب، لكن ليس ما يكفي لتحقيق أي شيء يشبه نصرا حاسما. وهذا ما يتماشى تماما مع أهداف الأمريكيين الحقيقية من وراء الحرب.
فشل العقوبات
العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا تعرضت لفشل ذريع. في الواقع، لقد ارتفعت قيمة الصادرات الروسية بالفعل منذ بداية الحرب.
وعلى الرغم من انخفاض حجم واردات روسيا نتيجة للعقوبات، فقد زادت عدد من البلدان (مثل الصين والهند وتركيا، وكذلك بعض البلدان التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وإسبانيا وهولندا) حجم تجارتها مع روسيا. وعلاوة على ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد عوض الإيرادات التي خسرتها روسيا بسبب العقوبات. فالهند والصين تشتريان الكثير من نفطها الخام، وإن بسعر مخفض.
وهكذا فإن المداخيل التي ضاعت بسبب العقوبات قد تم تعويضها بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. يواصل فلاديمير بوتين تمويل جيوشه من العائدات، بينما يواجه الغرب احتمال اضطراب طاقي خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع فواتير الطاقة وتزايد الغضب الشعبي.
تناقص الدعم
السؤال هو: من هو الجانب الذي سوف يتعب من الحرب أولا؟ من الواضح أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية. وهو ما سيكون له الدور الحاسم، في آخر المطاف.

والشتاء، الذي عانت فيه أوروبا من نقص كبير في الغاز والكهرباء، من شأنه أن يضعف التأييد الشعبي للحرب في أوكرانيا. لكن الطقس الأكثر دفئا لن يجلب أي فترة راحة، حيث سيتحول الانتباه إلى المشكلة المستحيلة المتمثلة في كيف يمكن تجديد مخزون الغاز في الوقت المناسب للعام المقبل دون الاستعانة بالإمدادات الروسية. ومع كل شهر تستمر خلاله العقوبات ستتزايد المخاوف بخصوص الشتاء المقبل. كما أنه لا يمكن اعتبار الدعم الأمريكي أمرا بديهيا. يواصل الأمريكيون في العلن التعبير عن دعمهم الذي لا يتزعزع لأوكرانيا، لكنهم في الواقع ليسوا مقتنعين على الإطلاق بالنتيجة. ووراء الكواليس تضغط واشنطن على زيلينسكي للتفاوض مع بوتين.
لكن الهجوم الأوكراني الناجح في شتنبر 2022 والانسحاب الروسي من خيرسون، أدى من الناحية العملية إلى تعقيد الوضع على رقعة الشطرنج الدبلوماسية.
فمن ناحية بدأ زيلينسكي والقوى القومية المسعورة والقوى الفاشية الصريحة داخل جهاز الدولة، المخمورين بمكاسبهم غير المتوقعة، يرغبون في الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير. ومن ناحية أخرى شكلت الانتكاسات العسكرية ضربة مذلة لبوتين الذي توصل إلى نتيجة مفادها أنه بحاجة إلى تصعيد “عمليته العسكرية الخاصة”. وبالتالي فلا يتمتع أي من الطرفين بمزاج يسمح له بالتفاوض على أي شيء ذي معنى في الوقت الحاضر. لكن هذا سوف يتغير.
ديماغوجية زيلينسكي، الذي يكرر باستمرار أنه لن يتخلى عن شبر واحد من الأرض، مصممة بشكل واضح للضغط على الناتو والإمبريالية الأمريكية. إنه يصر على أن الأوكرانيين سيقاتلون حتى النهاية، بشرط أن يستمر الغرب في إرسال كميات ضخمة من الأموال والأسلحة.
يود بايدن إطالة أمد الصراع الحالي من أجل إضعاف روسيا وتقويضها، لكن ليس بأي ثمن، وبالتأكيد ليس إذا كان ذلك ينطوي على احتمال صدام عسكري مباشر مع روسيا. وفي غضون ذلك تُظهر استطلاعات الرأي، الواحدة منها تلو الأخرى، أن دعم الرأي العام في الغرب للحرب في أوكرانيا يتراجع شيئا فشيئا.
حرب نووية؟
كان تلميح بوتين بأنه قد يفكر في استخدام أسلحة نووية مجرد خدعة على نحو شبه مؤكد، لكنه أثار القلق في البيت الأبيض. وفي حديثه في حفل لجمع التبرعات في نيويورك، قال بايدن إن الرئيس الروسي “لا يمزح” بشأن «الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيماوية لأن جيشه، كما يمكن القول، ضعيف الأداء بشكل كبير».
ونتيجة لذلك التهديد النووي، بدأت مفاوضات سرية بين واشنطن وموسكو. كانت تلك هي قبلة الموت للجانب الأوكراني، الذي كان يبحث يائسا وبشكل متزايد عن أي عذر للقيام باستفزاز كان يأمل أن يجر الناتو أخيرا إلى المشاركة المباشرة في الحرب.
هذا ما يؤكد الأخطار التي تنطوي عليها الحرب إذا سمح لها بالاستمرار. هناك الكثير من العناصر التي لا يمكن السيطرة عليها، والتي قد تؤدي إلى نوع من الانحدار اللولبي الذي قد يؤدي إلى حرب حقيقية بين الناتو وروسيا.
وقد تم التأكيد على خطورة مثل هذه التطورات في نوفمبر 2022، عندما صُدم العالم لسماع تصريح الرئيس البولندي بأن بلاده تعرضت لقصف بصواريخ روسية الصنع، مع ادعاء وسائل إعلام غربية أن روسيا تقف وراء ذلك.
لكن سرعان ما انفضحت هذه الكذبة عندما اعترف البنتاغون نفسه أن الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية في مزرعة بالقرب من قرية برزيودو، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، قد أطلقه الجيش الأوكراني.
سارعت منظمة حلف شمال الأطلسي والبولنديين إلى توضيح أن الأمر برمته كان “حادثا مؤسفا”. لكن وعلى الرغم من أن الصاروخ هو صاروخ مضاد للطائرات، من طراز S-300، بمدى محدود للغاية، ولا يمكن إطلاقه من روسيا، فإن زيلينسكي كذب بوقاحة وأصر على أنه هجوم متعمد من روسيا. لقد كان يأمل في أن يمنحه ذلك مبررا قويا للمطالبة بمزيد من الأسلحة والأموال. وفي أفضل السيناريوهات (حسب وجهة نظره) أن يدفع ذلك الناتو إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد روسيا، مع عواقب مثيرة للاهتمام.
لو أن ذلك الحادث أدى إلى دفع الناتو إلى اتخاذ إجراءات ضد روسيا، لكان من الممكن أن يكون قد أشعل شرارة سلسلة لا يمكن وقفها من الأحداث التي ربما كانت لتؤدي إلى حرب شاملة. ليس هناك شك على الإطلاق في أنه من المناسب لزيلينسكي أن يرى الناتو يدخل الحرب وبالتالي يخفف الضغط عن نفسه.
كان من الممكن لاندلاع حريق أوروبي عام أن يكون بمثابة كابوس لملايين الأشخاص. لكن بالنسبة لزيلينسكي وزمرته كان من الممكن أن يكون بمثابة استجابة لكل صلواتهم. من الطبيعي أن يكون من المستحيل على الأمريكيين الوقوف على الهامش والاكتفاء بتدفئة أيديهم على ألسنة اللهب.
كان سيتوجب وضع قوات أمريكية على الأرض. وهو ما كان سيشكل أخبارا ممتازة من وجهة نظر نظام كييف، لكن ليس من وجهة نظر البيت الأبيض والبنتاغون. لم يكن من المفترض أن يكون هذا جزءا من السيناريو!
ليست لدى الأمريكيين أية نية لترك الأمور تسير إلى هذا الحد. فالمواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا، بكل تداعياتها النووية، خطر سوف يعمل كلا الجانبان على تجنبه بأي ثمن. ولهذا السبب بالتحديد توجد لدى الأمريكيين عدة قنوات مفتوحة، من أجل تجنب أي احتمال لمثل هذه التطورات الخارجة عن السيطرة. إنهم، في الواقع، يجهدون لوضع حدود محددة للحرب الحالية وفتح الطريق نحو المفاوضات.
أمريكا تدعو لإجراء محادثات
حقيقة الوضع لم تغب عن بال الخبراء الاستراتيجيين العسكريين الجادين في واشنطن. فقد دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، زيلينسكي إلى بدء محادثات مع روسيا.
وقال ميلي إنه قد تكون هناك فرصة للتفاوض على إنهاء النزاع إذا ما استقرت الخطوط الأمامية خلال فصل الشتاء:
وصرح أنه: «عندما تكون هناك فرصة للتفاوض، وعندما يمكن تحقيق السلام، اغتنمها». «انتهز اللحظة.»
وقال إنه إذا لم تتحقق المفاوضات أو فشلت، فإن الولايات المتحدة ستستمر في تسليح أوكرانيا، رغم أن تحقيق النصر العسكري الصريح لأي من الجانبين يبدو مستبعدا على نحو متزايد.
وأضاف:
يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري، بالمعنى الحقيقي للكلمة، ربما لا يمكن تحقيقه من خلال الوسائل العسكرية، وبالتالي هناك حاجة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى.
هذا هو الصوت الحقيقي للإمبريالية الأمريكية. وهذا، في نهاية المطاف، هو ما يحدد مصير أوكرانيا، وليس تصريحات زيلينسكي البلاغية.
لقد بقيت واشنطن مترددة على الدوام في إمداد كييف بالأسلحة المتقدمة التي تطلبها. والهدف من ذلك هو إرسال إشارة إلى موسكو مفادها أن الولايات المتحدة غير راغبة في توفير أسلحة يمكنها أن تصعد حدة الصراع، مما يؤدي إلى احتمال اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
إنه أيضا تحذير لزيلينسكي بأن هناك حدودا معينة لاستعداد الولايات المتحدة لمواصلة دفع فاتورة حرب باهظة الثمن مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق.
الإرهاق الأوكراني
خلال الشهر الأول من الحرب، كان الأوكرانيون على استعداد للتفاوض مع روسيا. لكن منذ ذلك الحين صار زيلينسكي يرفض فكرة المفاوضات تماما. لقد قال مرارا إن أوكرانيا ليست مستعدة للدخول في مفاوضات مع روسيا إلا إذا سحبت هذه الأخيرة قواتها من جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والمناطق الشرقية لدونباس، التي تسيطر عليها روسيا فعليا منذ عام 2014، وتقديم الروس الذين ارتكبوا جرائم في أوكرانيا للمحاكمة.
كما أوضح أنه لن يجري مفاوضات مع القيادة الروسية الحالية. حتى أنه وقع مرسوما ينص على أن أوكرانيا لن تتفاوض إلا مع رئيس روسي يخلف فلاديمير بوتين.

تسببت هذه التصريحات الجريئة في استياء شديد في واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين حذروا الحكومة الأوكرانية على انفراد من أن “الإرهاق الأوكراني” بين الحلفاء قد يتفاقم إذا استمرت كييف في رفض التفاوض مع بوتين.
وقال مسؤولون للصحيفة إن موقف أوكرانيا من المفاوضات مع روسيا لم يعد مقبولا بين الحلفاء القلقين بشأن الآثار الاقتصادية لحرب طويلة الأمد.
إلى حدود وقت كتابة هذه الوثيقة، تكون الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا ما قيمته 65 مليار دولار من المساعدات وهي على استعداد لتقديم المزيد، قائلة إنها ستدعم أوكرانيا “طالما تطلب الأمر ذلك”. لكن الحلفاء في أجزاء من أوروبا، ناهيك عن إفريقيا وأمريكا اللاتينية، قلقون من الضغط الذي تفرضه الحرب على أسعار الطاقة والغذاء وكذلك سلاسل التوريد. وقد قال مسؤول أميركي: «الإرهاق الأوكراني شيء حقيقي لبعض شركائنا».
لا يمكن للأمريكيين، بطبيعة الحال، أن يعترفوا علنا بأنهم يمارسون الضغط على زيلينسكي. بل إنهم، على العكس من ذلك، يحتفظون بمظهر التضامن الراسخ مع كييف. لكن تصدعات خطيرة في الواقع بدأت تظهر في الواجهة.
بالنسبة للقيادة الأوكرانية سيعني قبول طلب الولايات المتحدة تراجعا مهينا بعد شهور عديدة من الخطاب العدائي حول الحاجة إلى انتصار عسكري حاسم ضد روسيا من أجل ضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.
كما أن سلسلة النجاحات التي حققتها أوكرانيا في ساحة المعركة، أولا في شمال شرق منطقة خاركيف ثم مع الاستيلاء على خيرسون، قد شجعت زيلينسكي على الإيمان بإمكانية تحقيق “نصر نهائي”. لكن الأمريكيين لديهم فهم أفضل للواقع وهم يعرفون جيدا أن الوقت ليس بالضرورة في صف أوكرانيا.
هل يواجه بوتين خطر الإطاحة به؟
لا تتوقف آلة الدعاية الغربية عن تكرار الفكرة القائلة بأنه ستتم الإطاحة ببوتين قريبا على يد الشعب الروسي الذي سئم الحرب. لكن هذه مجرد متمنيات. إنها تقوم على فكرة خاطئة جوهريا. في الواقع لقد تمكن بوتين بنجاح من أن استعمال الحرب لثلم نصل الصراع الطبقي المتصاعد والسخط الجماهيري. هذا إلى جانب القمع المتزايد، مما منح النظام فترة راحة مؤقتة. في الوقت الحالي، يتمتع بقاعدة دعم واسعة جدا وقد ارتفع هذا إلى مستويات جديدة خلال الأشهر الأخيرة. إنه لا يواجه في الوقت الحالي خطر الإطاحة به.
لا توجد حركة مناهضة للحرب ذات وزن في روسيا، والحركات الموجودة تقودها وتوجهها عناصر ليبرالية برجوازية. هذه هي بالضبط نقطة ضعفها الرئيسة. بمجرد ما يلقي العمال نظرة واحدة على السيرة الذاتية لتلك العناصر الموالية للغرب، يبتعدون وهم يطلقون الشتائم.
ما تزال الحرب تحظى بتأييد الأغلبية، حتى لو كان لدى البعض شكوك في ذلك. إن فرض العقوبات والتيار المستمر للدعاية المعادية لروسيا في الغرب، وحقيقة قيام الناتو والأمريكيين بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة، كل ذلك يؤكد الشكوك في أن روسيا محاصرة من قبل أعدائها. وهو ما يستعمله النظام لحشد الشعب وراءه.
يحاول فلاديمير بوتين، في دعايته الحربية، استحضار ذكرى الصراع السوفياتي ضد ألمانيا النازية وكراهية الشعب الروسي الطويلة الأمد للإمبريالية الغربية، والتي يمزجها مع الشوفينية الروسية الرجعية. إنه يصور حرب أوكرانيا على أنها حرب ضد الإمبريالية الغربية، من أجل تطهير نظام كييف من النازية والدفاع عن الأقلية الناطقة بالروسية في أوكرانيا. كل هذا، بالطبع، مجرد ديماغوجية بحتة.
لا يوجد على الإطلاق أي شيء تقدمي في نظام بوتين. فهو ليس مناهضا للإمبريالية، ولا مناهضا للفاشية، ولا صديقا للعمال. وليس سرا، على سبيل المثال، أن هناك وحدات ذات تعاطف واضح مع النازيين الجدد واليمين المتطرف، تعمل بشكل علني كجزء من الجيش الروسي، ولا سيما في شركة فاغنر.
ومع اتخاذ الحزب الشيوعي الروسي لموقف خياني وقومي ومدافع عن الوطن، وتوفيره لغطاء يساري لقومية بوتين الروسية الكبرى، فإن العمال الروس لا يجدون بديلا سياسياً لتمثيل مصالحهم في معارضة النظام وحربه.
الضغط الوحيد على بوتين لا يأتي من أي حركة مناهضة للحرب، بل على العكس من القوميين الروس وغيرهم ممن يريدون مواصلة الحرب بقوة وتصميم أكبر. ومع ذلك فإنه إذا استمرت الحرب لفترة أطول دون دليل كبير على نجاح عسكري روسي، فقد يتغير ذلك.
في أوائل نوفمبر، نظم أكثر من 100 مجند من جمهورية تشوفاشيا الروسية احتجاجا في أوليانوف أوبلاست لأنهم لم يتلقوا الأجور التي وعدهم بها بوتين.
ذلك مؤشر صغيرة بلا شك. لكن إذا طال أمد الصراع الحالي، فقد يتضاعف على نطاق أوسع بكثير، مما يشكل تهديدا، ليس للحرب فقط، بل وللنظام نفسه.
ومن المؤشرات الأكثر أهمية هناك احتجاجات أمهات الجنود الذين قتلوا في أوكرانيا. ما تزال هذه الحركة صغيرة الحجم وتتركز بشكل أساسي في الجمهوريات الشرقية مثل داغستان، حيث دفعت مستويات البطالة المرتفعة بأعداد كبيرة من الشباب إلى التطوع في الجيش.
إذا استمرت الحرب وازداد عدد القتلى، قد نشهد احتجاجات للأمهات في موسكو وبيترسبورغ، والتي لن يستطيع بوتين تجاهلها ولن يتمكن من قمعها. هذا من شأنه، بلا شك، أن يمثل تغييرا في الوضع برمته. لكنه لم يتحقق… حتى الآن.
احتياطيات روسيا
في معارضتهم للحرب منذ بدايتها، اتخذ الماركسيون الروس موقفا مبدئيا في ظل ظروف قمع قاسية للغاية، وتحت وابل من الدعاية الحكومية. تتمثل مهمتهم أولا وقبل كل شيء في فضح ديماغوجية بوتين التي لا تعدو أن تكون مجرد غطاء للمصالح الرجعية للأوليغارشيين الرأسماليين، الذين هم العدو الرئيسي للعمال والفقراء الروس.
وفي الوقت نفسه، يجب عليهم أن يعارضوا الإمبريالية الغربية وكذلك الليبراليين المغتربين الموالين لكييف وما يسمى بـ ‘وسائل الإعلام المستقلة’ التي تعمل بمثابة الناطق بلسانهم في روسيا. إن السباحة ضد التيار والحفاظ على موقف طبقي مستقل اليوم، هو ما سوف يهيئ الماركسيين الروس للقيام بخطوات هائلة إلى الأمام بمجرد أن يبدأ اتجاه التيار في التحول.
وفي حين أن الثورة ليست بعد على جدول الأعمال مباشرة، فإن الحرب بلا شك تحرك الأمور بعمق داخل صفوف البروليتاريا وتهيئ لاندلاع تحركات اجتماعية هائلة في المستقبل.
كان الهدف المعلن لروسيا هو “منع عضوية أوكرانيا في الناتو ونزع سلاحها وتطهيرها من النازية”، كما أراد بوتين قيام حكومة محايدة أو موالية لروسيا في كييف. وهذا في الواقع يعني القضاء على أوكرانيا باعتبارها دولة قومية مستقلة.
لكن من الواضح أن بوتين قد أخطأ في الحسابات، ولم يكن لدى الروس القوى الكافية لتحقيق تلك الأهداف. بل اتضح أنه حتى مهمة الحفاظ على مكاسبهم في دونباس كانت صعبة، وهي الحقيقة التي ظهرت بوضوح خلال الهجوم الأوكراني في أوائل شتنبر.
لكن الإخفاقات في الجبهة كانت بمثابة الحافز الضروري لإعادة التكيف. ولقد اتخذوا خطوات لحشد القوات اللازمة للقيام بما هو ضروري.
نفذت روسيا تعبئة جماهيرية. سيؤدي إرسال 300 ألف جندي روسي جديد إلى الجبهة إلى تغيير ميزان القوى بشكل كبير.
إن الدعاية المتكررة حول أن الروس تنقصهم الذخيرة هي كلام خاطئ تماما. تمتلك روسيا صناعة أسلحة ضخمة وقوية. ولديهم مخزون كبير جدا من الأسلحة والذخيرة.

صحيح أن مخزونهم من أحدث الصواريخ ذات الدقة العالية محدود وسوف ينفد. لكن لا يوجد نقص في الصواريخ الأخرى الملائمة تماما للأنشطة القتالية العادية.
وفي غضون ذلك يواصل الروس سحق أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا باستخدام المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف، مما يؤدي إلى تدمير مراكز القيادة العسكرية ومراكز النقل والبنية التحتية، الشيء الذي سيعوق بشكل كبير حركة القوات والأسلحة إلى الجبهة.
ماذا الآن؟
إن مقولة نابليون بأن الحرب هي المعادلة الأكثر تعقيدا من بين جميع المعادلات، ما تزال تحتفظ بكامل راهنيتها. الحرب صورة متحركة تحتوي العديد من المتغيرات والسيناريوهات المحتملة.
يبدو أن التوقع الذي تقدمت به آلة الدعاية الغربية بثقة منذ بدء الأعمال العدائية قد تحقق من خلال نجاح الهجوم الأوكراني في شتنبر 2022، ثم الانسحاب الروسي من الجزء الغربي من خيرسون فيما بعد.
ومع ذلك فإنه يجب علينا الحذر من الاستنتاجات الانطباعية المستخلصة من عدد محدود من الأحداث. نادرا ما يتم تحديد نتيجة الحروب من خلال معركة واحدة أو حتى من خلال عدة معارك.
السؤال هو: هل هذا الانتصار، أو ذاك التقدم، قد غيّر فعليا ميزان القوى الأساسي، الذي وحده القادر على تحديد النتيجة النهائية؟ هذه الأسئلة الجوهرية لم يتم تحديدها بعد. هناك احتمالات مختلفة، وكلها رهينة بكيفية تطور الظروف في كل من روسيا من جهة، وأوكرانيا وأسيادها الغربيين من جهة أخرى.
ما فتئت روسيا تعزز قواتها في الشرق، وتعزز وجودها العسكري في بيلاروسيا وتكثف قصفها الجوي على كل من الأهداف العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية الضعيفة أصلا.
لقد وصل التدهور في البنية التحتية إلى نقطة بدأ فيها الحديث حتى عن إخلاء المدن الرئيسية -بما في ذلك كييف- التي أصبحت غير صالحة للسكن نتيجة لانقطاع إمدادات الطاقة والمياه.
متى سيبدأ هذا التدمير في تقويض إرادة المقاومة هو سؤال تصعب الإجابة عنه. تشير التجربة التاريخية إلى أن القصف الجوي وحده لا يمكنه أن يربح الحروب أبدا.
على المدى القصير سيكون لذلك تأثير معاكس، إذ سيزيد من كراهية العدو ويشعل روح المقاومة. لكن لكل شيء حدوده. إذ بعد نقطة معينة، سيبدأ شعور عام بالضجر من الحرب وستضعف الرغبة في مواصلة القتال.
لقد أظهر الأوكرانيون، حتى الآن، مستوى عالٍ من العزيمة. لكن من غير الواضح إلى متى يمكن الحفاظ على الروح المعنوية لكل من السكان المدنيين والجنود في الجبهة.
ولكن بمجرد ما سيبدأ الكلام عن السلام، ستندلع انقسامات عميقة بين صفوف الفئة القيادية في كييف: بين القوميين اليمينيين، الذين يرغبون في مواصلة القتال حتى النهاية، وبين العناصر الأكثر براغماتية، الذين يرون أن المزيد من المقاومة لن يؤدي إلا إلى التدمير الكامل لأوكرانيا وأن نوعا من التسوية التفاوضية هو المخرج الوحيد.
لكن مهما كانت النتيجة فإنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق في أوروبا. لقد ولدت مرحلة جديدة من الاضطرابات الشديدة والحروب والحروب الأهلية والثورة والثورة المضادة.
العلاقات العالمية
يشهد العالم تغيرات تشبه التحولات الدراماتيكية للصفائح التكتونية في الجيولوجيا. دائما ما تكون تلك التحولات مصحوبة بالزلازل.
ولهذه التحولات السياسية والدبلوماسية نفس الأثر. وحتى قبل الحرب كان تراجع العولمة، وما تبعه من صعود القومية الاقتصادية، قد أدى إلى اشتداد حدة الصراعات بين القوى المختلفة.
لكن النزاع الأوكراني قد أدى إلى تفاقم التوترات بشكل كبير وعمق كل التناقضات. ونتيجة لكل هذا، صرنا نشهد تغيرا عميقا في العلاقات العالمية.

إن أوضح علامة على ذلك هي حقيقة أن الصين قد اقتربت كثيرا من روسيا، بما أن كلاهما في منافسة مع الإمبريالية الأمريكية. والدليل الأكثر وضوحا على ذلك هو حقيقة أن الصين أصبحت أقرب إلى روسيا، حيث أن كلاهما في منافسة مع الإمبريالية الأمريكية. لقد تم تمرير الدور الصيني في حرب أوكرانيا تحت ستار الدعوة إلى “مفاوضات السلام”. تمثل هذه الحرب بالنسبة للطبقة السائدة الصينية اضطرابا غير مرحب به للعلاقات التجارية المفيدة التي بنتها على مدار الثلاثين عاما الماضية، إذ لا تشعر بأنها مستعدة بعد للدخول في مواجهة مباشرة ضد منافسها الأمريكي.
لكن وراء هذه النزعة المسالمة المزعومة هناك خط أحمر واضح، وهو: عدم السماح بزعزعة استقرار روسيا نتيجة لهزيمة عسكرية. إذ من شأن مثل تلك الهزيمة أن توسع نفوذ الإمبريالية الأمريكية وتفقد الصين شريكا قيما في صراعها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وحلفائها. ومن الواضح أنه لولا مساعدة الصين في التحايل على العقوبات الغربية، لكانت روسيا ستكون في وضع أسوء بكثير فيما يتعلق بإدارة الحرب.
روسيا
روسيا قوة إمبريالية إقليمية. لكن امتلاكها لاحتياطيات ضخمة من النفط والغاز والمواد الخام الأخرى، وقاعدتها الصناعية القوية ومجمعها الصناعي العسكري المتقدم، إلى جانب جيشها القوي وترسانتها النووية، تتضافر جميعها لمنحها امتدادا عالميا يجعلها في حالة تصادم مع الإمبريالية الأمريكية.
تاريخيا، كانت أوكرانيا مندمجة بالكامل في اقتصاد الاتحاد السوفياتي. وبعد عودة الرأسمالية، ظلت هذه الروابط الاقتصادية قائمة، مما جعل أوكرانيا مصدرا اقتصاديا رئيسيا للرأسمالية الروسية. كما أن هناك أيضا روابط ثقافية وجغرافية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأيديولوجية الرجعية للشوفينية الروسية الكبرى. ويرى الأوليغارشيون الروس أن السيطرة الغربية على نظام كييف تمثل تهديدا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا مباشرا لمصالحهم. ومن وراء دعاية الدولة الروسية، تخفي طغمة الكرملين مصلحتها الضيقة في استعادة السيطرة على أوكرانيا وإخضاعها لخدمة أهدافها الخاصة.
تَعتبِر واشنطن روسيا تهديدا لمصالحها العالمية، وخاصة في أوروبا. تلك الكراهية القديمة والشكوك تجاه الاتحاد السوفياتي لم تختف مع انهيار الاتحاد السوفياتي. ويُعد جو بايدن مثالا بارزا على جيل الرُّهاب من الروس الذي خلفته سنوات الحرب الباردة.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، استغل الأمريكيون فوضى سنوات يلتسين لتعزيز هيمنتهم على النطاق العالمي. لقد تدخلوا في المناطق التي كانت تسيطر عليها روسيا في السابق، وهو ما لم يكونوا ليجرؤوا على فعله في الحقبة السوفياتية.
في البداية تدخلوا في البلقان، لتسريع تفكك يوغوسلافيا السابقة. وأعقب غزوهم الإجرامي للعراق وأفغانستان تدخلا فاشلا في الحرب الأهلية السورية، مما أدى إلى اصطدامهم مع روسيا.
وقد استمروا طوال الوقت في توسيع سيطرتهم على أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف الناتو من خلال ضم البلدان التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي سابقا، مثل بولونيا وبلدان البلطيق. كان ذلك خرقا مباشرا للوعود التي قطعها الغرب مرارا وتكرارا بأن الناتو لن يتوسع ولو “بوصة واحدة” في اتجاه الشرق.
أدى ذلك إلى وصول تحالف عسكري معاد إلى حدود الفدرالية الروسية. لكن محاولتهم جذب جورجيا إلى فلك الناتو كانت بمثابة تجاوز للخط الأحمر. تعرضت الطبقة السائدة في روسيا للإذلال والتهديد، فاستخدمت القوة العسكرية لإعادة الجورجيين إلى الصف.
كان هدف روسيا من وراء غزو أوكرانيا أن تظهر للأمريكيين أنها تسخن عضلاتها وتدفع الإمبريالية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي إلى الوراء.
الولايات المتحدة وأوروبا
تستخدم الولايات المتحدة الصراع الدائر في أوكرانيا لتحقيق هدفها المتمثل في إجبار الأوروبيين على قطع علاقاتهم مع روسيا وبالتالي تعزيز قبضة الإمبريالية الأمريكية على أوروبا بأكملها.
قبل حدوث ذلك، كانت الطبقة السائدة الألمانية، في الواقع، تستخدم علاقاتها مع روسيا أداة لتأمين استقلال، جزئي على الأقل، عن الولايات المتحدة.
وكانت أداتها الرئيسية الأخرى هي هيمنتها الفعلية على الاتحاد الأوروبي، الذي كانت تأمل في أن تجعل منه قوة بديلة قادرة على السعي لتحقيق أهدافها ومصالحها على المسرح العالمي.

هناك توترات متنامية بين الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي لا يمكن إخفاؤها تحت البساط إلا بشكل مؤقت. وقد عادت هذه التوترات إلى الظهور في مشروع قانون الحمائية الأخير من قبل الولايات المتحدة، والذي يفرض ضغطا إضافيا على الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي.
التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا ليست جديدة. لقد ظهرت على السطح خلال حرب العراق، ومؤخرا على خلفية العلاقات مع إيران. لقد كان زعماء فرنسا وألمانيا متشككين على الدوام في علاقات أمريكا الوثيقة ببريطانيا التي اعتبروها بحق حصان طروادة أمريكي داخل المعسكر الأوروبي.
والفرنسيون، الذين لم يخفوا أبدا طموحاتهم الخاصة بالسيطرة على أوروبا، كانوا تقليديا أكثر صخبا في خطابهم المعادي لأمريكا. بينما الألمان، الذين هم في الواقع سادة أوروبا الحقيقيين، أكثر حذرا مفضلين حقيقة القوة على التفاخر الفارغ.
لم ينخدع الأمريكيون بذلك. فقد رأوا أن ألمانيا، وليس فرنسا ، هي منافستهم الرئيسية، ولم يخف ترامب على وجه الخصوص عدم ثقته في برلين وكراهيته الشديدة لها.
من أجل تأمين استقلالهم عن واشنطن، دخل الرأسماليون الألمان في علاقة وثيقة مع موسكو. أثار ذلك غضب “حلفائهم” في الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي، لكنه منحهم فوائد كبيرة على شكل إمدادات رخيصة ووفيرة من النفط والغاز.
إن الحرمان من تلك الإمدادات هو ثمن باهظ يجب دفعه لإسعاد الأمريكيين. في عهد أنجيلا ميركل حرصت ألمانيا بشدة على الحفاظ على دورها المستقل. لقد تطلب الأمر اندلاع حرب في أوكرانيا لجعل ألمانيا تتخلى عن ذلك الدور، على الأقل في الوقت الحالي.
فضح حزب الخضر البرجوازي نفسه باعتباره أكثر المدافعين حماسة عن الإمبريالية الأمريكية.
لكن وراء واجهة “الوحدة في مواجهة العدوان الروسي”، ما تزال الخلافات قائمة. تم توضيح ذلك في رسم كاريكاتوري تم تداوله بشأن امرأتين -واحدة أمريكية والأخرى أوروبية- حيث تقول المرأة الثانية بفخر للأولى: «سأكون سعيدة بأن أتجمد حتى الموت لمساعدة أوكرانيا»، فترد عليها المرأة الأمريكية بابتسامة قائلة: «حتى أنا سأكون سعيدة برؤيتك تتجمدين!».
تستخدم الولايات المتحدة ذريعة الحرب، في الواقع، لتشديد قبضتها على أوروبا. وقد نجح هذا في الوقت الحاضر. لكن ليس من الواضح على الإطلاق إلى متى سيستمر صبر الألمان والأوروبيين الآخرين. وسوف تتضح التناقضات الناتجة عن ذلك عندما ستتم تسوية المسألة الأوكرانية.
الولايات المتحدة والصين
خلال عشرينيات القرن الماضي صرح تروتسكي، في تنبؤ رائع، بأن مركز تاريخ العالم قد انتقل من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، وأنه محكوم بأن ينتقل من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. لقد أصبح هذا التوقع الآن حقيقة ملموسة أمام أعيننا.
الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا يجري أساسا (وإن لم يكن بالكامل) في أوروبا. لكن الصراع بين الصين وأمريكا يدور بشكل رئيسي عبر المحيط الهادئ. وعلى المدى الطويل، ستلعب منطقة المحيط الهادئ دورا أكثر حسما في تاريخ العالم من دول الدرجة الثانية في أوروبا، والتي دخلت في مرحلة طويلة من الانحدار التاريخي.
سيكون للأحداث الساخنة في المحيط الهادئ بلا شك تداعيات هامة على الصعيد العالمي في المستقبل. التوترات بين البلدين تزداد كل يوم. ولا يخفي كل من الديمقراطيين والجمهوريين حقيقة أنهم يعتبرون الصين خصمهم الرئيسي والأكثر خطورة.
تسير أمريكا على طريق يؤدي إلى حرب تجارية مع الصين. لقد شددت أكثر قيودها على تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
يتكهن الاستراتيجيون البرجوازيون بأن الصين سوف تنفصل عن روسيا. لكن هذه مجرد متمنيات. في ظل الظروف الحالية، لا سبيل إلى أن تبتعد الصين عن روسيا، أو العكس، لأنهما بحاجة إلى بعضهما البعض لمواجهة قوة الإمبريالية الأمريكية.
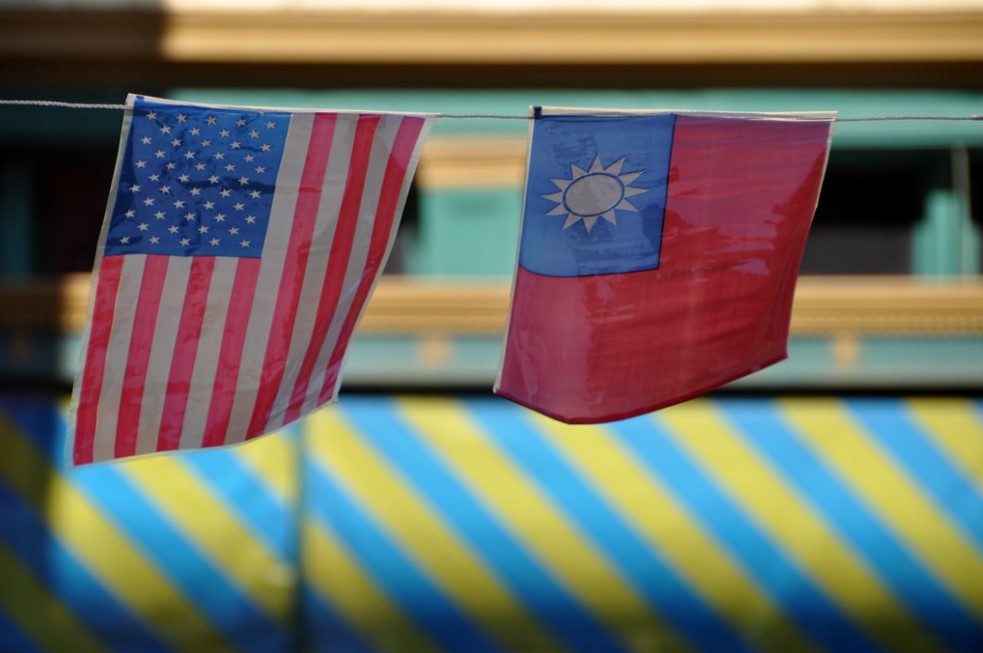
يتمحور الصراع بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الحاضر، حول مسألة تايوان. كان للحرب في أوكرانيا تأثير فوري على وضع قضية تايوان على أجندة السياسة العالمية. لقد أوضحت بكين منذ فترة طويلة، وبعبارات لا لبس فيها، أنها تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين.
لكن الأمريكيين بدعمهم للقوات القومية التايوانية، وتعزيز المساعدات العسكرية وإعاقة وصول الصينيين إلى السوق التايوانية، يزيدون حدة التوترات المحيطة بالجزيرة. إلا أنهم في الوقت نفسه يحافظون على سياسة “الغموض الاستراتيجي”، أي الحفاظ على دعم الوضع القائم في تايوان، لأنهم يعلمون أن الخروج عن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية كارثية.
كانت الزيارة غير الرسمية لنانسي بيلوسي إلى الجزيرة عملا في غاية الغباء، واستفزازا لا طائل من ورائه، نظر إليه بفزع الممثلون الأكثر تبصرا للإمبريالية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء آسيا الذين لا يرغبون في أن يُجبروا على الانحياز إلى أحد الأطراف في حرب تجارية، ناهيك عن حرب حقيقية.
حتى جو بايدن، الذي لا يشتهر بفطنته الفكرية، استطاع أن يرى أن ذلك سيؤدي إلى رد فعل فوري من جانب الصين. وذلك ما كان، حيث صعدت بكين من الضغط بمناورات بحرية وجوية حول الجزيرة. واشتدت حدة الحرب الكلامية بين البلدين.
لكن الواقع هو أن لا أحد من الجانبين يريد أن يجعل الأمور تصل إلى حد المواجهة العسكرية الفعلية. التدخل العسكري للولايات المتحدة سيواجه مشاكل لوجستية هائلة، في حين أن شي جين بينغ مهتم بالحفاظ على الاستقرار الداخلي أكثر من رغبته في الانخراط في مغامرات عسكرية. وبعد أن ضمن “إعادة انتخابه” في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، تبنى نبرة أكثر تصالحية فيما يتعلق بتايوان والولايات المتحدة.
إن اندلاع أزمة خطيرة للغاية داخل الصين، تهدد بإسقاط النظام، أو إعلان استقلال تايواني مدعوم من الولايات المتحدة، هو وحده الذي يمكن أن يرجح كفة الميزان لصالح مثل تلك المغامرة. لكن هذا ليس على جدول الأعمال حاليا.
وهكذا فإن التوازن المضطرب الحالي بين الصين وأمريكا وتايوان سوف يستمر لبعض الوقت في المستقبل، مع فترات صعود وهبوط حتمية. لكن الصراع الهائل من أجل السيادة بين الولايات المتحدة والصين سوف ينمو حتى يشمل آسيا بأكملها، مع عواقب بعيدة المدى على الكوكب بأسره.
الولايات المتحدة والسعودية وروسيا
لقد أشعلت حرب أوكرانيا أيضا نزاعات بين الولايات المتحدة والبلدان التي كانت تُعتبر في السابق حليفة مقربة لها. تشعر الولايات المتحدة بالغضب من استمرار العديد من البلدان في التجارة مع روسيا، مما يقوض العقوبات التي تفرضها. وتواصل الصين الاستهزاء علانية برغبات أمريكا، في حين أنها لا يمكنها أن تفعل الكثير لوقف ذلك.
والهند، التي من المفترض أن تكون صديقة لأمريكا، تشتري بدورها كميات ضخمة من النفط الروسي بأسعار زهيدة وتبيعها إلى أوروبا بسعر مرتفع. جو بايدن غاضب لكن مودي لا يبالي. إذ إن النفط الروسي، قبل كل شيء، رخيص جدا…
قد يكون رخيصا بالنسبة للهند والصين، لكن النقص العالمي في النفط قد أدى إلى ارتفاع أسعار السوق، الأمر الذي يعود بالفائدة على روسيا، كما أوضحنا.
لذلك فقد تصاعدت التوترات بين السعودية، التي هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وبين الولايات المتحدة، التي هي أكبر مستهلك للنفط في العالم. والرياض، التي تجاهلت طلب بايدن زيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار النفط العالمية، توصلت إلى اتفاق مع موسكو لتطبيق تخفيضات في الإنتاج تهدف إلى وقف تراجع الأسعار.
تعاون السعودية مع موسكو مصدر سخط وغضب هائلين في البيت الأبيض. وقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين إنه من “الواضح” أن أوبك + “متحالفة مع روسيا”.
الخلاف بين السعوديين والولايات المتحدة هو أحد أعراض الرغبة المتزايدة للحكومات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في الاستفادة من الصراع العالمي بين روسيا والصين والولايات المتحدة، لخدمة مصالحها الخاصة، والتوازن بين الجانبين. إن سلوك أردوغان في تركيا هو مثال آخر على ذلك.
عالم متعدد الأقطاب؟
لقد أدت التحولات التي أشرنا إليها إلى بروز الكثير من التكهنات حول عالم “متعدد الأقطاب”. من المفترض أن صعود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية سيتحدى الموقف الريادي للإمبريالية الأمريكية.
يعود الحديث عن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالصين إلى عقود طويلة. ومع ذلك، فإنه يجب التأكيد على أن هذا تراجع نسبي. إذ إن الولايات المتحدة تبقى، من حيث القيمة المطلقة، أغنى وأقوى دولة عسكرية على وجه الأرض.
في السبعينيات، كانت هناك تكهنات مماثلة حول صعود اليابان، والتي توقع البعض أنها ستتفوق على الاقتصاد الأمريكي في غضون عقود قليلة. لكن ذلك لم يتحقق.
بلغ النمو الهائل للاقتصاد الياباني حدوده ودخلت اليابان في مرحلة طويلة من الركود الاقتصادي. والآن هناك مؤشرات على أن الصين ربما تقترب من نقطة مماثلة.
تتجلى حدود ما يسمى بالنموذج الصيني في تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي. ستحتفظ الولايات المتحدة، في المستقبل المنظور، بمكانتها باعتبارها قوة إمبريالية رئيسية. لكن هذا سيجلب مشاكله الخاصة.
في القرن التاسع عشر سيطرت الإمبريالية البريطانية على جزء كبير من الكرة الأرضية. سيطر أسطولها على بحار العالم، على الرغم من أنها كانت قد بدأت تواجه تحديا متزايدا من قبل القوة الصاعدة لألمانيا، وكانت الإمبريالية الأمريكية ما تزال في مراحل تطورها الأولى.
في ذلك الوقت، نجحت بريطانيا في إثراء نفسها على حساب مستعمراتها وبفعل دورها المهيمن في التجارة العالمية. لكن قوتها تقوضت بسبب حربين عالميتين، وورثت الولايات المتحدة دور بريطانيا كشرطي عالمي. لكنها فازت بهذا الوضع في مرحلة تدهور الإمبريالية. وقد اتضح أن دور شرطي العالم دور شاق للغاية.
على الرغم من ثروتها الهائلة وقوتها العسكرية الكبيرة، فقد عانت الولايات المتحدة الأمريكية أول هزيمة عسكرية لها في أدغال فيتنام. وقد انتهت الحرب الكورية بالتعادل وما تزال دون حل. كما أن المغامرات العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا انتهت كلها بالإذلال وخسارة مليارات الدولارات.
والآن أصبحت الحرب في أوكرانيا -التي من المفترض أن الولايات المتحدة ليست مشاركة نشطة فيها، رغم أنها كذلك من الناحية العملية- مصدر استنزاف هائل لمواردها. ونتيجة لذلك هناك رد فعل قوي من جانب الرأي العام الأمريكي ضد المغامرات العسكرية في الخارج. يعمل هذا كعامل كبح قوي يحد من قدرتها على شن الحرب.
الهزائم المهينة التي عانت منها في العراق وأفغانستان ما تزال مشتعلة في ضمير الشعب الأمريكي. لقد سئم الشعب الأمريكي بشدة التدخلات الخارجية والحروب، وهذا عامل قوي يحد من مجال المناورة لكل من بايدن والبنتاغون.
ومن ناحية أخرى يُظهر جناح ترامب في الحزب الجمهوري توجها قويا نحو الانعزالية، التي كانت تقليديا عاملا قويا في السياسة الأمريكية.

الاضطراب العام في العالم يهدد باستمرار بتأجيج الاضطراب السياسي داخل المجتمع الأمريكي. هذا ما قصده تروتسكي عندما تنبأ بأن الولايات المتحدة ستظهر كقوة عالمية مهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية، لكن ستكون لها متفجرات مزروعة في أسسها.
الحرب والسلام
ستتسم المرحلة التي دخلناها بتزايد الاضطرابات والاحتكاكات بين مختلف القوى والتكتلات. لقد تبنى الإصلاحيون اليمينيون كل برنامج وخطاب أجندات البرجوازية الإمبريالية (“الدفاع عن الديمقراطية”). بينما يواصل الإصلاحيون “اليساريون” دائما ترديد ترانيم السلام والأخوة البشرية، والتي يتصورون أنها مصونة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ومع ذلك فإن ما يسمى بالأمم المتحدة، وطيلة الثمانين عاما، أو نحو ذلك منذ تأسيسها، لم تمنع أبدا أي حرب. فما بين عامي 1946 و2020، كان هناك ما يقرب من 570 حربا، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 10.477.718 مدنيا وعسكريا. ليست الأمم المتحدة سوى ناد للثرثرة يعطي الانطباع بأنه يستطيع حل المشاكل.
في الواقع قد تتمكن، في أفضل الأحوال، من حل بعض القضايا الصغيرة التي لا تمس المصالح الجوهرية للقوى العظمى. أما في أسوء الأحوال، كما في الحرب الكورية في الخمسينيات، والكونغو في الستينيات، والحرب الأولى على العراق عام 1991، فتلعب دور ورقة تين مناسبة لإخفاء المخططات الإمبريالية.
في الماضي، كان في إمكان التوترات الحالية أن تؤدي بالفعل إلى حرب كبرى بين القوى العظمى. لكن تغير الظروف قد أزال هذا الاحتمال من جدول الأعمال، على الأقل في الوقت الحاضر. لم تشهد العقود السبعة الماضية أي حرب عالمية، رغم أنه كانت هناك، كما أشرنا سابقا، الكثير من الحروب الصغيرة.
إن الرأسماليين لا يشنون الحروب من أجل النزعة الوطنية أو الديمقراطية أو أي من المبادئ السامية الأخرى. إنهم يشنون الحروب من أجل الربح، والاستيلاء على الأسواق الأجنبية ومصادر المواد الخام (مثل النفط)، وتوسيع مناطق النفوذ.
لكن الحرب النووية لن تحقق أيا من تلك الأشياء، بل ستعني فقط التدمير المتبادل لكلا الطرفين. بل إنهم صاغوا عبارة لوصف هذا الاحتمال: [2]MAD (تدمير متبادل مؤكد). إن مثل هذه الحرب لن تكون في مصلحة أصحاب الأبناك والرأسماليين.
وهناك عامل حاسم آخر -سبقت الإشارة إليه- وهو المعارضة الجماهيرية للحرب، ولا سيما (على سبيل المثال لا الحصر) في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لأحد استطلاعات الرأي، فإن 25% فقط من سكان الولايات المتحدة يؤيدون التدخل العسكري المباشر في أوكرانيا، مما يعني أن الغالبية العظمى تعارضه.
هذه العوامل، وليس حب السلام، وبالتأكيد ليس أي احترام للأمم (غير) المتحدة، هي التي منعت الولايات المتحدة من إرسال قواتها إلى مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي في أوكرانيا.
بالطبع لا يوجد خصاص في الجنرالات الأمريكيين الأغبياء، أو حتى المضطربين عقليا الذين يعتقدون أن الحرب مع روسيا أو الصين، أو الأفضل مع كليهما، ستكون فكرة جيدة، وأنه إذا كان ذلك سيعني الإبادة النووية للكوكب، فإنه سيكون ثمنا ضروريا يمكن دفعه.
لكن هؤلاء الأشخاص موضوعون تحت السيطرة، مثلما يحرص شخص يمتلك كلب حراسة شرس للدفاع عن ممتلكاته، على إبقائه مربوطا بسلسلة. وطالما لسنا أمام منظور وصول هتلر أمريكي إلى السلطة، فلن يميل أحد إلى التوقيع على مذكرة انتحار جماعية باسم الشعب الأمريكي.
لكن وعلى الرغم من استبعاد نشوب حرب عالمية في ظل الظروف الحالية، فإنه ستكون هناك العديد من الحروب “الصغيرة” والحروب بالوكالة، مثل تلك التي تجري في أوكرانيا. وهذا سوف يزيد من الاضطرابات العامة ويضيف الوقود إلى نيران الفوضى العالمية.
الولايات المتحدة الأمريكية
كان استقرار الوضع في الولايات المتحدة قائما على تداول السلطة بين حزبين برجوازيين: الجمهوري والديمقراطي. ولأكثر من 100 عام، تناوب هذان العملاقان السياسيان على الحكومة بانتظام يشبه انتظام حركة بندول ساعة قديمة.
كان كل شيء يبدو على أنه يسير بسلاسة. لكن ذلك الانتظام السابق قد أفسح الآن الطريق أمام الاضطرابات الأكثر عنفا.
اتسمت سنوات حكم ترامب بصعوبة توقع ما سيحدث. وقد أدى رفضه قبول نقل السلطة، أو حتى الاعتراف بأنه يمكن أن يخسر أي انتخابات في أي وقت، إلى تهيئة الظروف لهجوم 06 يناير 2021 على الكونغرس من قبل حشد من أنصاره الغاضبين. كانت تلك الأحداث إيذانا بمرحلة جديدة من الاضطرابات العنيفة في المجتمع الأمريكي.
يتوقع جميع المعلقين الاقتصاديين الجادين أن تدْخل الولايات المتحدة في ركود خلال عام 2023. معدل التضخم السنوي للولايات المتحدة هو الآن أعلى من 8%، وهو أعلى معدل منذ 40 عاما. وكما ذكرنا سابقا فقد عمل الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مما رفع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما، بحيث صارت تقترب من 7%، مقارنة بما يزيد قليلا عن 3% في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، تجاوز الدين القومي الأمريكي حاجز الـ 31 تريليون دولار. ومع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، سيؤدي ذلك إلى ضغط كبير على المالية العامة للولايات المتحدة. كما تباطأت وتيرة خلق فرص العمل، وبدأت البطالة في الارتفاع.
يأتي هذا إلى جانب تدهور نسبي طويل الأمد، شهد ركودا، أو حتى تراجعا، في مستويات المعيشة لملايين الأمريكيين. ظلت الأجور الحقيقية راكدة منذ السبعينيات. وتم تدمير الملايين من الوظائف ذات الأجر الجيد في قطاع الصناعة على مدى عقود.
هذا ما يفسر تراجع شعبية الديمقراطيين، الذين كان يُنظر إليهم في السابق على أنهم “أصدقاء للعمال”، كما يفسر سبب استفادة شخصية مثل ترامب من استياء فئة من الطبقة العاملة تجاه الحكومة.
ومع ذلك فإن انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 لم تسفر عن انتصار الحركة الترامبية، الذي توقعه الكثيرون، على الرغم من تراجع شعبية بايدن. تعرض العديد من مرشحي ترامب للهزيمة. وقد كان أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو رد الفعل ضد إسقاط قانون Roe vs Wade من قبل المحكمة العليا، الذي كان يحمي سابقا حقوق الإجهاض.
وسيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان ترامب سيفوز بالترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري، أو ما إذا كانت ستتم إزاحته جانبا من قبل شخص مثل رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، الذي نصب نفسه على أنه مرشح “الترامبية بدون ترامب”. قد يكون المسرح مهيأ لحدوث انشقاق في الحزب الجمهوري، إذا لم يفلح ترامب في تحقيق ما يريد.
سخط عميق
هناك استياء واسع النطاق وعميق الجذور ينعكس من خلال استطلاعات الرأي.
فوفقا لاستطلاع رأي أجرته جامعة كاليفورنيا، في عام 2022، يعتقد أكثر من نصف الأمريكيين أن “الولايات المتحدة ستشهد حربا أهلية خلال السنوات القليلة المقبلة”.
ووفقا لاستطلاع رأي آخر، يعتقد 85% من الأمريكيين أن البلد يسير على “المسار الخطأ”. ويعتقد 58% من الناخبين الأمريكيين “أن نظام حكومتهم لا يعمل…”، الخ، الخ.
وقد وجد مزاج السخط العميق هذا تعبيره الأكثر وضوحا في حركة حياة السود مهمة (Black Lives Matter) في عام 2021، والتي حظيت بتأييد 75% من السكان. لكن هذا التجذر تعرض للتخريب جزئيا بسبب ما يسمى بسياسات الهوية.
يتم استخدام ما يطلق عليه اسم “الحروب الثقافية” بشكل روتيني من قبل السياسيين اليمينين المتطرفين والليبراليين لتعبئة مؤيديهم. هذا سم لا يمكن مكافحته إلا بالسياسة الطبقية.
المسألة الطبقية
عودة المسألة الطبقية إلى الساحة تتجلى في موجة تشكيل النقابات في شركات مثل أمازون وستاربكس، لكن أيضا في موجات الإضراب التي أثرت على الولايات المتحدة ، مثل “ستريكتوبر” عام 2021. هذا ويستمر نشاط الإضرابات في التصاعد.
تكشف أحدث الأرقام أن 71% من الأمريكيين يؤيدون النقابات العمالية، وهو أعلى مستوى للدعم منذ الستينيات. وهذا الرقم أعلى بكثير بين الشباب. بل حتى بين الفئة العمرية 18-34 عاما من أنصار ترامب، يتعاطف 71% مع الحملات النقابية في أمازون.

إن الحركة نحو تشكيل النقابات بين صفوف الفئات العمالية الهشة، وخاصة الشباب، هي أول مؤشر حقيقي على عودة الصراع الطبقي إلى الحياة. هذه الحملات النقابية يقودها عمال كفاحيون شباب ليس لديهم ارتباط كبير بالحركة النقابية التقليدية. إنهم جزء من جيل جديد من المناضلين الطبقيين الذين يظهرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويتحركون بسرعة نحو اليسار.
إلا أن هناك عدم ثقة عميق ومتزايد في جميع الأحزاب القائمة، ولا سيما الحزب الديمقراطي. هذا الوضع هو ما يفسر أزمة رئاسة بايدن. يُنظر إليه على أنه غير قادر على حل أي من المشاكل الملحة التي تواجه الطبقة العاملة والشباب، من التضخم إلى الحرب في أوكرانيا ، ومن التأثير المتزايد والمدمر لتغير المناخ إلى نقص المنازل بتكلفة معقولة.
هذا الشعور العام بالضيق هو ما يفسر انعدام الثقة العام بين شريحة واسعة من السكان تجاه بايدن والديمقراطيين. إن المزيد من تطور الصراع الطبقي سيفتح الطريق، عند نقطة معينة، لظهور حزب ثالث، مستند إلى الطبقة العاملة. سيمثل ذلك تغييرا جوهريا في الوضع برمته.
الصين
كانت الصين في السابق إحدى القوى المحركة الرئيسية التي تدفع الاقتصاد العالمي. لكن هذا وصل الآن إلى حدوده وبدأ يتحول إلى نقيضه. والاقتصاديون البرجوازيون يراقبون التطورات في الصين بقلق متزايد.
في الأسواق الحرة في الغرب، يمكن أن تندلع الأزمات المالية فجأة، مما يفاجئ الحكومات والمستثمرين. لكن في الصين، حيث ما تزال الدولة تلعب دورا مهما في الاقتصاد، يمكن للحكومة استخدام رأس المال السياسي والمالي إلى درجة أعلى بكثير، من أجل التخفيف من حدة الأزمة أو تأجيلها.
يعطي هذا مظهر الاستقرار، لكنه مجرد وهم. فنظرا لأن الصين اختارت السير في الطريق الرأسمالي وأصبحت الآن مندمجة تماما في السوق العالمية الرأسمالية، فإنها تخضع لنفس قوانين اقتصاديات السوق الرأسمالية.
ومن العوامل الرئيسية في إنقاذ الاقتصاد الصيني والعالمي من أزمة كبرى بعد انهيار عام 2008، كانت هناك تلك المبالغ الضخمة التي ضختها الدولة الصينية في الاقتصاد.
وصلت قيمة تلك المبالغ مئات المليارات من الدولارات، تم توجيه معظمها إلى مشاريع البنية التحتية والتطوير. وما نشهده الآن هو نهاية ذلك النموذج. الاقتصاد الصيني يتباطأ. وقد كان معدل النمو الضئيل البالغ 2,8%، الذي تم تسجيله في عام 2022، هو الأدنى منذ عام 1990. وفي عام 2021 نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 8,1%.
جزء كبير من تلك الاستثمارات خصص لوكالات التمويل الحكومية المحلية (LGFVs)، التي راكمت جبلا ضخما من الديون، بقيمة 7,8 تريليون دولار، صار يهدد استقرار الاقتصاد الصيني بأكمله. يتم إخفاء قدر كبير من تلك الديون من خلال القطاع البنكي الموازي شبه القانوني، الذي تشارك فيه بشكل كبير المقاولات والبنوك المملوكة للدولة.
يعادل ذلك الدين ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2021، أو حوالي ضعف حجم الاقتصاد الألماني. ومع انخفاض دخل الحكومات المحلية، يبدو من المرجح بشكل متزايد انطلاق سلسلة مدمرة من التخلف عن السداد.
لا يؤدي تدخل الدولة إلا إلى عرقلة عمل آلية السوق، لكنه لا يزيل تناقضاتها الجوهرية. يمكن لتدخل الدولة أن يؤخر الأزمة، لكنها عندما تندلع في نهاية المطاف -وهو ما يجب أن يحدث عاجلا أم آجلا- سيكون لها طابع أكثر تفجرا وتدميرا ولا يمكن السيطرة عليها.
سيكون لأي انهيار مالي في الصين تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي ككل. كما أنه سيخلق وضعا متفجرا للغاية داخل الصين.
من المفترض على الدوام أن الصين بحاجة إلى معدل نمو سنوي لا يقل عن 8% للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وبالتالي فإن معدل النمو البالغ 2,8% غير كاف على الإطلاق. ومن شأن أزمة اقتصادية كبرى، ناجمة عن انهيار سوق العقارات، أن تمهد الطريق لاضطرابات اجتماعية كبرى.
الصين تواجه انفجارا اجتماعيا
هذا هو السياق الذي يجب أن نرى في ضوئه مؤتمر الحزب “الشيوعي” الصيني، لعام 2022، حيث عزز شي جين بينغ قبضته على السلطة. وفقا لقواعد الحزب القديمة، كان ينبغي له أن يتنحى عن منصبه في ذلك المؤتمر، لكنه بدلا من ذلك عمل على أن يكون زعيما مدى الحياة.
ليس من قبيل المصادفة أن شي جين بينغ يعمل على تركيز كل السلطة بين يديه. الصين دولة شمولية تجمع بين اقتصاديات السوق الرأسمالية وبين عناصر سيطرة الدولة، الموروثة عن الدولة العمالية المشوهة السابقة.
في دولة شمولية، حيث يتم التحكم بشكل صارم في جميع مصادر المعلومات وقمع جميع أشكال المعارضة بلا رحمة، من الصعب للغاية معرفة ما يجري تحت السطح، إلى أن ينفجر كل شيء فجأة.

يمكننا أن نرى هذا الواقع في نضال عمال مصنع Foxconn الضخم في تشنغتشو، والاحتجاجات الواسعة المناهضة للإغلاق في نوفمبر 2022. اتخذت تلك الحركات، التي بدا وكأنها خرجت من العدم، شكلا متفجرا، وفي حالة الاحتجاجات ضد الإغلاق انتشرت في غضون ساعات إلى مئات المواقع على الصعيد الوطني. تشير هذه الأحداث إلى بدايات انهيار التوازن الاجتماعي في الصين.
النخبة الحاكمة تدرك ذلك جيدا. لديها جهاز قمعي قوي وشبكة ضخمة من الجواسيس والمخبرين الموجودين في كل مصنع ومكتب ومجمع سكني ومدرسة وجامعة.
تنفق الصين الآن على الأمن الداخلي كل عام أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني، وتقوم بزيادة كليهما. شي جين بينغ وزمرته يدركون جيدا المخاطر الهائلة للاضطرابات الشعبية ويتخذون خطوات لاستباق حدوثها. ومع ذلك فإن نظام الرقابة المتطور للغاية على الإنترنت لم يكن قادرا على منع انتشار المعلومات حول الاحتجاجات الأخيرة، على الرغم من حقيقة أن هذه الاحتجاجات لم تشمل سوى بضع مئات من الأشخاص في كل مدينة. لكن في حالة اندلاع حركة جماهيرية للطبقة العاملة فسوف تجتاح هذا النظام.
هذا ما يفسر إلى حد كبير سحق حركة الاحتجاج الجماهيري لعام 2019 في هونغ كونغ. لأنه لو تم تركها، لكانت قد انتشرت بسرعة إلى البر الرئيسي.
النطاق الواسع لتلك الحركة -قبل أن يتم اختطافها وقيادتها إلى طريق مسدود من قبل النخبة الليبرالية الموالية للغرب- يعطي المرء فكرة مبسطة عما ستبدو عليه الثورة البروليتارية في الصين، إلا أنها ستكون على نطاق أوسع.
هناك مقولة منسوبة لنابليون بونابرت مفادها أن: «الصين تنين نائم. دع الصين تنام، لأنها عندما ستستيقظ سيهتز العالم». هناك الكثير من الحقيقة في هذا المقولة. لكن يجب علينا إدخال تغيير بسيط عليها.
البروليتاريا الصينية هي الأكبر والأقوى في العالم. إنها بالفعل مثل تنين نائم على وشك الاستيقاظ. وعندما سيحدث ذلك، سيهتز العالم بالفعل.
هناك انفجار اجتماعي ضخم يجري التحضير له في الصين، على الرغم من أنه من المستحيل تحديد موعد حدوثه. لكن هناك شيء واحد يمكن توقعه بيقين مطلق وهو أنه سيحدث عندما لن يكون حدوثه متوقعا.
وبمجرد أن يبدأ، لن يتوقف. آنذاك لن يكفي أي قدر من القمع أو الترهيب. ومثلما يفعل نهر يانغتسي عندما يفيض، فإنه سيكتسح كل شيء أمامه.
أوروبا: ميول نحو التفكك
كانت وحدة الاتحاد الأوروبي أمرا مفروغا منه طالما استمرت ظروف الازدهار. لكن تلك الظروف المواتية قد اختفت الآن. والاضطرابات الاقتصادية والمالية ستؤدي إلى مزيد من الحمائية والقومية الاقتصادية.
في ظروف الانكماش الاقتصادي العميق سيتعرض النسيج الهش للوحدة الأوروبية لاختبار عسير إلى درجة الانفراط. وسوف تؤدي النزعات النابذة إلى تسريع الابتعاد عن العولمة ونحو مزيد من الانقسامات في أوروبا والاقتصاد العالمي ككل.
بلدان جنوب أوروبا هي الحلقة الأضعف في السلسلة وهي جاهزة لحدوث اضطرابات وهزات سياسية كبيرة. قد يؤدي الضعف المالي المستمر لليونان وإيطاليا إلى انهيار الاتحاد النقدي الأوروبي. لكن حتى البلدان الأقوى تتعرض للهزات. سوف تزداد حتما قوة هذه الميولات، مما سيضع ضغطا هائلا على النسيج الهش للوحدة الأوروبية.
الانقسامات في أوروبا
فضحت الأزمة خطوط الصدع العميقة الموجودة بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحتى قبل حرب أوكرانيا والجائحة، كان الاقتصاد الأوروبي يتباطأ وكانت التوترات بين بلدانه تتصاعد. وقد كان أوضح مؤشر على ذلك هو انسحاب بريطانيا، الأمر الذي ترك العديد من المشاكل دون حل. لكن العلاقات مع بريطانيا ليست المصدر الوحيد للخلاف داخل الاتحاد الأوروبي.
إن الاتحاد الأوروبي مهدد بكارثة اقتصادية نتيجة للحرب في أوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. ويكافح الرأسماليون في كل البلدان الأوروبية لاتخاذ إجراءات لخدمة مصالحهم الخاصة.
التضامن الأوروبي لا يدخل في هذه المعادلة. إنهم يطبقون شعار بسيطا للغاية: “أنا وبعدي الطوفان”.
تسببت الحرب في أوكرانيا في خلق انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي. وكما سبق لنا أن أشرنا فإن بولونيا ودول البلطيق هي الأكثر تشددا. لكن المجري فيكتور أوربان ينتقد بشكل صريح عقوبات الغرب ضد روسيا، كما أن المجر تحافظ على علاقات ممتازة مع الكرملين. وبالتالي فإن المجر تتلقى الآن الغاز بأدنى الأسعار.
لقد علق أوربان على الوضع بجرعة كبيرة من السخرية قائلا: «في ما يتعلق بمسألة الطاقة، نحن مجرد أقزام والروس عمالقة. يقوم قزم بمعاقبة عملاق فإذا بنا نندهش جميعا عندما يموت القزم». وقد أثارت تصريحاته تلك استنكار قادة الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يكن مخطئا.

حزمة الدعم التي قدمتها الحكومة الألمانية لشركات الطاقة أثارت على الفور رد فعل عنيف من طرف عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، التي تطالب بموقف أوروبي مشترك تجاه أزمة الطاقة. حذر رئيس الوزراء المجري من أن حزمة الدعم الألمانية المخطط لها تصل إلى مستوى “أكل لحوم البشر”، مما يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي في وقت تتعرض فيه الدول الأعضاء لضغوط اقتصادية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال أحد كبار مستشاري رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني: «إنه عمل دقيق ومتعمد وغير متفق عليه وغير مشترك وغير مبرر، مما يقوض أسباب الاتحاد». بينما كان إيمانويل ماكرون أكثر دبلوماسية، لكنه ذهب إلى صلب الموضوع عندما قال: «لا يمكننا التمسك بالسياسات الوطنية، لأن هذا يخلق اضطرابات داخل القارة الأوروبية».
ومع ذلك فقد رد وزير المالية الألماني، روبرت هابيك، مدافعا عن حزمة الدعم في مجال الطاقة في ألمانيا، بتحذير شديد، حيث قال: «إذا تعرضت ألمانيا لركود عميق حقا، سوف تجر أوروبا بأكملها معها».
يدور الصراع، من حيث الجوهر، حول من عليه أن يدفع الفاتورة، مع عدم استعداد ألمانيا والبلدان الرأسمالية الأكثر ثراء في شمال أوروبا لدفع الفاتورة للاقتصادات الرأسمالية الأفقر في الجنوب والشرق.
إلا أن هناك علامات على تزايد الاستياء من الموقف برمته. نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالا بعنوان: «الألمان العاديون يدفعون الثمن: الاحتجاجات المناهضة للحرب تمتد عبر وسط أوروبا». وأشارت إلى نمو مثير للقلق للمظاهرات المناهضة للحرب والموالية لروسيا في ألمانيا وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية.
عددهم في الغالب لا يتجاوز المئات في هذه الفترة. لكن ومع استمرار انخفاض درجات الحرارة، سيرتفع غضب المزيد من الناس. والتوترات الاجتماعية الناتجة عن ذلك سوف تهدد النسيج السياسي لألمانيا.
وبدورها شهدت جمهورية التشيك، في 03 شتنبر 2022، تظاهر ما بين 70.000 و100.000 شخص في ساحة فاتسلاف في براغ، مطالبين باستقالة حكومة رئيس الوزراء، بيتر فيالا، اليمينية المؤيدة لحلف شمال الأطلسي. ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون شعارات تعارض أزمة غلاء المعيشة ومشاركة التشيك في حرب الوكالة التي يخوضها الناتو ضد روسيا.
الدعم الإيطالي للحرب بدوره لا يمكن اعتباره أمرا محسوما. ففي حين اتخذت ميلوني على الفور الموقف “المسؤول” الموالي للغرب بخصوص الحرب، فقد تحدث شركاؤها في التحالف، سالفيني وبرلسكوني، بنبرة مختلفة، حيث دعا سالفيني إلى إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا وتباهى برلسكوني علانية بصداقته مع فلاديمير بوتين.
ألمانيا
الأزمة العالمية للرأسمالية وصلت إلى ألمانيا. وقد قدمت الحرب في أوكرانيا صفعة قوية للطبقة السائدة الألمانية بخصوص الطبيعة الهشة للإمبريالية الألمانية.
كانت ألمانيا لعقود من الزمان القوة الصناعية الأولى في أوروبا. وفي عهد أنجيلا ميركل، التي استمرت 15 عاما في منصب مستشارة، نجحت الرأسمالية الألمانية في تفادي أزمة عام 2008.
لقد تعززت قدرتها التنافسية على حساب الطبقة العاملة، من خلال الإصلاحات المضادة من قبيل نظام هارتز 04 وإضفاء الهشاشة على علاقات العمل، التي نفذتها في عام 2004 حكومة جيرهارد شرودر الاشتراكية الديمقراطية.
كما استفادت الطبقة السائدة الألمانية أيضا من عودة الرأسمالية إلى أوروبا الشرقية لتوسيع نفوذها شرقا، مما منحها احتياطيا كبيرا من العمالة الماهرة الرخيصة.
كل هذا، بالإضافة إلى القدرة على الوصول السهل وغير المحدود إلى إمدادات النفط والغاز الروسية الرخيصة، أعطى الرأسماليين الألمان ميزة تنافسية إضافية على منافسيهم. وكانت النتيجة ازدهار الصادرات إلى بقية بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين على مدى العقد الماضي، مع تعزيز ألمانيا لمكانتها كقوة تجارية عالمية عظمى.
أدى المستوى المنخفض نسبيا لديون الدولة، والسيطرة على اليورو، ومكانتها الريادية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى منح الطبقة السائدة الألمانية هوامش للمناورة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الداخلي، على حساب بقية أوروبا.

ومع ذلك، فإن جميع نقاط القوة في “النموذج الألماني” بدأت تتحول إلى نقيضها. أدى تدهور التجارة العالمية في عام 2019، والذي تفاقم بسبب تأثير الجائحة، وما تلاه من تفكك سلاسل توريد المواد الخام والمكونات والرقائق وارتفاع تكاليف الشحن، إلى تقويض الإنتاج الألماني وصادرات السيارات والآلات والمواد الكيماوية.
آثار حرب أوكرانيا أبرزت حقيقة أن ألمانيا لا تمتلك القوة الاقتصادية أو العسكرية الكافية لفرض مصالحها الاستراتيجية الخاصة عند مواجهة قوى اقتصادية وعسكرية أكبر.
كانت حزمة النفقات العسكرية الإضافية، البالغة 100 مليار يورو، التي أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتز، بمثابة إقرار بهذا الواقع، لكنها لن تؤدي إلا إلى زيادة أرباح المركب الصناعي العسكري.
الضغط الهائل من جانب الإمبريالية الأمريكية أجبر الرأسماليين الألمان على إخراج أنفسهم من شبكة العلاقات التجارية الروسية الألمانية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المباشرة، وذلك بتكلفة كارثية.
وعلى الرغم من المحاولات الألمانية لإبطاء الوتيرة وتفادي الإجراءات التي كان من شأنها أن توحي بمواجهة مباشرة مع روسيا، فإن دينامية الحرب عرّضت حتما اقتصاد ألمانيا إلى انتقام روسي شديد عن طريق خنق إمدادات الطاقة، ثم قطعها بالكامل.
هذا الوضع، المقرون بارتفاع التضخم، ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة على الاستقرار السياسي والاجتماعي للرأسمالية الألمانية. سوف تكشف الفترة القادمة حتما التناقضات الطبقية الحادة، والتي ستقوض سياسات التعاون الطبقي للاشتراكيين الديمقراطيين والقادة النقابيين.
في مواجهة التدهور السريع لمستويات المعيشة، وتحت مطرقة التضخم المتفشي وارتفاع تكاليف الطاقة، ستضطر الطبقة العاملة إلى المقاومة. وكل محاولة من قبل البيروقراطية النقابية للالتزام بالأساليب القديمة للشراكة الاجتماعية ستزيد من تقويض سلطتها.
محاولات تعبئة الطبقة العاملة لدعم الطبقة الرأسمالية، مثل كلمات الرئيس الفيدرالي السابق، يواكيم غاك، الذي دعا الألمان إلى “التجمد من أجل الحرية” تبدو جوفاء بالفعل. وفي هذا السياق فإن المظاهرات المناهضة للحرب التي أشرنا إليها هي تحذير جدي. إن الاتجاه الحتمي نحو تفكك الشراكة الاجتماعية وانفجار الصراع الطبقي واقع متضمن في هذا السياق، مع نفاذ خيارات الطبقة السائدة.
إيطاليا
كان وصول حكومة ميلوني المحافظة إلى السلطة تطورا مقلقا للغاية بالنسبة للبرجوازية الإيطالية وللإمبريالية.
إيطاليا، التي تعاني بالفعل من ركود اقتصادي، بلغ التضخم فيها أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 40 عاما، ترزح تحت عبء ديون ضخمة تبلغ 2,75 تريليون يورو، أي 152% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يهدد بأن يصير عبئا أكبر مع ارتفاع أسعار الفائدة.
كان نجاح ميلوني الانتخابي يرجع إلى حقيقة أنها بقيت خارج حكومة ماريو دراغي. كان دراغي رجل الطبقة البرجوازية، لكن المشكلة كانت أن كل الأحزاب التي شاركت في ائتلافه تكبدت خسائر فادحة في الانتخابات.
ميلوني عنصرية متعصبة ورجعية متطرفة، لكن ليست هناك “عودة إلى الفاشية” في إيطاليا. بل هناك انعدام ثقة متزايد تجاه جميع الأحزاب، كما تؤكد ذلك نسبة الامتناع عن التصويت البالغة 40%.
لم تسجل الأصوات الإجمالية لائتلاف اليمين أي ارتفاع، لكن عددا كبيرا من الأصوات انتقل من برلسكوني وحزب الرابطة إلى حزب إخوة إيطاليا. فقط صوت واحد من أصل ستة هو من صوت لصالح حزب إخوة إيطاليا.
مباشرة بعد الانتخابات، بذلت ميلوني كل ما في وسعها لطمأنة الأسواق المالية الأوروبية بأنه يمكن الوثوق بها وأنها ستستمر إلى حد ما في نفس السياسات التي كان دراغي ينفذها. والتمويل الأوروبي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الإيطالي مشروط بفرض الحكومة لتدابير التقشف.

إن الأزمة الحالية، مع ارتفاع معدلات التضخم، وتدني الأجور، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب السياسات الرجعية بشأن مسائل مثل حقوق الإجهاض والهجرة، وما إلى ذلك، هي وصفة جاهزة لتفجير الصراع الطبقي واحتجاجات العمال والشباب.
فرنسا
أنفقت الحكومة الفرنسية، كما هو الحال في جميع البلدان الرأسمالية الكبرى، مبالغ ضخمة لتجنب أزمة كبيرة أثناء الجائحة، لكن الآن يتعين على أحد ما أن يدفع الثمن، ومن الواضح أنه سيكون الطبقة العاملة الفرنسية.
لكن البرجوازية الفرنسية واجهت ردا كفاحيا من جانب العمال في كل مرة حاولت فيها بشكل جدي ضرب المكاسب السابقة. عندما تم انتخاب ماكرون لأول مرة، واجه حركة السترات الصفراء بعد عام واحد من توليه منصبه. لكنه الآن صار أضعف مما كان عليه آنذاك.
كانت قاعدة دعمه الحقيقية خلال الجولة الأولى بالكاد 20% من مجموع الناخبين. وعوض تقوية الوسط، ما نشهده هو حدوث استقطاب حاد نحو اليسار (ميلونشون) ونحو اليمين (لوبين).
ظهرت حالة الاضطراب المتزايد خلال الانتخابات البرلمانية، بعد بضعة أشهر فقط، حيث فشل ماكرون في الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان. والنتيجة هي حكومة ضعيفة، قائمة على برلمان منقسم، وتحت ضغط هائل لتنفيذ البرنامج الذي تطلبه الطبقة الرأسمالية.
يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية، مع استمرار ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري لملايين الأسر، وخطر ارتفاع معدلات البطالة بفعل تأثير الأزمة الرأسمالية العالمية على فرنسا.
يمكن ملاحظة مؤشر على تغير الحالة المزاجية في إضراب عمال النفط، أكتوبر 2022، لمدة أسابيع بقيادة نقابة FNIC، النقابة الأكثر يسارية داخل CGT. لقد حاولت الحكومة اتخاذ إجراءات لهزم الإضراب، لكن عمال النفط حصلوا على دعم الأغلبية الساحقة من السكان، على الرغم من الخصاص في الوقود الذي سببه الإضراب.
دعا قادة النقابات العمالية إلى أيام النضال لتخفيف الاحتقان بين العمال لتجنب شن معركة شاملة ضد الحكومة. تم استخدام نفس التكتيك في النضال ضد إصلاح نظام التقاعد. وقد سمح ذلك للحكومة بفرض إصلاحاتها، على الرغم من تعبئة ملايين العمال والشباب، في العديد من المناسبات.
لن تكون القيادة النقابية قادرة على كبح الحركة إلى ما لا نهاية. فإضراب عمال النفط والتحركات الهائلة ضد إصلاح نظام التقاعد ونمو معارضة يسارية داخل صفوف الاتحاد العام للشغل (CGT)، كلها بمثابة استباق لما يمكن أن نتوقع حدوثه على نطاق أوسع بكثير خلال الفترة المقبلة. تدرك شريحة متنامية من الطبقة العاملة انسداد أفق “أيام النضال”. وقد صار شعار ”الإضراب العام“ في المظاهرات أكثر وضوحا من أي وقت مضى. إن تكرار ما حدث في ماي 1968 احتمال متضمن في الوضع برمته.
بريطانيا
قال الملياردير وارن بافيت ذات مرة إنه «فقط عندما ينحسر المد، ينفضح من كان يسبح عاريا». ينطبق هذا الوصف بشكل مثير للإعجاب على الوضع الحالي لبريطانيا.
لم يمر وقت بعيد منذ أن كانت بريطانيا تبدو على أنها البلد الأكثر استقرارا سياسيا واجتماعيا، وربما البلد الأكثر محافظة في أوروبا. لكن ذلك الآن ينقلب إلى نقيضه.
تم “انتخاب” ريشي سوناك بعد طرد ليز تروس، في أعقاب الكارثة المالية. وقد دخل إقامة 10 داونينغ ستريت، رافعا لوعد بـ”إصلاح” “أخطاء” سلفه.
لكن الحاجة الملحة إلى موازنة الحسابات والقضاء على الثغرة الكبيرة في المالية العامة تعني حتماً أن الشعب البريطاني يواجه فترة جديدة من التقشف والاقتطاعات والهجمات على مستويات المعيشة.
تضطر ملايين الأسر البريطانية للاختيار بين إضاءة المنزل وبين وضع الطعام على المائدة. لم يسبق للفرق الصارخ بين الأغنياء والفقراء أن كان أوضح مما هو عليه الآن. وهذا يؤجج نيران الاستياء والغضب.
هناك العديد من المؤشرات على حدوث تغيير في الوعي في بريطانيا، مثل حقيقة أن 47% من ناخبي حزب المحافظين يؤيدون تأميم قطاعات الماء والكهرباء والغاز، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع سياسات السوق الحرة لحكومة المحافظين.

بعد سنوات عديدة من الهجمات غير المسبوقة على الأجور ومستويات المعيشة، لم يعد العمال في حالة مزاجية تسمح لهم بقبول أي هجوم إضافي. التناقضات بين الطبقات تزداد حدة كل يوم.
ينعكس مزاج الغضب في عدد متزايد من الإضرابات: عمال السكك الحديدية، وعمال الموانئ، وعمال البريد، وعمال قطاع النظافة، وحتى المحامون الجنائيون، انخرطوا بالفعل في إضرابات. وتبعهم آخرون مثل المعلمين والممرضين.
يتزايد الحديث عن التنسيق لإضراب عمالي. هل سيكون هناك إضراب عام في بريطانيا؟ من المستحيل التنبؤ بهذا. كل ما يمكن للمرء أن يقوله بكل يقين هو أنه لا الحكومة ولا قادة النقابات العمالية يريدون ذلك، لكن وبما أن جميع الشروط الموضوعية لمثل هذه النتيجة متوفرة، فإنهم قد يقعون فيها.
إعادة تنشيط النضال الاقتصادي تطور هام. لكن له حدوده. سبق لتروتسكي أن أشار إلى أنه حتى أكثر الإضرابات عاصفية لا يمكنها أن تحل المشاكل الجوهرية للمجتمع، فبالأحرى تلك التي تعرضت للهزيمة.
حتى عندما ينجح العمال في انتزاع زيادة في الأجور، فإنه يتم إلغاؤها بسرعة من خلال ارتفاع الأسعار. لذلك فإنه، في مرحلة ما، سيتعين على الحركة أن تكتسب تعبيرا سياسيا. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟
حزب العمال وحزب المحافظين
لفترة من الوقت مال حزب العمال بحدة نحو اليسار في ظل قيادة جيريمي كوربين. آنذاك فقدت الطبقة السائدة في الواقع السيطرة على كلا الحزبين الرئيسيين: حزب العمال لصالح الإصلاحيين اليساريين، وحزب المحافظين لصالح الشوفينيين اليمينيين الموالين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكن، ونتيجة للاستسلام المخزي الذي قام به اليسار، نجح اليمين في استعادة السيطرة على حزب العمال، وهو الأمر الذي اعتبره حتى أكثر المراقبين البرجوازيين تفاؤلا أمرا مستحيلا تقريبا.
الآن حزب المحافظين فاقد للمصداقية وغارق في الأزمة. إنهم منقسمون على أنفسهم إلى عدة تيارات متصارعة ويتزايد احباطهم، وينقلبون على بعضهم البعض في حين تتراكم ضغوط الأزمة، وذلك على وجه التحديد في الوقت الذي تحتاج فيه الطبقة السائدة إلى حكومة موحدة لتنفيذ هجماتها على العمال.
تتمثل سياسات الحكومة الجديدة في مجموعة من الاقتطاعات والزيادات الضريبية التي لن تؤثر على العمال فحسب، بل ستؤثر حتى على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى. إنها وصفة ملائمة لاحتدام الصراع الطبقي. وكل ما سيفعله المحافظون الآن سيكون خطأ.
تحاول حكومة حزب المحافظين الجديدة تجنب الدعوة إلى انتخابات لأنهم يعرفون أنهم سيتعرضون خلالها للإبادة. سيصل حزب العمال إلى السلطة، ليس بفضل ستارمر، بل على الرغم منه.
ستارمر، من جانبه، ليس متحمسا جدا لرئاسة حكومة ذات أغلبية عمالية، لأن ذلك سيحرمه من أي عذر لعدم تنفيذ سياسات لصالح الطبقة العاملة. وتتمثل سياسته في كبح التوقعات والوعود إلى أقصى قدر ممكن.
ليس من المستبعد حتى أن يكون هناك انقسام مفتوح داخل حزب المحافظين، عبر انشقاق الجناح اليميني لتشكيل حزب جديد من أنصار البريكست، ربما مع نايجل فاراج. يمكن لذلك أن يؤدي إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية” مع حزب العمال بتحالف مع الليبراليين والمحافظين المعتدلين.
سيتعين على الطبقة العاملة أن تتعلم من جديد، بطريقة أو بأخرى، بعض الدروس المؤلمة في مدرسة السير كير والزمرة اليمينية التي تسيطر الآن على حزب العمال، وهم سياسيون برجوازيون في كل شيء ما عدا الاسم.
قام الجناح اليميني بحملة تطهير شاملة للحزب، من أجل منع أي احتمال لتكرار تجربة كوربين. لكن وبمجرد أن يصبح حزب العمال في الحكومة ، سيتعرض لضغوط من جانب الرأسماليين ومن جانب الطبقة العاملة.
ستارمر، باعتباره خادما مخلصا لأصحاب الأبناك والرأسماليين، لن يتردد في تنفيذ سياسات لصالحهم. لكن أي محاولة لتطبيق سياسة الاقتطاعات والتقشف ستثير انفجارا للغضب، والذي سيجد في النهاية تعبيرا له داخل حزب العمال، بدءا من النقابات التي، على الرغم من كل شيء، ما تزال تحتفظ بصلتها بالحزب. ستكون الأحداث الكبرى ضرورية لإجبار الناس على تقبل حقيقة أنه لم يعد من الممكن العودة إلى ما كان موجودا من قبل.
وفي اسكتلندا، خسر حزب العمال معقله منذ فترة طويلة. ويعيش الحزب الوطني الاسكتلندي -الذي هو أكبر حزب في اسكتلندا- حالة من الاضطراب، بعد أن فقد 30 ألف عضو منذ عام 2021 بسبب المأزق الاستراتيجي الذي وصله بشأن المسألة القومية. ومع ذلك، فإن الطبقة العاملة، وخاصة الشباب، الذين يؤيد غالبيتهم الاستقلال، لا يعودون إلى حزب العمل بأعداد كبيرة، بل يبحثون عن طريق آخر للمضي قدما. في ظل هذه الظروف، ستفتح فرص كبيرة للتيار الماركسي في جميع أنحاء بريطانيا.
أزمة الطبقة السائدة
الطبقة السائدة لديها القادة الذين تستحقهم. ليس من قبيل المصادفة أن الطبقة السائدة تواجه في كل مكان أزمة قيادة، كما تظهر من خلال الانقسامات المفتوحة التي تحدث في القمة، في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي البرازيل وفي باكستان.
لكن أسباب أزمة القيادة هذه متأصلة في الوضع نفسه. الأزمة الحالية عميقة لدرجة أنها تستبعد عمليا أي مجال للمناورة في القمة. وكما لاحظ لينين فإن الشخص الذي يقف على حافة الهاوية لا يستطيع التفكير. سيجد حتى أكثر القادة ذكاء وكفاءة أنه من المستحيل تخليص أنفسهم من هذا المستنقع.
ومع ذلك فإن نوعية القيادة تلعب دورا هاما. خلال الحرب قد يضطر الجيش أحيانا إلى التراجع. لكن مع وجود جنرالات جيدين، يمكن للجيش أن يتراجع بنظام تام، ويحافظ على معظم قواته لأجل القتال في يوم آخر، في حين أن الجنرالات السيئين سيحولون الانسحاب إلى كارثة.
يكفينا أن نشير إلى بريطانيا في الوقت الحاضر لكي نظهر صحة هذا الموقف.
أزمة الديمقراطية البرجوازية
إن عصرنا -عصر الإمبريالية- يتميز قبل كل شيء بهيمنة رأس المال المالي. تعرف كل الحكومات فور وصولها إلى السلطة أن وزير المالية يجب أن يكون “مقبولا من طرف رجال الأعمال”.
ساهمت التجربة القصيرة لحكومة تروس في بريطانيا في توضيح الطبيعة الوهمية بالكامل للديمقراطية البرجوازية الرسمية في العصر الحالي. لقد اختار الرأسماليون في بريطانيا كلا من وزير المالية ورئيس الوزراء، وأعفوا بذلك الشعب البريطاني من المهمة الصعبة المتمثلة في انتخاب أي كان.
خلف قناع الليبرالية المبتسم، تختبأ القبضة الحديدية للرأسمالية الاحتكارية وديكتاتورية أصحاب الأبناك، التي يمكن استخدامها في أي وقت لتحطيم أي حكومة لا تطيع إملاءات رأس المال.
من الواضح أن هذا ينطبق على الحكومات اليسارية، كما في حالة اليونان، لكنه يمكن أن ينطبق كذلك حتى على الحكومات اليمينية، كما اكتشفت ذلك السيدة تروس مؤخرا. الحكومة التي تنتهج سياسات لا تحبها البرجوازية يتم إسقاطها دون تردد.

لدينا هنا دليل واضح جدا على من هو السيد الحقيقي. السوق هي التي تحكم، أما الباقي فهو مجرد خداع وتلاعب. وهذا طبيعي تماما. فحتى في أفضل الظروف كانت الديمقراطية البرجوازية دائما نبتة هشة للغاية.
لا يمكن للديمقراطية أن توجد إلا عندما تكون الطبقة السائدة قادرة على منح بعض الامتيازات للطبقة العاملة، والتي تؤدي، إلى حد معين ولفترة محدودة، إلى تحسين ظروف الجماهير وبالتالي ثلم نصل الصراع الطبقي ومنعه من تجاوز حدود معينة.
كانت “قواعد اللعبة” مقبولة من طرف الجميع، وكانت المؤسسات القائمة (البرلمان، والسياسيون، والأحزاب، والدولة، والشرطة، والقضاء، و”الصحافة الحرة”، إلخ) تتمتع بنوع من السلطة والاحترام.
كان ذلك النموذج ناجحا بشكل عام لفترة طويلة في البلدان الرأسمالية المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية. لكن الظروف تغيرت الآن وأصبح صرح الديمقراطية البرجوازية الشكلية برمته تحت الضغط إلى حد الانهيار.
أينما نظر المرء يرى دليلا واضحا على اشتداد التناقضات الطبقية التي تمزق نسيج المجتمع. تتجلى الميول النابذة في المجال السياسي في انهيار الوسط السياسي، وهو أوضح تعبير عن الاستقطاب الاجتماعي.
أمريكا اللاتينية
أمريكا اللاتينية كلها تشبه بركانا يستعد للانفجار. اقتصاداتها تتعرض للعقاب بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة ديونها الحالية ويجعل المزيد من التمويل أكثر تكلفة.
يمكن لهذا أن يؤدي إلى أزمة ديون معممة مثل أزمة الثمانينيات. قد تكون الأرجنتين الآن أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية ضعفا، لكن العديد من البلدان الأخرى هي بالفعل على وشك التخلف عن السداد.
كانت أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19، التي جاءت بعد فترة من الركود الاقتصادي. قبل الجائحة شهدنا تحركات جماهيرية في العديد من البلدان، أخذت أبعادا ثورية في العديد منها، لا سيما الإكوادور وتشيلي في أكتوبر ونوفمبر 2019.
أدت عمليات الإغلاق إلى إبطاء ذلك جزئيا، لكن السيرورات الأساسية تعيد الآن تأكيد نفسها مرة أخرى. شهدنا إضرابا وطنيا تاريخيا في كولومبيا عام 2021، ثم إضرابا وطنيا آخر في الإكوادور عام 2022.
عادت الجماهير إلى الشوارع بأعداد كبيرة في هاييتي وبلدان أخرى. والسبب الوحيد في أن الطبقة العاملة لم تستول على السلطة في تشيلي والإكوادور وكولومبيا هو فقط غياب قيادة ثورية.
في الفترة السابقة، خلال طفرة صادرات السلع، تمكن إيفو موراليس، وكوريا، ونيستور كيرشنر، وحتى تشافيز، من تنفيذ سياسات اجتماعية إلى حد ما. لكن ذلك انتهى في عام 2014 مع التباطؤ الذي شهدته الصين.
أما الآن فستواجه مثل تلك الحكومات أزمة اقتصادية عميقة للرأسمالية. هامش المناورة أمامها سيتقلص بشكل كبير. وسيكون هذا هو الحال أيضا مع حكومة لولا في البرازيل.
البرازيل
يبلغ عدد العاطلين في البرازيل رسميا حوالي 11 مليون نسمة، لكن العدد الحقيقي للعاطلين أعلى من ذلك بكثير. وتظهر أحدث الأرقام أن حوالي 30% من السكان يعيشون في فقر، وهي ظاهرة زادت بشكل ملحوظ خلال الجائحة. ومع تصاعد التضخم -الذي يبلغ الآن حوالي 8%- فإن هذا الوضع سوف يزداد سوءا.
السكان في حالة استقطاب شديد مع تزايد الفقر من جهة، وتركيز الثروة في أيدي أقلية صغيرة من فاحشي الثراء من جهة أخرى. وينعكس هذا الاستقطاب في الوضع السياسي. خلال انتخابات عام 2022، صوتت أفقر المجتمعات في الشمال والشمال الشرقي بأغلبية كبيرة لصالح لولا، بينما انتصر بولسونارو في الوسط والجنوب الأكثر ثراء.
لكن وبسبب موقف لولا المبني بشكل صريح على التعاون الطبقي، وميله إلى اليمين خلال الحملة الانتخابية، تمكن بولسونارو من كسب شريحة كبيرة من أصوات الطبقة العاملة.
كانت سياسة التقشف التي طبقتها ديلما، في عام 2018، هي التي عبدت الطريق لانتصار بولسونارو، الذي تمكن من تقديم نفسه بشكل ديماغوجي على أنه مرشح “الشعب”. كان هذا العنصر حاضرا حتى في انتخابات 2022، وهو ما يفسر أيضا سبب تحقيق بولسونارو لنتيجة أفضل بكثير مما توقعه منظمو الاستطلاعات في الأصل.
افتقرت حملة لولا إلى أي محتوى يمكن أن يجذب بجدية العمال والفقراء على أساس طبقي.
استخدم العمال الانتخابات لتحرير أنفسهم من بولسونارو الممقوت. لكن هذه الآمال ستتحطم بسبب الواقع القاسي لأزمة الرأسمالية في البرازيل. وبمجرد أن يمروا من تجربة لولا في السلطة في ظل مرحلة الأزمة الرأسمالية العميقة، سيبدأون في استنتاج أنه يتعين عليهم البدء في أخذ الأمور بأيديهم، من خلال الإضرابات واحتجاجات الشوارع وتحركات الشباب، كما رأينا في العديد من البلدان الأخرى.
فشل الحكومات “التقدمية”
الحكومات “اليسارية” و”التقدمية” في السلطة كشفت بشكل صارخ عن حدودها خلال مرحلة الأزمة الاقتصادية الحادة للرأسمالية. هذا هو الحال مع حكومة فرنانديز وكيرشنر في الأرجنتين، التي وقعت صفقة مع صندوق النقد الدولي تتضمن سياسات تقشف قاسية.
في تشيلي واصل بوريك سياسة عسكرة مناطق مابوتشي ونفذ سياسة مالية تتمثل في الاقتطاعات من أجل تقليص العجز. وفي المكسيك، أبرم لوبيز أوبرادور جميع أنواع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن الهجرة، وأخرج الجيش إلى الشوارع لفرض الأمن، وما إلى ذلك.
في بيرو، قدم كاستيلو تنازلا تلو الآخر للطبقة السائدة والشركات متعددة الجنسيات. لم يؤد ذلك إلا إلى تقويض قاعدة دعمه، دون أن يتمكن من استرضاء الطبقة السائدة، التي تخلصت منه تماما الآن.

كل تلك الحكومات لديها فكرة مشتركة، وهي فكرة “مناهضة النيوليبرالية”. هذه هي الفكرة الطوباوية القائلة بأنه يمكن للمرء أن يحكم لصالح العمال والفلاحين في حدود الرأسمالية. لكن “النيوليبرالية” ليست خيارا سياسيا، إنها مجرد تعبير عن مأزق الرأسمالية الحالية على نطاق عالمي.
ليس من الممكن تنفيذ نوع مختلف من السياسات دون تحدي هيمنة الطبقة السائدة والإمبريالية. هذه هي نقطة الضعف القاتلة لجميع تلك الحكومات التقدمية المزعومة. هذا التناقض المركزي هو الذي يمهد الطريق لانفجارات اجتماعية جماهيرية جديدة في أمريكا اللاتينية. إن الانتفاضات الثورية هي على رأس جدول الأعمال في وقتنا الحالي.
كوبا عند مفترق الطرق
تواجه كوبا أصعب موقف منذ ثورة 1959. من وجهة النظر الاقتصادية نرى تزامن الضربات المشتركة: سياسة ترامب لتشديد العقوبات الأمريكية، وتأثير كوفيد على السياحة، وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الحصار الأمريكي المستمر منذ عقود، وسوء الإدارة وعدم كفاءة الحكم البيروقراطي.
وقد تفاقم الوضع أكثر بسبب السياسات المؤيدة للرأسمالية التي تنهجها البيروقراطية الكوبية، التي تسعى جاهدة لإيجاد مخرج من المأزق عبر اتباع النموذج الصيني والفيتنامي.
هذه هي الخلفية التي يمكن أن تتطور على أساسها الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بطريقة لم نشهدها منذ 1994. والوضع الآن أسوء. فبعد 10 سنوات من مناقشة الإصلاحات الاقتصادية، لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا.
فقد قسم من السكان كل أمل، وعشرات الآلاف يهاجرون إلى الخارج، وفقد آخرون كل الثقة في الحكومة والبيروقراطية. وفي هذا السياق اندلعت احتجاجات هي الأكبر منذ 1994. لكنه من الضروري تحليل مضمون تلك المظاهرات.
في ظل غياب قيادة ثورية واعية، يمكن لسخط الجماهير المشروع أن يشكل أرضية خصبة مواتية لدعم الثورة المضادة الرأسمالية.
ومن ناحية أخرى هناك شريحة كبيرة من السكان تدعم الثورة ولديها شعور قوي مناهض للإمبريالية وتعادي الثورة المضادة. وبين صفوف هذه الفئة هناك انتقادات متزايدة ضد البيروقراطية.
مهمتنا هي أن نشرح بصبر، للعناصر الأكثر تقدما بينهم، أن السبيل الوحيد للمضي قدما للدفاع عن الثورة، هو النضال من أجل الديمقراطية العمالية والأممية البروليتارية.
أفريقيا
تشهد أجزاء كبيرة من أفريقيا الآن فترة من الاضطرابات الشديدة وعدم الاستقرار. ومن بين الدول الستين التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها “تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لخطر أن تصبح كذلك”، فإن 50 منها تقع في أفريقيا. لقد عانى نحو 278 مليون شخص -ما يقرب من خمس إجمالي عدد السكان- من الجوع في عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 50 مليون شخص منذ عام 2019 وفقا لأرقام الأمم المتحدة. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 310 ملايين بحلول عام 2030.
هذه هي الأرضية التي قامت على أساسها الاضطرابات والهزات الاجتماعية والسياسية العامة التي انتشرت في جميع أنحاء القارة. لقد كانت هناك تحركات جماهيرية وانقلابات وحروب وحروب أهلية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد والسودان وإثيوبيا وغينيا بيساو وغينيا ومنطقة الساحل بأكملها.
كانت هذه النزاعات جزئيا قوة دافعة وراء الرقم القياسي للنازحين والذي بلغ 100 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم بحلول عام 2022. كما ساهمت النزاعات في أوكرانيا وميانمار واليمن وسوريا في ارتفاع هذا الرقم. ومع ذلك فإن مشكلة الهجرة القسرية حادة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب الأزمة البيئية. ووفقا لتقرير حديث، فإن ثلثي البلدان الـ 27 التي تواجه “تهديدات بيئية كارثية” تقع في هذا الجزء من العالم، وجميع البلدان الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، والتي يبلغ عددها 52، باستثناء بلد واحد، تواجه “إجهادا مائيا شديدا”. سيكون للضغوط المجتمعة للأزمة البيئية والصراعات والهجرة القسرية تأثير مزعزع للاستقرار بشكل متزايد في جميع أنحاء القارة وخارجها.
نيجيريا
نيجيريا، التي هي أكبر اقتصاد في القارة، ليست في مأمن بأي حال من الأحوال من هذه الاضطرابات. وعلى الرغم من الموارد النفطية والمعدنية الهائلة التي تمتلكها، فإنه ما يزال 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع.
إن النخبة الحاكمة الفاسدة والمنحطة عاجزة تماما عن حل أي من مشاكل الرأسمالية النيجيرية. والحزبان الرئيسيان في البلد، حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، وحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الديمقراطي، فقدا مصداقيتهما تماما بين شرائح واسعة من المجتمع.

في عام 2020، اهتزت البلاد على وقع اندلاع حركة الشباب الجماهيرية “EndSARS”. بدأت تلك الحركة العظيمة، التي قادها الشباب بشكل رئيسي، كرد فعل على مقتل شاب في دلتا أوغيلي على يد الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (SARS) التابعة لجهاز الشرطة النيجيري.
انتشرت الحركة كالنار في الهشيم في كل ولايات الجزء الجنوبي من البلاد تقريبا. وقد عبرت هذه الحركة عن الغضب المتراكم والإحباط وعدم الرضا لدى الشباب النيجيري الذي كان الأكثر تضررا من أزمة الرأسمالية.
لكن وبينما تلاشت الحركة في نهاية المطاف، لم يتم حل أي من المشاكل الجوهرية التي أدت إليها. ومع الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم المتصاعد، وانحدار ملايين آخرين إلى صفوف الفقراء، يتم تعبيد الطريق لاندلاع جولات جديدة من الصراع الطبقي على مستوى أعلى.
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا هي البلد الرئيسي في القارة الأفريقية. لديها اقتصاد وبنية تحتية متطورين نسبيا. إنها واحدة من أكبر مصدري المعادن في العالم. كما أن لديها قطاعات تصنيعية ومالية وطاقية واتصالاتية قوية. والأهم من كل شيء، من وجهة النظر الماركسية، هو أن لديها بروليتاريا كبيرة وقوية ذات تقاليد كفاحية عظيمة.
جميع العناصر الضرورية لبناء بلد مزدهر موجودة. ومع ذلك فإن غالبية الناس تعيش حياة البؤس. العدد الحقيقي للعاطلين يبلغ 10,2 مليون شخص ويعيش نصف السكان في فقر.
ظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي طيلة عقود من الزمان دعامة لاستقرار الرأسمالية في جنوب أفريقيا. لكن سنوات من فضائح الفساد والهجمات على الطبقة العاملة أضعفت سلطته وأغرقته في أعمق أزمة يعرفها على الإطلاق.
وبينما تتناقص قاعدة دعمه، ينزلق هو داخليا إلى حروب استنزاف لا تنتهي بين مختلف الفصائل البرجوازية التي تشق الحزب إلى أشلاء، بينما تعمل على فصله أكثر فأكثر عن الجماهير التي اعتادت أن تعتبره حزبها.
إن التطور الخاص للصراع الطبقي في جنوب إفريقيا وتطور القوى السياسية فيها يعني تاريخيا أن الطبقة السائدة ليس لديها حزب آخر تعتمد عليه.
وبينما تعبد الظروف الاقتصادية لاندلاع نهوض آخر للصراع الطبقي، ستجد الطبقة السائدة صعوبة أكبر في استخدام ثقل قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لكبح جماح الحركة.
باكستان
تواجه باكستان أزمة مالية حادة وهي معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 130 مليار دولار. انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى واحدة من أدنى مستوياتها في تاريخ البلد. والتضخم في أعلى مستوى له منذ الاستقلال. وقد بلغ التضخم في السلع الغذائية والوقود أكثر من 45%.
وفوق كل هذا هناك تأثير الفيضانات الأكثر كارثية في تاريخ الأمة. يعيش ملايين الأشخاص حالة مأساوية من الجوع ونقص مياه الشرب والتشرد والفقر المدقع.
لجأ رئيس الوزراء شريف إلى صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، لكن الأضرار الجسيمة التي سببتها الفيضانات واسعة النطاق تعني أنه حتى قروض صندوق النقد الدولي لن تكفي لسد الفجوة المالية التي تعرفها باكستان.
وفي غضون ذلك، النظام غارق في الانقسامات والأزمة، حيث تقاتل الفصائل المتنافسة بعضها البعض مثل القطط في كيس، بينما تبقى السلطة الحقيقية في أيدي الجنرالات.
الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف معنية بشكل رئيسي بإزاحة حزب عمران خان من المجالس المحلية وتشديد قبضتها على السلطة.
محاولة عمران خان اليائسة لاستعادة موقعه تعرضت للكبح من قبل الجيش، الذي حاول إبعاده عن المشهد من خلال وسيلة بسيطة وهي عملية اغتيال (فاشلة).

وقد أدى ذلك إلى انتشار انعدام الثقة على نطاق واسع بين غالبية السكان تجاه جميع الأحزاب، والتي يرون بحق أنها مجرد عصابات إجرامية. بالنظر إلى كل هذه العوامل، فإنه لا يمكن على الإطلاق استبعاد اندلاع احتجاجات جماهيرية تشبه تلك التي حدثت في سريلانكا عام 2022.
وتعليقا على الوضع الكارثي الحالي، قال عمران خان نفسه: «لقد شهدت منذ ستة أشهر ثورة تجتاح البلد… والسؤال الوحيد هو هل ستكون ثورة ناعمة من خلال صناديق الاقتراع، أم أنها ستكون مدمرة من خلال إراقة الدماء؟».
قد تكون كلماته تنبؤات صحيحة أكثر مما يدرك هو نفسه.
المعقول يصير غير معقول
عندما يتأمل معظم الناس في الوضع الحالي يستنتجون أن العالم قد جن جنونه. تشعر الجماهير في أعماقها أن هناك خطأ ما، وأن شيئا ما لا يعمل، وأن كل شيء مقلوب رأسا على عقب. لكنهم لا يعرفون ما هو.
إن ما يقصدونه بهذا هو أنهم لا يستطيعون إيجاد أي تفسير منطقي لما يحدث. وعندما ينسبون كل شيء إلى نوع من الجنون العام، فهم بمعنى ما ليسوا مخطئين. إلا أن ذلك الجنون منغرس في الحمض النووي للنظام الرأسمالي. وعلى حد تعبير هيجل المعقول يصير غير معقول.
لكنهم بمعنى آخر، أعمق، هم مخطئون. إنهم يعتقدون أن ما يحدث لا يمكن فهمه وهم يائسون.
لكن كل تلك السيرورات التي نلاحظها، مثلها مثل الكون بشكل عام، لها تفسير منطقي ويمكن فهمها. ومن أجل الحصول على هذا الفهم، من الضروري امتلاك منهج مناسب. وهذا المنهج لا يمكن أن يكون إلا منهج التفكير الديالكتيكي: منهج الماركسية.
إن ما يتم وصفه هنا هو مجرد المظاهر الخارجية لأزمة وجودية للرأسمالية.
لم يعد النظام الرأسمالي قادرا على استخدام كل القوى المنتجة -بما في ذلك قوة عمل الطبقة العاملة- التي أوجدها. هذا مؤشر على الحدود التي وصل إليها النظام الرأسمالي.
هذا لا يعني أن النظام الرأسمالي على وشك الانهيار. لقد سبق للينين أن أوضح أن الرأسماليين سيجدون دائما مخرجا حتى من أعمق الأزمات. لكن السؤال هو: بأي ثمن تتحمله البشرية، والطبقة العاملة على وجه الخصوص؟
من شأن الركود الشديد أن يؤدي إلى وصول البطالة إلى مستويات تاريخية. سيكون لذلك عواقب ثورية هائلة. وهذا الواقع مفهوم بالفعل من قبل منظري رأس المال.
في أواخر شتنبر الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم من “شتاء السخط العالمي” الذي يلوح في الأفق في عالم يعاني من أزمات متعددة من حرب أوكرانيا إلى أزمة المناخ.
قال غوتيريس أثناء افتتاحه الجمعية العامة السنوية: «الثقة تتداعى، والتفاوتات تتفجر، وكوكبنا يحترق». كان ذلك تقييما صحيحا للوضع العالمي. لكنه لم يكن الوحيد الذي توصل إلى منظور قاتم. فقد كتبت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر[3] في تقرير لها صدر يوم 02 شتنبر 2022:
«يواجه العالم ارتفاعا غير مسبوق في الاضطرابات الأهلية في حين تكافح الحكومات من جميع الأطياف ضد تأثيرات التضخم على أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة».
وجاء في تقرير فيريسك مابلكروفت إنه «بالنسبة للحكومات غير القادرة على الخروج من الأزمة، من المرجح أن يكون القمع هو الرد الرئيسي على الاحتجاجات المناهضة للحكومة».
لكن القمع يأتي مصحوبا بمخاطره الخاصة، حيث لا يترك للسكان الساخطين إلا آليات أقل للتعبير عن معارضتهم، في وقت يتزايد فيه الإحباط من الوضع القائم. وفي البلدان التي يوجد فيها عدد قليل من الآليات الفعالة لتوجيه السخط الشعبي، مثل وسائل الإعلام الحرة والنقابات الفعالة والمحاكم المستقلة، من المرجح أن يرتفع احتمال نزول السكان إلى الشوارع.
لا إصلاحات؟
من الناحية الموضوعية لم يعد النظام الرأسمالي قادرا على ضمان الإصلاحات التي حققتها الطبقة العاملة خلال العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
تواجه البرجوازية الآن مشكلة لا يمكن التغلب عليها وهي: كيف تجعل الطبقة العاملة تقبل بتصفية تلك المكتسبات؟ وقد ثبت أن ذلك صعب للغاية لدرجة أن الطبقة السائدة مضطرة لمواصلة الحفاظ على نظام غير مستدام.
لكن هل يصح القول، كما يفعل البعض، إن الإصلاحات صارت مستحيلة الآن؟ كلا، هذا غير صحيح. فإذا وجدت الطبقة السائدة نفسها مهددة بفقدان كل شيء، سوف تقدم إصلاحات فورا، بما في ذلك الإصلاحات التي “لا تستطيع تحملها”.
خلال فترة ما بعد الحرب، كان بإمكان البرجوازية في البلدان الرأسمالية المتقدمة تقديم تنازلات لأنها كانت قد راكمت طبقة من الدهون. ويمكن الاستفادة من تلك الاحتياطيات في أوقات الأزمات، عندما يكون بقاء النظام في خطر.
وحتى إذا ثبت أن ذلك غير كاف، فيمكنهم اللجوء إلى الاقتراض، مما يؤدي إلى خلق ديون ضخمة، يمكنهم أن يلقوها على عاتق الأجيال القادمة لسدادها. وهذا بالضبط ما فعلوه خلال الجائحة، لأنهم كانوا خائفين من العواقب الاجتماعية والسياسية المحتملة للانهيار الاقتصادي العام.
لذلك لجأوا إلى الأساليب الكينزية، التي كان الاقتصاديون قد رموها في سلة مهملات التاريخ. لقد أنفقوا مبالغ طائلة أثناء الجائحة. لكنهم وجدوا أنفسهم أمام ديون ضخمة يجب سدادها عاجلا أم آجلا. وما يزال هذا هو الحال.
ما يمكن للمرء أن يقوله هو إن البرجوازية لا تستطيع إجراء أي إصلاحات جدية عميقة وطويلة الأمد. ما يعطونه بيد يستردونه باليد الأخرى. والتضخم يلغي بسرعة أي زيادات في الأجور. وتراكم الديون لا يؤدي إلا إلى مراكمة تناقضات أكبر للمستقبل.
سيؤدي التضخم إلى موجة من الإضرابات وإلى اشتداد النضال الاقتصادي.
الركود العميق، على النقيض من ذلك، سيؤدي إلى تقليص نشاط الإضرابات، لكن التهديد بإغلاق المصانع يمكنه أن يؤدي إلى احتلال المصانع والاعتصامات، وسيكون هناك تأرجح نحو النضال السياسي.
لا يمكن استبعاد أن تضطر البرجوازية في النهاية، في مواجهة معارضة الجماهير للتقشف، إلى التراجع، واختيار الهجوم غير المباشر بدلا من ذلك.
يعتبر كل من التضخم والانكماش هجوما على الطبقة العاملة. الفرق هو أن التضخم هجوم غير مباشر، في حين أن الانكماش (أي البطالة) هو هجوم مباشر. الاختيار بينهما، من وجهة نظر العمال، هو اختيار بين الموت البطيء بالنار أو الموت السريع شنقا. كلاهما غير مقبول، وكلاهما سيؤدي إلى انفجار الصراع الطبقي.
اللامساواة
توقع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أنه إذا لم يحدث انتعاش حاد في الاقتصاد العالمي، سيبقى ما يقدر بنحو 574 مليون شخص، أو حوالي7% من سكان العالم، يعيشون على 2,15 دولار فقط في اليوم بحلول عام 2030، معظمهم في أفريقيا.

وعلى النقيض من ذلك فإن الأغنياء يزدادون ثراء بشكل فاحش أكثر من أي وقت مضى. وقد تحدث مقال حديث لبلومبرغ (Bloomberg) عن احتمالات بروز ظاهرة جديدة تسمى “أطفال الصناديق الائتمانية ذات التريليون دولار”، والتي من المنتظر أن تظهر خلال العقد القادم. إنهم أبناء الأغنياء فاحشي الثراء الذين سيمتلكون منذ ولادتهم ثروات أكبر من ميزانيات بعض البلدان الصغيرة.
وتساءل المقال:
كيف يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص، في حين يرث البعض ثروات تفوق ميزانيات جامعات بأكملها؟ وكيف يمكنك الإشادة بأخلاقيات العمل في حين لدينا طبقة مرفهة تتوسع باستمرار؟
هذا الواقع هو ما وصفه ماركس في كتاب رأس المال حين قال: «إن تراكم الثروة في قطب هو، بالتالي، وفي نفس الوقت تراكم للبؤس وعذاب الكدح، والعبودية، والجهل، والوحشية، والتدهور العقلي، في القطب المقابل، أي في جانب الطبقة التي تخلق منتجها في شكل رأس مال».
إن المكاسب الفاحشة التي أعلنت عنها شركة شل، وغيرها من شركات الطاقة الكبرى، في وقت يكافح فيه ملايين الناس من أجل البقاء، تفاقم الإحساس العميق والدائم بالظلم والمرارة.
هذه التناقضات الصارخة التي تلاحظها الجماهير، تؤجج نيران الاستياء والكراهية ضد تلك الطفيليات الثرية، وستؤجج نيران الصراع الطبقي. إن الوضع برمته يحبل بإمكانيات ثورية. ويمكننا بالفعل رؤية دليل واضح على ذلك.
سريلانكا
إذا كنتم ترغبون في رؤية كيف تكون الثورة، ما عليكم سوى إلقاء نظرة على التمرد الشعبي العفوي الذي شهدته سريلانكا. رأينا هناك القوة الكامنة الهائلة للجماهير. وقد ضربت دون سابق إنذار، مثل صاعقة في سماء زرقاء صافية.
كانت تلك إجابة مدوية على كل من يشك في قدرة الجماهير على القيام بثورة. لقد أظهرت الأحداث في سريلانكا أنه عندما تتخلص الجماهير من خوفها، لا يعود في إمكان أي قدر من القمع أن يوقفها.
نزلت الجماهير إلى الشوارع، دون قيادة ولا تنظيم ولا برنامج واضح، وأطاحت بالحكومة بكل سهولة. لكن تجربة سريلانكا تظهر لنا أيضا شيئا آخر.
كانت السلطة ملقاة في الشوارع، في انتظار من يلتقطها. كان يكفي لقادة الاحتجاجات أن يقولوا: “لدينا السلطة الآن. نحن الحكومة”.
لكن تلك الكلمات لم تُقل قط. غادرت الجماهير القصر الرئاسي بهدوء، وتمكنت السلطة القديمة من العودة. أعيدت ثمار النصر إلى نفس المضطهِدين القدامى والدجالين البرلمانيين.
كانت السلطة في أيدي الجماهير، لكنها تسربت من بين أصابعهم. هذه حقيقة مرة، لكن هذه هي الحقيقة.
الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أنه دون قيادة صحيحة لا يمكن للثورة أن تنجح إلا بصعوبة كبيرة، وفي أغلب الأحيان لا يمكنها أن تنجح على الإطلاق.
إيران
الدليل الآخر على ذلك أعطته الانتفاضة ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ الملهمة التي شهدتها ﺇﻳﺮﺍﻥ. جاءت تلك الانتفاضة في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاما، في مركز للشرطة، والتي اعتقلتها شرطة الآداب الممقوتة بحجة “عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح”.
لكن ذلك لم يكن حدثا منعزلا. لقد كانت هناك العديد من مثل تلك الوفيات في إيران. لكن في هذه الحالة الأخيرة، تم الوصول إلى نقطة حرجة حيث تحول الكم إلى كيف.
الانفجار الذي أعقب ذلك امتد على الفور إلى كل المدن الرئيسية، بل وحتى إلى البلدات والقرى الصغيرة التي لم يسبق لها أن شهدت أي مظاهرات من قبل. كان المتظاهرون في أغلبيتهم الساحقة من الشباب، مع مشاركة واسعة للفتيات، ليس فقط من الجامعات بل أيضا من المدارس.
ردت قوات الأمن بحملة قمع وحشي ازداد قسوة مع نمو الحركة. وخلال الاشتباكات العنيفة العديدة بين الشباب وقوى القمع، قُتل المئات واعتقل الآلاف.
وردا على ذلك، امتد الإضراب الطلابي إلى أكثر من مائة جامعة والكثير من المدارس. وقد كان الجانب الأكثر إثارة للانتباه في تلك الاحتجاجات هو الغياب التام للخوف من جانب الشباب، وخاصة الفتيات.
بدأت التلميذات في إيران يلوحن بحجابهن في الهواء ويرددن هتافات ضد السلطات الدينية. يا لها من أحداث ملهمة! كانت هتافاتهن في كثير من الأحيان ذات محتوى ثوري صريح، يدعو إلى إسقاط النظام، و”الموت للمرشد الأعلى!”.

رد الفعل الوحشي من جانب النظام لم يؤد فقط إلى المزيد من تجذر الشباب، بل أدى أيضا إلى تجذر المنظمات العمالية، حيث انخرط العديد منها في إضرابات. وتشمل القائمة سائقي الشاحنات ومجلس تنظيم الاحتجاجات لعمال عقود النفط، وعمال شركة هفت تابيه، وعمال شركة حافلات طهران، وتنسيقية المعلمين، وغيرهم.
تشكلت لجان شبابية ثورية في جميع أنحاء البلاد، وكانت هناك دعوات للإضراب العام، بدعم من المنظمات المذكورة أعلاه، فضلا عن النقابات المستقلة. وكانت هناك سلسلة من الإضرابات لأصحاب المتاجر الصغيرة، البازاريين، الذين كانوا في الماضي أحد أقوى أعمدة النظام. لكن العمال الصناعيين لم يتحركوا بطريقة حاسمة بعد، وكانت هذه هي نقطة ضعف الحركة.
كل هذا كان مشابها جدا للحركات التي حدثت قبل الانتفاضة الثورية لعام 1979. لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الحركة الحالية ستنتقل إلى مرحلة أعلى.
يبدي العمال تعاطفا وتأييدا كبيرين لتمرد الشباب، لكن إذا استمرت الانتفاضة مقتصرة على الشباب، فلن تنجح.
لا يمكن لحركة مثل هذه أن تبقى على حالها لفترة أطول دون أن تصل إلى النقطة الحرجة حيث إما أنها ستنجح في قلب النظام، أو أنها ستتعرض للهزيمة. وكما هو الحال في سريلانكا، فإن السؤال الأكثر أهمية هو العامل الذاتي، أي: القيادة الثورية.
العامل الذاتي
إن اشتداد الصراع الطبقي ينبع من هذا الوضع بنفس الحتمية التي يلي بها النهار الليل. لكن نتيجة الصراع الطبقي لا يمكن التنبؤ بها مسبقا، لأننا نتعامل مع صراع قوى حية.
وكما سبق لنا أن أوضحنا فإنه توجد العديد من التشابهات بين الحرب بين الطبقات والحرب بين الأمم. في كلتا الحالتين هناك عوامل موضوعية وذاتية متضمنة. وغالبا ما يلعب العامل الذاتي دورا حاسما.
نشير هنا إلى أشياء مثل الروح المعنوية والروح القتالية للقوات وقبل كل شيء كفاءة القيادة. تتميز المرحلة الحالية بأنها مرحلة صراعات طبقية وانتفاضات جماهيرية مكثفة. لكن ما ينقص هو القيادة الثورية.
العامل الذاتي مهم في الثورات مثلما هو مهم في أي حرب. كم مرة في تاريخ الحروب تعرضت قوة كبيرة من الجنود العازمين والشجعان للهزيمة بسبب قيادة من الضباط الجبناء وغير الأكفاء، عندما واجهتهم قوة أصغر بكثير من الجنود المحترفين المنضبطين والمدربين بقيادة ضباط جريئين وماهرين!
هذا هو العامل المفقود، أو شديد الضعف، في الوقت الحاضر. لقد تراجعت قوى الماركسية الحقيقية طيلة عقود من الزمن بسبب عوامل تاريخية لا مجال لشرحها هنا. ووصل انحطاط القادة الإصلاحيين والستالينيين السابقين إلى نقطة متدنية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي.
ولذلك فعلى الرغم من أنه يمكننا أن نتوقع بثقة تامة أن العمال سوف يثورون في كل مكان، بلدا تلو الآخر، فإنه لا يمكننا التعبير عن نفس الدرجة من الثقة فيما يتعلق بنتيجة تلك النضالات.
فشل اليسار
لنأخذ بعض الأمثلة، بدءا بساندرز في الولايات المتحدة وكوربين في بريطانيا. لقد كانا مرتبكين للغاية ومن الواضح أن لديهما العديد من القيود. وقد كان ذلك واضحا جدا للماركسيين منذ البداية. لكن الشيء الذي هو واضح لنا ليس بالضرورة واضحا للجماهير.
ومع ذلك فقد كان لكل منهما، من وجهة نظرنا، أهمية عرضية هائلة. لقد كشفا عن شيء مهم للغاية. لقد عمل كلاهما كمحفز أدى إلى صعود مزاج عميق من الاستياء تجاه النظام السياسي والمجتمع القائم، وهو المزاج الذي كان موجودا بين الجماهير، لكنه بقي كامنا فقط لأنه كان يفتقر إلى نقطة مرجعية.
كانت خطابات ساندرز وكوربين الراديكالية بمثابة مغناطيس قوي سمح للمشاعر الثورية العفوية والجنينية بالتعبير عن نفسها بطريقة منظمة. هذه حقيقة مهمة للغاية، ولها عواقب مهمة على المستقبل.
لقد طفت التساؤلات العامة حول النظام الرأسمالي إلى السطح، وعادت كلمة الاشتراكية إلى جدول الأعمال، وهو أمر إيجابي للغاية. ومع ذلك فقد اتضح، في التحليل النهائي، أنهما لم يكونا سوى شخصيتين عرضيتين اصطدمتا بالقيود الخاصة بهما وتحطمتا بفعلها. ونتيجة لذلك فقد خبت جذوة تلك الحركات الجماهيرية التي تحلقت حولهما.
يمكن للمرء أن يقول نفس الشيء عن هوغو شافيز، رغم أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، وأنجز أكثر من ذلك بكثير. والسؤال حول ما إذا كان سيتطور أكثر لو أنه لم يمت بشكل مبكر، هو سؤال لا يمكن الإجابة عليه أبدا. لكن وفي حالته أيضا، لعب الافتقار إلى الوضوح السياسي دورا قاتلا، كما أوضحت ذلك بجلاء التطورات اللاحقة التي عرفتها فنزويلا.

وتقدم تجربتا بوديموس في إسبانيا وسيريزا في اليونان مثالا أوضح على الدور الكارثي لما يسمى باليسار في السياسة. كلما اقترب هؤلاء القادة من السلطة، كلما أصبحوا أكثر خجلا وجبنا وخيانة.
إن خطابهم الراديكالي مجرد غطاء لحقيقة أنهم لا يشككون في وجود النظام الرأسمالي، وبالتالي فإنهم عندما يجدون أنفسهم في الحكومة، يكونون مجبرين على العمل على أساس قوانينه.
والنتيجة الحتمية هي الخيانة وإحباط معنويات قواعدهم. والاستنتاج بديهي: مع القيادة الحالية ستكون هناك هزيمة تلو أخرى.
لكن هذا ليس سوى جانب واحد من السيرورة. فتدريجيا سيتعلم العمال من هزائمهم، بدءا من الفئات الأكثر تقدما، وخاصة الشباب. وسيبدأون في فهم الدور الحقيقي للإصلاحية اليسارية وسيسعون لتجاوزها.
لقد شهدنا في العديد من البلدان الظهور العفوي لمجموعات من الشباب يطلقون على أنفسهم اسم شيوعيين. هذا تطور مهم للغاية، يجب أن ننتبه له بعناية.
أوجه التشابه والاختلاف
ستكون الظروف الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة أكثر شبها بثلاثينيات القرن الماضي من الظروف التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. لكن هناك اختلافات مهمة، وذلك أساسا لأن المعادلة الاجتماعية قد تغيرت.
القاعدة الاجتماعية للردة الرجعية صارت أضعف بكثير مما كانت عليه في ذلك الوقت، والوزن النوعي للطبقة العاملة صار أكبر بكثير. لقد اختفى الفلاحون إلى حد كبير في البلدان الرأسمالية المتقدمة، بينما صارت شرائح واسعة من الطبقة الوسطى السابقة (المهنيون، والعمال ذوو الياقات البيضاء، والمدرسون، وأساتذة الجامعات، والموظفون العموميون، والأطباء ، والممرضون) أكثر قربا من البروليتاريا وأصبحوا ينتمون للنقابات.
الطلاب، الذين وفروا في الماضي القوات الصدامية للفاشية، قد انعطفوا بشدة نحو اليسار وأصبحوا منفتحين على الأفكار الثورية. والشيء الأكثر أهمية هو أن الطبقة العاملة في معظم البلدان لم تتعرض لهزائم ساحقة منذ عقود. وقواتها سليمة إلى حد كبير.
وعلاوة على ذلك، فإن الطبقة السائدة قد أحرقت أصابعها بالفاشية في الماضي، وليس من المرجح أن تسلك ذلك الطريق بسهولة. ما نراه هو استقطاب سياسي متزايد، نحو اليمين ونحو اليسار أيضا. يوجد الكثير من الديماغوجيين اليمينيين في الساحة، بل إن بعضهم انتخب إلى السلطة. ومع ذلك فإن هذا ليس هو نفسه النظام الفاشي، الذي يقوم على التعبئة الجماهيرية للبرجوازية الصغيرة الغاضبة، والتي تستخدم كأداة لتدمير المنظمات العمالية.
هذا يعني أن الطبقة السائدة ستواجه صعوبات جدية عندما ستحاول دفع الأمور إلى الوراء واستعادة مكاسب الماضي. عمق الأزمة يعني أنه سيتعين عليهم محاولة تطبيق سياسات تقشف قاسية، لكن ذلك سيؤدي إلى حدوث انفجارات في جميع البلدان، واحدا تلو الأخرى.
النساء والشباب
من هذه الفوضى ينشأ مستوى جديد من الوعي. هناك شعور غريزي بين الناس العاديين، وخاصة الشباب والنساء، بأن “هناك شيئا سيئا في هذا المجتمع”، وأننا “نعيش في عالم غير عادل”.
وهذا، إلى حد ما، هو الحال مع العمال بشكل عام. لقد تمت ممارسة ضغوط قاسية على العمال لزيادة الكمية المنتجة وتقليل الوقت اللازم لإنتاجها. وقد تخلفت الأجور باستمرار عن مكاسب الإنتاجية. في أمريكا، استمرت الأجور الحقيقية حتى وقت قريب جامدة لمدة تقارب 40 عاما. ومع عودة التضخم المرتفع، عادت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة إلى الانخفاض مرة أخرى.
لكن الوضع أكثر وضوحا وأكثر حدة في حالة الشباب والنساء الذين يفرض عليهم أن يتحملوا وطأة أزمة الرأسمالية. إنهم أكثر فئات الطبقة العاملة تعرضا لاستغلال والاضطهاد.

وفي بلد تلو الآخر خرجت حشود كبيرة من النساء ضد حظر الإجهاض: من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بولندا الكاثوليكية وأيرلندا. كما شهدت الأرجنتين وتشيلي حركات جماهيرية من أجل حق الإجهاض. وفي المكسيك، حيث وصلت المعاملة اللاإنسانية والهمجية للنساء إلى مستويات كارثية، كانت هناك أيضا حركات ضخمة للاحتجاج على العنف ضد المرأة. وقد كان ذلك أيضا عاملا في التجذر السياسي في إسبانيا.
وفي هذا السياق، يمكن لأبسط الشعارات الديمقراطية أن تكتسب بسرعة مضمونا ثوريا بشكل صريح.
وقد كان أوضح تعبير عن تمرد النساء هو ذلك الذي شهدته إيران، حيث انتقلت حركة أعداد هائلة من الفتيات بسرعة من الاحتجاج ضد ارتداء الحجاب الإجباري إلى المطالبة بالإطاحة الثورية بنظام قمعي فظيع.
يشير ذلك إلى أن هناك بداية مستوى جديد تماما من الوعي. وفي ظل هذه الظروف هناك حساسية عميقة بين تلك الفئات ضد أي مظهر من مظاهر الظلم. وهذا يشمل مسألة العنصرية، كما رأينا في انتفاضة “حياة السود مهمة”.
يوجد الشباب في طليعة النضال في جميع البلدان. وهذا ليس من قبيل الصدفة. أظهرت الأحداث أن عددا متزايدا من الشباب على استعداد للخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد الرأسمالية.
عن الوعي مرة أخرى
سيكون من الخطأ الجوهري أن نفترض أن غالبية العمال يرون الأشياء بنفس الطريقة التي نراها بها. إن رؤية السيرورة التاريخية برمتها شيء، لكن مسألة كيف تفهم الجماهير هذه السيرورة شيء آخر، مختلف تماما.
يتأثر وعي الطبقة العاملة بقوة بالتغيرات في الوضع الموضوعي. وقد سبق لتروتسكي أن شرح هذا ببراعة في مقال هام بعنوان “المرحلة الثالثة لأخطاء الكومنترن”.
بالنسبة لبعض العصبويين هذه المسألة لا تطرح أصلا. فالطبقة العاملة، بالنسبة لهم، مستعدة دائما للثورة. ويعتبر هذا بالنسبة لهم ثابتا لا علاقة له بالتغيرات في الظروف الموضوعية. لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق.
سبق لتروتسكي أن انتقد بشدة الفكرة التي طرحها الستالينيون في “المرحلة الثالثة” سيئة السمعة، والتي ما يزال بعض اليساريين المتطرفين المجانين يكررونها اليوم، والتي تقول بأن الجماهير مستعدة دائما للثورة، وأن وحدها الأجهزة البيروقراطية المحافظة للحركة العمالية هي التي تمنعهم من ذلك.
لقد شن تروتسكي نقدا لاذعا على هذه الفكرة، ومن الجدير الاستشهاد بكلماته بإسهاب:
يتم تصوير تجذر الجماهير وكأنه سيرورة مستمرة: فالجماهير اليوم هي أكثر ثورية مما كانت عليه بالأمس، وستكون غدا أكثر ثورية مما هي عليه اليوم. لكن مثل هذه الفكرة الميكانيكية لا تتوافق مع السيرورة الحقيقية لتطور البروليتاريا أو المجتمع الرأسمالي ككل.
كانت الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وخاصة قبل الحرب، تتخيل المستقبل على أنه زيادة مستمرة في أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي ستنمو بشكل منهجي حتى لحظة الاستيلاء على السلطة. ما يزال هذا المنظور يحتفظ بقوته بشكل جوهري، بالنسبة للثوري المبتذل أو الزائف، الفرق الوحيد هو أنه بدلا من الحديث عن الزيادة المستمرة في عدد الأصوات، يتحدث عن التجذر المستمر للجماهير. هذا المفهوم الميكانيكي يقره أيضا برنامج بوخارين- ستالين للكومنترن.
غني عن الذكر أن تطور البروليتاريا، من وجهة نظر عصرنا ككل، يتقدم في اتجاه الثورة. لكن هذا ليس تطورا ثابتا، ولا يمثل أكثر من سيرورة موضوعية لتعمق التناقضات الرأسمالية. لا يرى الإصلاحيون سوى صعود الطريق الرأسمالي، بينما “الثوريون” الرسميون لا يرون سوى انحداره. لكن الماركسي يرى الطريق ككل، بكل فترات صعوده وانحداره الظرفية، دون أن يغفل ولو للحظة عن اتجاهه الرئيسي: كارثة الحروب وانفجار الثورات.
المزاج السياسي للبروليتاريا لا يتغير تلقائيا في نفس الاتجاه. ففترات نهوض الصراع الطبقي تليها فترات تراجعات، والمد يليه جزر، اعتمادا على مجموعات معقدة من الظروف المادية والأيديولوجية، الوطنية والعالمية. ونهوض الجماهير، إذا لم يتم استخدامه في اللحظة المناسبة أو تمت إساءة استخدامه، يتحول إلى العكس ويدخل في فترة من التراجع، التي تتعافى منها الجماهير، بشكل أسرع أو أبطأ، تحت تأثير محفزات موضوعية جديدة.
تتميز حقبتنا بتقلبات دورية حادة بشكل استثنائي، من خلال انعطافات في الوضع مفاجئة بشكل غير عادي، وهذا يضع على عاتق القيادة التزامات غير عادية فيما يتعلق بالتوجه الصحيح الذي يجب اتخاذه.
نشاط الجماهير، إذا فهمناه بشكل صحيح، يعبر عن نفسه بطرق مختلفة، حسب الظروف المختلفة. قد تنغمس الجماهير، في فترات معينة، بشكل كامل في النضالات الاقتصادية ولا تبدي اهتماما كبيرا بالمسائل السياسية. أو أنها، بعد سلسلة من الهزائم في النضالات الاقتصادية، قد تحول انتباهها فجأة إلى السياسة. وعند ذلك -واعتمادا على الظروف الملموسة وتجربتها السابقة- قد يسير نشاطها السياسي إما في اتجاه النضال البرلماني البحت أو في اتجاه النضال خارج البرلمان.
هذه السطور في غاية الأهمية لأنها تبين أنه من خلال التصريحات العامة عن طبيعة الحقبة من المستحيل استنتاج المستوى الذي يوجد فيه وعي البروليتاريا، أو الحركة الملموسة للطبقة العاملة. نرى هنا بوضوح شديد منهج تروتسكي، الذي لا ينطلق من الصيغ المجردة (“الحقبة الجديدة”) بل من الحقائق الملموسة.
تتضافر كل الأشياء لتشكيل وعي الجماهير في البلدان الرأسمالية المتقدمة، ليس فقط خلال الوضع الحالي، أو حتى خلال العقد الماضي، بل كذلك خلال الظروف التي نشأت على مدى العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. ينطبق هذا بشكل خاص على الجيل الأكبر سنا، بينما عقلية الشباب أمر مختلف. لكن هذا نقاش آخر.
لقد تشكل وعي العمال في أوروبا والولايات المتحدة على مدى عقود من خلال ما كان فترة ازدهار، نسبي على الأقل.
في 15 نوفمبر 1857، اشتكى إنجلز في رسالة إلى ماركس قائلا: «لابد أن الجماهير قد أصيبت بالخمول بعد هذا الازدهار الطويل». وأضاف: «إن الضغط المزمن ضروري لبعض الوقت من أجل تسخين الجماهير. عندئذ ستضرب البروليتاريا بشكل أفضل، وبوعي أفضل بقضيتها وبالمزيد من الوحدة …».
تتمتع الطبقة العاملة، بشكل عام، بقدرة هائلة على التحمل. سوف يتحملون حتى الظروف السيئة، لبعض الوقت، قبل أن يصبحوا غير قادرين على الاحتمال مطلقا. يستغرق الأمر وقتا حتى يتغير الكم إلى كيف. ويستغرق الوعي، الذي هو محافظ بطبيعته، وقتا ليواكب الواقع المتغير.
خلال فترة طويلة، كان معدل التضخم منخفضا، مما كان يعني أنه على الرغم من زيادة معدل الاستغلال، فإن أجور العمال كان بمقدورها أن تشتري أكثر من ذي قبل. كان العمال قادرين على شراء السيارات وأجهزة التلفزيون الكبيرة، وغيرها من السلع، التي انخفض سعرها نتيجة للتقدم التكنولوجي وارتفاع إنتاجية العمال.
كما أن انخفاض أسعار الفائدة أدى إلى توسع غير مسبوق في الاقتراض. فتمكن الملايين من الناس من شراء أشياء لا يستطيعون تحمل سعرها حقا إلا من خلال الانغماس أعمق فأعمق في لجة الديون.
عندما يرى المرء مدى سوء الأوضاع الآن، وينظر إلى الماضي، من السهل جدا أن يكون تصورا خاطئا عن أن الأمور كانت جيدة في الأيام الخوالي. لكن كل هذا مهدد الآن. وهذا ما بدأ في إحداث تغيير جوهري في الوعي.
السيرورة الجزيئية للثورة
تعتبر مسألة التضخم عنصرا أساسيا في تغيير موقف الجيل الأكبر سنا. فعلى الرغم من أن الشباب هم أكثر الفئات تجذرا وأكثر انفتاحا على الأفكار الثورية، فإن هناك مزاجا غاضبا متصاعدا يتطور بين جميع الفئات. وهؤلاء الناس الذين كانوا، حتى وقت قريب جدا، يعتقدون أن الأمور على ما يرام، وكانت حياتهم مستقرة ومنتظمة، صاروا يتعرضون الآن لصدمة حقيقية.
كل شيء يتحول إلى نقيضه. هناك الآن تدهور مفاجئ وحاد للغاية في ظروف الحياة، وهو ما يغير نظرة الناس. فجأة صار الجميع يشتكون. حيث لم تعد أجرتهم تكفيهم حتى نهاية الشهر.
في الغرب سابقا، كان أرباب العمل وزعماء النقابات يبرمون صفقات بزيادات سنوية في الأجور، بنسبة واحد أو اثنين في المائة، والتي كانت بالكاد تتماشى مع التضخم، ويفرضونها على العمال. لكن اليوم من شأن مثل تلك الصفقات أن تعني انخفاضات كبيرة في الأجور الحقيقية. لقد صار من الواضح بالنسبة لعدد متزايد من العمال أنه للحفاظ فقط على مستوى معيشتهم، يتعين عليهم التنظيم والنضال. في كل مكان هناك ارتفاع ملحوظ في النضالات النقابية، التي تنتهي غالبا بانتصار العمال.

في بريطانيا شارك مئات الآلاف من عمال العديد من القطاعات في حركة الإضرابات. لقد شهدنا إضرابات عامة في اليونان وبلجيكا وفرنسا. وفي الولايات المتحدة، يناضل عمال ستاربكس وأبل وأمازون، من أجل تكوين نقابات، وبدأوا في خوض نضالات نقابية، كما شهدنا أيضا تحرك عمال السكك الحديدية. وأخيرا رأينا في كندا أيضا كيف أدت هجمات دوج فورد ضد عمال قطاع التعليم، في أونتاريو، إلى اندلاع إضراب غير رسمي، وتلويح قادة النقابات بخوض إضراب عام مما ألحق الهزيمة بتشريع العودة إلى العمل، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ كندا. لقد بدأت الطبقة العاملة، في كل مكان، في الاستيقاظ تحت تأثير أزمة غلاء المعيشة.
للتضخم تأثير هائل أيضا على المقاولات الصغيرة، التي تجد الكثير منها نفسها في مواجهة الإفلاس، كما يؤثر على كبار السن الذين يرون قيمة معاشاتهم التقاعدية تتآكل يوما بعد يوم. وقد كانت هناك بالفعل مظاهرات حاشدة للمتقاعدين في إسبانيا. وجزء كبير من التقلبات الاجتماعية التي نراها في بلدان مثل إيطاليا هي ظاهرة وثيقة الصلة بذلك.
هناك شعور عام بانعدام الأمان والخوف من المستقبل مما يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وهذا يعرض الطبقة الرأسمالية لمخاطر كبيرة، وهو ما يفسر سبب اضطرارهم إلى اتخاذ إجراءات شديدة الخطورة في محاولة منهم لمنع التطورات الثورية.
عندما يبدأ الناس، الذين لم يسبق لهم أن أبدوا أي اهتمام بالسياسة، فجأة في الحديث عن السياسة في محطات الحافلات أو في الأسواق، فإن هذه هي بداية ما أطلق عليه تروتسكي اسم السيرورة الجزيئية للثورة.
صحيح أنهم يفتقرون إلى التحليل العلمي الدقيق الذي يمتلكه الماركسيون. فهمهم للسياسة سطحي وخام وبسيط. لكنه مدفوع بإحساس عميق بالظلم، وشعور بأن هناك شيئا ما لا يعمل في المجتمع، وأن شيئا ما يجب أن يتغير.
إنه وعي طبقي أولي يمثل بداية تشكل جنين الوعي الثوري. أهم عنصر في هذا هو التغير الاقتصادي، لكنه ليس العامل الوحيد.
الكارثة البيئية
النظام الرأسمالي يقود العالم نحو كارثة بيئية تلوح الآن أمام أعين كثير من الناس. وهي بالنسبة للبعض مشكلة وجودية بالفعل. وبالنسبة لأمم بأكملها، فإن مستقبلها نفسه صار في خطر.
فمن ناحية هناك مشكلة الجفاف وجفاف الأنهار، التي لها تأثير مدمر على المحاصيل وإنتاج الغذاء، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ومن ناحية أخرى هناك عواصف وأعاصير مدمرة وفيضانات رهيبة، كما رأينا في بلدان مثل بنغلاديش وباكستان، حيث تضرر 33 مليون شخص بشكل مباشر.
وفي بلدان مثل الصومال، نفق أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية، مما أدى إلى تدمير سبل عيش الملايين من الناس. في البرازيل وصل التدمير الإجرامي لغابة الأمازون إلى مستويات قياسية. لقد تمت تعرية حوالي 3988 كيلومترا مربعا (1540 ميلا مربعا) من الأراضي في المنطقة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2022. وتم تدمير 3088 كيلومترا مربعا من الغابات المطيرة خلال نفس الفترة.
وتوجد في البلدان الرأسمالية المتقدمة أيضا، أدلة واضحة على ظروف مناخية أكثر قسوة. حيث يعيش الكثير من الناس في خوف دائم من أن تتعرض منازلهم للغمر أو أن يتم جرفها.
يتعرض هواء المدن الكبرى للتلوث بالغازات السامة، وتختنق الأنهار بالنفايات الكيماوية من المصانع والمزارع والنفايات البشرية، وتتلوث المحيطات بأطنان لا نهاية لها من البلاستيك والفضلات الأخرى.
البحث عن المعادن في أعماق البحار، الذي كان يوما ما يقتصر على الخيال العلمي، أصبح الآن حقيقة واقعة، مع عواقب وخيمة يمكن التنبؤ بها على التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي للكوكب. وقد بلغ معدل انقراض الأنواع النباتية والحيوانية في جميع البلدان مستويات تنذر بالخطر.
كل هذه الأشياء تستفز ضمير الملايين، وخاصة الشباب. لكن السخط الأخلاقي والتظاهرات الغاضبة ليست كافية على الإطلاق لأنه دون التشخيص الصحيح، من المستحيل تقديم أي حل.
لقد توصل البرجوازيون بشكل متأخر إلى استنتاج مفاده أنه يجب القيام بشيء ما. لكن في ظل الرأسمالية، كل شيء يخضع لدافع الربح ومصالح الشركات الاحتكارية. وعلى سبيل المثال فإنهم يخفون السياسات الرامية إلى حماية الصناعة الأميركية أو الأوروبية من السلع القادمة من بلدان ذات تشريعات بيئية “أقل صرامة” (الصين في المقام الأول) باستخدام خطاب صديق للبيئة.
تحاول جميع سياساتهم، في الأساس، تحميل فاتورة الأزمة البيئية على عاتق الطبقة العاملة وأفقر شرائح المجتمع. وبينما تستمر شركات الطاقة المتعددة الجنسيات في تحقيق أرباح قياسية، ستضطر عائلات الطبقة العاملة إلى دفع أسعار أعلى للوقود، وكذلك دفع تكاليف استبدال سياراتها وأجهزة التسخين. كما سيتعين عليها، في الوقت نفسه، أن تدفع ثمن الإعانات السخية للشركات الكبرى من خلال زيادة الضرائب.
ونتيجة لذلك، يمكن أن يصبح “النضال ضد تغير المناخ” في نظر قسم من الطبقة العاملة مرتبطا بشكل متزايد بالتقشف الرأسمالي وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. وهذا من شأنه أن يصب في مصلحة تلك القوى الرجعية التي تنكر وجود الانحباس الحراري العالمي الناتج عن الأنشطة البشرية وتروج للوقود الأحفوري. للنضال ضد هذا لا بد من سياسة ثورية.
إن الكارثة البيئية هي نتيجة واضحة لجنون اقتصاد السوق. يجب التأكيد على أن وجود الرأسمالية يمثل الآن تهديدا واضحا وراهنيا لمستقبل الحضارة الإنسانية.
إذا اقتصرت الحركة البيئية على الشعارات الفارغة، فإنها ستحكم على نفسها بالعجز. إن الطريقة الوحيدة أمامها لكي تنجح في تحقيق أهدافها هي أن تتخذ موقفا ثوريا واضحا لا لبس فيه ضد الرأسمالية. يجب أن نسعى للوصول إلى أفضل العناصر من بين هؤلاء الشباب وإقناعهم بهذه الحقيقة.
دور الماركسيين
لن يكون للأزمة الحالية حل سريع وذلك أساسا نتيجة لضعف العامل الذاتي. هذا التأخير مفيد للماركسيين، لأنه سيمنحنا الوقت الذي نحتاجه لتطوير قوانا وبناء قاعدة صلبة داخل الطبقة العاملة والمنظمات العمالية.
سوف تكون الأزمة طويلة الأمد، وسوف تكون هناك العديد من موجات المد والجزر للصراع الطبقي. فترات الابتهاج ستتبعها فترات أخرى من التعب والخمول وحتى اليأس. لكن في كل مرة سوف تعود الطبقة العاملة دائما للنهوض، مستعدة لتجديد النضال، ليس لأسباب سحرية، بل فقط لأنه لا يوجد لديها بديل آخر سوى النضال.
إن الطبقة العاملة ككل لا تتعلم من الكتب، بل من التجربة. لكنها تتعلم، من الهزائم والنكسات وكذلك من الانتصارات. وهي تتعلم الآن عن حدود الإصلاحية اليسارية. قال إنجلز ذات مرة إن الجيوش المنهزمة تتعلم دروسها بشكل أفضل، وهي الكلمات التي علق عليها لينين قائلا: «تنطبق هذه الكلمات الرائعة بدرجة أكبر على الجيوش الثورية».
لكن هذا مسار تعلمي طويل جدا وستكون هناك حاجة إلى العديد من التجارب المستقبلية قبل أن تتخلص الطبقة العاملة أخيرا من أوهامها في الإصلاحيين (خاصةً أصحاب القناع “اليساري”) وتفهم الحاجة إلى ثورة اجتماعية كاملة.
مهمتنا ليست هي أن نلقي المحاضرات على الطبقة العاملة من الخارج، بل أن نشارك بنشاط في الصراع الطبقي. إنها مهمة الماركسيين أن يمروا بهذه السيرورة إلى جانب الطبقة العاملة، وأن يناضلوا جنبا إلى جنب مع العمال، وبالتالي كسب احترامهم وثقتهم.
ومع ذلك، فإنه إذا كان هذا هو المحتوى الوحيد لنشاطنا، فسنكون مجرد نشطاء ولن يكون لدينا أي مبرر لكي نوجد باعتبارنا تيارا مستقلا داخل الحركة العمالية.

إن أهم دور لنا هو مساعدة العمال والشباب، بدءا من الفئة الأكثر تقدما، على استخلاص الدروس الضرورية من تجربتهم، ونظهر في الممارسة تفوق الأفكار الماركسية.
سيستغرق هذا بعض الوقت، ويجب علينا أن نتعلم فضائل الصبر الثوري. ليس هناك من طريق سهل. إن البحث عن طرق مختصرة ينتهي دائما بانحرافات خطيرة، إما من النوع الانتهازي أو اليساري المتطرف.
علينا أن نتذكر أن لينين، في عام 1917، وفي خضم الثورة، طرح شعار: “اشرح بصبر!”. لدينا الأفكار الصحيحة، والتي وحدها القادرة على أن تحدد طريق النصر في الصراع الطبقي.
لا يمكن التنبؤ بالإيقاع الفعلي للأحداث. لكن احتمال اشتداد الصراع الطبقي بشكل متفجر هو احتمال موجود في العديد من البلدان. لا يمكننا القول من أين سيبدأ. قد تكون فرنسا أو إيطاليا أو إيران أو البرازيل؛ أو قد تكون إندونيسيا أو باكستان أو الأرجنتين، أو حتى الصين.
سنرى ذلك. لكن الشيء الرئيسي هو أنها ستفتح إمكانيات جديدة أمام التيار الماركسي، بشرط أن نكون قادرين على الاستفادة منها. وهذا يعتمد على شيء واحد فقط، وهو: قدرتنا على تنمية قواتنا إلى النقطة الحاسمة بحيث نصير قادرين على التدخل في الأحداث فعليا.
وهذا بدوره يعتمد على العمل الذي نقوم به الآن. هذا ما يجب علينا أن نشرحه لكل رفيق وكل رفيقة. يجب أن يكون شعارنا هو: كل القوى في نقطة الهجوم. وهذا يعني على وجه التحديد: بناء قواتنا.
يجب علينا أن نعمل بلا كلل على بناء القوى المطلوبة لنقل هذه الأفكار إلى كل مصنع وكل فرع نقابي وكل مدرسة وكل جامعة. بهذه الطريقة فقط سيمكن بناء القيادة الثورية المستقبلية للبروليتاريا.
لقد بقينا لمدة طويلة نحارب ضد التيار. تقوت كوادرنا وتصلبت في ذلك النضال. لقد كسبنا احترام العمال والشباب الأكثر تقدما. ولم يكن النفوذ السياسي والمعنوي لأمميتنا في أي وقت مضى أعلى مما هو عليه الآن.
هذه مكاسب عظيمة! لكن ما يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. إنه طريق طويل وشاق، ولن يكون كله معبدا. لحظات الابتهاج ستتبعها لحظات أخرى من الإحباط وحتى اليأس. يجب علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الصعوبات وأن نقبل الهزائم مثلما نقبل النجاحات بنفس رباطة الجأش.
لكن تيار التاريخ قد انقلب، وقد بدأنا الآن في السباحة مع التيار، وليس عكسه. إن العمال والشباب صاروا منفتحين على أفكارنا أكثر من أي وقت مضى. وسيتم تسريع السيرورة برمتها.
ستسنح لأمميتنا فرص هائلة في وقت أقرب بكثير مما قد يتوقعه المرء. ستنفتح أمامنا العديد من الأبواب. والأمر متروك لنا لضمان الاستفادة الكاملة من كل الفرص، وإعطاء الدليل على أننا في حجم المهام العظيمة التي يطرحها التاريخ على كاهلنا.
التيار الماركسي الأممي
26 يوليو/تموز 2023
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية



2 تعليقات
تعقيبات: خطاب آلان وودز حول المنظورات العالمية: الأزمة والصراع الطبقي ومهام الشيوعيين – ماركسي
تعقيبات: رئاسة ترامب تخلق اضطرابات هائلة في جميع أنحاء العالم – ماركسي