ننشر فيما يلي النص الكامل لوثيقة المنظورات العالمية كما تمت المصادقة عليها في المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأممي هذا الصيف. الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة هو تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسية في عالم اليوم، ووضع منظور للصراع الطبقي في الفترة المقبلة، ليكون بمثابة مرشد عمل لتدخل الماركسيين على الصعيد الأممي.
بدء عام 2016 بحدوث انخفاضات حادة في سوق الأسهم في الصين والتي اجتاحت جميع أنحاء العالم، مما يعكس مزاج الذعر السائد بين المستثمرين. يعبر هذا القلق عن وجود مخاوف لدى البرجوازية من أن العالم يتجه نحو ركود جديد. إن تاريخ الرأسمالية هو تاريخ موجات الازدهار والركود، وسوف تستمر هذه الدورة حتى يتم القضاء على الرأسمالية، تماما مثلما يستمر الشخص في الشهيق والزفير حتى وفاته. ومع ذلك فبالإضافة إلى هذه الأحداث، يمكن للمرء أن يميز فترات أطول ومنحنيات التطور والتراجع. لكل فترة مميزاتها المختلفة التي لها تأثير حاسم على الصراع الطبقي.
حاول البعض، مثل كوندراتييف[1] ومقلديه المعاصرين، أن يشرحوا ذلك بطريقة ميكانيكية. وقد أصبحت أفكار كوندراتييف على الموضة هذه الأيام، لأنها تفترض أن كل انخفاض ستعقبه حتما فترة طويلة من الصعود. تقدم هذه الفكرة جرعة من الثقة للاقتصاديين البرجوازيين الذين هم في أشد الحاجة إليها والذين يعتصرون أدمغتهم في محاولة لفهم طبيعة الأزمة وإيجاد مخرج منها.
يتميز الوضع العالمي الحالي بالأزمة على جميع المستويات: الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية. إن السبب الرئيسي للأزمة هو عدم قدرة الرأسمالية على تطوير القوى المنتجة على المستوى العالمي. وتعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه لن يكون هناك أي نمو حقيقي على مدى الخمسين عاما المقبلة على الأقل. سوف تستمر دورة النمو والركود، إلا أن الاتجاه العام سيكون نحو الأسفل. وهذا يعني أن الجماهير ستواجه عقودا من ركود مستويات المعيشة أو انخفاضها وسيكون الوضع أكتر سوءا في ما يسمى بالبلدان النامية. هذه هي الوصفة المناسبة لاحتداد الصراع الطبقي في كل مكان.
ركود جديد يلوح في الأفق
يتوصل المنظرون الإستراتيجيون للرأسمال الأكثر جدية إلى نفس الخلاصات التي يتوصل إليها الماركسيون، ولو أنهم يقومون بذلك ببعض التأخير، ومن وجهة نظر مصالح طبقتهم. إن تشاؤم الاقتصاديين البرجوازيين يظهر في توقعاتهم بفترة من “الكساد طويل الأمد”. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت أسوء من الأزمات السابقة، ويحذر من أنه على معظم الاقتصادات الرائدة في العالم أن تستعد لفترة طويلة من انخفاض معدلات النمو.
تقارير صندوق النقد الدولي مليئة بالكآبة، وقد خفض توقعاته مرارا. بالنسبة إلى توقعات عام 2012 ، راجع صندوق النقد الدولي تقديراته لمستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2020 بنسبة 6% وبنسبة 3% لأوروبا و14% للصين وبنسبة 10% للأسواق الصاعدة و 6% بالنسبة للعالم ككل. ولم يتجاوز النمو في البلدان الصناعية 2% على مدى السنوات الأربع الماضية.
وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي يقدر نمو الناتج المحتمل في البلدان الرأسمالية المتقدمة بمعدل 1,6% سنويا بين عامي 2015 و 2020. وهذا معدل أعلى قليلا من النمو الذي تحقق في السنوات السبع الماضية، لكنه أقل بكثير من معدلات النمو التي كانت قبل الركود، عندما كان نمو الناتج المحتمل عند 2,25% في السنة، والذي يعتبر هو بدوره معدلا بائسا بالمقارنة مع الإمكانات الهائلة للصناعة الحديثة والعلوم والتكنولوجيا. لكن الاقتصاد الآن بالكاد يزحف وبالتالي فإن حتى هذا التوقع يبقى غير مؤكد.
وعلى حد قول رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، «آفاق النمو على المدى المتوسط أصبحت أضعف. إن خطر النمو “العادي مجددا” [”new mediocre”] الذي حذرت منه قبل سنة بالضبط – أي خطر انخفاض النمو لفترة طويلة- صار يبدو أقرب […] وتستمر الديون المرتفعة وانخفاض الاستثمار وضعف البنوك، تشكل عبئا لبعض الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في أوروبا؛ وتواصل العديد من الاقتصاديات الصاعدة القيام بالتقويمات بعد ازدهار القروض والاستثمار لما بعد الأزمة».
حذرت لاغارد من أن التباطؤ الذي تعرفه الصين ستكون له آثار وخيمة على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني على المواد الخام. وقالت إن هناك إمكانية لفترة طويلة من انخفاض أسعار السلع الأساسية، ولا سيما في كبريات البلدان المصدرة للسلع. واشتكت من أن انخفاض الإنتاجية يكبح النمو. لكن هذا تفسير لا يفسر شيئا.
وتحذر لاغارد قائلة: «إن المخاطر تتزايد، ونحن في حاجة إلى وصفة جديدة». إلا أنها لسوء الحظ لم تخبرنا بطبيعة تلك الوصفة الجديدة. لكن صندوق النقد الدولي يمتلك كتاب طبخ مفتوحا على صفحة تتضمن وصفة قديمة جدا: يدعو السياسيين في “الأسواق الصاعدة” إلى “تنفيذ إصلاحات هيكلية”، أي إلى فتح أسواقها لتنهب من قبل الرأسماليين الأجانب وخصخصة القطاع العام وجعل أسواق العمل أكثر “مرونة”، أي: اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الهجمات على مناصب الشغل والأجور وظروف العيش.
نجد في قلب الأزمة حقيقة أن الاستثمار المنتج – الذي هو مفتاح أي ازدهار – آخذ في الانخفاض. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق الاستثماري دون مستويات ما قبل الأزمة حتى إذا استمر الانتعاش الاقتصادي البطيء الحالي. إن ما يعنيه هذا هو أن النظام الرأسمالي قد وصل إلى أقصى حدوده على الصعيد العالمي، بل إنه في واقع الأمر قد تجاوز تلك الحدود. ويجد هذا الواقع التعبير عنه في جبل الديون المتراكمة الموروثة من الفترة الماضية. لعدة سنوات استثمرت الشركات متعددة الجنسيات بكثافة في “الاقتصادات الصاعدة”، لكن تلك الاقتصادات بدأت الآن في التباطؤ، نظرا لفائض الإنتاج الذي يؤثر على اقتصاداتها.
لقد فقد الرأسماليون الثقة في النظام. إنهم يجلسون على أكوام من تريليونات الدولارات. ما الذي سيدفعهم للاستثمار لتعزيز الإنتاج في الوقت الذي لا يتمكنون فيه حتى من استخدام القدرة الإنتاجية التي يمتلكونها بالفعل؟ انخفاض الاستثمار يعني أيضا ركود إنتاجية العمل. تنمو الإنتاجية في الولايات المتحدة بنسبة بائسة قدرها 0,6% سنويا. لا يستثمر الرأسماليون إلا من أجل الربح، لكن هذا يفترض أن هناك أسواق لبيع منتجاتهم. إن السبب الأساسي في أنهم لا يستثمرون بما فيه الكفاية لتطوير الإنتاجية هو أن هناك أزمة فائض الإنتاج على الصعيد العالمي.
وبدلا من الاستثمار في إنشاء مصانع جديدة وآلات وتكنولوجيا جديدة، يحاولون زيادة هوامش الربح عن طريق خفض الأجور الحقيقية في سباق نحو القاع في كل مكان. لكن هذا لا يؤدي إلا إلى مفاقمة التناقض عن طريق الحد من الطلب وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من تراجع الاستثمار.
إن انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات الفائدة، وهو الشيء الذي من المفترض أن يكون خبرا سارا في الأوقات العادية، أصبح الآن خطرا قاتلا. إنه انعكاس للركود الاقتصادي وانخفاض الطلب. لقد استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض على مدى العقد الماضي، وقد وصلت الآن إلى القاع، بل بدأت تتحول إلى معدلات سلبية. ووفقا لأندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، هذه أدنى معدلات فائدة تم تسجيلها خلال 5000 سنة.
ينضاف انخفاض النمو وانخفاض التضخم ومعدلات فائدة تقارب الصفر إلى ما يسميه الاقتصاديون البرجوازيون بالركود الطويل الأمد. إن المحرك الاقتصادي في الدول الصناعية بالكاد يعمل. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر لفترة طويلة. ووفقا للمنظرين الاستراتيجيين للرأسمال تعتبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي الآن أشد مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ إفلاس بنك ليمان براذرز في عام 2008.
وقد أعرب آندي هالدين عن مخاوف البرجوازية بشكل جيد في خطاب ألقاه في شتنبر 2015، حيث حذر من أن: «الأحداث الأخيرة تمثل آخر جزء في ما يمكن تسميته بأزمة ثلاثية الأجزاء. كان الجزء الأول من هذه الثلاثية هو الأزمة “الأنجلوسكسونية” خلال 2008- 2009. وكان الجزء الثاني هو أزمة “منطقة اليورو” خلال 2011- 2012. ويمكن أن نكون الآن على مشارف الجزء الثالث من الثلاثية، أي أزمة “الأسواق الصاعدة” في عام 2015 وما بعدها».
المشكلة بالنسبة للبرجوازية الآن هي أنها قد استخدمت بالفعل الآليات التي تحتاج إليها للخروج من الركود أو تقليل أثره. وعند حدوث الركود المقبل (وهو الشيء الحتمي) ستجد نفسها بدون الأدوات اللازمة للرد. إن أسعار الفائدة منخفضة جدا والمستويات العالية من الديون تمنع من حقن مزيد من الأموال العمومية. “إن وسائل التعامل مع مثل هذه الحالة ليست متاحة بسهولة”، كما قال مارتن وولف[2] بخجل.
الدين العام وبلدان بريكس [3]
لقد ارتفع الدين العام بشكل فعلي منذ بداية الأزمة، ولم تظهر بوادر الشفاء المالي المأمولة سوى في بضعة أجزاء متناثرة من الاقتصاد العالمي. لقد وصل الدين معدلات لم يسبق له أن وصلهاإلا في زمن الحرب، لكنه لم يسبق له أن وصل هذه المستويات في زمن السلم، أما ديون الأسر والشركات فلم يسبق لها أبدا أن وصلت إلى هذه المستويات على الإطلاق. قبل الأزمة كانت الديون ترتفع في كل مكان، وصلت في الولايات المتحدة إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 ونحو 200% تقريبا في بريطانيا. في البرتغال وصلت الديون إلى 226,7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2009. وفي عام 2013 كانت ما تزال عند مستوى 220,4%. أما في الوقت الحاضر فقد وصل مجموع الديون في الولايات المتحدة 269% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو المعدل الذي لم يسبق لها أن بلغته إلا مرة واحدة فقط في تاريخها، وكان ذلك حوالي 1933 عندما وصل إلى 258%، وبعد ذلك تراجع بسرعة إلى 180%.
كان هدف سياسة التقشف هو خفض حجم الديون، ولا سيما الديون العمومية. لكن الأرقام تظهر أن هذا أبعد ما يكون عن التحقق. في تقرير لمعهد ماكينزي العالمي، فبراير 2015، نجد أن الدين العالمي قد زاد بنسبة 57 تريليون دولار منذ عام 2007، أو من 269% من الناتج العالمي الإجمالي إلى 286%. يحدث هذا في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي، لكن على وجه الخصوص مع الدين الحكومي، والذي يرتفع بنسبة 9,3% سنويا. هذا الارتفاع في مستويات الديون يحدث أيضا في كل بلد على حدة. فقط عدد قليل من البلدان، التي تعتمد على الصين أو على النفط، هي من تمكنت من خفض مستويات ديونها، لكن هذا وصل إلى نهاية مفاجئة في العامين الماضيين. يشكل هذا الجبل الهائل من الديون عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي، ويخنق الطلب ويؤدي إلى هبوط الإنتاج.
كل اقتصادات ما يسمى ببلدان بريكس في أزمة: تواجه البرازيل والهند وروسيا الصعوبات. بل إن البرازيل وروسيا في الواقع تعيشان الركود. إن التباطؤ الذي تعرفه ما يسمى بالأسواق الصاعدة أكثر حدة مما هو عليه في البلدان الرأسمالية المتقدمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحتمل، الذي استمر في النمو خلال الفترة التي سبقت الأزمة، سينخفض من 6,5% سنويا، التي كان يسجلها بين عامي 2008 و 2014، إلى 5,2% في السنوات الخمس المقبلة.
لقد كان نمو هذه الاقتصادات واحدا من العوامل الرئيسية التي حالت دون أن تتطور أزمة عام 2008 إلى ركود عميق للاقتصاد العالمي. على مدى السنوات الخمس الماضية سجلت ما يسمى بالأسواق الصاعدة 80% من النمو العالمي. لقد لعبت هذه الأسواق، وخاصة الصين، دور قاطرة للاقتصاد العالمي قبل وبعد الركود. وكانت مجالا هاما للاستثمارات في السابق، عندما كانت المنافذ المربحة نادرة في الغرب.
لكن كل ذلك تحول الآن إلى نقيضه. فبدل كونها أحد العوامل التي تدعم الرأسمالية العالمية أصبحت الآن الخطر الرئيسي الذي يهدد بسحب الاقتصاد العالمي كله إلى أسفل. ليست الاقتصاديات المتقدمة تقليديا هي وحدها من تشهد ارتفاع الديون بشكل كبير، بل حتى ديون ما يسمى بالأسواق الصاعدة قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. تبين الدراسة التي قام بها معهد ماكينزي أن إجمالي ديون “الأسواق الصاعدة” ارتفع إلى 49 تريليون دولار في نهاية عام 2013، وهو ما يمثل 47% من نمو الديون العالمية منذ عام 2007. وهذا أكثر من ضعف حصتها من نمو الديون بين عامي 2000 و2007.
وفقا لصندوق النقد الدولي شهد إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية لدى “الأسواق الصاعدة” في عام 2014 (وهو مؤشر رئيسي لتدفقات رأس المال) أول تراجع سنوي له منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 1995. تشبه تدفقات الرأسمال هذه تدفق الدم لشخص في حاجة إلى نقل الدم. ودون التدفق المستمر للرساميل لن تجد ما تسمى بالاقتصادات الصاعدة المال لدفع ديونها وتمويل عجزها، مع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في الإنتاج.
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن المركز الدولي للدراسات النقدية والمصرفية (ICMBS) ما يلي:
«منذ ذلك الحين [2008]، كان العالم النامي، وخاصة الصين، هو من يعرف أكبر زيادة في الديون. في حالة الصين، يصف التقرير ارتفاع الدين بأنه ‘هائل’، وباستثناء الشركات المالية فقد ارتفعت الديون بنسبة 72 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى أعلى بكثير من أي اقتصاد صاعد آخر. ويقول التقرير إن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الديون في تركيا والأرجنتين وتايلاند أيضا.

«الاقتصادات الصاعدة مثيرة بشكل خاص لقلق مؤلفي التقرير: “يمكنها أن تكون في بؤرة الأزمة المقبلة. وعلى الرغم من أن مستوى الاقتراض هو أعلى في الأسواق المتقدمة، فإن سرعة سيرورة الاقتراض الأخيرة في الاقتصادات الصاعدة، وخصوصا في آسيا، هي في الواقع مصدر قلق متزايد”».
بعض أهم تدفقات رأس المال تصدر عن البلدان التي راكمت ديونا أسرع. فكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، شهدت ديونها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 45 نقطة مئوية بين عامي 2007 و2013، في حين شهدت الصين وماليزيا وتايلاند وتايوان ارتفاع ديونها بـ 83 و49 و43 و16 نقطة مئوية على التوالي.
تعرف هذه الاقتصادات بدورها تباطؤا في النمو أو هي في حالة ركود، مما يحضر لحدوث ركود عالمي عميق في الفترة المقبلة.
مشاكل الصين
الأخطر من ذلك كله هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا حادا. إن التباطؤ الذي تعرفه “الاقتصادات الصاعدة” يرجع، من جهة إلى الركود المطول في الطلب في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، ومن جهة أخرى إلى تراجع الاقتصاد الصيني. وسيترجم هذا السيناريو في تراجع أكبر للتجارة العالمية. كل شيء مترابط بشكل جدلي، بحيث أن ضعف الطلب والأسواق يؤدي إلى ضعف الإنتاج والاستثمار، وضعف الاستثمار يؤدي إلى ضعف الانتعاش وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف الطلب.
يعود النمو الهائل للصناعة في الصين إلى أنها استثمرت بشكل ملموس، ما بين 2010 و2013، أكثر مما فعلت الولايات المتحدة طيلة القرن العشرين. لكن القدرة الإنتاجية الضخمة للصناعة الصينية لا توازيها زيادة مقابلة في الطلب العالمي، والنتيجة الحتمية هي أزمة فائض الإنتاج.
إلى حدود عام 2007، كان الطلب العالمي يتطور من خلال القروض وبناء المنازل، وخاصة في الولايات المتحدة وإسبانيا. وقد انهار هذا وصار الطلب رهينا بالصين التي ضخت مليارات الدولارات في البنية التحتية والقروض المصرفية. استثمرت أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى إلى تطوير قوى الإنتاج ورفع الطلب على المواد الخام، كما أنها طورت أيضا فائضا ضخما من الطاقة الإنتاجية.
انفجار الفقاعة في الغرب، بدءا من عام 2008، دفع بالدولة الصينية إلى ضخ كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد، وهذا بدوره أدى إلى تضخم فقاعة مضاربة هائلة وتراكم هائل للديون على كافة مستويات الاقتصاد الصيني. وهذه الفقاعة في طريقها للانفجار، مع عواقب بعيدة المدى. تسير الصين في نفس الطريق الذي سبق لليابان أن سارت فيه، أي طريق الركود طويل الأمد. يعني التباطؤ في الصين بدوره انهيار أسعار السلع الأساسية، وهو ما أضر كثيرا “بالاقتصادات الصاعدة”. والأهم من ذلك تمثل الصين 16% من الناتج العالمي و 30% من النمو العالمي، وبالتالي عندما تتباطأ الصين سيتباطأ العالم بأسره.
فائض الإنتاج في الصين يؤثر في صناعة الصلب والسلع الأخرى. هناك تراكم هائل للديون، وهناك مخاوف من انهيار سوق العقارات المحموم. أكثر من 1000 منجم لخام الحديد على وشك الانهيار المالي. وتتوقع صحيفة فاينانشال تايمز أنه: «يمكن للصين، على وجه الخصوص، أن تشهد انكماشا حادا في نمو الناتج المحتمل، بينما هي تحاول إعادة موازنة اقتصادها بعيدا عن الاستثمار نحو الاستهلاك».
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، لسفير الولايات المتحدة إنه يعتمد على ثلاثة مؤشرات للحكم على النمو الاقتصادي وهي: استهلاك الكهرباء وكميات البضائع المنقولة بالسكك الحديدية والإقراض المصرفي. على هذا الأساس جمع الاقتصاديون “مؤشر الزخم الصيني” من المؤشرات الثلاث. ويظهر المؤشر أن الوتيرة الفعلية للنمو يمكن أن تكون منخفضة إلى 2,4%. فقد تراجع حجم الشحن بالسكك الحديدية بشكل حاد وانخفض استهلاك الكهرباء بشكل كبير. ونتيجة لتراجع النمو خفضت الصين أسعار الفائدة ست مرات في الأشهر الاثني عشر الماضية. كما أنها خفضت أيضا قيمة عملتها لإنعاش الصادرات، مما يزيد من حدة الصراع مع الولايات المتحدة ويخلق حالة عدم استقرار واسع النطاق في كل مكان.
تراجع النمو في الصين ضرب بقوة الاقتصادات التي تعتمد على تصدير السلع، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الصين. تظهر المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني داخل الصين نفسها، وخصوصا في انهيار سوق الأسهم. تدخلت السلطات بضخ مبلغ 200 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنها استسلمت في النهاية. لقد استولت حالة من الذعر على المستثمرين. وقال تاو ران، أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين: «إذا لم نقم بالإصلاح، فإن الاقتصاد الصيني يمكن أن يتباطأ نحو الانهيار. وسيضيع كل ما حققناه خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية».
قامت دائرة الأبحاث في دايوا (Daiwa)، التي هي ثاني أكبر شركة وساطة في اليابان، بما لم يقم به أحد من قبل وأصدرت تقريرا كان أفضل سيناريوهاته هو “انهيار” مالي عالمي، سينتج عن كارثة اقتصادية صينية. وأضاف أن هذا الانهيار العالمي “سوف يكون أسوأ انهيار شهده العالم على الإطلاق“.
التجارة العالمية
من بين أخطر االتهديدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هو عودة ظهور النزعات الحمائية. لقد شكل نمو التجارة العالمية في العقود السابقة وتكثيف التقسيم الدولي للعمل (“العولمة”) القوة المحركة الرئيسية للاقتصاد العالمي. ومن خلال تلك الوسائل نجحت البرجوازية جزئيا ولمدة مؤقتة في التغلب على حدود الدولة القومية. لكن كل ذلك تحول الآن إلى نقيضه.

من الأمثلة الصارخة على ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث حاولت البرجوازية الأوروبية (بزعامة فرنسا وألمانيا في البداية، والآن بزعامة ألمانيا وحدها)، توحيد صفوفها في سوق واحدة بعملة واحدة: اليورو. لقد توقع الماركسيون أن تلك المحاولة ستفشل، وأنه عند أول أزمة اقتصادية جدية ستعود إلى الظهور جميع الانقسامات والصراعات الوطنية القديمة، التي كانت مستترة لكنها لم تختف في سوق واحدة.
تعكس أزمة اليورو، الذي انخفض مقابل الدولار، خطورة الأزمة الاقتصادية. وليست الأزمة اليونانية سوى التعبير الأكثر وضوحا عن الأزمة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار اليورو وحتى تفكك الاتحاد الأوروبي نفسه. وسيكون لمثل هذا التطور أوخم العواقب على الاقتصاد العالمي برمته. هذا هو السبب الذي يدفع أوباما لحث الأوروبيين على حل الأزمة اليونانية بأي ثمن. إنه يدرك أن انهيار الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة في الولايات المتحدة نفسها.
عام 2015 هو العام الخامس على التوالي الذي يشهد فيه متوسط النمو في “الأسواق الصاعدة” انخفاضا، مما أدى إلى هبوط النمو العالمي. قبل عام 2008، نما حجم التجارة العالمية بنسبة 6% سنويا، وفقا لمنظمة التجارة العالمية. لكنه تباطأ في السنوات الثلاث الماضية إلى 2,4%. وخلال الستة أشهر الأولى من عام 2015، عانت التجارة العالمية أسوء أداء لها منذ عام 2009.
في الماضي كانت التجارة عاملا رئيسيا في تنشيط الإنتاج، لكنها لم تعد كذلك الآن. منذ عام 2013، أدى كل 1% من النمو العالمي إلى ارتفاع التجارة العالمية بـ 0,7% فقط. وفي الولايات المتحدة، لم ترتفع واردات الصناعات التحويلية نهائيا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000. بينما في العقد الذي سبق كانت قد تضاعفت تقريبا.
والاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن العولمة آخذة في التباطؤ. إن محرك النمو الاقتصادي، أي التجارة العالمية، يتباطأ. لقد تراجع حجم التجارة العالمية في ماي (2015) بنسبة 1,2%. وكان قد واصل الهبوط طيلة أربعة أشهر من بين الخمسة أشهر الأولى من عام 2015. استمرت جولات محادثات الدوحة في الانعقاد منذ 14 عاما، لكن تم التخلي عنها اليوم. وبدلا من ذلك تحاول الولايات المتحدة التركيز على خلق تكتلات إقليمية للتجارة الحرة، لخدمة مصالحها الامبريالية الخاصة. وقد تفاوضت مؤخرا بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، والتي يمكن أن تغطي 40% من الاقتصاد العالمي، لكن هذه الشراكة مليئة بالتناقضات، إذ لا بد من التصديق عليها من قبل مجموعة من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهو الشيء الذي ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال. ويواجه أوباما الكونغرس المعادي له وقد يكون غير قادر على التصديق على الشراكة قبل نهاية ولايته. وستحدث مشاكل مشابهة، إن لم نقل أكبر، أثناء مفاوضات اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار (TTIP)، التي تهدف إلى ضم أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. إن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار لم توقع بعد ولم يتم الإعلان عنها رسميا، لكنها بدأت منذ الآن تخلق اختلافات قوية بين البلدان الأوربية.
اللامساواة
بلغ تركيز الرأسمال، الذي تنبأ به ماركس، مستويات لم يسمع بها من قبل. لقد خلق مستويات من اللامساواة لم يسبق لها مثيل. تتركز قوة هائلة في أيدي أقلية ضئيلة من الأثرياء الذين يسيطرون حقا على حياة ومصائر شعوب العالم.
الشباب والنساء والأقليات العرقية يعانون بشكل رهيب من الأزمة. إنهم أول من يطردون وهم من يعانون أكثر من تخفيض الأجور. وتتسبب الأزمة في مفاقمة آثار اللامساواة والتمييز بين الجنسين، فضلا عن تغذية مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب تجاه الأقليات بين الفئات المتخلفة من السكان.
يواجه الشباب أسوء الآفاق الاقتصادية منذ عدة أجيال، وهو ما يعترف به جميع الاقتصاديين البرجوازيين. لقد شهد الشباب أكبر انخفاض في الدخل وفرص العمل. إنهم يعانون من الهجمات المستمرة على جميع مستويات التعليم، الذي يتعرض لحملة شرسة لضربه وخصخصته لصالح الرأسمال المالي. ويواجه شباب الطبقة العاملة بشكل متزايد ارتفاع تكاليف الدراسة والديون مدى الحياة عندما يلتحقون بالجامعة، وهو ما يمنع البعض من الالتحاق بها أصلا.
غالبية الشباب محرومون من الفرص التي كانت تعتبر في الماضي بديهية. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار ويهدد بالانفجارات الاجتماعية. لقد كان ذلك عاملا رئيسيا في اندلاع ما يسمى بالربيع العربي وتتحضر غيرها من الانتفاضات المماثلة في كل مكان.
في كل مكان يصير الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر ثراء. نشرت مؤسسة أوكسفام (Oxfam) الخيرية لمكافحة الفقر تقريرا يظهر أن حصة الثروة العالمية التي يملكها أغنى 1% من سكان العالم ارتفعت من 44% في عام 2009 إلى 48% في عام 2014، في حين أن أفقر 80% من سكان العالم لا يملكون حاليا سوى 5,5% من الثروة العالمية. وبحلول نهاية عام 2015 صار أغنى 1% في العالم يملكون بالفعل حصة من الثروة (50,4%) أكبر من التي يمتلكها بقية 99% من سكان العالم مجتمعين.
البرجوازيون الأكثر ذكاء يفهمون الخطر الذي يمثله على نظامهم هذا التفاوت الهائل بين الأغنياء والفقراء. تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه يثير تساؤلات اجتماعية وسياسية إضافة إلى التساؤلات الاقتصادية. وقال ويني بيانيما، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، إن التركيز المتزايد للثروة الذي نشهده منذ الركود العميق 2008-2009 “خطير ويجب عكس اتجاهه“.
يدعو الإصلاحيون حسنو النية قادة العالم لمعالجة مشاكل اللامساواة والتمييز والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن تغير المناخ والمسائل الأخرى الملحة التي تواجه البشرية، لكنهم لم يشرحوا أبدا كيف يمكن لهذه المعجزات أن تتحقق في ظل الرأسمالية. تأتي مؤتمرات القمة والندوات وتذهب وتلقى الخطابات ويتم تمرير القرارات، لكن لا شيء يتغير.
التقشف الدائم
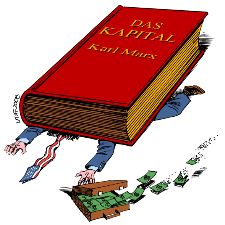
إن المنظور القائم أمامنا هو مرحلة طويلة جدا حيث الركود الاقتصادي ستقطعه فترات من النمو الاقتصادي البطيء مع تزايد مستمر للمصاعب الاقتصادية، أو بعبارة أخرى: التقشف الدائم. هذا سيناريو جديد مختلف تماما عن ذلك الذي عرفته البلدان الرأسمالية المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية. وبالتالي فإن العواقب السياسية ستكون أيضا مختلفة جدا.
لقد أوضحنا مرات عديدة أن كل محاولة تقوم بها البرجوازية لاستعادة التوازن الاقتصادي سوف تدمر التوازن الاجتماعي والسياسي. وهذا هو بالضبط ما يحدث الآن على الصعيد العالمي. إن الركود الاقتصادي الطويل الأمد يخلق صعوبات اقتصادية ويضرب التوازنات القديمة. اليقينيات القديمة تتلاشى، وهناك تشكيك شامل في الوضع القائم والقيم والأيديولوجيات السائدة.
لقد تم فقدان أكثر من 61 مليون منصب شغل منذ بداية الأزمة العالمية في عام 2008. ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية (ILO)، سوف يستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة في الارتفاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى أكثر من 212 مليون بحلول عام 2019. وأعلنت أن «الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة تجمع بين معدلات نمو أبطأ واتساع التفاوتات والاضطرابات». وإذا أضفنا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في مجال العمالة الهامشية، في ما يسمى بالقطاع غير الرسمي، فإن الرقم الحقيقي للبطالة في العالم لن يقل عن 850 مليون. هذا الرقم وحده يكفي لإثبات أن الرأسمالية قد أصبحت عقبة لا تطاق أمام التقدم.
في البلدان الرأسمالية المتقدمة تحاول الحكومات الحد من مستويات الديون التي تراكمت خلال الأزمة عن طريق خفض الأجور ومعاشات التقاعد. لكن سياسات التقشف تلك قد خفضت بشكل حاد من مستويات المعيشة دون أن يكون لها أي تأثير جدي على جبل الديون. لقد فشلت كل التضحيات المؤلمة التي فرضت على الجماهير، خلال السنوات السبع الأخيرة، في حل الأزمة، بل على العكس من ذلك جعلتها أسوء.
لا أتباع كينز ولا أنصار النظرية النقدية التقليدية يمتلكون أي حل يقدمونه. ما تزال مستويات الديون العالية جدا مستمرة في النمو بدون انقطاع، وتمثل عبئا هائلا على النمو. لخفض مستويات ديونها تحاول الحكومات والشركات تمرير عبء الأزمة على كاهل الطبقة العاملة والطبقة الوسطى. وهذا له آثار عميقة على العلاقات الاجتماعية وعلى وعي جميع الطبقات.
الآثار السياسية للأزمة

نواجه هنا ما يبدو لأول وهلة وكأنه مفارقة لا يمكن تفسيرها. إذ أنه حتى وقت قريب كان الرأسماليون يتباهون بأنهم تمكنوا من اجتياز أعمق أزمة في التاريخ دون حدوث ثورة. هذه النتيجة المثيرة للدهشة ملأت نفوسهم بإحساس متعجرف بالرضا الذاتي، خاطئ وغبي في نفس الوقت.
إن المشكلة الرئيسية لهؤلاء الناس هي أنهم يفتقرون لأبسط فهم للديالكتيك الذي يفسر أن كل شيء لا بد أن يتحول، عاجلا أو آجلا، إلى نقيضه. تحت سطح الهدوء الظاهري، هناك غضب متزايد ضد النخب السياسية: ضد الأغنياء والأقوياء وأصحاب الامتيازات. يحبل الوضع الراهن ببذور جنينية لتطورات ثورية.
تؤكد المادية الجدلية بأن الوعي البشري يتخلف دائما وراء الأحداث، لكنه عاجلا أم آجلا يلحق بها بطفرة. وهذا هو بالضبط ما تعنيه الثورة. إن ما نشهده اليوم في العديد من البلدان هو بداية تغيير ثوري في الوعي السياسي، يهز مؤسسات النظام القائم وأحزابه من الأساس. صحيح أن الوعي يتشكل إلى حد كبير بذكريات الماضي، وسوف يمر وقت طويل قبل أن يتخلص وعي الجماهير من الأوهام القديمة في الإصلاحية، لكن تحت ضربات مطرقة الأحداث، ستحدث تغييرات مفاجئة وحادة في الوعي. الويل لمن يحاول أن يستند على وعي يعود للماضي الذي بدأ بالفعل يختفي! يجب على الماركسيين أن يستندوا على السيرورة الحية وعلى منظورات المرحلة المقبلة، والتي لن تكون مجرد تكرار للماضي.
تهز الأزمة وعي الجماهير على نطاق لم يسبق له مثيل منذ أجيال، وتثير تحركات واسعة في جميع البلدان الواحد منها تلو الآخر. إن ما رأيناه في اليونان وإسبانيا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، هو الخطوة الأولى في اتجاه الصحوة السياسية، وهي مرحلة ستتلوها مراحل أخرى أوسع وأعمق.
ما هي ملامح هذه التحركات؟ في الواقع يمكننا أن نتحدث عن تعبئة تتشكل فيها جبهة موحدة بين الطبقة العاملة وبين قطاعات واسعة من الشرائح شبه البروليتارية، وحتى البرجوازية الصغيرة، التي زعزعتها أزمة الرأسمالية.
حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة، حيث يمثل الأجراء الغالبية العظمى من السكان العاملين، هناك قطاعات واسعة من الفئات شبه البروليتارية من البرجوازية الصغيرة والمثقفين والشرائح المتميزة نسبيا من الطبقة العاملة، الخ، هزتهم بشدة الأزمة الاقتصادية. في الواقع، إن التدهور النسبي في الأوضاع الاقتصادية، الذي تعرضت له قطاعات من البرجوازية الصغيرة، تدهور أكثر عنفا، من بعض النواحي، من ذلك الذي تعرضت له الطبقة العاملة، بسبب طبيعتهم الاجتماعية المفككة والصعوبات التي يواجهونها في الدفاع عن أنفسهم عبر النضال الجماعي.
إن الارتباك والأوهام التي عبرت عنها شخصيات بارزة مثل إغليسياس وساندرز وكوربين وتسيبراس، وغيرهم، هي في جزء منها انعكاس للحالة الأولية لحركة الجماهير التي لا تدخل الساحة السياسية ببرنامج عمل متكامل للإطاحة بالرأسمالية. لكن هذا ليس سوى جزء من الحقيقة. إن الطبيعة المتباينة والمتناقضة والطوباوية، في نهاية المطاف، لهذه البرامج هي أيضا انعكاس لمصالح وأجندات طبقات مختلفة، وخاصة البرجوازية الصغيرة التي لديها نقاط اتصال قوية وتقارب كبير مع الفئات القيادية داخل المنظمات العمالية.
من هذه الفئات تنبع الشعارات “الطوباوية” مثل “تنظيم السوق” (في مقابل تحرير التجارة الدولية من قبل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات)؛ تطوير السوق الداخلية (وبالتالي الحد من الفوارق الاجتماعية “المفرطة”)؛ الحد من قوة البنوك الكبيرة أو تقسيمها إلى كيانات أصغر؛ المطالبة بـ “النزاهة” في ممارسة السياسة، وما إلى ذلك. إن الخلاصة السياسية لهذه الأفكار هي مطلب “الديمقراطية الحقيقية” وإحياء الديمقراطية السياسية التي يصير في ظلها للمواطن العادي قيمة مثله مثل أصحاب الملايير.
“ثورة كوربين”، و”الثورة السياسية ضد طبقة أصحاب الملايير” التي رفعها ساندرز، والخطاب الديمقراطي الجذري لإغليسياس، كلها محاولات لتصوير ديمقراطية مثالية، ديمقراطية لم توجد أبدا في ظل الرأسمالية، ووجودها في ظل رأسمالية اليوم هو أكثر استحالة. لكنها تمارس جاذبية كبيرة على ملايين، بل ملايير، الناس الذين يشعرون بحق بأنهم خدعوا وسلب حقهم في تقرير مستقبلهم ومستقبل المجتمع.
لقد حاولت حركة النضال ضد سياسات التقشف التي تخوضها قطاعات واسعة من العمال والعاطلين والشباب، وأيضا فئات غير بروليتارية دمرتها الأزمة، العثور على تعبير سياسي عنها، وخاصة على الصعيد الانتخابي. وهكذا شهدنا النجاح الانتخابي لسيريزا، وانتخاب جيريمي كوربين زعيما لحزب العمال البريطاني، والتصويت لحزب بوديموس وحلفائه في إسبانيا، والتصويت لصالح اليسار في البرتغال، ونجاح حملة بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأميركي ضد هيلاري كلينتون. وفي مرحلة ما ستؤدي الحركة الجماهيرية التي اندلعت في فرنسا إلى تطورات مماثلة، وإن لم يكن من الممكن حتى الآن التنبؤ بالضبط كيف ومتى سيحدث ذلك.
في كل مرة تظهر هذه الشخصيات على الساحة، وتصعد كثيرا وتصير أكثر بروزا، يندفع المثقفون اليساريون إلى “دراستها”، في محاولة لاكتشاف سر نجاحها والتشبه بها. إنهم لا يفهمون أن بروز تسيبراس وإغليسياس فجأة كعمالقة حقيقيين، لا يعود إلى مكانتهم الخاصة أو ميزة خفية ما لأحزابهم، بل لأنهم دفعوا من قبل موجة عملاقة. وبدلا من النظر إلى الأغصان التي يدفعها المد، علينا أن نفهم الموجة التي تدفع تلك الأغصان (والتي قد تتخلى عنها لاحقا، وتجعلها تسقط بنفس الفجائية التي رفعتها بها).
لقد تابعت الحركة، في كل من تلك الحالات، مسارات مختلفة، مستخدمة بطريقة تجريبية الاحتمالات التي تنفتح أمامها. في اليونان حولت حزبا صغيرا (Synaspismos) من 4% من الأصوات إلى أكبر حزب في البلاد. وفي إسبانيا خلقت حزبا جديدا تماما (حزب PODEMOS)؛ وفي بريطانيا أحدثت ثورة في حزب جماهيري، وجد منذ أكثر من قرن، هو حزب العمال، مع تدفق مئات الآلاف من الناس، خاصة الشباب منهم، الذين وجدوا فجأة في انتخابات الرئاسة منبرا لإسماع أصواتهم.
ومع ذلك، فإنه في ظل رأسمالية اليوم لا يمكن لأية حركة جماهيرية حقيقية ضد الطبقة الحاكمة أن تعبر عن نفسها دون مشاركة الطبقة العاملة، بالنظر إلى وزنها الاقتصادي وكثرتها العددية. وهكذا، فإنه في جميع هذه الحركات تتعايش، على نحو انتقائي ومتناقض، برامج برجوازية صغيرة أو حتى برجوازية، مع مطالب تعبر عن جزء من مصالح الطبقة العاملة (رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة في حملة ساندرز أو مقترحات مجانية وتعميم التعليم والرعاية الصحية، الخ).
«لا تندفع الجماهير إلى الثورة وفق مخطط جاهز للتحويل الاجتماعي، بل بإحساس حاد بأنها غير قادرة على تحمل النظام القديم فترة أطول. (…) تتمثل السيرورة السياسية الأساسية للثورة في وعي الطبقة التدريجي بالمشاكل الناجمة عن الأزمة الاجتماعية، وتوجه الجماهير بصورة فعالة وفق أسلوب التقريبات المتتالية.» (ليون تروتسكي، مقدمة كتاب: تاريخ الثورة الروسية).
ما عدا في ظروف محددة للغاية، يعتبر من المستحيل عادة أن تتبنى الجماهير منذ الوهلة الأولى برنامجا ثوريا ناجزا. فحتى عندما يشعرون بالتقزز من الوضع الذي يعيشون فيه، وحتى عندما يبدءون في التحرك ضد الوضع القائم، فإن الاستنتاج الأول الذي يتوصلون إليه لا يكون هو ضرورة الإطاحة بالنظام الاجتماعي والاقتصادي بأكمله واقتلاعه من جذوره. إنهم يسعون إلى حل أكثر بساطة: تغيير الحكومة، تغيير القادة السياسيين، المطالبة بقوانين أفضل، استهداف هذا الجانب أو ذاك من جوانب النظام المثيرة للاشمئزاز، على أمل أن الأمور ستتحسن.
الثورة الاجتماعية ليست هي الخيار الأول الذي تعتنقه الجماهير، بل هي الخيار الذي تتوصل إليه بعد أن تكون كل الخيارات الأخرى قد باءت بالفشل.
هذا لا يعني أن الجماهير “معتدلة” أو “متخلفة”. فقط من خلال وضع مختلف التيارات السياسية على المحك، تتوصل الجماهير إلى استنتاج مفاده أن كرهها لهذا النظام يمكنه أن يجد تعبيرا علميا عنه في البرنامج الثوري للماركسية. وهذا أيضا هو الدرس المستفاد من كل الثورات الكبرى، بما في ذلك الثورة الروسية.
الحركة، التي نشهد الآن مراحلها الأولى، ستمزقها حتما التناقضات الطبقية، وفقط من خلال هذه السيرورة سوف تتوصل إلى إنجاز مهامها التاريخية بإسقاط هذا النظام.
الماركسية ليست مجرد أداة لتحليل الأزمة الاقتصادية والسياسية. إنها النصل الحاد الذي نستخدمه لقطع تلك الخيوط السياسية والأيديولوجية، الواحد منها تلو الآخر، التي تحاول الطبقة الحاكمة بواسطتها باستمرار كبح وتحويل مسار حركة الجماهير، وخاصة عن طريق الضغط على الفئات الأكثر تميزا ومحافظة (البيروقراطية النقابية والبرلمانيين، والقادة الذين بقدر ما يتم دفعهم على “الساحة السياسية الوطنية”، يميلون بشكل حتمي للانفصال عن قاعدتهم).
يمكن للماركسية ويجب عليها أن تنتقل من حالتها باعتبارها تيارا يشكل أقلية، باعتبارها النظرية الوحيدة التي يمكنها توجيه سيرورة التوضيح والتمايز داخل الحركة الجماهيرية، والدفاع داخلها عن مصالح البروليتاريا الطبقية.
إن الجماهير، وفي سياق بحثها عن وسيلة للخروج من الأزمة، تضع على المحك الأحزاب الواحد منها تلو الآخر. تضع القادة القدامى والبرامج القديمة موضع الاختبار وتعمل على التخلص منهم. وتلك الأحزاب التي انتخبت وخانت آمال الشعب، وقامت بتنفيذ سياسة الاقتطاعات في انتهاك لوعودها الانتخابية، تفقد مصداقيتها بسرعة. والإيديولوجيات التي كانت تعتبر سائدة صارت هدفا للاحتقار. والقادة الذين كانوا يتمتعون بالشعبية أصبحوا ممقوتين. لقد صارت التغيرات الحادة والمفاجئة على رأس جدول الأعمال.
هناك غضب متزايد ضد النظام القائم، غضب يتجاوز الوضع الاقتصادي المباشر. لم يعد الناس يصدقون ما يقوله لهم السياسيون أو يعدونهم به. هناك خيبة أمل متزايدة في النظام السياسي والأحزاب السياسية بشكل عام. هناك شعور عام وعميق بالسخط في المجتمع، لكنه ما زال يفتقر إلى وسيلة قادرة على إعطائه تعبيرا منظما.
في فرنسا، شكل النضال ضد ما يسمى قانون العمل قفزة نوعية إلى الأمام في تطور الصراع الطبقي والتجذر السياسي لجزء كبير من الشباب والطبقة العاملة. وكما جرى خلال تحركات 2010 ضد الهجوم على نظام التقاعد، انطلقت موجة من الإضرابات المتجددة في عدة قطاعات رئيسية في الاقتصاد (الطاقة والموانئ والبواخر والنقل، وما إلى ذلك) بمبادرة من قواعد النقابات. تحت ضغط مناضليها اضطرت قيادة الكنفدرالية العامة للشغل (CGT – أكبر نقابة عمالية) لأن تدعم -بالكلمات على الأقل- هذه الإضرابات، في حين أنها كانت قد أدانتها عام 2010. عدد كبير من النقابيين انتقدوا علنا استراتيجية “أيام التحرك” وطالبوا بأساليب نضال أكثر جذرية.
وفي الوقت نفسه، عكست حركة ليالي النضال ” Nuit Debut” تجذر الشباب، كما هو الحال في اسبانيا وفي اليونان والولايات المتحدة الأمريكية عام 2011. لقد اتسمت الحركة منذ البداية برغبتها في مد الأواصر مع الحركة العمالية و دفعها نحو المزيد من العمل المتجذر ( “الإضراب العام”). والأكثر أهمية هو أن هذه التجمعات العامة قد وضعت موضع تساؤل ليس فقط الإصلاحات المضادة، بل أيضا النظام الرأسمالي ومؤسساته.
سيكون للحركة ضد قانون العمل عواقب سياسية على المدى القصير. الحزب الاشتراكي صار أكثر انفضاحا. وفرانسوا هولاند هو الرئيس الأقل شعبية منذ عام 1958. يفتح هذا مجالا سياسيا واسعا على يسار الحزب الاشتراكي. وفي توقعات الانتخابات الرئاسية لعام 2017، يمكن لحركة ميلينشون (فرنسا المتمردة – La France Insoumise) أن تبلور حولها المعارضة اليسارية ضد التقشف وضد “النظام”، على مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2012.
في اليونان شهدنا انهيار حزب باسوك وصعود حزب سيريزا. أما في إسبانيا فلدينا ظاهرة حزب بوديموس. وشهدنا في اسكتلندا صعود الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP). أما في بريطانيا ككل فقد شهدنا بروز جيريمي كوربين. كل هذا هو تعبير عن الاستياء العميق الموجود في المجتمع، والذي يسعى للحصول على تعبير سياسي عنه.
شهدنا نفس السيرورة تجري في ايرلندا خلال الاستفتاء الأخير. استمرت ايرلندا لعدة قرون واحدة من أكثر بلدان أوروبا تشبثا بالكاثوليكية. فإلى حدود وقت ليس ببعيد كانت الكنيسة تمارس سيطرة مطلقة على كل جوانب الحياة هناك. لكن نتيجة الاستفتاء على زواج المثليين، حيث صوت 62% بالموافقة، كانت صفعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. كانت النتيجة احتجاجا واسع النطاق ضد سلطة الكنيسة وتدخلها في السياسة وفي حياة الناس. وهذا يمثل تغييرا جوهريا في المجتمع الأيرلندي.
الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة هي البلد الرأسمالي الرئيسي الوحيد الذي شهد انتعاشا، على الرغم من أنه كان انتعاشا ضعيفا وهزيلا. كان معظم النمو الذي تم تسجيله في العام الماضي يرجع إلى تراكم المخزون (السلع غير المباعة). في الواقع النمو يتباطأ في الولايات المتحدة وقد تباطأ بالفعل في اليابان والاتحاد الأوروبي. منذ يوليوز 2015 وزع صندوق النقد الدولي علامات ناقص على جميع توقعاته. وبالتالي لا شيء تبقى من ذلك الانتعاش الذي تبجحوا به كثيرا.
أدى ضعف الاقتصاد العالمي، وخاصة ما يسمى بالاقتصادات الصاعدة، إلى التدافع على اقتناء الدولار، الذي ما زال ينظر إليه باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات. لكن قوة الدولار هي في حد ذاتها مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، مما يعطي ميزة تنافسية لخصومها ويضر بالصادرات الأمريكية. في العام الماضي انخفضت الصادرات والواردات في الولايات المتحدة، مما يعكس الضعف العام للاقتصاد العالمي.
تقسم الأزمة المجتمع الأمريكي. وينظر إلى إدارة أوباما بأنها فاشلة. وحقيقة أن الخطاب المضاد للإدارة عند دونالد ترامب وبيرني ساندرز قد وجد صدى له عند الكثير من الأميركيين هو دليل على تغير الوعي عند الملايين من الناس. هناك استقطاب إلى اليسار وإلى اليمين، وهي السيرورة التي تجري على الصعيد الأممي.

يضرب خطاب ترامب الرجعي على وتر حساس لدى الناس الذين يشعرون بالغضب تجاه النخبة السياسية في واشنطن. وقد شكل ارتفاع شعبيته صدمة لقيادة الحزب الجمهوري الذي صار يواجه الأزمات والانقسامات.
تمثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية تطورا مثيرا جدا للاهتمام. من المستحيل، بطبيعة الحال، التنبؤ بشكل يقيني بنتيجة الانتخابات، بالنظر إلى المرحلة غير المستقرة للغاية والمتقلبة التي تمر منها السياسة الأميركية. على الرغم من أنه من الواضح أن هيلاري كلينتون هي المرشحة المفضلة بالنسبة للطبقة السائدة. وقد ركزت وسائل الإعلام، بشكل حصري تقريبا، على شخص الجمهوري دونالد ترامب.
إلا أن الشيء الأكثر أهمية من ترامب وكلينتون هو الدعم الهائل لبيرني ساندرز الذي يدافع علنا عن الاشتراكية. إن بروز بيرني ساندرز باعتباره منافسا قويا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة هو دليل على الاستياء العميق والغليان الموجودين في المجتمع. لقد وجدت هجماته ضد طبقة أصحاب الملايير ودعوته لـ “ثورة سياسية” صدى لها عند ملايين الناس، حيث يحضر لقاءاته الانتخابية عشرات الآلاف من الأنصار.
كثيرا ما يتم استخدام كلمة “اشتراكية” الآن في وسائل الإعلام. وأظهر استطلاع للرأي أنجز سنة 2011 أن 49% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة لديهم فكرة ايجابية عن الاشتراكية، مقابل 47% فقط لديهم فكرة ايجابية عن الرأسمالية. بينما أظهر استطلاع للرأي أكثر حداثة، ابتداء من يونيو عام 2014، أن 47% من الأمريكيين سيصوتون لصالح مرشح اشتراكي، وسيصوت 69% من الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة لصالحه.
أعداد كبيرة من الناس، أغلبهم من الشباب وكذلك العديد من قواعد النقابات، حريصون على سماع خطاب بيرني ساندرز. صحيح أن مقترحاته هي أقرب إلى النموذج الديمقراطي الاجتماعي الاسكندينافي، وليس الاشتراكية الحقيقية، لكن ومع ذلك فإن هذا مظهر من المظاهر الأكثر أهمية على أن شيئا ما يتغير في الولايات المتحدة الأمريكية.
ضرب بيرني ساندرز على وتر الكراهية الشعبية ضد النظام وضد حكومة مالكي الأبناك وأصحاب المليارات في وول ستريت. لقد هز الركود العالمي أمريكا من أساسها. ويعيش اليوم واحد من كل خمسة أمريكيين بالغين إما في أسر فقيرة أو على حافة الفقر. ومنذ اندلاع الأزمة العالمية سقط حوالي 5,7 مليون شخص إلى مستوى الحد الأدنى للدخل.
تفاخر الإدارة الأمريكية بأن مستوى البطالة انخفض إلى 5%. لكن السبب في ذلك ليس النمو الاقتصادي، بل تراجع مشاركة القوى العاملة. إذا كانت نسبة الذين يعملون أو يبحثون بنشاط عن عمل هي نفسها كما كانت في عام 2008، فإن معدل البطالة سيكون أكثر من 10%. وقد اضطر العمال إلى القبول بوظائف هشة ومنخفضة الأجر.
مع ركود النمو وارتفاع معدلات البطالة في منطقة اليورو، وغرق اليابان في الركود، وتسجيل الولايات المتحدة “لانتعاش” يتراوح بين 2% و2,5%، لا يوجد أي بلد يمكنه أن يلعب دور المحرك لازدهار جديد، وبالتالي فإن البلدان الصناعية المتقدمة بقيت في الفترة الأخيرة معتمدة على “الأسواق الصاعدة” لدعم الاقتصاد العالمي. لكن هذا الخيار لم يعد متاحا.
أوروبا
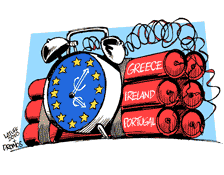
يستيقظ الناس في جميع أنحاء أوروبا اليوم على حقيقة أن سياسات التقشف ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي هجوم دائم على مستويات المعيشة. وبالفعل لقد أدت هذه السياسات في بلدان مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا إلى تخفيضات كبيرة في الأجور الاسمية والمعاشات التقاعدية دون أن تحل مشكلة العجز. وهكذا كانت كل المعاناة وأشكال الحرمان التي فرضت على الشعوب بدون جدوى.
تواجه أوروبا فترة طويلة من تباطؤ النمو والانكماش. وستكون محاولة التقليص من حجم الديون في ظل هذه الوضع مهمة “أكثر صعوبة وأكثر قسوة” مما شهدناه في السابق. إذا نظرنا إلى اقتصاد منطقة اليورو ككل، نرى أنه لم يتعاف بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة، عام 2007. وهذا على الرغم من سلسلة من العوامل التي من شأنها تعزيز النمو، أي: انخفاض أسعار النفط وبرنامج التسهيل الكمي الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي (والذي يصل إلى 60 مليار يورو شهريا) وضعف قيمة اليورو الذي من المفترض أن يحفز الصادرات.
لكن الانخفاض الكبير لنسبة التضخم ليس انعكاسا لصحة الاقتصاد، بل هو دليل على مرض مزمن؛ إنه يعكس عدم وجود الطلب على السلع الاستهلاكية، والذي هو بدوره نتيجة الديون الضخمة المتراكمة وانخفاض الدخل. يمكن لهذا أن يؤدي إلى دوامة هابطة قد تنتهي بفترة ركود طويلة. ونتيجة لذلك يتحدثون عن مزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الودائع المصرفية قصيرة المدى والزيادة في برنامج التيسير الكمي.
وفي معرض تعليقه على الوضع، كتب رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي: «بعد دورات الركود التي شهدتها البلدان التي تشكل الآن منطقة اليورو خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات استغرق الأمر منها آنذاك ما بين خمسة فصول وثمانية فصول[4] لكي تستعيد مستوى الناتج الحقيقي الذي كان لديها في مرحلة ما قبل الركود. لكن خلال الركود الأخير، الذي من المسلم به أنه الأسوأ منذ الثلاثينات، سيستغرق الأمر 14 فصلا بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة لكي يصل إلى ذروته قبل الأزمة. وإذا كان تقييمنا الحالي صحيحا فسوف تستغرق منطقة اليورو 31 فصلا للعودة إلى مستوى الناتج الذي كان لها ما قبل الأزمة، أي في عام 2016».
يعتبر حتى هذا القول تقييما مفرطا في التفاؤل. الاتحاد الأوروبي في حالة ضعفه الراهنة حساس للصدمات. إن التباطؤ الذي يعرفه الاقتصاد الصيني وأزمة “الأسواق الصاعدة” لهما تأثير كبير بالخصوص على ألمانيا، التي هي بلد مصدر للتجهيزات إلى الصين. وبما أن الصادرات شكلت 45,6% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عام 2014، فإن البلد الوحيد الذي يمكنه أن يكون بمثابة القوة المحركة للانتعاش الاقتصادي في أوروبا لم يعد في وضع يمكن له أداء هذا الدور.
كلما انخفض معدل النمو كلما تضخم عبء الديون، هذا هو الدرس المستفاد من اليونان. وفي ظل هذه الظروف يأتي التخلف عن سداد القروض والخسائر المالية مثلما يأتي الليل بعد النهار، ويرافقه موجة من حالات الإفلاس وانهيار اقتصاديات البلدان الواحد منها تلو الآخر.
تسبب المأزق الاقتصادي في تعميق كل التناقضات وإثارة توترات حادة بين الدول الوطنية في أوروبا. جاءت أزمة اللاجئين، ومسألة من الذي سيدفع ثمنها، بمثابة المحفز الذي دفع بكل تلك التناقضات إلى السطح. لقد أدت إلى اندلاع مواجهات غاضبة بين ألمانيا وبين دول أوروبا الشرقية (بولندا وهنغاريا)، التي كانت إلى وقت قريب قد تحولت تقريبا إلى مستعمرات ألمانية.
تخوض فرنسا وألمانيا صراعا بينهما حول مسألة الاتحاد المصرفي، الذي تضغط فرنسا من أجل تحقيقه، بينما تنهج ألمانيا سياسة التسويف حياله. ليست برلين متحمسة بطبيعة الحال لفكرة ضمان بنوك البلدان الأخرى، والتي ترى فيها وكأنها قيام شخص لديه حساب بنكي سليم بإعطاء بطاقته الائتمانية لجاره الذي سبق وأن حكمت عليه المحكمة بالإفلاس عدة مرات.
خطة إنقاذ اليونان لم تتحقق بعد على الرغم من انبطاح تسيبراس. لن يكون من السهل عليه تنفيذ الاقتطاعات الكبيرة التي طالبته بها ميركل وشركاؤها. سوف يكون هناك تكثيف للصراع الطبقي حيث أن العمال اليونانيين سيقاومون الاقتطاعات والخصخصة. وفي مرحلة معينة سوف يثير هذا أزمة داخل الحكومة وصداما جديدا مع الترويكا، مما سيبعث مرة أخرى شبح خروج اليونان من الاتحاد الأوربي والأزمة في منطقة اليورو.
ثم هناك مسألة الاستفتاء المقبل في بريطانيا بخصوص الاتحاد الأوروبي. يمثل كاميرون حزب المحافظين الذي يعارض بشكل حازم تعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي. وستكون المفاوضات صعبة. سيكون على كاميرون أن يظهر أنه حصل على بعض التنازلات الكبيرة وسيكون على ميركل أن تبين أنها لم تعطه شيئا.
لقد وصل توسع الاتحاد الأوروبي إلى نهايته. لم يعد في موقف يسمح له بدمج أعضاء جدد من أوروبا الشرقية. وبعد أن وعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بإقامة علاقات أوثق، سيترك هذا البلد البائس ليواجه خطر الغرق لوحده، وقد بدأ يغرق بالفعل. وعلاوة على ذلك فإن سيرورة الاندماج الأوروبي (التي ذهبت أبعد مما كنا نظن) قد بدأت تسير الآن في الاتجاه المعاكس، حيث عادت الرقابة على الحدود.
تؤدي الأزمة في أوروبا إلى إحداث تغيرات حادة في الوعي. وقد أظهرت الانتخابات الإقليمية الفرنسية، خلال دجنبر 2015، السيرورة التي تجري. احتلت الجبهة الوطنية المرتبة الأولى في الجولة الأولى، بينما جاء الحزب الاشتراكي في المركز الثالث وراء حزب الجمهوريون [Les Republicans] المحافظ بزعامة ساركوزي، لكن اكبر حزب كان هو حزب أولئك الذين لم يصوتوا (أكثر من 50%)، مما يعبر عن السخط العام السائد بين جزء كبير من السكان ضد جميع الأحزاب الرئيسية.
في إسبانيا، عام 2011، فاز الحزب الشعبي اليميني في الانتخابات. وتفسير ذلك يكمن في حقيقة أن حكومة الحزب الاشتراكي “اليسارية” طبقت سياسة الاقتطاعات التي تسبب في خيبة أمل الجماهير وأدت بشكل حتمي إلى فوز الحزب الشعبي. لكننا نرى الآن سيرورة معاكسة تحدث مع صعود حزب PODEMOS، الذي تطور، في غضون 18 شهرا، من الصفر إلى حركة تضم مئات الآلاف.

تعرف إسبانيا حالة من الغليان وسيرورة تجذر ما تزال في تصاعد. الانتخابات الإسبانية العامة التي جرت شهر دجنبر الماضي لم تحل أي شيء. فقد الحزب الشعبي الأغلبية التي كانت له، والنتيجة هي أزمة حكومية ستؤدي بالتأكيد إلى انتخابات جديدة. والدعم الواسع النطاق الذي يتمتع به حزب PODEMOS، الذي رفع عدد مقاعده من صفر إلى 69 مقعدا، يثير مخاوف الطبقة الحاكمة.
النمو السريع لحزب PODEMOS انعكاس للاستياء العميق ضد النظام السياسي القائم بأكمله. يمكن للمرء في الوقت الحالي أن يقول إن الجماهير لا تعرف بالضبط ماذا تريد، لكنها تعرف جيدا ما لا تريد. إن الانتقادات الصريحة التي يوجهها بابلو اغليسياس لأصحاب الأبناك والأغنياء وتنديده بالمؤسسة السياسية، التي يصفها بـ “الطغمة” (La Casta)، هي انتقادات تعكس بدقة غضب الجماهير.
صحيح أن أفكار قادة حزب PODEMOS مشوشة وغير واضحة. لكنها تتوافق مع الحالة الراهنة لوعي الجماهير، التي نهضت للتو إلى الحياة السياسية، وبالتالي فإن تلك الأفكار لن تمنع الحزب من النمو، على الأقل في المرحلة الأولى. لكن إذا لم يتم تصحيح تلك الأفكار فإن عدم الوضوح هذا يمكنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير حزب PODEMOS. قريبا جدا سيكون على الحزب أن يقرر أين يقف وفي أي اتجاه ينوي أن يسير.
ستتسارع جميع هذه السيرورات في حالة حدوث ركود عميق. ستواجه أوروبا وضعا أكثر شبها بذلك الذي شهدته خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، من ذلك الذي شهدته خلال العقود التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، أي مرحلة طويلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية مع تقلبات عنيفة نحو اليسار ونحو اليمين. لكن وفضلا عن وجود أوجه تشابه مع فترة ما بين الحربين، فهناك أيضا اختلافات عميقة، فموازين القوى بين الطبقات مختلفة تماما.
هذا يعني أن البرجوازية الأوروبية تواجه معضلة غير قابلة للحل. إنها مضطرة إلى محاولة إلغاء الإصلاحات التي حققتها الطبقة العاملة على مدى نصف القرن الماضي، لكنها تواجه مقاومة عنيدة من طرف الطبقة العاملة. ولهذا السبب بالضبط فإن الأزمة سوف تستمر لسنوات مع موجات صعود وهبوط.
توقعات دونالد توسك
تخفي الأرقام العامة للبطالة في منطقة اليورو الانقسامات العميقة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. قبل الأزمة كانت معدلات البطالة في كبريات اقتصادات المنطقة متماثلة على نطاق واسع.
سيحاول الاتحاد الأوروبي، في عام 2016، تسريع سياسة الاقتطاعات والتقشف المشؤومة تحت شعار “ضبط المالية العامة”. يمكن للمنظرين الاستراتيجيين الرأسماليين الجديين أن يروا المخاطر التي ينطوي عليها هذا الوضع. لقد وصلوا إلى نفس الخلاصات التي وصل إليها الماركسيون. في مقال نشره في صحيفة فاينانشال تايمز، يوم: 15 يونيو 2015، حذر فولفجانج مونشاو من أن أوروبا توجد تحت «التهديد المستمر للعجز والاضطراب السياسي… وخلاصة القول إن إجمالي تقويم ما بعد الأزمة سيكون أقسى بكثير مما كان عليه الحال في اليابان قبل 20 عاما. في ظل هذ الوضع أتوقع أن تصير الصدامات السياسية أكثر خطورة… وحتى لو كانت سياسة تخفيض الديون ناجعة اقتصاديا – وهو الشيء غير المؤكد – فإنها قد لا تكون ناجعة سياسيا… وعن طريق ضرب الاستقرار السياسي، سيتسببون في نهاية المطاف بضرب الاستقرار المالي».
في الآونة الأخيرة، قال دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي السابق الذي يرأس حاليا المجلس الأوروبي، إنه يخشى “العدوى السياسية”، التي يمكن أن تنتج عن الأزمة اليونانية، أكثر بكثير من خشيته من تداعياتها المالية:
قال: «إن ما أخشاه حقا هو العدوى الأيديولوجية أو السياسية لهذه الأزمة اليونانية وليس العدوى المالية». وأضاف: « كانت نفس اللعبة، أي هذا التحالف التكتيكي بين المتطرفين من جميع الجهات، تحدث دائما قبل وقوع أكبر المآسي في تاريخنا الأوروبي. واليوم يمكننا بالتأكيد أن نلاحظ هذه الظاهرة السياسية نفسها».
توسك هذا هو نفس الشخص الذي لعب دورا مركزيا (إلى جانب أنجيلا ميركل) في إجبار ألكسيس تسيبراس على الموافقة على شروط قاسية تتضمن إجراءات تقشف واسعة، بما في ذلك خصخصة ما قيمته 50 مليار دولار من الأصول العمومية اليونانية وتخفيض معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، وغيرها من الاقتطاعات العميقة. وهو نفس الشخص الذي احتج، في وقت لاحق، قائلا إنه لا يمكن قبول الحجة القائلة بأن «أحدا ما قد تعرض للعقاب، خصوصا تسيبراس أو اليونان. لقد كانت العملية برمتها تتعلق بمساعدة اليونان».
لكن توسك قال أيضا إنه يشعر بالقلق من اليسار المتطرف، الذي يدعو إلى «ذلك الوهم اليساري الراديكالي القائل بأنه في الإمكان بناء بديل ما للنموذج الاقتصادي الحالي للاتحاد الأوروبي». وقال إن هؤلاء القادة اليساريين المتطرفين يدفعون إلى نبذ القيم الأوروبية التقليدية، مثل “التدبير” والمبادئ الليبرالية القائمة على السوق التي خدمت الاتحاد الأوروبي بشكل جيد.
في أوربا، وكما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، تعرض الشباب بشكل خاص لأقسى الضربات، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة. في الوقت الحاضر وصلت بطالة الشباب في ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى نسبة 7,1%. وفي إيطاليا أكثر من 40% من البالغين أقل من 25 سنة ويبحثون عن عمل، هم عاطلون. يبلغ هذا الرقم بالنسبة لفرنسا 24% وفي بريطانيا 17%. لكنه أكثر من 45% بالنسبة لكل من اليونان واسبانيا.
الطبقة الحاكمة تعي جيدا الخطر الذي يمثله هذا على نظامها. قالت السيدة ريشلين من مدرسة لندن للأعمال: «هناك مخزون كبير من الشباب في إيطاليا يواجه خطر الضياع إلى الأبد، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغوطا سياسية مع مرور الوقت. المعارضة الايطالية منقسمة في الوقت الحالي، لكن هذا لن يكون بالضرورة هو الحال دائما».
قال دونالد توسك، في إشارة إلى تسيبراس، يمكن للخطاب الحماسي لقادة اليسار المتطرف إلى جانب ارتفاع البطالة بين الشباب في العديد من البلدان، أن يشكل خليطا متفجرا: «بالنسبة لي يشبه الوضع الحالي، إلى حد ما، ذلك الذي شهدناه بعد عام 1968 في أوروبا». وأضاف: «أستطيع أن أشعر، ربما ليس بمزاج ثوري، لكن بشيء يشبه نفاد الصبر على نطاق واسع. وعندما لا يبقى نفاد الصبر شعورا فرديا، بل يصير شعورا اجتماعيا، يكون ذلك بداية الثورات».
لقد وصل تأثير الأزمة اليونانية إلى أبعد من حدود اليونان. لقد تحطمت فكرة الاندماج الأوروبي. كانت ألمانيا خلال المفاوضات مثل قائد أوركسترا دكتاتوري. ولم تخف ميركل حقيقة أنها كانت المسؤولة عن إدارة الحدث بأكمله. البرجوازية الفرنسية، التي كان لديها في الماضي الوهم بأنها تشارك في حكم أوروبا، حرصت على عدم التعبير عن مخاوفها. وسوف تنمو هذه التوترات أكثر فأكثر مع تفاقم الأزمة.
لقد انفضحت طبيعة الديمقراطية البرجوازية أمام أنظار الملايين باعتبارها مجرد خداع. قالت ميركل بلغة واضحة جدا إن: الاستفتاءات الشعبية والانتخابات هي أشياء لا قيمة لها على الإطلاق، القوى الكبرى والحكام الفعليون لأوروبا، أي الأبناك والرأسماليون، هم من يتخذون جميع القرارات، بغض النظر عن آراء الأغلبية. وبالمثل فإن الاستسلام المهين الذي قام به تسيبراس فضح حدود الإصلاحية والديمقراطية الاجتماعية.
هذه المرحلة هي مرحلة الحروب والثورات والثورات المضادة، لكن هذا لا يعني أن الفاشية أو البونابرتية خطران وشيكان. على المدى الطويل، وإذا لم تقدم الطبقة العاملة أي مخرج من الوضع الحالي، ستحاول الطبقة الحاكمة، بطبيعة الحال، التحرك في اتجاه الردة الرجعية. لكن ونظرا لتغير موازين القوى بين الطبقات، لا يمكن لتلك الردة الرجعية أن تتخذ شكل الفاشية، كما كان الحال في الماضي، بل ستتخذ شكل نوع من الأنظمة البونابرتية. ومع ذلك لن تتمكن من تثبيت ديكتاتورية عسكرية على الفور دون التعرض لخطر الحرب الأهلية، التي لن يكون انتصارها فيها مضمونا.
عاجلا أم آجلا ستقرر الطبقة الحاكمة أن الديمقراطية مجرد ترف لم تعد تستطيع تحمله. لكنها ستتحرك بحذر، خطوة خطوة، لتضرب تدريجيا الحقوق الديمقراطية وتتجه في البداية نحو البونابرتية البرلمانية. لكن، في ظل ظروف الأزمة الرأسمالية، سيكون النظام البونابرتي الرجعي نظاما غير مستقر. لن يتمكن من حل أي مشكل وربما لن يستمر طويلا. لن يعمل سوى على التحضير لاضطرابات ثورية أكبر، مثلما انتهى المجلس العسكري اليوناني ما بين 1967 و1974 بثورة. يجب أن نكون مستعدين لمثل هذا النوع من التطورات وألا نسمح لأنفسنا بأن تدوخنا الأحداث.
بريطانيا

انتخاب كوربين زعيما لحزب العمال، بأغلبية كبيرة، حوّل الوضع برمته في بريطانيا عمليا بين عشية وضحاها. وجاء هذا التطور مسبوقا بالأحداث في اسكتلندا، حيث انعكس السخط ضد النظام من خلال النمو السريع للحزب الوطني الاسكتلندي. لم يكن ذلك النمو انعطافة نحو اليمين بل نحو اليسار. لم يكن تعبيرا عن تصاعد المشاعر القومية، بل عن الكراهية الشديدة ضد الطغمة التي تحكم في وستمنستر. صار حزب العمال، ونتيجة لسياسة التعاون الطبقي الجبانة التي يتبناها قادته، يظهر على أنه مجرد قطعة من ذلك النظام.
كان انتخاب كوربين في حد ذاته نتاج سلسلة من المصادفات، لكن وكما أشار هيغل تعبر الضرورة عن نفسها من خلال الصدفة. كون أن كوربين تمكن من وضع اسمه على قائمة الترشح للقيادة يندرج ضمن مفهوم الصدفة وفق التحديد الفلسفي، أي الشيء الذي يمكن أن يحدث أو لا يحدث. لكن من خلال هذا الحادث عبرت ضرورة إيجاد منفذ لإحباط العمال والشباب البريطانيين عن نفسها. كان الضغط من أجل إيجاد مثل هذا المنفذ يتراكم خلال الفترة الماضية بسبب خيبة الأمل في النظام السياسي، فلو لم يكن حادث قبول كوربين في لائحة الاقتراع قد وقع، لعبرت هذه الضرورة عن نفسها في مكان آخر – كما فعلت في اسكتلندا. لقد غير هذا الوضع برمته.
منذ أول ظهور له في مناظرة تلفزيونية، تميز كوربين بشكل واضح عن بقية المرشحين الآخرين. لقد دافع عن أفكار مختلفة وجديدة وأكثر صدقا وأكثر جذرية وأكثر انسجاما مع التطلعات الحقيقية لملايين الناس الذين ضاقوا ذرعا من الوضع الراهن ويريدون التعبير عن رفضهم للنظام.
قبل الانتخابات العامة كانت الحياة داخل حزب العمال ضعيفة أو معدومة. لكن حملة كوربين غيرت الوضع. كانت حملته، على وجه التحديد، نقطة تجميع لكل الاستياء المتراكم في المجتمع والذي لم يكن قد وجد حتى ذلك الحين أية نقطة مرجعية، وخاصة في حزب العمال الذي يسيطر عليه الجناح اليميني.
وفّر انتخاب جيريمي كوربين الشيء الوحيد الذي كان مطلوبا في بريطانيا، ألا وهو نقطة مرجعية لتجميع الاستياء والإحباط المتراكمين بين صفوف الجماهير. لقد انطلقت حركت استخدمت حزب العمال للمقاومة وقد بدأت هذه الحركة تتجه نحو اليسار. وهذا يمثل خطرا قاتلا على الطبقة الحاكمة، التي لن توفر أي جهد في سبيل تدميره.
استمر حزب العمال، على مدى عقود، تحت سيطرة قيادة يمينية شكلت ركيزة لدعم النظام القائم. ولن تتخل الطبقة الحاكمة عنه دون مقاومة شرسة. إن خط الدفاع الأول عن النظام الرأسمالي هو الفريق البرلماني لحزب العمال نفسه. يمثل البرلمانيون البليريون[5] لحزب العمال عملاء مباشرين واعين لأصحاب الأبناك والرأسماليين في هذا الصراع. وهذا ما يفسر إصرارهم المتعصب للتخلص من جيريمي كوربين مهما كلف الأمر. يجري الآن التحضير لانشقاق داخل حزب العمال والذي من شأنه خلق وضع جديد تماما في بريطانيا.
ليس حزب العمال وحده من يعرف الانقسام داخل صفوفه، بل أيضا حزب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الاتحاد الأوروبي. من الصعب التنبؤ بنتيجة الاستفتاء البريطاني، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له آثار هائلة على كل من أوروبا وبريطانيا معا. سوف يزيد من سرعة التفكك التي يمكن أن تنتهي بانهيار الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيطالب القوميون الاسكتلنديون، الذين هم مؤيدون للاتحاد الأوروبي، بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفكك الدولة البريطانية المتحدة.
سوف تتعمق التصدعات الموجودة داخل حزب المحافظين، وربما ستؤدي إلى انشقاق اليمين المعادي لأوروبا، والذي يمكن أن يندمج مع حزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP) المناهض لأوروبا والمناهض للهجرة، لتشكيل حزب بونابرتي ملكي على يمين حزب المحافظين. وعلى الطرف الآخر، من الواضح أن البليريين يتحركون في اتجاه الانشقاق عن حزب العمال. وعلى الرغم من أنهم هم والبرجوازية يخشون من عواقب مثل هذه الخطوة، فمن المرجح أنه في مرحلة معينة سيضطر الجناح اليميني لحزب العمال إلى الانشقاق والتلاقي مع “يسار” حزب المحافظين والليبراليين الديمقراطيين لتشكيل حكومة وطنية.
يبدو أن هذا هو السبيل الوحيد أمام الطبقة الحاكمة البريطانية لمنع صعود حكومة بزعامة جناح كوربين. لكنها إستراتيجية محفوفة بالمخاطر، إذ يمكنها أن تتسبب في حدوث استقطاب شديد، ودفع حزب العمال أبعد نحو اليسار. في وقت الأزمة العميقة من شأن وجود حزب العمال في المعارضة أن يمكنه من استعادة شعبيته، مما سيمهد الطريق لتشكيل حكومة عمالية يسارية. لقد هدد جنرالات الجيش البريطاني بالفعل بالقيام بانقلاب في حالة ما إذا وصل كوربين إلى السلطة.
قالت التقارير إن جنرالا كبيرا في الجيش قد حذر من أن حكومة جيريمي كوربين قد تواجه “تمردا” من جانب الجيش إذا ما حاولت استهداف وضعه. وقال لصحيفة صنداي تايمز: «إن الجيش لن يسانده. إن هيئة الأركان العامة لن تسمح لرئيس وزراء أن يهدد أمن هذا البلد وأعتقد أن الناس سيستعملون كل وسيلة ممكنة صحيحة أو خاطئة للحيلولة دون ذلك. لا يمكنك أن تضع إنسانا خارجا عن المألوف في موقع المسؤولية عن أمن البلاد.
ستكون هناك استقالات جماعية على جميع المستويات، وستواجه احتمالا حقيقيا جدا لحدث سيكون فعليا بمثابة تمرد.» (صحيفة الإندبندنت، 20 شتنبر 2015)
سيفتح هذا على الفور الباب أمام احتداد الصراع الطبقي واندلاع أزمة ثورية في بريطانيا.
إن المنظور الآن هو حدوث أزمة وانقسام في حزب العمال، وهو ما سوف يتيح إمكانات أكبر للتيار الماركسي. لكن أولويتنا ما زالت هي كسب الشباب وتثقيفهم. سوف يوفر لنا ذلك الكوادر التي سنحتاجها إذا أردنا الاستفادة من الإمكانيات المتاحة. هذه ليست أزمة عادية، فالوضع يحبل بانعطافات حادة ومفاجئة، لذلك يجب علينا أن نتوقع ما هو غير متوقع، ونمتلك القدرة على تغيير التكتيكات في غضون أربع وعشرين ساعة.
كل هذه الأحداث هي انعكاس للتغيير العميق الذي يجري في أعماق المجتمع. وقد عبر تروتسكي عن ذلك بشكل جيد بحديثه عن السيرورة الجزيئية للثورة الاشتراكية، أي السيرورة التي تتراكم خلالها تدريجيا سلسلة من التغيرات الصغيرة حتى تصل إلى تلك النقطة الحرجة حيث يتغير الكم إلى كيف.
أوهام البرجوازية
مع انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة ظهرت أوهام كبيرة عند البرجوازية الأوروبية حول إمكانية تحقيق الازدهار الاقتصادي الدائم والمزيد من التكامل الأوروبي الذي من شأنه أن يمكن أوروبا (تحت الهيمنة الألمانية) من توسيع حدودها حتى منطقة الأورال. قامت البرجوازية الأوروبية، المخمورة بأحلام العظمة تلك، بالتخلي عن جزء كبير من السيادة الوطنية في بعض المناطق الحساسة جدا. وربما كان إنشاء منطقة اليورو أبرز مثال على ذلك.
سبق لنا نحن الماركسيون أن أوضحنا أنه من المستحيل أن يكون هناك اتحاد نقدي دون اتحاد سياسي. وقد توقعنا أنه سيكون من الممكن الاحتفاظ باليورو طالما بقيت الظروف الاقتصادية مواتية، لكن في حالة الركود ستعود كل التناقضات الوطنية الظهور وسينهار اليورو “وسط الاتهامات المتبادلة”. وبعد خمسة وعشرين عاما ما زال هذا التنبؤ يحتفظ بكل مصداقيته.
يدافع الماركسيون بشكل لا لبس فيه عن إلغاء كل الحدود وتوحيد أوروبا. لكن في ظل الرأسمالية يبقى هذا المنظور مجرد يوتوبيا رجعية. وقد تبين الجانب الرجعي في المعاملة الوحشية التي عوملت بها اليونان من طرف بروكسل وبرلين. يدافع الاتحاد الأوروبي، في ظل هيمنة أصحاب الأبناك والرأسماليين، عن سياسة التقشف الدائم. ويمكن لزمرة غير منتخبة وغير مسؤولة من البيروقراطيين أن تملي السياسات وتبطل قرارات الحكومات المنتخبة، مثلما حدث مع حكومة سيريزا في اليونان.
وفي إطار التحالف مع الناتو والإمبريالية الأمريكية يلعب الاتحاد الأوروبي دورا رجعيا على الصعيد العالمي أيضا. لقد تدخل في البلقان، حيث كان له دور أساسي في جريمة تقطيع أوصال يوغوسلافيا. وشارك في مؤامرة تفكيك تشيكوسلوفاكيا – وهو ما لم يستشر فيه أبدا لا التشيك ولا السلوفاك. وقد تسبب تدخله في أوكرانيا، إلى جانب الإمبريالية الأمريكية، في الفوضى الكارثية الحالية. كل هذا كان في الأساس لمصلحة الإمبريالية الألمانية، التي هي السيدة الحقيقية للاتحاد الأوروبي، وتسعى جاهدة لتأكيد سيطرتها على أوروبا الشرقية والبلقان.
تجد القوى الامبريالية الأوروبية الأخرى، وفي المقام الأول بريطانيا وفرنسا، نفسها الآن في دور الشريك الصغير التابع لألمانيا. لكنها، هي أيضا، لديها مصالحها الامبريالية الخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، والتي تواصل الدفاع عنها تحت لواء الاتحاد الأوروبي. قاد الفرنسيون والبريطانيون حملة قصف ليبيا، وكان البريطانيون الحلفاء الأكثر حماسا للولايات المتحدة الأمريكية في غزوها الإجرامي للعراق. والآن تلعب فرنسا دورا مماثلا في سوريا. جميعهم يسعون لتحقيق مصالحهم الكلبية الخاصة بهم، وذلك تحت راية “المهام الإنسانية”، بطبيعة الحال.
تمثل اتفاقية شنغن، إلى جانب اليورو، واحدة من الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي. لقد خفضت وقت وتكلفة نقل البضائع في جميع أنحاء أوروبا لأن الشاحنات لم تعد مضطرة للانتظار ساعات طويلة لعبور الحدود الدولية. واستفاد السياح والناس الذين يعيشون في المدن الحدودية، لأنه لم تعد هناك حاجة لجوازات السفر والتأشيرات. لقد تم التخلص من التبذير السخيف للمال على مراقبة الحدود التي عفا عليها الزمن. كان من المفترض أن تكون هذه المعاهدة خطوة أساسية في اتجاه خلق أوروبا فيدرالية.
عام 1995 ألغت اتفاقية شنغن الرقابة على الحدود بين البلدان الموقعة عليها، وخلقت سياسة تأشيرات مشتركة بين 26 بلدا. ولكن الآن بدأت السيرورة نحو مزيد من التكامل الأوروبي تمشي في الاتجاه المعاكس. وقد انفضحت أزمة الاتحاد الأوروبي بشدة بسبب قضية اللاجئين.
أوروبا وأزمة اللاجئين
مع مجزرة نوفمبر 2015 في باريس، صار العمال يدفعون ثمن البربرية والرعب الذي نشرته الإمبريالية في الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت وضع وصول الآلاف من الناس، اليائسين الفارين من ويلات الحرب والجوع والقهر، حكومات أوروبا أمام معضلة عويصة. في الواقع هناك أزمة لاجئين عالمية وليست مجرد أزمة شرق أوسطية. فعلى الصعيد العالمي بلغ عدد النازحين بسبب الحروب واضطهاد الأقليات وانتهاك حقوق الإنسان ما يقرب من 60 مليون نسمة في نهاية عام 2014. هذا انعكاس واضح للأزمة العالمية للنظام الرأسمالي وعدم قدرته على أن يوفر للناس أبسط حقوق الإنسان، أي الحق في الحياة. وقد أدى تدفق اللاجئين من سوريا وأفغانستان وغيرهما من البلدان التي مزقتها الحرب والتي تعاني من الفقر في العالم، إلى تزايد المطالب بتشديد الرقابة على الحدود.
كانت أنجيلا ميركل سريعة في فتح ذراعيها للاجئين الفقراء الذين كانوا يطرقون بابها. أحد الأسباب بدون شك هو محاولة الاستفادة من مشاعر التعاطف الحقيقية الذي أبداها، بشكل طبيعي، كثير من الناس في ألمانيا وجميع البلدان الأوروبية الأخرى، لأن الناس العاديين، الذين ليست أفكارهم وأفعالهم مدفوعة بالحسابات الباردة التي تحرك أصحاب الأبناك والرأسماليين، دائما ما يبدون التعاطف والتضامن مع الفقراء والمضطهدين. والسبب الآخر كان هو مصلحة الشركات الكبرى في سياسة الباب المفتوح، ليس من منطلق التعاطف مع معاناة الآخرين، بل كوسيلة لتأمين كميات كبيرة من اليد العاملة البشرية بأسعار زهيدة.
لكن مشاعر ميركل الرقيقة لم تدم طويلا. كانت ألمانيا تتوقع استقبال أكثر من مليون طالب لجوء عام 2015. لكن الهجمات ضد ملاجئ مهاجرين في ألمانيا تتزايد مع ارتفاع أصوات أحزاب اليمين المناهضة للهجرة مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا” (Alternativ für Deutschland). والآن ها هي ميركل تتوسل لتركيا ليس فقط لوقف تدفق اللاجئين بل لإعادتهم. تطالب برلين بشكل عاجل بالتوزيع النسبي للمهاجرين بين مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي – وهو الاقتراح الذي لم يلاق حماسة كبيرة في لندن وباريس، ولاقى الرفض الصريح في وارسو وبودابست.
ظهرت تناقضات حادة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. اتهمت السلطات الفرنسية والنمساوية روما بالسماح لطالبي اللجوء (بل وحتى تشجيعهم) لمغادرة إيطاليا وهددت بإغلاق حدودها مع إيطاليا؛ في الواقع نفذت فرنسا تهديدها وقامت لفترة وجيزة بإغلاق الحدود في أواخر يونيو. توجد ألمانيا، التي تعتبر أغنى بلد في أوروبا، في وضع يمكنها من استيعاب عدد كبير من اللاجئين. لكن البلدان الأخرى ليس لها نفس الحظ. لقد استقبلت إيطاليا واليونان اللاجئين أكثر من معظم البلدان الأخرى. وتطالبان مرارا بالمزيد من الموارد وتطبيق حصص الهجرة في الاتحاد الأوروبي. لكن هذه النداءات سقطت على آذان صماء، فقد رفضت بلدان وسط وشرق أوروبا على الفور فكرة الحصص.
والآن يطرح المشكل التالي: ما الذي يجب القيام به بالضبط تجاه اتفاقية شنغن، التي تجعل من الممكن للمهاجرين التحرك بحرية بين الدول الأعضاء. وحتى قبل أحداث باريس قال الرئيس البولندي للمجلس الأوروبي، دونالد توسك: «دعونا نكون واضحين، إن مستقبل شنغن على المحك والوقت آخذ في النفاد… يجب علينا استعادة السيطرة على حدودنا الخارجية». وقد قدمت هجمات باريس للحكومات المبرر الملائم من أجل فرض مراقبة “مؤقتة” على الحدود، ليس فقط من طرف فرنسا، بل كذلك من طرف بلدان أخرى، بما في ذلك ألمانيا والسويد.
في جميع أنحاء أوروبا هناك شعور بالضيق المتزايد وعدم الثقة والعداء تجاه الاتحاد الأوروبي. وبعد المعاملة الوحشية التي تعرضت لها اليونان، هناك تزايد للمعارضة ضد سياسية بروكسل من طرف العمال والشباب في البلدان الأوروبية الجنوبية التي تعارض التقشف. وعلى الطرف الآخر هناك معارضة من الأحزاب اليمينية الشعبوية والمعادية للمهاجرين في ألمانيا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وبلدان أخرى في شمال أوروبا.
كلما طالت مدة فرض تلك البلدان للرقابة على حدودها أو إغلاقها، كلما زاد ذلك في ضرب مبدأ أوروبا المفتوحة. صعود الأحزاب القومية والمناهضة للهجرة في ألمانيا وفرنسا وفنلندا والدنمارك والسويد والمجر يضع مزيدا من الضغوط على الحكومات الأوروبية لإغلاق الحدود. من الواضح أن أيام اتفاق شنغن صارت معدودة. وحتى إذا لم يتم إلغاؤها تماما، فمن المؤكد أنه ستتم مراجعتها إلى درجة أنه لن يبق الكثير من مبدأ حرية الحركة في أوروبا.
تسعى الدول الأعضاء لأن يتم إعطاؤها المزيد من السلطة التقديرية فيما يتعلق بمسألة إعادة فرض الرقابة على الحدود. وسواء أدخلت الإصلاحات على اتفاقية شنغن أم لا، فإنه سوف تكون هناك رقابة بوليسية أكثر صرامة في محطات القطارات والحافلات وفي المطارات. وهذا ما بدأ يحدث بالفعل منذ الآن. سيتم تشديد قوانين الهجرة لتجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية. البلدان التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية شنغن، مثل رومانيا وبلغاريا، سوف تطالب برقابة أكبر. بولندا والمجر، اللتان كانتا تابعتان للإمبريالية الألمانية، دخلتا الآن في صراع مباشر مع برلين حول قضية اللاجئين.
سوف يؤدي تقويض اتفاقية شنغن بالضرورة إلى تقييد حرية الحركة للشعوب، والتي هي واحدة من الركائز الرئيسية للاتحاد الأوروبي. وبمجرد إضعاف أساس واحد، سيفتح الباب أمام ضرب أساسات أخرى على نحو مماثل. إن إزالة أو إضعاف حرية تنقل الأشخاص يمكن أن يشكل خطوة نحو إضعاف الحركة الحرة للسلع، وهذا ما سوف يشكل، إلى جانب انهيار اليورو -وهو الأمر الممكن جدا-، نهاية الاتحاد الأوروبي كما نعرفه. لن يتبق شيء من حلم الوحدة الأوروبية سوى قشرة فارغة.
في ظل الرأسمالية، سوف تبقى فكرة قارة بدون حدود مجرد حلم بعيد المنال. إن مهمة توحيد أوروبا -وهي المهمة التقدمية والضرورية تاريخيا- لا يمكن تحقيقها إلا عندما سيتحرك عمال أوروبا للإطاحة بديكتاتورية البنوك والاحتكارات ، تحطيم الاتحاد الأوروبي الرأسمالي الحالي ووضع الأسس لاتحاد حر وطوعي للشعوب على أساس فدرالية الدول الاشتراكية الأوروبية، باعتبارها خطوة في اتجاه الفدرالية الاشتراكية العالمية .
العلاقات الدولية

تعتبر المرحلة التي نمر منها اليوم، من وجهة نظر العلاقات الدولية، مرحلة دون سابقة تاريخية. في الماضي كان هناك دائما ما لا يقل عن ثلاث أو أربع قوى عظمى تتنافس للهيمنة على الصعيد الأوروبي أو العالمي. وهكذا فقد كانت العلاقات الدولية، لفترات طويلة، تميل نحو نوع من التوازن الذي كانت تتخلله الحروب بشكل دوري.
وينعكس الاضطراب الاقتصادي في زيادة الاضطراب السياسي كذلك. منذ الحرب العالمية الثانية، لم يسبق للعلاقات الدولية أن كانت مشحونة بالتوترات مثلما هي عليه الآن. لقد أدت النزعات التوسعية العدوانية للإمبريالية الأمريكية، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، إلى خلق حالة من الفوضى في كل مكان: في البلقان وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا وباكستان ومؤخرا في أفريقيا أيضا.
سبق لليون تروتسكي أن توقع، قبل الحرب العالمية الثانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبرز باعتبارها القوة العالمية المهيمنة، لكنه أضاف أنه سيكون للولايات المتحدة ألغام في أساساتها. وقد تأكد هذا التوقع بشكل كبير مع تصاعد الإرهاب في الولايات المتحدة وعالميا وعجز الولايات المتحدة عن فرض إرادتها مثلما كانت تفعل في الماضي.
عام 1945، فرضت الولايات المتحدة نفسها باعتبارها قوة عالمية مهيمنة. وقد رافق صعود القوة الأميركية انهيار قوة الدول الإمبريالية الأوروبية. لقد حطمت الحرب العالمية الثانية قوى كل من اليابان وأوروبا الغربية. وسيطرت الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، على الرغم من أنها واجهت قوة الاتحاد السوفياتي.
قام توازن غير مستقر استمر حوالي نصف قرن تقريبا، لم يكن خلاله مركز السلطة لا في لندن ولا في باريس ولا في وارسو، بل كان في واشنطن وموسكو. في ذلك الوقت لم يكن في مقدور الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في بلدان مثل العراق وسوريا ويوغوسلافيا، التي كانت في دائرة النفوذ السوفياتي، فبالأحرى أن تفكر في التدخل في أوكرانيا أو جورجيا، اللتان كانتا ما تزالان جزءا من الاتحاد السوفياتي.
لكن كل شيء تغير مع انهيار الاتحاد السوفياتي، قبل أكثر من عقدين من الزمن. وجدت موسكو، التي كانت تعيش أزمة داخلية وتواجه ضغط حركة احتجاج واسعة النطاق، نفسها مضطرة للانسحاب من أوروبا الشرقية. وتم حل حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي، لكن حلف شمال الأطلسي استمر في الوجود باعتباره تهديدا محتملا لروسيا.
في سنوات الثمانينات قدم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وعدا شفهيا للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف بأن الغرب ليست لديه أية نية في توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا إلى منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي. وكانت تلك مجرد كذبة. فخلال العقدين الماضيين عملت الولايات المتحدة بشكل منهجي على توسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، ليضم العديد من البلدان التي كانت في السابق ضمن منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي.
كانت الإمبرياليتان الألمانية والأمريكية وراء تفكك يوغوسلافيا، وهو ما شكل حدثا رجعيا بشكل مطلق بالنسبة لشعوب يوغوسلافيا وإذلالا كاملا لروسيا. وعلى الرغم من أن روسيا كانت لها قوات مرابطة هناك، فإن الغرب تمكن من بسط سيطرته في حين اكتفى الجيش الروسي بدور المتفرج العاجز.
في الماضي كان في إمكان التناقضات على الصعيد العالمي أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية، لكن هذا لم يعد ممكنا اليوم. إن ميزان القوى على الصعيد العالمي لا يسمح بذلك. لكن هذا لا يعني أننا أمام حقبة من السلام. بل على العكس من ذلك، ستعبر التناقضات عن نفسها من خلال سلسلة لا تنتهي من الحروب الصغيرة، مما يؤدي إلى سفك رهيب للدماء والفوضى.
على الرغم من أن الولايات المتحدة ما تزال قوية جدا، فهي بعيدة عن أن تكون مطلقة القوة. لقد فضحت الحروب في أفغانستان والعراق حدود قوة الإمبريالية الأمريكية. فحتى أقوى دولة إمبريالية لا تستطيع أن تشارك مباشرة في عدد كبير من الصراعات في جميع أنحاء العالم. وسرعان ما تجد نفسها منهكة اقتصاديا وسياسيا، مع وقوف الرأي العام بحدة ضد التدخلات الخارجية. لقد غاب هذا الدرس عن ذهن الزمرة قصيرة النظر التي حكمت في عهد جورج دبليو بوش، لكن كان لا بد من تعلمه بشكل مؤلم من طرف خلفه.
روسيا وأمريكا
بضغط من الإمبريالية الأمريكية وسع الناتو نفوذه وصولا إلى حدود روسيا. في البداية انضمت دول البلقان إلى الحلف، وبعد ذلك بولندا. لكن عندما حاول الأمريكيون ضم جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي، كانت تلك خطوة أبعد مما ينبغي. أرسلت روسيا جيشها إلى جورجيا وسحقتها بسرعة. جاء الآن دور الأمريكيين للتعرض للإهانة، حيث استولى الروس على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي أعطتها واشنطن للزمرة الحاكمة في جورجيا، بما في ذلك حتى مقاعد المراحيض.
كان ذلك تحذيرا واضحا للأمريكيين. قال لهم الكرملين: “كفى يعني كفى!” لكن حكام الولايات المتحدة مصابون بالعمى والصمم والبكم. عندما كان الألمان على استعداد للتراجع خلال الصراع في أوكرانيا، أواخر عام 2013، قرر جون ماكين وحلفاؤه الجمهوريون التدخل والضغط على أوباما في هذه المسألة. كانوا يفكرون في توجيه ضربة قوية لروسيا انتقاما لجورجيا وجذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كانت فكرة أن بوتين سيقبل بهدوء فقدان أوكرانيا، مجرد فكرة حمقاء إلى أقصى الحدود. وكان الأكثر حماقة هو توقع تقبله لخسارة شبه جزيرة القرم، حيث تملك البحرية الروسية قاعدة كبيرة في سيباستوبول.
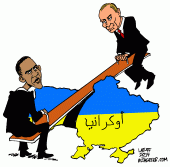
نجح الانقلاب اليميني في كييف، المدعوم من القوى القومية والفاشية المتطرفة، في إسقاط حكومة يانوكوفيتش، لكن ذلك أدخل أوكرانيا في هاوية الانهيار الاقتصادي والحرب الأهلية. الغرب، وكما كان متوقعا، لم يف بأي من الوعود التي قدمها للشعب الأوكراني، كما أنه لم يفعل أي شيء للوقوف في وجه روسيا، على الرغم من كل التهديدات التي أطلقها وصرخات الوعيد.
لم يؤد فرض العقوبات على روسيا إلى إضعاف النظام، بل أدى إلى تقويته. قبل الأزمة الأوكرانية والعقوبات الأميركية، لم يكن بوتين في موقف قوي جدا، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة “لمعاقبة روسيا” كانت لها نتيجة عكسية. تمكن بوتين من الركوب على موجة الوطنية، وعند نقطة معينة صار يتمتع بشعبية تقرب من 90٪.
ظاهريا قد يبدو متناقضا كيف أن بوتين خرج قويا من أزمات أوكرانيا وسوريا. لقد تعرضت جهود الغرب لعزله للفشل الذريع. إنه الآن الرجل الذي يوجه الأحداث في سوريا. وحتى لو استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على عقوباتها على شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، فيمكننا التنبؤ بثقة أن حلفائها الأوروبيين سوف يرفعون عقوباتهم. يحتاج الاقتصاد الأوروبي الغارق في الأزمة للسوق الروسية والغاز الروسي بقدر ما تحتاج البرجوازية الأوروبية إلى المساعدة الروسية لتنظيف الفوضى في سوريا ووقف تدفق اللاجئين.
لكن إذا نظرنا أعمق في الوضع سوف يتضح أنه ليس مستقرا مثلما يبدو في الظاهر. الاقتصاد الروسي يواصل الانخفاض، وقد تضرر بسبب انخفاض سعر النفط والعقوبات الغربية. الأجور الحقيقية آخذة في الهبوط. والطبقة الوسطى لم يعد في إمكانها أن تقضي عطلة نهاية أسبوع لطيفة في لندن وباريس. إنها تبدي تذمرها لكنها لا تفعل شيئا. تأثر العمال الروس بالدعاية الرسمية في أوكرانيا، وأثارت استنكارهم أنشطة الفاشيين والقوميين المتطرفين الأوكرانيين، وكان بوتين قادرا على الاستفادة من تعاطفهم الطبيعي مع إخوانهم وأخواتهم في شرق أوكرانيا. وعلى هذا الأساس ارتفعت شعبيته.
قد يكون بوتين قادرا على مواصلة إحكام قبضته على السلطة لبعض الوقت، لكن لكل شيء حدود، وفي النهاية يقدم التاريخ دائما حكمه. لقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى هبوط حاد في مستويات معيشة العديد من العمال، خصوصا الذين يعيشون خارج بيترسبورغ وموسكو. الجماهير صبورة، لكن صبرها له حدود واضحة. رأينا الدليل على ذلك في نهاية عام 2015 عندما دخل سائقو شاحنات المسافات الطويلة في الإضراب. كان ذلك مؤشرا صغيرا ربما، لكنه مؤشر رغم كل شيء، وعاجلا أو آجلا سوف يجد استياء العمال الروس تعبيرا له في احتجاجات وإضرابات أقوى.
في مقاله: “كتاب الثورة المغدورة تحفة ماركسية”، قدم آلان وودز التحليل التالي:
«إن مشهد قيام الشركات الاحتكارية الروسية الكبيرة بإثراء نفسها على حساب الشعب تثير عنده شعورا بالغضب الشديد. ليست روسيا مثل الغرب حيث تعود الناس منذ أجيال على الرأسمالية. الناس في الغرب قد لا يعجبهم ما ينتج عن الرأسمالية، لكن معظمهم يعتبرونها حتمية وطبيعية تقريبا. إنهم لا يشككون عادة في حق الرأسماليين الإلهي في امتلاك الصناعة واستغلال اليد العاملة. لكن في روسيا الأمور مختلفة. فطيلة أجيال تعود الشعب على مجتمع حيث كانت وسائل الإنتاج في يد الدولة وكانت الدولة، على الأقل اسميا، من المفترض أنها تخدم مصالح الشعب العامل. الأغلبية الساحقة تعتقد أن أصحاب المؤسسات التي تمت خصخصتها ليسو سوى لصوص سرقوا ممتلكات الشعب. وهذا صحيح تماما. ليست للرأسمالية أية شرعية في نظر الطبقة العاملة. هذا فرق مهم جدا بين روسيا وبين الغرب، وهو الفرق الذي يمكن أن تكون له عواقب هامة في المرحلة المقبلة».
ويمكن أن ينطبق هذا أيضا على غيرها من البلدان الستالينية السابقة. كان سقوط الاتحاد السوفييتي وبلدان الاقتصادات المخططة أكبر هزيمة للبروليتاريا العالمية، إلى جانب الحرب العالمية الثانية. ومع الفقر الاقتصادي الذي نتج عن ذلك شهدنا أيضا الفقر الاجتماعي والأخلاقي. شهدت هذه البلدان الاغتراب والفساد والمذابح التي اقترفها اليمين المتطرف وطاعون الانقسامات القومية العنيفة، بينما وصلت الدعاية الرأسمالية والمناهضة للشيوعية مستويات هستيرية وسممت الوعي. ومع ذلك فإنه سيكون من الخطأ استخلاص استنتاجات متشائمة من هذا. لم تشهد الجماهير في أوروبا الشرقية مرحلة الطفرة الاقتصادية الرأسمالية لما بعد الحرب. وعلى عكس الطبقات العاملة من الدول الغربية، لن تكون الأوهام في الإصلاحية قوية، ويمكن التوصل إلى استنتاجات ثورية بسرعة مدهشة. وليست الانتفاضات في البوسنة وبلغاريا والتمرد الذي شهدته أوكرانيا والإضرابات الكفاحية جدا في بولندا وسلوفاكيا سوى بعض الأمثلة عن الطبيعة المتفجرة للأوضاع التي ستشهدها الدول العمالية المشوهة سابقا.
أحس بوتين بما يكفي من الثقة لشن هجوم عسكري في سوريا، وهو الهجوم الذي أخذ الغرب على حين غرة. ونتيجة لذلك، فإن الرجل الذي كان من المفترض أن يكون منبوذا على الساحة الدولية، صار الآن، في واقع الحال، المتحكم في مصير سوريا.
لم يمر وقت بعيد منذ أن كان أوباما وكيري ينفثان النار ضد الرجل الموجود في الكرملين. ثم فجأة وصل بوتين إلى الأمم المتحدة وأصبح مركز الاهتمام. بل إنه ظهر إلى جانب الرئيس الأميركي، مع مصافحة حظيت بتغطية إعلامية، على الرغم من أنها لم تكن حميمية جدا بالتأكيد.
كان الهدف الرئيسي لبوتين في سوريا هو الحفاظ على الأسد في السلطة، باعتباره حليفا موثوقا به لروسيا، ووقف تقدم المتمردين الإسلاميين، الذين كانوا يقتربون كثيرا من المناطق الرئيسية التي تدعم الأسد في الغرب، وحيث توجد القواعد الروسية. على الأقل يمكن القول بأن نوايا بوتين كانت واضحة لا لبس فيها، وهذا ما أعطاه مظهر القوة.
أوباما، على العكس من ذلك، رجل لديه كونغرس منقسم بشكل حاد ويواجه معارضة جمهورية مسعورة. إنه يدرك تمام الإدراك خطورة التورط في حرب على الأرض في العراق. لقد سئم الشعب الأمريكي من المغامرات الخارجية، وهذا، وليس أي اعتبارات سلمية أو إنسانية، هو السبب وراء سعيه المحموم لتجنب إقحام القوات الأمريكية على الأرض في سوريا.
ليس من الصعب فهم السبب في هذا التناقض الذي تعرفه سياسة الولايات المتحدة في سوريا. كانت العمليات العسكرية الجدية الوحيدة ضد الجهاديين في سوريا هي تلك التي نفذها الروس بالتعاون مع جيش بشار الأسد. والعمليات العسكرية الجدية الوحيدة ضد داعش في العراق (بصرف النظر عن الأكراد الذين يقاتلون في مناطقهم)، لا يقوم بها ما يسمى بالجيش العراقي وداعميه الأمريكان، بل تلك التي تنفذها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران وعناصر من الجيش الإيراني.
اضطر الأمريكيون عمليا إلى الاعتراف بهذا الواقع، وقبلوا بمطالب روسيا وإيران باستمرار بشار الأسد في السلطة خلال المستقبل المنظور. وهذا هو السبب الذي دفع أوباما للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الأسلحة النووية، وهو الاتفاق الذي رفضته كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وأصدقائهما الجمهوريين في الكونغرس. إنه باختصار مضطر لمواجهة الجميع في وقت واحد، وهذا ما يعطيه مظهر الضعف. عاد الرئيس الروسي إلى موسكو وهو مقتنع بأن الأمريكيين سيتصرفون فيما يتعلق سوريا بالضبط مثلما تصرفوا فيما يتعلق بأوكرانيا، أي أنهم لن يقوموا بشيء يذكر، ولم يكن مخطئا.
ضاعف الروس شحنات الأسلحة لدمشق، وأغرقوها بالأسلحة والمعدات. كما شنوا سلسلة من الغارات الجوية ضد داعش وأهداف أخرى. لقد غيرت الغارات الروسية على نحو فعال ميزان القوى على أرض المعركة. وقد أجبر هذا الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على تصعيد حملة القصف، والتي كانوا يقومون بها حتى ذلك الحين بشكل فاتر، وتهدف إلى احتواء داعش بدل إلحاق الهزيمة بها. وهكذا، ففي كل خطوة يقوم الروس بإحراج الدبلوماسية الأمريكية. في سوريا اضطرت واشنطن لابتلاع كبريائها وقبول شروط موسكو. وقد أدى هذا إلى تغيير جذري في ميزان القوى، ليس فقط في سوريا، بل في الشرق الأوسط ككل.
الشرق الأوسط
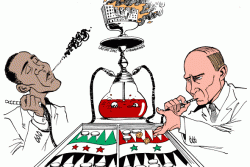
“C’est pire qu’un crime, c’est une faute” ( “إنها أسوأ من جريمة، إنها خطأ”). يمكن لهذه الكلمات الشهيرة المنسوبة للويس أنطوان هنري دو بوربون كوندي، دوق إنيين (Enghien) أن تكون بمثابة شاهد قبر مناسب للسياسات الخارجية للإمبريالية الأمريكية في العقود الأخيرة.
إن النيران التي تحاصر منطقة الشرق الأوسط بأكملها هي نتيجة مباشرة للغزو الإجرامي للعراق، ولاستمرار تدخل الإمبريالية الأمريكية في تلك المنطقة المنكوبة. وبعد أن ضرب الأمريكيون وحلفائهم استقرار العراق وحولوه إلى بلد مدمر مزقته الحرب، ساعدوا وحرضوا القوى الرجعية في سوريا، التي صارت تشكل الآن تهديدا خطيرا لمصالحهم. لكن الحرب المزعومة ضد الإرهاب، التي شنت منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما في العراق، لم تحققت أي شيء على الإطلاق.
لم يفهم الساسة في واشنطن أي شيء، ولم يتوقعوا أي شيء. ومن المفارقات أنهم بتدميرهم لدولة صدام حسين والجيش العراقي، قلبوا موازين القوى في المنطقة، وخلقوا فراغا استفادت منه عدوتهم القديمة إيران. عندما اقتحم الجيش الأمريكي العراق لم يكن هناك وجود لتنظيم القاعدة. لكن كل المنطقة صارت الآن في قبضة الجنون الجهادي. هذه نتيجة مباشرة لغزو الإمبريالية الأمريكية.
لقد انتبه الأمريكيون متأخرين إلى سوء الأوضاع التي خلقوها هم أنفسهم والتي صارت الآن تهددهم. تواجه الولايات المتحدة الآن التهديد المتزايد للعنف الجهادي الذي ينتشر كوباء لا يمكن السيطرة عليه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبر الصحراء للانفجار في نيجيريا ويصيب البلدان المجاورة في النيجر وتشاد والكاميرون.
كيف ردت أكبر قوة عسكرية في العالم على هذا التهديد؟ لقد اضطرت للاقتصار على عمليات قصف من ارتفاع كبير. لكن ليس سرا أن القصف وحده لا يمكن من كسب الحروب، وخاصة مثل تلك الحروب التي تجري في العراق وسوريا. لقد قصفت أمريكا وحلفاؤها مواقع داعش لأكثر من سنة، لكن يبدو أن تأثير ذلك على داعش كان هزيلا.
صحيح أن تلك الحركة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية بعقوباتها القاسية واللاإنسانية وعمليات الصلب وقطع الرؤوس والرجم حتى الموت وقمع النساء والهجمات التي تشنها ضد الثقافة والتعليم، تمثل نزعة رجعية وردة إلى الماضي المظلم والبدائي. لكن كل ذلك ليس سوى صورة طبق الأصل لجرائم الإمبريالية والتفجيرات العشوائية والتعذيب وإساءة معاملة السجناء في أبو غريب وغوانتانامو. لقد تسببت التدخلات الإمبريالية في الشرق الأوسط، منذ عام 2001، في مقتل ما بين 1,3 و2 مليون شخص، وأدت إلى نزوح الملايين، الذين يعيشون الآن في ظروف قاسية. وهي المآسي التي يتم إدراجها تحت عنوان “أضرار جانبية”.
يحتاج الامبرياليون لذريعة لعدوانهم الإجرامي في منطقة الشرق الأوسط، وقد وفرتها لهم جرائم الجهاديين. لقد صنعت آلة الدعاية الإمبريالية بدأب الانطباع بأن داعش مطلقة القوة، لكن الأحداث سوف تظهر أن داعش ليست بكل تلك القوة التي تبدو عليها. ومنذ تدخل الروس سرعان ما أجبرت داعش وغيرها من الجماعات الجهادية على اتخاذ موقف دفاعي.
لقد غير التدخل الروسي كل شيء. وقد اضطر الأمريكيون إلى تكثيف نشاطهم. لهزيمة داعش يحتاجون لقوات على الأرض، لكن شريطة ألا تكون قوات أمريكية. يشارك عدد قليل من القوات الخاصة الأميركية على الأرض، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى تلك المشاركة.
لكن لسوء حظ أوباما، لهزيمة داعش لا تكفيه قوات صغيرة، بل هو في حاجة لقوات كبيرة. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ يضع بعض المتفائلين، الميؤوس من شفائهم، آمالهم في الجيش العراقي، لكن هذا من أكثر الأوهام تهافتا. عندما دمر الأمريكيون الجيش العراقي في عام 2003، أزالوا القوة العسكرية الوحيدة في المنطقة القادرة على مواجهة قوة إيران. والآن لا تصلح بقايا تلك القوة المثيرة للشفقة والمحطمة المعنويات لا لمحاربة داعش ولا لأي شيء آخر. لقد تبين عجز الجيش العراقي التام عن القتال خلال الصيف الماضي عندما فر كالأرانب المذعورة، وترك الموصل تحت رحمة جحافل داعش.
وفي الوقت نفسه، اتضح أن “المعارضة المعتدلة” داخل سوريا مجرد وهم. كل المنظمات التي تحارب الأسد، ومع استثناءات طفيفة، هي منظمات متعصبين إسلاميين من هذا النوع أو ذاك. أولويتهم هي محاربة حكومة الأسد أكثر من القتال ضد داعش. والدور الرئيس لهؤلاء “المعتدلين” هو توفير جسر لتمرير الأسلحة الأمريكية إلى الجماعات الجهادية. أعلن الأمريكان أنهم سيشكلون قوة قتالية من 5000 من “المعتدلين”، لكنهم اعترفوا الآن أنه لم يتبق منهم في الميدان سوى حفنة صغيرة (أين هم وماذا يفعلون؟ لا أحد يعرف!). بينما قتل الآخرون على أيدي الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة – والتي تلقت معلومات استخباراتية عن أماكن وجودهم من تركيا حليفة الولايات المتحدة- أو أنهم التحقوا بصفوف القاعدة وسلموها أسلحتهم.
في النهاية اضطرت الولايات المتحدة إلى التخلي عن كل خططها في سوريا. تم التراجع بشكل كبير عن خطة دعم المتمردين “المعتدلين”. وفي غضون ذلك اضطرت إلى الوقوف بكل ثقلها وراء القوات الكردية المنظمة تحت لواء وحدات حماية الشعب (YPG). وحول وحدات حماية الشعب أنشأت القوات السورية الديمقراطية (SDF) والمؤتمر السوري الديمقراطي.
أثبتت وحدات حماية الشعب فعاليتها الكبيرة في سوريا، وذلك أساسا لأنها ميليشيا شعبية قائمة على أساس برنامج ديمقراطي وغير طائفي. وهي، بقواتها البالغ عددها ما بين 50.000 و70.000 مقاتل، تمثل قوة لا يتفوق عليها من حيث العدد سوى جيش الأسد، الذي هو أقل منها في مجال التدريب والروح المعنوية والتحفيز. وبعد تشكيل المؤتمر السوري الديمقراطي أصبحت بحكم الواقع دويلة كردية.
تعتبر وحدات حماية الشعب ولا شك الحركة الأكثر تقدمية في الشرق الأوسط في الوقت الراهن. ومع ذلك يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة لأسباب رجعية بالكامل. تهدف الإمبريالية الأمريكية إلى تفكيك سوريا إلى دويلات صغيرة تديرها الميليشيات وأمراء الحرب المتصارعين والذين يمكنها دفعهم ضد بعضهم البعض للحفاظ على سيطرتها. ليس شعار تقرير المصير للدول الصغيرة بالنسبة للإمبرياليين سوى فخ ووسيلة رجعية للخداع. إنهم في الوقت الحاضر مضطرون للاستفادة من الأكراد في القتال ضد داعش نيابة عنهم، لكن هؤلاء الإمبرياليين سيحاولون حتما، في مرحلة معينة، استخدام تكتيك فرق تسد هذا ضد الأكراد أنفسهم. إن الماركسيين، وفي نفس الوقت الذي يدعمون فيه الجوانب التقدمية للحركة الكردية ويدافعون عن حق الشعب الكردي في تقرير المصير، يحذرون من خلط القضية الكردية مع مؤامرات الإمبريالية الأمريكية، وينتقدون تناقضات وأوجه قصور القيادة الكردية.
لقد عمق هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه الأكراد من الخلافات بين واشنطن وبين حليفتها تركيا، التي بدأت تنظيمات القاعدة التابعة لها تخسر الدعم المباشر وغير المباشر الذي كانت تتلقاه من الولايات المتحدة. تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني على أنهما تهديد لها، وقد أثارت السياسة الأمريكية الجديدة سخطها. أدى هذا الوضع إلى حالة غريبة من الحرب المنخفضة الحدة، التي تختمر بين قوات الدفاع الذاتي المدعومة من الولايات المتحدة وبين التنظيمات الإسلامية المدعومة من طرف السعودية وتركيا، وهو ما يمكن له أن ينفجر على شكل حرب واسعة النطاق في أي لحظة.
وإلى جانب الدعم الذي تقدمه للأكراد، أدركت الولايات المتحدة أنها تحتاج القوات المدعومة من إيران، فضلا عن نظام الأسد، لتحقيق الاستقرار في سوريا والحيلولة دون سقوطها في يد الجماعات الأصولية الإسلامية. يعلم الجميع أن وطأة القتال في العراق، وبصرف النظر عن الأكراد الذين يهتمون بشكل رئيسي بالقتال في مناطقهم، إنما تتحملها الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران والحرس الثوري، وأن تدريب الجيش العراقي وقيادته تتم على يد الضباط الإيرانيين. إن محاولة بناء قوة قتالية على أساس “الإسلاميين المعتدلين” محكومة بالفشل أيضا. فالفصائل المختلفة أكثر حرصا على محاربة حكومة الأسد ومحاربة بعضها البعض من حرصها على قتال داعش. وقد تصاعدت الاشتباكات بين مجموعات القاعدة وبين جماعات تابعة للقوات الديمقراطية السورية التي شكلت حديثا (وهي مجموعة مدعومة من الولايات المتحدة تتكون من وحدات حماية الشعب الكردي وبقايا من الجيش الحر مشكوك في انتمائها للفكر الجهادي).
ولذلك تم نسيان كل ذلك الإصرار على تغيير النظام في سوريا وأجبر الأمريكيون على التراجع عن موقفهم العدائي السابق تجاه طهران وعلى التوصل إلى حل وسط هش مع إيران بشأن برنامجها النووي، مع وعد بخفض العقوبات. كان ذلك بدون شك إهانة كبيرة لواشنطن ونصرا دبلوماسيا كبيرا لطهران. تمتلك إيران الآن سيطرة فعلية على جنوب وشرق ووسط العراق (بينما داعش والأكراد يسيطران على الغرب والشمال) ولها كذلك تأثير كبير في سوريا، فضلا عن معظم لبنان، حيث قاعدة حزب الله القوي الموالي لإيران.
وجدت واشنطن نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الخيار الوحيد القابل للتطبيق، أي توقيع صفقة مع إيران (وروسيا). لكن أليست هذه هي نفس إيران تلك التي كانت، منذ وقت ليس ببعيد، هدفا للهجوم في الصحافة الأمريكية باعتبارها جزءا من “محور الشر”؟ لم يمر وقت طويل منذ أن كان جون كيري ينفث النار في خطاباته العدوانية ضد طهران. والآن فجأة صار كل شيء جميلا ومشرقا في تعامل واشنطن مع طهران. ألقى السيد كيري خطابات تصالحية، وظهر مبتهجا مع ابتسامة واسعة وهو يغني تراتيل المديح لقادة إيران نظرا لحكمتهم العظيمة واعتدالهم.
وينطبق الشيء نفسه على تعامل أمريكا مع روسيا، وإن على مستوى أعلى. فمنذ وقت ليس ببعيد كان فلاديمير بوتين يعتبر خارج حدود الحضارة، وكان رجلا يجب عدم التعامل معه ومقاطعته. والآن، فجأة، صار بطل الساعة في سوريا. تثير هذه التطورات قلقا بالغا في أنقرة والرياض. تحاول الإمبريالية الأمريكية السير في طريقين في آن واحد، وفي خضم ذلك تجد نفسها في مواجهة تناقضات جديدة وغير قابلة للحل. هذه القفزات الدبلوماسية دليل آخر على الفوضى التي أغرق الأمريكان فيها أنفسهم في الشرق الأوسط. الحكومة في بغداد تعتمد اعتمادا كبيرا على إيران. وما تخشاه السعودية، ودول أخرى في المنطقة، هو أن يتحول العراق إلى مجرد مرزبانية[6] إيرانية. ليست هذه النتيجة هي ما ترغب فيه واشنطن، لكنها النتيجة المنطقية لجميع ممارساتها.
موقفها تجاه سوريا أكثر تناقضا. فهي على المستوى العلني تواصل إدانة الأسد والشكوى من “التدخل” الروسي في سوريا، بينما في الواقع هناك انفراج في العلاقات. يشتكي الأمريكيون من أن الروس لا يعطونهم ما يكفي من المعلومات حول أهدافهم في سوريا، وأنه من المستحيل بالنسبة لهم تنسيق الغارات، وأن هناك خطر وقوع حوادث الخ، الخ. إنهم يشتكون بصوت عال من أن الروس لا يقصفون أهداف داعش فقط، بل أيضا قوى “المعارضة المعتدلة” المدعومة من الغرب، التي تهاجم الجيش السوري في الغرب. لكن الروس لا يولون اهتماما لذلك ويواصلون قصف أهدافهم بلا رحمة.
السعودية واليمن
هناك مبدأ قديم في الدبلوماسية يقول إن الدول لا أصدقاء لها، بل لها فقط مصالح. وفي الشرق الأوسط تسعى الولايات المتحدة لتحقيق التوازن بين أربع قوى إقليمية كبرى – إيران والسعودية وإسرائيل وتركيا- حيث تميل مرة نحو إحداها، وبعد ذلك تميل نحو الأخرى، في عملية بحث دائم عن التوازن. في العراق نفذ مقاتلو الولايات المتحدة غارات جوية بتنسيق مع القوات البرية الإيرانية، بينما في اليمن تؤيد الولايات المتحدة الضربات الجوية السعودية ضد الحوثيين، الذين تدعمهم إيران. تقول الولايات المتحدة إنها ستمد السعودية بشحنات أسلحة، لكنها في الوقت نفسه تحاول جاهدة إقناع طهران بأنها لا ترغب في الدخول في صدام معها بشأن اليمن.
إن الطغمة الحاكمة في السعودية هي معقل الثورة المضادة في المنطقة بأسرها. وعلى مدى عقود أيد القادة الغربيون باستمرار الأسرة المالكة السعودية الرجعية وتقبلوا بخنوع كل أفعالها المقيتة وتجاهلوا بكلبية الجرائم المشئومة لتلك المخلوقات التي تحكم الرياض، كما رأينا ذلك في جنازة الملك غير المأسوف عليه عبد الله.
هؤلاء المسلمون الملتزمون و”حماة الأماكن المقدسة”، والذين في نفس الوقت حلفاء أميركا الأكثر ولاء، قطعوا رؤوس أكثر من 50 شخصا في عام واحد فقط، ناهيك عن ممارسات صغيرة لطيفة أخرى مثل الجلد والصلب. لكن النظام السعودي الفاسد يقف على أسس هشة جدا. هناك سخط متزايد بين صفوف السكان الشيعة المضطهدين في السعودية وكذلك بين صفوف جزء كبير من الشباب. وهذا يمكنه أن يؤدي إلى انتفاضة في مرحلة معينة. لكن هناك أيضا نفاذ صبر متزايد بين المتعصبين الوهابيين الرجعيين، الذين هم أكثر تعاطفا مع داعش والقاعدة مما هم متعاطفون مع العائلة المالكة، التي يعتبرونها غير شرعية. هذا التناقض يقوض أسس النظام الذي يحاول بيأس التشبث بالسلطة.
كانت هذه هي العوامل الرئيسية التي حددت رد الفعل السعودي تجاه الأحداث في اليمن. أدت تقلبات السياسة الخارجية الأمريكية في العلاقة مع إيران إلى مزيد من التعقيدات أمام واشنطن، فقد أغضبت السعوديين والإسرائيليين، الذين يرون في إيران عدوهما الرئيسي. تمتلك إيران علاقات جيدة مع ميليشيات الحوثي الشيعية التي اجتاحت اليمن وسيطرت على عدن وطردت دمية السعودية من هناك. وردا على ذلك أمرت السعودية سلاحها الجوي بقصف المتمردين.
شكل السعوديون على عجل ائتلافا من عشر دول هدفه إغراق التمرد اليمني في الدم. وقد انضمت الولايات المتحدة وبريطانيا على مضض إلى الائتلاف، على الرغم من أنهما تجنبتا المشاركة المباشرة في عملية القصف. قامت قوات التحالف بشن قصف وحشي على البلد وعملت على تخريب بنيته التحتية وتدمير المدارس والمستشفيات وقتل عدد كبير من المدنيين. ويوجد عشرون مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات. وعلى الرغم من القصف الشديد، فإن قوات الحوثيين لم تدمر وهناك كراهية عامة تجاه السعوديين وحلفائهم بين الجماهير. ومجرد حقيقة أن الجيش الباكستاني رفض طلب السعودية له بالمشاركة في حملتها العسكرية ضد المتمردين الحوثيين، دليل كاف على أن هجوما بريا في اليمن سينتهي بكارثة.
تلعب الزمرة الحاكمة الحالية بالنار. كان الملك عبد الله شخصا حذرا جدا يفضل تجنب التورط المباشر في المغامرات الخارجية المحفوفة بالمخاطر والتي يمكن أن تضرب استقرار نظامه. لكن خلفاءه أناس حديثو نعمة منحطون جاهلون أغبياء ويبالغون في الثقة بالنفس. ولأنهم واثقون بالحصانة التي يمتلكونها، فقد شنوا حربا لا يمكنهم الانتصار فيها. تخاطر السعودية، من خلال تدخلها عسكريا في اليمن، بزعزعة استقرار نظامها أو حتى بإثارة انتفاضة ضدها.
تعمل السعودية بشكل متعمد على إثارة النزعات الطائفية الدينية ضد الحوثيين. وقد أدى ذلك إلى تعزيز مواقع تنظيم القاعدة في أجزاء واسعة من البلاد. كان إعدام نمر النمر جريمة قتل قضائية أمرت بها الزمرة الحاكمة في السعودية، وكان استفزازا متعمدا يهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة، ودفع حكومة طهران إلى القيام بعمل عسكري ضد السعودية، والتي كانت ستدعو الأمريكيين لمساعدتها.
أدى هذا على الفور إلى اقتحام السفارة السعودية في طهران وقطع السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران. كل هذا كان مدبرا بعناية. وقد سارت الأحداث بشكل مدروس، مثل خطوات راقصة باليه، لكن هذا الباليه هو رقصة الموت. لقد كانت تلك خطوة يائسة من قبل نظام يجد نفسه في ورطة كبيرة، ويواجه احتمال السقوط.
لقد أخطأت العصابة السعودية الحسابات في اليمن، وأثارت غضب الشيعة، الذين يشكلون 20٪ على الأقل من الشعب السعودي، والذين هم من بين أكثر الفئات فقرا واضطهادا. اندلعت مظاهرات حاشدة في المدن السعودية مع شعارات مثل “الموت لآل سعود!”. لقد زرعت الزمرة الحاكمة في السعودية الرياح وسوف تجني الأعاصير.
تركيا

تمثل الدولة التركية، إلى جانب السعودية وإسرائيل، معقلا رئيسيا للثورة المضادة في المنطقة. وعلى الرغم من أنها رسميا جزء من حلف شمال الأطلسي، فإنها، في ظل نظام أردوغان الرجعي، تدعم داعش والقوى الإسلامية الأخرى في سوريا.
طموحات أردوغان الإقليمية معروفة جيدا. إنه يرغب في إعادة تأسيس ما يشبه الإمبراطورية العثمانية القديمة، ووضع أجزاء كبيرة من آسيا الوسطى والشرق الأوسط تحت السيطرة التركية. ومن أجل تحقيق هذا الطموح حاول استخدام الشعوب الناطقة بالتركية مثل التركمان لأغراضه الكلبية الخاصة، تماما مثلما كان النظام القيصري الروسي يستخدم السلاف الجنوبيين في الماضي كبيادق لخدمة سياسته الخارجية التوسعية.
ومن المعروف كذلك أن أردوغان يدعم داعش والعصابات الإسلامية الأخرى في محاولة للإطاحة بالأسد واقتطاع أجزاء من الأراضي السورية. هذا هو السبب الذي جعله يسمح لعدد كبير من المقاتلين الإسلاميين بعبور الحدود التركية إلى سوريا، في حين يمنع توريد الأسلحة والمتطوعين للقوات المعارضة لداعش في سوريا وسحق بوحشية الأكراد الذين يقاتلون داعش.
كان إسقاط طائرة حربية روسية من قبل الأتراك استفزازا يهدف لخلق صراع بين أمريكا وروسيا. تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وقد ناشدت حلفائها للمساعدة. لكن الناتو الذي عبر علنيا عن دعمه “لحق تركيا في الدفاع عن سيادتها الوطنية” لم يقم بأي شيء، في حين استخدم بوتين الحادث كذريعة لنقل نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 إلى سوريا، وبالتالي السيطرة على المجال الجوي السوري.
لم يحقق الاستفزاز الذي قام به أردوغان أي شيء. لم يمنع الرئيس هولاند من زيارة موسكو أو الدعوة إلى تحالف دولي واسع ضد داعش. في الواقع نظام أردوغان غير مستقر.
في العام الماضي، عندما لم يفز حزب العدالة والتنمية أردوغان بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان التي كان يريدها لتعزيز قوته، أطلق العنان لهجوم غير مسبوق على الحركة الكردية واليسار بأكمله. في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو 2015، فاز حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الكردي، بشكل مثير للتعجب، بـ 13٪ من الأصوات. شكل هذا تهديدا وجوديا لحزب أردوغان “العدالة والتنمية”؛ ولا سيما في ضوء فضائح الفساد والمحسوبية التي لا تعد ولا تحصى. وحتى بعد الانتخابات الجديدة، والتي عقدت في ظل موجة من الإرهاب الشديد ضد اليسار والحركة الكردية، تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من البقاء فوق عتبة 10٪.
على هذا الأساس حاول أردوغان أن يثير النزعة القومية عبر تفجير حرب أهلية ضد الأكراد والقوى اليسارية في تركيا. هذا انعكاس لأزمة نظام أردوغان، الذي بعد سنوات من الاستقرار، على أساس طفرة اقتصادية، بدأ يواجه موجة متصاعدة من الاستياء وخيبة الأمل، مع بداية دخول الاقتصاد في الأزمة، بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي ومغامرات أردوغان المتهورة. وتحت ستار الحرب الأهلية يحاول أردوغان توطيد حكمه الهش؛ لكنه بقيامه بذلك يعمل على زعزعة استقرار كل المجتمع التركي ويمهد الطريق لتفكك البلاد.
الرأسمالية التركية عاجزة عن حل مشاكل الجماهير، وهذا هو السبب في احتداد الصراع الطبقي خلال الفترة الأخيرة. شاهدنا مؤشرات ذلك في حركة منتزه غيزي عام 2013 وصعود حزب الشعوب الديمقراطي. لا يمكن إخفاء التناقضات بين الطبقة العاملة التركية وبين النظام طويلا من خلال القمع والتقسيم على أسس قومية. وليست الإضرابات والتحركات الكثيرة، مثل الإضرابات التي تنتشر بسرعة في قطاع صناعة السيارات والعديد من التحركات التي اندلعت بعد تفجيرات أنقرة – على الرغم من العمليات البوليسية والعسكرية الكبيرة-، سوى لمحة عن النضالات القادمة.
إسرائيل
ما تزال القضية الفلسطينية بدون حل وتستمر في تسميم الحياة السياسية في الشرق الأوسط. وتمثل محاولات عباس والسلطة الفلسطينية عزل إسرائيل دبلوماسيا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، مجرد عبث.
لقد صارت العلاقات بين إدارة الرئيس أوباما وبين حكومة إسرائيل علاقات عداء واضح منذ أن قبل نتنياهو دعوة من الجمهوريين لمخاطبة الكونغرس الأمريكي العام الماضي.
عندما انتخب نتنياهو، امتنع البيت الأبيض عن توجيه التهنئة المعتادة له. لم يكن هناك اتصال هاتفي من أوباما. وبدلا من ذلك تلقى رئيس الوزراء مكالمة قصيرة من وزير الخارجية، جون كيري. يشير هذا الحادث الصغير، ذو الأهمية الضئيلة في حد ذاته، إلى التناقضات المتنامية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي محاولة منه للضغط على واشنطن، لجأ نتنياهو إلى سياسة الابتزاز. حصلت المخابرات الإسرائيلية على تفاصيل سرية حول المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي تمت في اجتماعات “سرية”، من مسؤولين أمريكيين وكذلك مخبرين وعلاقات دبلوماسية في أوروبا وعمليات تنصت. وسلمت هذه المعلومات الحساسة لأعضاء في الكونغرس.
من خلال هذه الوسائل المخادعة، كان نتنياهو يحاول تخريب الصفقة مع إيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي كبير قوله: «أن تقوم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالتجسس على بعضهما البعض فذلك شيء، أما أن تقوم إسرائيل بسرقة أسرار الولايات المتحدة وتمريرها مرة أخرى إلى المشرعين الأمريكيين من أجل تقويض الدبلوماسية الأمريكية، ذلك شيء آخر مختلف تماما».
تعمقت الخلافات عندما رفض نتنياهو صراحة ما يسمى بحل الدولتين، الذي يشكل حجر الزاوية في جهود واشنطن. وقد حذر البيت الأبيض بأن إدارة أوباما قد تقوم “بإعادة حساباتها” في تعاملها مع نتنياهو.
لقد حافظت إسرائيل على قبضة حديدية على الضفة الغربية. ويتم خنق غزة ببطء ويجري توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بلا توقف. القيادة الفلسطينية عاجزة تماما، مما يؤدي إلى تصرفات يائسة من جانب الشباب، وهي التصرفات التي ستصب في مصلحة نتنياهو. يشكل هذا ضربة أخرى لأوباما وللإمبريالية الأمريكية، التي فشلت في محاولاتها لإيجاد حل توافقي.
صعود الصين

تواجه الولايات المتحدة، في الشرق، تحديا آخر بسبب صعود الصين. بعد أزمة 2008 أنقذت الصين الاقتصاد العالمي عن طريق امتصاص كمية كبيرة من فائض الرساميل (أي فائض الإنتاج). لكن دور الصين في العالم الآن قد تغير إلى نقيضه. باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة متعطشة للمواد الخام لتغذية صناعاتها، اخترقت الصين أفريقيا وأمريكا الجنوبية حيث كانت تستخرج المواد الخام أساسا. لكنها الآن تواجه أزمة فائض الإنتاج.
مثلها مثل ألمانيا قبل 1914، لا يمكن أن يتم احتواء القوى المنتجة التي راكمتها الصين داخل حدودها الخاصة. وهذا يؤدي إلى صراعات مع الدول المجاورة وكذلك مع القوى الامبريالية الكبرى. لم يكن لبرامج التحفيز الاقتصادية الضخمة أي تأثير دائم. وتجد الصين نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى سياسة الإغراق من أجل تفريغ كميات كبيرة من السلع الرخيصة في السوق العالمية. وهكذا فقد تحول دور الصين في الاقتصاد العالمي إلى نقيضه.
وأيضا مثلها مثل ألمانيا في الماضي، تسعى الصين بدورها للوصول إلى السلطة والنفوذ في الشؤون العالمية، بما يتناسب وقوتها الاقتصادية. إنها تسعى لإعادة توزيع مناطق النفوذ. تنظر القوى الكبرى، وخاصة اليابان والولايات المتحدة، إلى طموحات الصين باعتبارها تهديدا متزايدا. تصرح أمريكا أنها ترحب بصعود الصين كقوة عظمى، طالما أنها تحترم المعايير الدولية وتلعب دورا مناسبا في “النظام المتعدد الأطراف”. لكن في الواقع، كلما حاولت الصين فعل أي شيء على الساحة العالمية، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على منعها.
لقد عملت أمريكا، بشكل منهجي، على منع الصين من تقوية وجودها في الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وحتى اقتراح متواضع لزيادة موارد صندوق النقد الدولي (مما يعطي الصين بعض الأصوات الإضافية) تعطل لسنوات في الكونغرس. وبذلت أمريكا أيضا جهودا حثيثة لإحباط محاولة الصين تعزيز موقعها في البنك العالمي. ولمواجهة تصاعد مكانة الصين في المنطقة، تتآمر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مع إحدى عشرة بلدا من البلدان المطلة على المحيط الهادئ الأخرى لإقامة شراكة عبر المحيط الهادئ، تستثني الصين، على الرغم من كونها أهم اقتصاد في غرب المحيط الهادئ. لكن الصين تواصل توسيع نفوذها في المنطقة، مما يثير استياء الولايات المتحدة.
رأينا هذا في حالة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). اعتمدت أمريكا، كما جرت العادة، سياسة الاحتواء، لكنها فشلت عمليا. تمتلك الصين الآن بين يديها أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، وبذلك تخطط لإطلاق بنك جديد للمساعدة في بناء الجسور والطرق وغيرها من ضرورات التنمية في آسيا.
تريد النخبة الحاكمة في الصين أن تكون قوتها العسكرية ونفوذها السياسي متمشيان مع قوتها الاقتصادية. وتدفعها ميولها التوسعية إلى الدخول في صراع مع الإمبريالية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ التي تسير لتصبح المنطقة الحاسمة في تاريخ العالم. إن أمريكا التي تخشى (وهي محقة في ذلك) من أن يكون البنك الجديد وسيلة لتقوية النفوذ الصيني في منطقة حيوية من وجهة نظر مصالحها الخاصة، تسعى لتخريب تلك الخطة. وقد مارس الأمريكيون وراء الكواليس الضغوط على حلفائهم من أجل عدم الانضمام إلى ذلك البنك.
عندما أصبحت بريطانيا أول بلد خارج آسيا يتقدم بطلب العضوية في البنك، اشتكى مسؤول أمريكي من ميل المملكة المتحدة نحو “التوافق الدائم” مع الصين. لكن هذا لم يمنع كاميرون من دعوة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى لندن في زيارة رسمية، مع استقبال بالسجادة الحمراء وعشاء مع الملكة في قصر باكنغهام. تتسابق القوى الأوروبية فيما بينها لخطب ود بكين. وعلى خطى بريطانيا، أعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إنهم أيضا يريدون أن يصيروا من الأعضاء المؤسسين للبنك.

سيتم الانتهاء من بناء خط قطار فائق السرعة يربط بين شنغهاي وكونمينغ عام 2016، وهو ما سيعمل على مد نفوذ الصين إلى جنوب شرق آسيا. والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي هو أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف تقودها الصين، والذي أنشئ عام 2015، يعطي للصين فرصة لاستخدام احتياطياتها الضخمة لتعزيز طموحاتها السياسية.
لقد انخرطت الصين، على مدى العامين الماضيين، في حملة واسعة لبناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي. وردا على ذلك أرسل الأمريكيون مدمرة بحرية في ما أسموه “عملية حرية الملاحة” بالقرب من واحدة من تلك الجزر الاصطناعية، وهي الخطوة التي اعتبرها رئيس البحرية الصينية، وربما ليس لوحده، بأنها “تهديد مبطن”. إلا أنه لم يكن في الواقع مبطنا.
وقال الأدميرال وو شنغ لي إن قواته أظهرت “أقصى درجات ضبط النفس” أمام “الأعمال الاستفزازية” من قبل أمريكا في بحر الصين الجنوبي. في الماضي لو حدثت مثل هذه التوترات لكانت ستؤدي إلى الحرب. لكن ميزان القوى قد تغير بشكل كبير. لم تعد الصين ذلك البلد المسحوق الفقير وشبه المستعمر الذي يمكن أن تغزوه اليابان أو بريطانيا أو الولايات المتحدة. لم يعد الأمريكيون قادرين على القيام بعمل عسكري حتى ضد كوريا الشمالية التي تواصل استفزازهم باستمرار، فبالأحرى أن يجرؤوا على تحدي القوة العسكرية للصين الحديثة. وعلى الرغم من أنه يمكن للولايات المتحدة أن تطلق على معظم بلدان المنطقة، كفيتنام مثلا، اسم “حلفائها” ضد الصين، فإن صعود الصين سيضع موازين القوى تلك على المحك أكثر فأكثر. وفي كل مرة تفشل الولايات المتحدة في التدخل، كما حدث في أوكرانيا وسوريا، تتم ملاحظة ذلك ليس فقط في بكين، بل أيضا في هانوي وتايبيه وسيول. إن الصين هي أكبر شريك تجاري لجميع هذه البلدان، وسوف تتصاعد حصتها من تجارة تلك البلدان. وستتسبب هذه التناقضات مستقبلا في حدوث اضطرابات سياسية في بلدان غرب المحيط الهادئ، حيث تتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ.
إن مشروع التريليون دولار لإنشاء طريق الحرير الجديد، والذي يضم على وجه الخصوص باكستان وأفغانستان وبلدان آسيا الوسطى، مدفوع باعتبارات إستراتيجية (تجنب مضيق ملقة[7])، لكنه مدفوع أيضا بالحاجة إلى تصدير فائض الإنتاج. تتضمن 70٪ من القروض الممنوحة للبلدان المنخرطة في إستراتيجية طريق الحرير الجديدة شرط فتح الأبواب أمام الشركات الصينية. لكن هذا يثير أيضا الصراعات بين تلك البلدان وداخل كل واحدة منها على حدة.

المشروع الضخم الذي يهدف إلى ربط ميناء جوادر في جنوب غرب باكستان بمنطقة الحكم الذاتي في الصين شينجيانغ، هو امتداد لمبادرة طريق الحرير الصينية. إنه، في الواقع، خطة لتحويل باكستان إلى كويكب يدور في فلك الصين.
الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهو المشروع الضخم الذي يهدف إلى ربط ميناء جوادر في جنوب غرب باكستان بمنطقة الحكم الذاتي في الصين شينجيانغ، هو امتداد لمبادرة طريق الحرير الصينية. ومن المفترض أن توفر العديد من الفوائد لباكستان في مجال النقل والبنية التحتية والاتصالات والطاقة. إنه، في الواقع، خطة لتحويل باكستان إلى كويكب يدور في فلك الصين.
سوف تستفيد الصين أكثر من فتح طرق التجارة في غرب الصين، والتمكن من الوصول المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط الغنية بالموارد عبر بحر العرب، وتجاوز الطرق البعيدة لوجستيا التي تمر عبر مضيق ملقة. وسوف تشمل بناء الطرق السريعة والسكك الحديدية وأنابيب الغاز الطبيعي والنفط، التي تربط الصين بالشرق الأوسط. إن حصة الصين في جوادر تسمح لها أيضا بتوسيع نفوذها في المحيط الهندي، الذي هو ممر حيوي لنقل النفط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.
تعتزم الدولة الصينية من خلال هذا خدمة المصالح الجيوسياسية والإستراتيجية للنخبة الصينية. ويلقى هذا المشروع معارضة قوية من قبل الإمبريالية الأمريكية وأيضا من قبل جزء هام من القوميين البلوش. إنه لا يجلب أية فائدة لسكان جوادر الذين يعيشون ويعملون في ظروف بائسة. بل إنهم على العكس من ذلك محرمون من حقوقهم في المنطقة. وهناك أيضا استياء بين السند وقوميات أخرى لم تستفد من هذا “الممر”. وهكذا فإن السياسة التوسعية للصين تعمل على مفاقمة التناقضات في باكستان والمنطقة بأسرها.
باكستان وأفغانستان والهند
يعيش أكثر من خمس الجنس البشري في شبه القارة الآسيوية الجنوبية، التي تمتلك موارد طبيعية كافية لخلق جنة على الأرض. لكنها، وبعد نحو سبعة عقود على الاستقلال الرسمي، ما تزال غارقة في البؤس والفقر والأمية والاضطهاد. لقد ابتليت بالحروب والعنف العرقي والطائفي الرهيب. وقد أثبتت البرجوازية في كل من الهند وباكستان أنها عاجزة تماما عن حل أي من المهام الأساسية للثورة الديمقراطية البرجوازية. إنها الآن أكثر اعتمادا على الإمبريالية مما كانت عليه قبل الاستقلال. لم تنجح باكستان في القضاء على الإقطاع تماما، في حين لم تنجح الهند حتى في القضاء على نظام الطوائف القاسي والرجعي.
وضع الجماهير في باكستان ليس أفضل مما هو عليه في الهند. ففي كلا البلدين يصير استغلال الجماهير أسوأ بكثير مع سرطان الفساد ونهب الدولة من قبل السياسيين المرتشين ورجال الأعمال وجنرالات الجيش. وفي كلا البلدين يتم إهدار مبالغ طائلة على الإنفاق العسكري على حساب الصحة والتعليم.
وقد أدت الإستراتيجية المعادية للثورة، التي تنفذها الطغمة الحاكمة في باكستان، إلى خلق وضع مخيف في كل من أفغانستان وباكستان نفسها. فالطبقة الحاكمة والجيش متورطون بقوة في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى.
هذا هو الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه طالبان وغيرها من التيارات الأصولية الرجعية. إن الصراعات بين التيارات الأصولية المتنافسة والدولة هي في الجوهر معركة من أجل السيطرة على الكميات الضخمة من الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. جهاز المخابرات الباكستانية (ISI) هو من خلق في الأصل هذا الوضع وشجعه، بمعرفة ودعم الإمبريالية الأمريكية، لتمويل الثورة المضادة في أفغانستان. وقد كانت النتيجة كارثية بمعنى الكلمة.
والآن صار الأصوليون المتعصبون المسعورون، حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإسلامية الأصولية، خارج نطاق السيطرة. وقد ظهر هذا بطريقة وحشية من خلال الهجوم الدامي على مدرسة للجيش في بيشاور، في دجنبر عام 2014، حين قتلت طالبان الباكستانية 132 طفلا على الأقل وتسعة موظفين. لقد كانوا جميعا أبناء ضباط الجيش الباكستاني. ونتيجة لذلك اضطر الجيش لتصعيد هجماته على طالبان، التي كانت في السابق عميلة له ودمية في يده.
إن الامبرياليين وعملاءهم الإقليميون هم المسؤولون عن تدمير البلد الذي كان يمتلك واحدة من أغنى الثقافات في آسيا. لقد خلقوا وحوش فرانكشتاين: كلابا مسعورة لا تتردد في عض يد سيدها. في أفغانستان، وبعد خمسة عشر عاما من الاحتلال الإمبريالي، لم يتحسن أي شيء في ظروف الناس العاديين، فقد استمر اضطهاد المرأة بلا هوادة، وسجل حقوق الإنسان، الذي طالما هلل له المعلقون الغربيون، لم يزدد إلا سوءا.
حكومة كابول منقسمة بشكل يدعو للرثاء وغارقة في الأزمة. وقد انفضح عجزها من خلال سلسلة من الهجمات الدموية التي قامت بها طالبان في ما كان من المفترض أن تكون مناطق آمنة. ونتيجة لذلك يضطر الإمبرياليون الإبقاء على وجودهم العسكري الذي كانوا ينوون إنهاءه. إن حكومة كابول جالسة على الحراب الأمريكية، وبدونها ستسقط على الفور.
كانت الهند، حتى وقت قريب، تبدو وكأنها نقطة الضوء الوحيدة وسط كل ظلام شبه القارة الهندية. كانت البرجوازية الهندية تفاخر بالنمو الاقتصادي. وطالما جرى الحديث عن “النمر الآسيوي”. لكن ذلك كان عندما كان الاقتصاد العالمي في توسع. وعلى أي حال لم تستفد من ذلك النمو سوى أقلية محظوظة، بينما لم تتحسن الشروط بالنسبة للغالبية الساحقة. والآن صار الاقتصاد الهندي يشعر بالرياح الباردة للأزمة العالمية وانخفضت الروبية بشدة. لقد ربطت الهند مصيرها بالسوق الرأسمالي العالمي، ولا يمكنها أن تهرب من آثار الأزمة العالمية للرأسمالية.
تعيش حكومة نارندرا مودي، وعلى الرغم من كل ديماغوجيته، في ورطة كبيرة. لقد خسر حزبه بهاراتيا جاناتا انتخابات ولائية رئيسية في ولاية بيهار، حيث يشتكي الناخبون أساسا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. عندما صار مودي رئيسا للوزراء كان التضخم العام تحت السيطرة، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط، لكن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية رفعت التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي منتصف الحملة، شهدت أسعار العدس الهندي (arhar dal) – التي تشكل جزءا أساسيا من النظام الغذائي للشعب – ارتفاعا كبيرا، لتصبح سببا محوريا للاحتجاجات.
وقد اتضح الوضع الحقيقي من خلال الإضراب العام الذي دعت إليه عشر أكبر نقابات، في شتنبر 2015، والذي شل الهند. توقعت النقابات العمالية والقادة الشيوعيين مشاركة 100 مليون عامل في ذلك الإضراب كحد أقصى، وهو الرقم الذي يكشف في حد ذاته عن القوة الكامنة الهائلة للبروليتاريا الهندية. لكن عدد المشاركين في الإضراب العام ذلك اليوم كان في الواقع أكثر من 150 مليون عامل، مما يشكل أكبر إضراب عام في التاريخ.
وحدها البروليتاريا، وحلفاؤها الطبيعيون الفلاحون الفقراء، من يمكنها أن تقدم وسيلة للخروج من الكابوس الذي أغرقت الرأسمالية والإمبريالية فيه هذه البلاد ذات الحضارة القديمة وذات الإمكانيات الهائلة.
جنوب أفريقيا ونيجيريا
جنوب أفريقيا هي مفتاح القارة الإفريقية. إنها ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا (إذ نيجيريا هي الأكبر من حيث القيمة المطلقة). ويمكن أن نرى الفرق من حيث مستوى التنمية بين البلدين من خلال مؤشر واحد: كمية استهلاك الطاقة الكهربائية للفرد الواحد. في الفترة ما بين 2011 و2015 كانت 142 كيلو واط/ ساعة للفرد الواحد في نيجيريا و4328 كيلو واط/ ساعة للفرد الواحد في جنوب أفريقيا [إحصائيات البنك العالمي]. كما تقف نيجيريا وراء جنوب أفريقيا من حيث نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي. وتمتلك جنوب أفريقيا كذلك طبقة عاملة قوية ومنظمة. إنها تمتلك اقتصادا كبيرا وأكبر طبقة عاملة وهي بلد ذو تقاليد ثورية عظيمة جدا. لقد كانت نضالات الجماهير الثورية، وليس مهارات التفاوض عند قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، هي التي أدت إلى الإطاحة بنظام الفصل العنصري في عام 1992. لكن، وعلى الرغم من ذلك، بعد أربعة وعشرين عاما من الديمقراطية البرجوازية الرسمية، في ظل حكم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، لم يتغير الوضع كثيرا بالنسبة لأغلبية شعب ثاني أكبر بلد منتج للمعادن في العالم.
لقد وضع هذه الأساس لتطور مزاج متجذر على نحو متزايد، وخاصة بين جيل الشباب الذي لا توجد لديه أوهام في القادة السابقين لحركة التحرير، والذين انضم كثير منهم إلى صفوف البرجوازية. كان لمذبحة ماريكانا، عندما أطلقت قوات حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي النار على العمال السود بدم بارد من أجل الدفاع عن أصحاب صناعة التعدين (البيض والسود)، تأثير عميق على موقف الكثيرين تجاه الحزب الحاكم. ويعتبر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي اليوم من طرف الكثيرين مرتعا للفساد والسرقة والنهب.
نقابة عمال المعادن الأكثر جذرية NUMSAا[8]، انفصلت – مع ما يقرب من 400.000 عضو- عن التحالف الثلاثي -. يتحدث قادة NUMSA عن إنشاء حزب جديد، والذي من شأنه إذا ما حدث أن يمثل تحديا جديا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. لكن قادة NUMSA يترددون في هذا الصدد وبدلا من ذلك يضيعون جهودهم في صراعات بيروقراطية عديمة النفع والقضايا المعروضة على المحاكم مع يمين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
في هذا الفراغ صعد نجم يوليوس ماليما، الزعيم السابق لرابطة شبيبة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ومنظمة المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية. لقد مكنه خطابه الراديكالي من تحقيق شعبية كبيرة، ولا سيما في أوساط الشباب، على الرغم من أن برنامجهم يهدف إلى تطوير رأسمالية قومية “سوداء” في جنوب إفريقيا. كل هذا يعكس الإمكانيات الثورية الهائلة التي تتطور في مجتمع جنوب أفريقيا.
تؤثر الثورة أيضا في بقية أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع أحداث العام الماضي في الطوغو وبوروندي، والأهم من ذلك في بوركينا فاسو. لقد اندلعت تحركات ثورية في هذه البلدان، وفي بوركينا فاسو شهدنا مرة أخرى بروز حركة جماهيرية ضد محاولة الانقلاب العسكري. وهذا يؤكد الظروف المواتية للغاية بالنسبة للثورة حتى في البلدان المتخلفة نسبيا.
لقد قيل الكثير عن نيجيريا بعد أن أصبحت “عملاق أفريقيا” منذ أن تجاوز اقتصادها اقتصاد جنوب إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، ولكن هذا ناتج أساسا عن إعادة تقعيد اقتصادها[9] في أبريل 2014، والذي أنتج نظريا زيادة قدرها ثلاثة أرباع مجموع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. هذا الرقم المنقح وضع نيجيريا في المرتبة 26 بين أكبر اقتصادات العالم. لكن الوضع الحقيقي يكشفه واقع أن نيجيريا تحتل، من حيث الدخل الفردي (2688 دولار للفرد)، المرتبة 121. إنها سادس أكبر بلد مصدر للنفط الخام، لكنها لا تمتلك أية مصافي نفط تعمل وبالتالي فإنها تستورد كل وقودها.
إنها ما تزال اقتصادا متخلفا جدا وما يزال النفط يوفر أكثر من 90٪ من العائدات الأجنبية وما يقرب من 80٪ من الإيرادات الحكومية. كانت احتياطيات النقد الأجنبي سنة 2008، عندما كانت أسعار النفط ما تزال عالية جدا، تساوي حوالي 68 مليار دولار، لكنها انخفضت الآن إلى 27 مليار دولار. وما تزال في انخفاض مستمر.
إن الصورة الحقيقية للحياة التي يواجهها المواطن النيجيري العادي تظهر جلية من خلال أرقام مؤشر التنمية البشرية، الذي يعطي مقياسا لتنمية رأس المال البشري في ثلاثة مجالات: الدخل والصحة والتعليم. وتشير أحدث الأرقام إلى أن نيجيريا توجد، من حيث مؤشر التنمية البشرية، في المرتبة 156 من أصل 187 بلدا.
في 1998- 1999 قامت الطبقة الحاكمة النيجيرية، بنصيحة ودفع من قبل أسيادها الإمبرياليين، بإزالة النظام العسكري لتجنب اندلاع الصراع الطبقي من تحت وانتقلت نحو نظام برلماني شهد انتخاب أوباسانجو، رئيس حزب الشعب الديمقراطي. بقي حزب الشعب الديمقراطي في السلطة حتى العام الماضي عندما فقد الكثير من شعبيته.
كان اندلاع حركة “احتلوا نيجيريا”، يناير 2012، نقطة التحول في مسار الصراع الطبقي في البلد، وهي الانتفاضة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود من طرف حكومة جوناتان وحزب الشعب الديمقراطي وجاءت في أعقاب الثورات العربية، والتي تماهت بشكل واضح مع الحركة التي شهدتها مصر وتونس في العام السابق. لقد غيرت هذه الحركة ميزان القوى الطبقية بشكل جذري في البلاد وسرعت من انفضاح الحزب البرجوازي الحاكم، حزب الشعب الديمقراطي، وزرعت بذور الانهيار والانقسام وأخيرا الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها، في نهاية المطاف، في انتخابات 2015.
وأمام خطر زوال حزب الشعب الديمقراطي القديم، تحولت الطبقة الحاكمة النيجيرية إلى بوخاري لإنقاذها. أعلنوا تشكيل حزب المؤتمر التقدمي الشامل، ووضعوا بوخاري مرشحا عنه. كان ذلك لاستغلال صورته كزعيم غير فاسد، من المفترض أنه يعيش حياة الزهد، وصوروه بأنه “رجل الشعب” الذي من شأنه أن يضع حدا للفساد والفقر. كانوا في حاجة إلى شخصية مثل بوخاري لملء الفراغ الذي خلفه تراجع حزب الشعب الديمقراطي. وحقيقة أن سوق المال ارتفع عندما فاز بوخاري في انتخابات العام الماضي إشارة واضحة إلى أن البرجوازية آمنت بأنه يمكنه إدارة النظام لمصلحتها بشكل أفضل من جودلاك المنتهية ولايته.
انتخب بوخاري من طرف الجماهير المتحمسة على أمل أن يعمل على إحداث تغيير حقيقي. لكن برنامجه استمر برنامج عمليات الخصخصة. وبسبب قراره الأخير بالسماح ببيع الوقود بسعر أعلى بكثير انفضح جزئيا أمام أعين الفئات المتقدمة من الجماهير على الأقل. لن يمر وقت طويل قبل أن تدرك أوسع الجماهير النيجيرية الطبيعة الحقيقية لنظام بوخاري من خلال تجربتهم المعيشة الخاصة.
شيء واحد واضح هو أنه إذا كان حزب الشعب الديمقراطي قد استغرق 16 سنة طويلة قبل أن ينفضح وينهار، فإن حزب المؤتمر التقدمي الشامل لن يتمتع بمثل هذا الترف. عليه أن يحكم باقتصاد في وضع أكثر صعوبة وينفذ سياساته بين جماهير واسعة استيقظت بالفعل للنضال واختبرت قوتها. لقد تم تعويض فشل حزب الشعب الديمقراطي بصعود حزب المؤتمر التقدمي الشامل المتهالك من أجل الحفاظ على الوضع الراهن. لكن وبمجرد انفضاح الطبيعة الحقيقية لبوخاري أمام الجماهير، يمكننا أن نتوقع اندلاع حركة جديدة في مستوى تلك التي اندلعت عام 2012.
فنزويلا وحدود الإصلاحية

لقد تغير الوضع في أمريكا اللاتينية. وتلك العشر سنوات من الاستقرار النسبي، الذي كفله النمو الاقتصادي، قد وصلت إلى نهايتها. هذا له آثار اجتماعية وسياسية عميقة جدا.
لقد تغير الوضع في البرازيل بشكل كبير مع دخول الاقتصاد في مرحلة تدهور خطير، مع انخفاض الناتج الوطني الإجمالي العام الماضي بـ 4,5٪. هذا الوضع، إضافة إلى سلسلة من التدابير اللاشعبية المعادية للطبقة العاملة التي طبقتها الحكومة، أوضح بشكل كبير حقيقة أن حزب العمال يدافع عن مصالح الرأسمالية وليس عن مصالح العمال. وقد أدى هذا إلى إضعاف حزب العمال بشكل كبير. لقد ولت الأيام التي كانت خلالها قيادة الحزب تتمتع بولاء كبير من طرف الجماهير. وعوض ذلك لدينا تنامي التجذر، خاصة في أوساط الشباب، والذي اتضح في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات.
وضع انتصار موريسيو ماكري في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية نهاية لاثني عشر عاما من الكيرشنيرية[10] التي انتهت مع اقتصاد مأزوم، وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي، وبلوغ التضخم نحو 25٪، وعجز في الميزانية بأكثر من 6٪ من الناتج الوطني الإجمالي. لقد عبد هذا الوضع الطريق لانتصار اليمين. والآن يطبق ماكري سياسة تقشف وحشية، مع تسريح عشرات الآلاف من العمال في القطاع العام، واقتطاعات وحشية في ميزانية دعم الخدمات الأساسية والإنفاق الاجتماعي، وقمع شديد ضد المناضلين الاجتماعيين. ومن المؤكد أنه إذا فاز دانيال سيولي، سيكون مضطرا بدوره إلى تنفيذ سياسات مماثلة، إن أزمة الرأسمالية لن تترك له الكثير من الخيارات.
إن هذا يفضح حدود الديماغوجية القومية “اليسارية”، التي تحاول حل تناقضات الرأسمالية دون القيام بمصادرة أملاك البرجوازية والإمبريالية، أي أنها تحاول تحقيق المستحيل. بعد تجريدها من مصطلحاتها الراديكالية و”الثورية”، تقف القومية “اليسارية” عارية باعتبارها مجرد تنويعة من تنويعات الإصلاحية اليسارية بعد تكييفها وفقا لتقاليد وسيكولوجية أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، فإن الكيرشنيرية ما زالت تحتفظ بقاعدة دعم كبيرة. إن الوحشية التي يطبق بها ماكري والبرجوازية الأرجنتينية سياسة التقشف صارت تثير بالفعل، بعد مرور بضعة أشهر من الصدمة والارتباك، إعادة تجميع للاحتجاجات الشعبية واندلاع تحركات جماهيرية مهمة جدا. إن هذا الوضع يخلق ظروفا مواتية للغاية بالنسبة للماركسيين للوصول إلى الفئة الأكثر تقدما بين الجماهير، والتي بدأت في البحث عن بوصلة وطريق للمضي قدما يتجاوز السياسة الكيرشنيرية الديماغوجية الفاشلة.
لقد اقترب تشافيز في فنزويلا أكثر من أي كان إلى الثورة الاشتراكية. لكنه لم يعمل أبدا على إنجازها حتى النهاية. وبعد وفاته صعدت كل التناقضات إلى السطح مع ما تتضمنه من عواقب وخيمة.
لا يمتلك نيكولاس مادورو لا كاريزما سلفه اللامع ولا جرأة منظوره. إنه يذكرنا بروبسبيير، الذي يستمر في دعوة الجماهير مرة بعد أخرى لإنقاذ الثورة، حتى يأتي اليوم الذي ستتوقف فيه تلك الجماهير عن الاستجابة. عندما انتقل روبسبير إلى اليمين، تصرف مثل رجل يقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه. إن القيادة البوليفارية، من خلال إحباطها لآمال قاعدتها الجماهيرية وضربها لروحهم المعنوية، تحضر أسباب دمارها.
كانت الهزيمة الانتخابية في فنزويلا، يوم 06 دجنبر 2015، نتيجة مباشرة لرفض إنجاز الثورة حتى نهايتها عبر مصادرة أملاك الطبقة الحاكمة وتدمير الدولة الرأسمالية. وبدلا من ذلك أدت محاولة تنظيم الرأسمالية من خلال الرقابة على الأسعار وعلى صرف العملات الأجنبية إلى تشوهات اقتصادية هائلة. لقد استخدمت القيادة البوليفارية عائدات النفط لتمويل البرامج الاجتماعية وبرنامج ضخم للأشغال العامة، لكن انهيار أسعار النفط في السوق العالمية حرمها من أي مجال للمناورة.
إن التشوهات التي خلقتها محاولة تنظيم الرأسمالية أدت حتما إلى حالة من الفوضى: حلقة مفرغة من التضخم الرهيب والتهريب والسوق السوداء والفساد والجريمة، بينما تقف حكومة مادورو، التي تبقى بحزم ضمن حدود الرأسمالية، عاجزة عن التصدي لهذه المشاكل. لقد فقد جزء هام من الجماهير الثقة في الحكومة، وهذا ما أدى مباشرة إلى الهزيمة الانتخابية. فما بين الانتخابات الرئاسية عام 2013 والانتخابات البرلمانية عام 2015 انتقل الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد والقوى المتحالفة معه من 7.587.532 صوتا إلى 5.599.025. وبعبارة أخرى لقد خسر البوليفاريون ما يقرب من مليوني صوت. بينما انتقلت المعارضة المعادية للثورة من جهة أخرى من 7.363.264 صوتا إلى 7.707.422 صوتا، أي أنها لم تحصل سوى على 344.000.
إن ما فشل لم يكن الاشتراكية أو الثورة، بل على العكس من ذلك، ما فشل هو الإصلاحية وأنصاف الحلول والفساد والبيروقراطية. إن المعارضة المعادية للثورة، التي تمتلك أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية، ستطلق هجوما ضد القوانين الأكثر تقدمية التي حققتها الثورة وستحاول استعادة السيطرة على المحاور الأساسية لأجهزة الدولة وخصخصة الشركات والأراضي المؤممة وإلغاء الرقابة على الأسعار والنقد الأجنبي وتحريك استفتاء لإسقاط الرئيس.
كشفت هذه الأحداث تهافت وهم “اشتراكية النفط”، تماما مثلما كشف استسلام تسيبراس في اليونان أوجه قصور وتناقضات اليسار الإصلاحي. إنهم في الممارسة العملية يعنون نفس الشيء: محاولة طوباوية لتطبيق السياسات الاشتراكية دون إحداث قطيعة جذرية مع الرأسمالية. إن مثل هذه السياسات لا تؤدي في النهاية دائما إلا إلى تحطيم معنويات الجماهير، وضرب اقتناعهم بالاشتراكية وتمهيد الطريق لانتصار الردة الرجعية بشكل أو بآخر.
سبق لماركس أن أوضح أنه يمكن للثورة المضادة أن تكون بمثابة السوط الذي يدفع الثورة إلى الأمام. وبعد فترة حتمية من الارتباك، ستعود الجماهير الثورية إلى مقاومة هجمات الثورة المضادة من خلال التعبئة والعمل المباشر. كما ستؤدي الهزيمة الانتخابية إلى تسريع عملية التمايز الداخلي داخل المعسكر البوليفاري. سيكون هناك ضغط قوي داخل القيادة لتقديم تنازلات للمعارضة. وستقفز العناصر الفاسدة والمنحطة من السفينة للانضمام إلى صفوف اليمين. لكن مناضلي القواعد الثوريين سيستخلصون خلاصات أكثر تقدما وسينفتحون على الأفكار الماركسية. وسوف يخلق هذا ظروفا جديدة ومواتية لتقوية التيار الماركسي داخل الحركة البوليفارية.
التكتيكات والمنظمات الجماهيرية

المنظورات علم، لكن التكتيكات فن. لذلك ومن أجل وضع التكتيكات الصحيحة لا يمكننا أن نعتمد على مخططات ومنظورات عامة للمستقبل. يجب على المرء أن يتذكر أيضا أن المنظورات نسبية وفرضيات للعمل، فهي ليست كتابا مقدسا وصالحة لكل زمان ولجميع الحالات. المنظورات يجب أن يتم تطويرها وتحيينها، ويجب مقارنتها باستمرار مع الواقع المعاش. وعلى أساس الأحداث يجب علينا تعديلها وتغييرها، أو، إذا لزم الأمر، التخلص منها والبدء من جديد.
يجب أن تستند التكتيكات على الظروف الملموسة، والتي تتغير باستمرار. وعند مناقشة التكتيكات، علينا أن نتذكر أننا لا نبحث عن صيغة تناسب كل السيناريوهات المحتملة. علينا تبني مقاربة مرنة، علينا إبقاء أعيننا مفتوحة على الوضع وكيف يتغير، وفي نفس الوقت بناء قواتنا بحيث نكون قادرين على التدخل عندما تسنح الفرصة.
عند وضعنا للتكتيكات يجب أن نولي اهتماما كبيرا للسيرورات التي تجري داخل المنظمات الجماهيرية. وهذه السيرورات تتغير مع مرور الوقت، تبعا لمد وجزر الحركة الجماهيرية. لقد تعرضت الحركة العمالية، بفعل فترات طويلة من السلام النسبي بين الطبقات، لضغط الطبقات الأخرى، وطورت الأحزاب الجماهيرية والنقابات قشرة بيروقراطية سميكة.
بدون المشاركة النشطة من طرف العمال تصير الحياة الداخلية لتلك المنظمات راكدة، وتقع فئاتها العليا تحت تأثير البرجوازية على نحو متزايد. على مدى عقود قبل الأزمة كانت تلك الأحزاب التي تسمى بالاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية تنفذ إصلاحات مضادة: لبرالية الاقتصاد والخصخصة والاقتطاعات. وعندما اندلعت الأزمة، في عام 2008، سلمت البرجوازية في كثير من الحالات السلطة للإصلاحيين للقيام نيابة عنها بالعمل القذر لإنقاذ الرأسمالية، من خلال تنفيذ هجمات وحشية على العمال (في اسبانيا واليونان، وغيرهما). في ظل هذه الظروف، يمكن للأحزاب القديمة أن تفقد قاعدتها الجماهيرية بسرعة. لقد انهار التوازن القديم. وقد دخلنا مرحلة تتميز بالتغيرات المفاجئة والأزمات والانقسامات، واختفاء بعض الأحزاب وظهور تشكيلات سياسية جديدة.
كان تفكك وانحطاط حزب باسوك هو الذي أدى إلى صعود سيريزا في اليونان. وبالمثل كانت خيانات الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني والانحطاط الإصلاحي للحزب الشيوعي ما أدى إلى الصعود السريع لحزب بوديموس في إسبانيا. وكان هذا النوع من الظواهر قد استبق بصعود تشافيز والحركة البوليفارية في فنزويلا.
حيثما تظهر مثل هذه الحركات سيكون علينا إبقاء العين عليها والعمل داخلها وحولها، لكن هذه التشكيلات لديها أيضا حدودها. إنها تميل إلى أن تكون مشوشة إيديولوجيّاً وهشة تنظيميا. وإذا لم تغرس جذورها في الطبقة العاملة وتتبنى سياسة معادية للرأسمالية بشكل واضح، فإنها يمكن أن تختفي بوتيرة أسرع من الوتيرة التي صعدت بها.
في الفترة الماضية كان الاتجاه السائد داخل الحركة العمالية هو التيار الإصلاحي اليميني، لكن في ظل ظروف الأزمة الرأسمالية سوف تتجه المنظمات الإصلاحية إلى الدخول في أزمة. يمكن أن يؤدي هذا إلى التحول إلى اليسار في اتجاه الإصلاحية اليسارية، مثلما نرى بالفعل في بريطانيا، أو إلى انهيار المنظمات التي لا يتطور داخلها أي جناح يساري.
نشهد ظهور تشكيلات سياسية جديدة في بعض البلدان التي اختفت فيها الأحزاب الجماهيرية التقليدية أو ضعفت بشدة. النقطة الرئيسية التي يجب علينا أن نفهمها هي أن الجماهير لا تتحرك من خلال التنظيمات الصغيرة. إن فكرة العصبويين بأنه يمكن بناء الحزب الثوري بالاكتفاء بالإعلان عنه هي فكرة سخيفة، وتتناقض مع الحقائق. عندما تتعرض الجماهير للخيانة من طرف منظماتها القديمة، يمكنها أن تلتف حول راية تشكيلات جديدة، لكن دائما تشكيلات جماهيرية. وتحت ضغط الأحداث تميل هذه التشكيلات نحو الإصلاحية اليسارية، أو حتى نحو الوسطية.
يجب علينا ألا ننسى أبدا أن الفرق بين الإصلاحية اليمينية والإصلاحية اليسارية فرق نسبي فقط. إن جوهر الإصلاحية – سواء اليمينية أو اليسارية- هو فكرة أنه ليس من الضروري الإطاحة بالنظام الرأسمالي، وأنه من الممكن تحسين أوضاع العمال والمضطهدين تدريجيا في إطار الرأسمالية. لكن تجربة اليونان وفنزويلا، وفي كل مكان آخر جرت فيه محاولة تطبيق ذلك، توضح أن هذا غير ممكن. إما أن تتخذ التدابير اللازمة لتدمير ديكتاتورية رأس المال، أو أن رأس المال سوف يدمرك.
هذا هو ما نعنيه عندما نقول إن الخيانة طبيعة متأصلة في الإصلاحية. لا يتعلق الأمر بخيانة متعمدة، بل بحقيقة أنه إذا تقبلت النظام الرأسمالي يجب عليك أن تتقبل قوانين هذا النظام. وهو ما يعني، في الوضع الحاضر، ضرورة تنفيذ سياسة الاقتطاعات والتقشف. ومثال تسيبراس مفيد جدا في هذا الصدد.
في نفس الوقت الذي نعطي فيه دعما نقديا للإصلاحيين اليساريين يجب علينا ألا نثير أية أوهام فيهم أو نقبل أية مسؤولية عن أعمالهم. ولنتذكر أن تسيبراس كان يتمتع بشعبية كبيرة قبل أن توضع سياساته على المحك، لكنه في النهاية ساوم واستسلم لضغوط البرجوازية. والآن هؤلاء الناس الذين كانت لديهم أوهام في تسيبراس، وكانوا يعتقدون أننا ننتقده أكثر مما يجب، صاروا أكثر انفتاحا على أفكارنا.
يجب علينا أن نميز أنفسنا. بالطبع يجب علينا أن نتجنب استعمال اللهجة الحادة التي يستعملها العصبويون، يجب أن ندخل في حوار ونحافظ على لهجة ودية ونؤكد على ما ندعمه، لكن علينا أيضا أن نشرح ضرورة السير إلى أبعد للانتقال نحو القضاء على الرأسمالية. نحن نسأل: كيف سيمولون الإصلاحات التي يقترحونها إذا لم يقوموا بتأميم البنوك والصناعات الرئيسية؟
إن التحول الحاد نحو اليمين في المنظمات الجماهيرية، خلال المرحلة الماضية، دفع العديد من التنظيمات اليسارية إلى تطوير خلاصات يسارية متطرفة، وشطبوا المنظمات الجماهيرية تماما من حسابهم. يعتقدون أنه يمكنهم بناء بديل على يسار المنظمات القديمة. لكن كل محاولات العصب لبناء أحزاب ثورية جديدة انتهت بالفشل الذريع. يفشل اليساريون المتطرفون لأنهم يتجاهلون الحركة الحقيقية للجماهير ومنظماتها. لكن التطرف اليساري يؤدي بدوره حتما إلى الانتهازية، ففي محاولة منهم للحصول على تعاطف الجماهير، ينتهي بهم المطاف بتمييع البرنامج من أجل محاولة الحصول على جمهور أوسع.
هذه الانتهازية، التي تحاول عادة إخفاء نفسها من خلال الدعوة إلى “مطالب انتقالية”، ينتهي بها المطاف دائما في طريق مسدود. لو أن الجماهير تريد برنامجا إصلاحيا فلديها بالفعل الكثير من القادة الإصلاحيين الذين يمكنها اللجوء إليهم. ليس البرنامج الانتقالي سلسلة من المطالب الإصلاحية الفردية التي يمكنك أن تختار منها ما يرضي وسطا إصلاحيا ما. إنه برنامج كامل مضبوط من أجل الثورة الاشتراكية الأممية ومن أجل سلطة العمال.
أولويتنا في هذه المرحلة هي التوجه نحو تلك الفئة في المجتمع، حيث يمكننا أن نبني الآن وليس في المستقبل. أي عموما نحو الشباب، الذين هم منفتحون على الأفكار الثورية. ومن خلال كسب الشباب وتكوينهم بالأفكار الماركسية نكون بصدد وضع الأساس لنجاح العمل في المنظمات الجماهيرية عندما ستسنح الفرصة لذلك.
مرحلة جديدة

كانت مرحلة النمو الاقتصادي الطويلة، التي ميزت العقدين السابقين للحرب العالمية الأولى، هي التربة التي نبتت فيها الإصلاحية. ظهر الوهم بأن الرأسمالية يمكن إصلاحها سلميا وتدريجيا من خلال النشاط البرلماني والنقابي، لكن تلك الأوهام تحطمت في عام 1914. أعلنت الحرب العالمية بداية مرحلة جديدة تماما: مرحلة الحروب والثورات والثورات المضادة.
لقد كانت المرحلة التي استمرت من 1914 إلى 1945 مختلفة تماما عن تلك التي سبقتها. كانت مرحلة من الاضطرابات التي انهار خلالها التوازن القديم. ومن خلال تجربة النضالات الطبقية العاصفة، كان العمال يتوصلون إلى استنتاجات ثورية. لقد هزت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المنظمات الإصلاحية القديمة من أساساتها. دخلت أحزاب الطبقة العاملة في أزمة، وبدأت تيارات يسارية جماهيرية تتبلور تحت تأثير الثورة الروسية، مما أدى إلى تشكيل أحزاب شيوعية جماهيرية.
ليس هذا هو المكان المناسب لنقاش تلك السيرورات بالتفصيل، ويكفي أن نقول إن هزيمة الثورتين الألمانية والإسبانية، نتيجة لخيانة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والقيادات الستالينية، قد أدت مباشرة إلى الحرب العالمية الثانية. لقد انتهت الحرب العالمية الثانية بطريقة غريبة لم يتوقعها تروتسكي، كما لم يتوقعها لا روزفلت ولا ستالين ولا تشرشل ولا هتلر.
لقد سبق لنا أن حللنا هذا في الماضي، وليست هناك حاجة لتكرار نقاش أسباب انتعاش الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية. دخل الاقتصاد العالمي مرحلة ازدهار استمرت لعقود، وتركت بصماتها على وعي الجماهير في البلدان الرأسمالية المتقدمة، في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان. ومثلما حدث خلال المرحلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، أدى ذلك إلى تعزيز الأوهام الإصلاحية. وعلى مدى عقود تعرض الماركسيون للعزلة عن الجماهير وصارعوا ضد التيار.
نشير هنا إلى الوضع الذي ساد في العالم الرأسمالي المتقدم صناعيا، أما الوضع بالنسبة للجماهير في ما كان آنذاك بلدانا مستعمرة وشبه مستعمرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فقد كان مختلفا تماما. طوال تلك المرحلة كلها كانت هناك اضطرابات مستمرة في الصين والجزائر والهند الصينية وبوليفيا وكوبا وتشيلي والأرجنتين وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء وإندونيسيا وشبه القارة الهندية. لكن ثورات البلدان المستعمرة التي أوقفت ملايين الناس على أقدامهم تعرضت للتشويه على يد الستالينية. وفي كثير من الحالات قاد الستالينيون الجماهير لهزائم رهيبة. وحتى عندما نجحوا في الاستيلاء على السلطة، كما هو الحال في الصين، فإنهم أنشأوا أنظمة على غرار روسيا الستالينية، التي لم تكن لديها أية جاذبية بالنسبة لعمال البلدان الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
كان الدور السلبي الذي لعبته الستالينية في تلك المرحلة عاملا في تعقيد الوضع على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بالدول العمالية المشوهة بيروقراطيا في روسيا وأوروبا الشرقية، يكفي أن نقول إن التطورات الثورية في ألمانيا الشرقية عام 1953 وفي المجر عام 1956 والتحركات في بولندا وتشيكوسلوفاكيا، تعرضت إما لتحريف مسارها على أساس قومي أو تم سحقها بوحشية من طرف البيروقراطية الروسية. يمكن للبرجوازية في أوروبا الغربية وأمريكا أن تشير بأصابع الاتهام إلى الستالينيين وتقول للعمال: “تريدون الشيوعية؟ ها هي الشيوعية!”، وسيستخلص معظم العمال الاستنتاج التالي:”الشيطان الذي تعرفه أفضل من الشيطان الذي لا تعرفه”.
لقد ظهرت الإمكانيات الثورية الهائلة التي تمتلكها البروليتاريا الأوروبية حتى في ذروة ازدهار ما بعد الحرب العالمية الثانية، في عام 1968، عندما قام عمال فرنسا بأكبر إضراب عام ثوري في التاريخ. في الواقع كانت السلطة عام 1968 في أيدي العمال الفرنسيين، لكن تلك الحركة الرائعة تعرضت للخيانة من قبل القادة الستالينيين لنقابة CGT والحزب الشيوعي. كانت أحداث فرنسا عام 1968 استباقا للتطورات الأكثر دراماتيكية التي اجتاحت أوروبا في السبعينات، والتي تزامنت مع أول ركود اقتصادي كبير منذ عام 1945. كانت هناك ثورات في اليونان والبرتغال واسبانيا وتحركات ثورية في إيطاليا وغيرها من البلدان.
مرة أخرى، وكما كان الحال في الثلاثينيات، تشكلت تيارات يسارية، بل وحتى تيارات وسطية، داخل المنظمات الجماهيرية في البرتغال واسبانيا واليونان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. لكن هذا الميل توقف عندما خرجت الحركات الثورية عن مسارها بسبب القيادة. بمجرد ما اقترب القادة الإصلاحيون اليساريون من السلطة، تخلوا عن خطابهم اليساري وانتقلوا بشكل حاد إلى اليمين. وفر ذلك الشرط السياسي لانتعاش الرأسمالية. وتأرجح البندول على مدى ثلاثة عقود نحو اليمين، وسقط العمال مرة أخرى في حالة من اللامبالاة، وأصبحت الفئات المتقدمة محبطة ومتشككة. كانت تلك فترة وصفناها بأنها فترة ردة رجعية خفيفة.
في ظل تلك الظروف تضاعف ضغط البرجوازية على الفئات العليا داخل الحركة العمالية بشكل حاد جدا. وقد تفاقمت هذه السيرورة بشكل كبير بفعل انهيار الستالينية. كانت البرجوازية مبتهجة، وتفاخرت بنهاية الشيوعية ونهاية الاشتراكية، بل وحتى نهاية التاريخ. لكن التاريخ أخذ ثأره أخيرا من البرجوازية والمدافعين عنها داخل قيادة الحركة العمالية. وبشكل جدلي تحول كل شيء إلى نقيضه.
خلاصة
إن المرحلة الجديدة التي دخلناها تشبه تلك السنوات العاصفة خلال فترة ما بين الحربين، أكثر مما تشبه فترة النصف الثاني من القرن الماضي. لكن هناك أيضا اختلافات عميقة. في سنوات العشرينيات والثلاثينيات كانت الحالة ما قبل الثورية لا تدوم طويلا. كان التناقض يحسم بسرعة من قبل حركة في اتجاه الثورة أو في اتجاه الثورة المضادة. في إيطاليا لم يفصل بين احتلال المصانع في 1919-1920 وبين زحف موسوليني على روما سوى عامين فقط.

لكن السيرورة الآن صارت أطول. والسبب الأساسي في ذلك هو تغير موازين القوى الطبقية. في معظم البلدان الأوروبية كان الفلاحون يشكلون نسبة كبيرة من السكان، حتى بعد عام 1945. وفي اليونان كانوا يشكلون الأغلبية. وهو ما وفر قاعدة اجتماعية للبونابرتية والردة الرجعية الفاشية. والشيء نفسه ينطبق على الطلاب والعمال ذوي الياقات البيضاء: المعلمون والموظفون العموميون وموظفو الأبناك، الخ. ولكن الفلاحين الآن تم تصفيتهم إلى حد كبير في أوروبا؛ وتم استيعاب العمال ذوي الياقات البيضاء ضمن صفوف البروليتاريا، وصاروا يتحولون إلى فئة كفاحية جدا. الطلاب، الذين كانوا قبل عام 1945 يوفرون قاعدة صلبة للردة الرجعية والفاشية، صاروا الآن في أغلبيتهم الساحقة ضمن معسكر الثورة.
لهذا السبب فإنه يمكن للأزمة أن تطول لفترة أطول بكثير مما كانت عليه في الماضي قبل أن تصل إلى نهاية حاسمة. هذا لا يعني أن الأمور ستكون أكثر هدوءا، بل على العكس تماما. ستكون هناك موجات صعود وهبوط سواء سياسيا أو اقتصاديا (انحطاط الرأسمالية لا يعني نهاية دورة الازدهار والركود، كما أنه لا يستبعد إمكانية الانتعاش المؤقت، والذي وقع حتى خلال فترة الكساد الكبير).
إن الموجات الحتمية لصعود وهبوط الدورة الاقتصادية لن تحل شيئا من وجهة نظر الرأسماليين. وبعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، يمكن حتى لانتعاش صغير (وهو أفضل ما يمكنهم أن يتوقعوا) أن يؤدي إلى نهوض للإضرابات في الجبهة الصناعية، حيث سيكافح العمال لاستعادة ما انتزع منهم أثناء فترة الركود. خلال الركود قد يكون هناك هبوط في النشاط الإضرابي، لكن سيكون هناك أيضا اتجاه نحو التجذر السياسي.
بالفعل هناك شعور بالضيق الشديد في كل أنحاء العالم. وبعد مهلة قصيرة بدأ الناس يفهمون أنه لا يوجد مخرج طالما بقي هذا النظام الجائر والظالم موجودا. إن السيرورة الثورية ما تزال تتطور وتصير أوسع وأعمق. ستكون هناك موجة تلو موجة من الإضرابات والمظاهرات، والتي ستكون بمثابة ساحة للتدريب بالنسبة للجماهير. فئات جديدة من الجماهير ستدخل إلى ساحة النضال – مثل الأطباء المبتدئين في بريطانيا والمزارعين اليونانيين ومضيفات الخطوط الجوية الفرنسية. لكن عمق الأزمة يجعل أنه حتى أشد الإضرابات والمظاهرات قوة لا يمكنها أن تقدم أي حل في حد ذاتها.
وحده التغيير الجوهري للنظام الاجتماعي من يمكنه أن يحل الأزمة. وهذا يتطلب عملا سياسيا جذريا. سوف تتميز الساحة السياسية بتقلبات عنيفة نحو اليسار ونحو اليمين. سوف تدخل الأحزاب القائمة في الأزمات والانقسامات. ويمكن لجميع أنواع التشكيلات الانتخابية اليمينية واليسارية أن تتطور. سوف تتحرك الطبقة العاملة من جبهة النضالات السياسية نحو جبهة النضالات الاقتصادية والعكس. ويجري حاليا إعداد هجمات جديدة وأكثر قسوة على العمال. إن الصراع الطبقي سيحسم في الشوارع.
يمكن للأزمة الحالية أن تستمر لسنوات – وربما عقودا- بسبب غياب العامل الذاتي، أي حزب ثوري جماهيري بقيادة ماركسية حقيقية. لكنها لن تسير في خط مستقيم. ستتوالى الانفجارات الواحد منها بعد الآخر. إن الوضع الحالي يحبل بالتغيرات الحادة والمفاجئة. وستكون هناك سلسلة كاملة من التحركات الجماهيرية والنضالات في كل البلدان الواحد منها تلو الآخر. سوف تهتز المنظمات القديمة من أساسها. فلنتذكر أن حزب بوديموس نما من لا شيء إلى 376.000 عضو في غضون 18 شهرا.
في بلد تلو الآخر ستقول الجماهير في نهاية المطاف: “كفى”. لكننا بدون سياسة ثورية واضحة وبرنامج ماركسي وبدون الأفكار الماركسية، لن نتمكن من الوجود باعتبارنا تيارا منفصلا ومستقلا عن الإصلاحيين اليساريين. إن الشرط المسبق لنجاحنا هو الحفاظ على هويتنا الثورية والحفاظ على أفكارنا حادة وواضحة. إن أية محاولة لتحقيق شعبية على المدى القصير عبر الاكتفاء بالسير جنبا إلى جنب مع التيار اليساري الإصلاحي ستنتهي في نهاية الأمر بكارثة.
إن الطريق نحو الانتصارات العظيمة يمر عبر مراكمة النجاحات الصغيرة. ما تزال مهمتنا هي كسب المناضلين واحد تلو الآخر وتثقيفهم على أساس النظرية الماركسية، وبناء روابط قوية مع الفئات الأكثر تقدما من العمال والشباب ومن خلالهم بناء روابط مع الجماهير. وعلى أساس الأحداث ستتعلم الجماهير. والأفكار التي لا يستمع لها الآن سوى أقلية صغيرة ستصل إلى أسماع عشرات ومئات الآلاف، وستمهد الطريق لبناء تيار كبير من الكوادر الماركسية والذي سيشكل أساسا لتيار ماركسي جماهيري قادر على النضال من أجل قيادة الطبقة العاملة.
نحن في الوقت الحاضر أقلية صغيرة، وهذا يعود أساسا لعوامل تاريخية موضوعية. طيلة مرحلة تاريخية كاملة بقيت القوى الماركسية الحقيقية ضعيفة ومعزولة. لقد كنا نسبح ضد التيار، لكن مجرى التاريخ قد تغير الآن. لقد صار التيار يجري لصالحنا. إن مهمتنا هي إعادة تأسيس تقاليد البلشفية أمميا وبناء أممية بروليتارية قوية مهمتها تغيير العالم. هذا هو الهدف الذي وضعناه على كاهلنا، وهو الهدف الوحيد الذي يستحق النضال والتضحية من أجله، إنه: هدف تحرر الطبقة العاملة العظيم.
تورين – إيطاليا- 31 يوليوز 2016
هوامش:
1]: نيكولاي كوندراتييف اقتصادي روسي مشهور باكتشافه لدورات طويلة الأمد للديناميكا الاقتصادية العالمية. وتلك الدورات معروفة الآن كموجات كوندراتييف. – ويكيبيديا –
2]: مارتن وولف محلل اقتصادي وكبير المعلقين الاقتصاديين في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية – المترجم –
3]: BRICS، اختصار للأحرف الأولى باللاتينية لبلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا. وهي البلدان التي تعتبر أسواقا صاعدة. – المترجم –
4]: الفصل (quarter) أو ربع السنة ويساوي ثلاثة أشهر.
5]: أتباع توني بلير – الجناح اليميني لحزب العمال.
6] ولاية فارسية – المترجم-
7] مضيق ملقة: ممر مائي يقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية، وهو بذلك بوابة تربط بين المحيطين الهادي والهندي. – المترجم-
8] النقابة الوطنية للصناعات التعدينية في جنوب إفريقيا
9] إعادة تقعيد الاقتصاد (The rebasing of the economy) سياسة تقوم على استبدال سنة مرجعية لقياس الناتج المحلي الإجمالي بسنة أخرى أحدث أو ببنية أسعار أكثر تحيينا.
10] نسبة إلى المرحلة التي حكم خلالها الزوجان نيستور كيرشنير، ما بين 2003 و2007، وكريستينا فرنانديز دي كيرشن، ما بين 2007 و2015. – المترجم-
عنوان النص بالإنجليزية:
Crisis and Class Struggle: World Perspectives 2016 – Part one
 ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية


